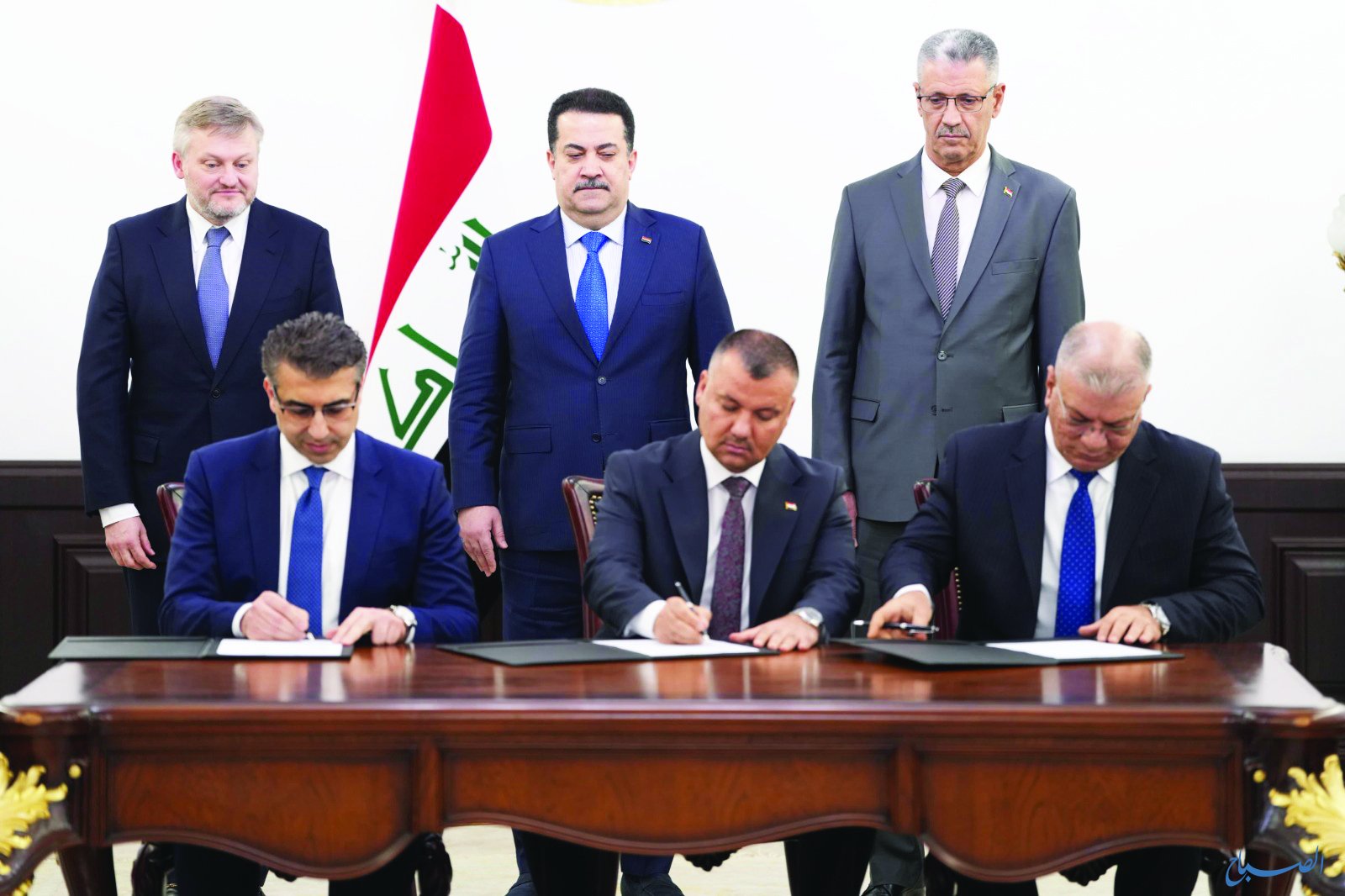هاشم شفيق: سجايا مسقط الرأس

د. عادل الثامري
تكشف قصيدة "سجايا مسقط الرأس" للشاعر هاشم شفيق، عبر شبكة من الاستعارات التصوريَّة، كيف يبني الشاعر قصيدة يحول فيها الفضاءات المادية إلى مستودعاتٍ للذاكرة، والفضاء المنزلي إلى جغرافيا سماويَّة، والجسد إلى تضاريس للنمو، والزمن إلى فضاءٍ مادي. تشتغل هذه الشبكة من الاستعارات على مستويات متعددة، إذ تربط التجربة المادية بالتجربة العاطفيّة والسياسيّة، وتحول المألوف إلى غير مألوف.
وتصل هذه البنية الاستعاريّة ذروتها في معالجة القصيدة للوعي السياسي، إذ يصبح الانتقال من براءة الطفولة إلى الإدراك السياسي مجسّداً في تحوّل الفضاءات من الانفتاح إلى الانغلاق. وبهذا، تقدم القصيدة رؤية لكيفيّة تشكل الهوية عبر التفاعل بين المكان والذاكرة والتجربة السياسيّة.
تشير نظرية الاستعارة التصوريّة، كما طورها اللسانيان الإدراكيان جورج لاكوف ومارك جونسون، إلى أنَّ فهمنا للتصورات المجرّدة متجذّر بشكل أساسي في تجاربنا الماديّة والمكانيّة. يوفر هذا الإطار النظري رؤى تتعلق بكيفية عمل قصيدة هاشم شفيق على مستويات متعددة. فالشاعر يوظف اللغة الاستعاريّة ليس كزخرف شعري، وإنما كأداة إدراكيّة تساعد القرّاء على فهم الطبيعة المجرّدة للذاكرة والنمو والهوية الثقافية عبر التجارب المادية الملموسة.
في "سجايا مسقط الرأس"، يُظهر الشاعر مهارة في بناء شبكات استعارية تربط المشهد المادي للطفولة بالمشهد العاطفي للذاكرة. من المياه الساحليّة، إذ يصطاد الأطفال النجوم المخبَّأة تحت الأحجار إلى الفضاءات المنزليّة المليئة بالوسائد المحشوّة بالغيوم، تخلق القصيدة عالماً يتحول فيه العادي إلى غير العادي بواسطة التفكير الاستعاري. يحاول هذا المقال قراءة اشتغال هذه الاستعارات التصوريّة لخلق تأمل في الطفولة والمكان والهوية في الشعر.
الطبيعة مستودعاً للذاكرة
تشتغل العناصر الطبيعيّة في قصيدة "سجايا مسقط الرأس" كمستودعاتٍ للذاكرة، إذ يتحول المشهد الساحلي إلى فضاء استعاري تُحفظ فيه اكتشافات الطفولة ودهشتها. تؤسس الأسطر الافتتاحية هذه العلاقة مباشرة، إذ يقول الشاعر: "هناكَ نشأنا/ قريباً من الماء/ نفتضُّ محّارةً/ ونراودُ موجاً/ لنصطادَه بالسنانيرِ". ويتجاوز فعل الصيد كونه نشاطاً حرفياً ليتحول إلى استعارة لاكتشاف الطفولة ومحاولة التقاط اللحظات العابرة. ومن اللافت أنَّ الأطفال لا يهتمون بالأسماك الحقيقيّة "ما همّنا سَمَكٌ لابط ٌ" بل يهتمون بـ " بل همّنا الضوءُ والمقتنى/من نجومٍ مخبّأةٍ تحت ذاك الحصى/ والترابِ المبطّنِ بالصدفِ الساحليِّ". هذا التحول الاستعاري من الصيد المادي إلى التقاط الضوء والنجوم يشير إلى كيفية تحول العناصر الطبيعيّة إلى أوعية لحفظ الذاكرة والوصول إليها.
تطور معالجة القصيدة للعناصر السماويّة هذا الإطار الاستعاري. فالنجوم ليستْ أجراماً سماويّة بعيدة بل أشياء ملموسة يمكن اللعب بها "مثل الكرات في الحقل". هذا التحول من الفلكي إلى الملموس يخلق واقعيّة سحريّة تميّز ذاكرة الطفولة، كما نرى في قول الشاعر: "نلعبُ بالشهبِ الساقطاتِ/ على الحقلِ مثل الكراتِ/ ونلعبُ بالثمراتِ التي سقطتْ/ جافةً في الظلالِ".
يتحول المشهد الساحلي نفسه إلى نصٍّ استعاريٍّ يمكن قراءته وتأويله. فـ "الصخيرات زرقاء" و"السماوات" التي "تلون أقدامنا في الشواطئ" و"تصبغ أظفارنا بضياء البدور" تشير إلى أنَّ العناصر الطبيعيَّة تترك علامات حرفيّة واستعاريّة على الأطفال، تاركة انطباعات دائمة تصبح جزءاً من هويتهم. ويعمل الماء، على وجه الخصوص، كعنصرٍ استعاريٍّ متعدد الأوجه. ففضلاً عن وجوده الحَرفي كبحر، يظهر في أشكال متنوعة - كندى، وكظلال يمكن شربها، وكصمت يمكن استهلاكه: "ونشربُ ما يتبقى/ من الظلِّ مبترداً في الوريقاتِ/ نشربُ ذاك الندى/ والنعاسَ بأجفاننا/ نشربُ الصمتَ في الأجماتِ/ ونعلكُهُ بضجيجٍ".
تشير تحولات العناصر الطبيعية هذه إلى مواد قابلة للاستهلاك إلى الطريقة التي تصبح فيها الذاكرة والمكان جزءاً داخلياً، يؤخذ حرفياً إلى الجسد ويصبح جزءاً من كيان المرء. إنَّ فعل شرب الظلال والصمت الاستعاري يمثل طريقة استيعاب الأطفال لبيئتهم ودمجهم لها في هوياتهم.
الفضاء المحلي جغرافيا سماويَّة
يشكّل تحول الفضاء المنزلي إلى جغرافيا سماويّة وأسطوريّة أحد الأطر الاستعاريّة الأكثر إقناعاً في القصيدة. فالأدوات المنزليّة والفضاءات اليوميّة ترتقي عبر لغة استعاريّة من أشياء عادية إلى حاملات للمعنى العميق. يبدأ هذا التحول مع السرير، حيث تُشحن المواد العادية بدلالات كونيَّة. فنجد الشاعر يقول: "الوسادةُ كانت معبّأةً بالغيومِ/ السريرُ من النخلِ نصنعُه في الهواجرِ/ والشرشفُ العائليُّ/ من الليفِ ننسجُه ليغطي سماءً"، تخلق الوسادة المحشوّة بالغيوم والسرير المصنوع من النخيل فضاءً منزليَّاً يوجد بين الأرض والسماء. والشرشف العائلي المنسوج من الليف "ليغطي سماءً" يشير إلى تجاوز الأشياء المنزلية أغراضها النفعية لتصبح جسوراً بين العادي والكوني. هذا التحول الاستعاري لأغراض غرفة النوم يخلق جغرافيا سماوية داخل المنزل، إذ يصبح النوم شكلاً من أشكال التواصل السماوي. وتطور القصيدة هذا الفضاء المنزلي السماوي عبر معالجتها للنشاطات المنزليّة التقليديّة. فتصبح أماكن تحضير الطعام وتخزينه مواقع للتحول السحري: "ننامُ حذاءَ الدواجنِ/ في خمّها برغلٌ عسجديّ/ تماهى مع الماسِ". يتحول مكان تخزين البرغل إلى فضاء تتحول فيه الحبوب العادية إلى ذهب وماس. هذا التماهي يحول الفضاءات المنزليَّة في الذاكرة الى مواقع للعجب والتسامي.
وتكتسب الجوانب الحسيَّة للحياة المنزليَّة أهمية خاصة في هذا الإطار الاستعاري: "على دقة الهاون المتهاونِ/ حيث الروائحُ تصعدُ/ في ضفّة من بذورٍ وطينٍ". يخلق صوت الهاون والروائح المتصاعدة طقساً منزليَّاً يحول المطبخ إلى فضاء تصبح فيه المواد العادية (البذور والطين) غير عادية في الممارسات اليوميَّة. الروائح المتصاعدة تشبه البخور، ما يشير إلى كيف تكتسب النشاطات المنزليَّة أهمية طقوسيَّة في الذاكرة. وبهذه التحولات الاستعاريَّة، يرتقي شفيق بالفضاء المنزلي متجاوزاً حدوده الماديَّة، خالقاً جغرافيا يتعايش فيها السماوي والعادي. يصبح المنزل ليس مجرد مكان للمأوى بل فضاءٌ أسطوريٌّ تكتسب فيه الأشياء والنشاطات اليوميَّة معنى أكثر عمقاً.
الجسد مشهداً للنمو
يقدم شفيق الجسد البشري كمشهد استعاري تتشابك فيه التجربة الجسديّة والعاطفيّة. يظهر هذا التجسيد لتطور الطفولة بشكل خاص عبر طريقة تصوير الإحساسات الجسديّة وتحولها إلى تجارب ميتافيزيقيّة. تقدم القصيدة استعارة جوهريّة لليقظة الجسديّة بواسطة صورة حليب الجاموس: "وحليبُ الجواميسِ/ أيقظَ فينا الذكورةَ/ أيقظَ نهراً يفيضُ بداخلنا، / سارحاً في الحنايا/ وتحت الضلوعِ". هنا، يصبح تناول حليب الجاموس استعارة للاستيقاظ الجنسي، إذ يتحول الجسد إلى تضاريس تجري فيها الأنهار تحت الأضلع وعبر المساحات الداخليّة. يقدم هذا الإطار الاستعاري النضج الجسدي على أنّه حدث جغرافي، يصبح فيه الجسد منطقة تُستكشف وتُستطلع. تطور القصيدة هذا المشهد الجسدي عبر أوصاف التفاعل الجسدي مع المحيط: "نخوّضُ في الكحلِ/ قرب جهاز العروسِ/ ومحملها الخشبيِّ/ وحنائها المتطايرِ بين المرايا". يمثل التفاعل مع الكحل والحناء والمرايا بجوار جهاز العروس تحول الجسد الى موقع للتدوين الثقافي. يقترح الإطار الاستعاري هنا كيف تصبح ممارسات الزينة الجسديّة وسائل لرسم الهوية الثقافيّة على الجسد.
وتبدو التجارب الحسيَّة قوية في بناء هذا المشهد الجسدي: "نشربُ ما يتبقى/ من الظلِّ مبترداً في الوريقاتِ، / نشربُ ذاك الندى/ والنعاسَ بأجفاننا". يمثل فعل شرب الظلال والندى كيف يصبح الجسد وعاءً لامتصاص وهضم التجارب البيئيّة. تخلق الرموش التي تشرب النعاس إطاراً استعارياً حيث تتجاوز الوظائف الجسدية حدودها المادية لتحتضن التجارب المجرّدة. وبواسطة هذه البنى الاستعاريّة، تقدم القصيدة الجسد ليس بوصفه كياناً مادياً فحسب، بل بوصفه مشهداً معقداً تلتقي فيه عناصر النمو الشخصي والهوية الثقافيَّة والتجربة الحسيَّة.
الزمنُ فضاءً مادياً
في قصيدة شفيق، تُصور التجربة الزمانيَّة باستمرار بواسطة استعارات مكانيَّة، وتشكّل بذلك إطاراً يصبح فيه الزمن مشهداً ملموساً يمكن اجتيازه والسكن فيه. هذا التمكين المكاني للزمن أساسي في كيفية بناء القصيدة للذاكرة والتجربة التاريخيَّة. إنَّ ترديد "هناكَ نشأنا" في القصيدة هو بمثابة رابط زماني ومكاني، يُحيل إلى أنَّ النمو لا يحدث فقط عبر الزمن بل في أماكن محددة. ينبني هذا الإطار عبر مشاهد مختلفة يصبح فيها الزمن ظاهراً بشكلٍ ماديٍّ: "في الليلِ نستدرجُ القصَّ/ عن غانياتِ المدائنِ/ والحَضَريّاتِ تلك اللواتي يَنمْنَ/ على شَبَقٍ ناعمٍ في الحرير السويسريِّ". هنا يصبح الليل فضاءً مادياً لاستدراج القصص واستكشافها. تخلق روايات نساء المدن النائمات على الحرير السويسري خريطة زمانيَّة - مكانيَّة تتعايش فيها فترات زمنية ووقائع اجتماعية مختلفة في الفضاء السردي نفسه.
تُظهر معالجة القصيدة للتحول التاريخي بشكل واضح في تصويرها للاستيقاظ السياسي: "استفقنا على صرخة الانقلاباتِ/ وقت السحورِ/ مُهيِّئةً للبلادِ النشيدَ الحماسيَّ". هنا، اللحظة التاريخيَّة للانقلاب هي استيقاظ مادي، ويعمل وقت السحور بوصفه علامة زمانيَّة ومشهداً مكانياً. ويصبح النشيد حضوراً مادياً يملأ مساحة البلاد- تجسيد الزمن التاريخي في الفضاء الجغرافي.
ويجري تصوير الحركة بين المراحل الزمنيَّة المختلفة عبر استعارات مكانيَّة للصعود والهبوط: "ثم نهبطُ للسطحِ/ ممتلئينَ ضياءً، / ففي الجيبِ نورٌ تضوّأ/ نحفنُه كالنقودِ". وتصبح هذه الحركة الرأسيَّة بين الفضاءات السماويَّة والأرضيَّة استعارة للانتقال بين الحالات الزمنيَّة المختلفة، إذ يعمل الضوءُ على أنّه تجسيد مادي للزمن يمكن حمله في الجيب مثل النقود.
وبواسطة هذه الاستعارات المكانية - الزمانية المركبة، يخلق الشاعر فهماً لكيفية اشتغال الزمن في الذاكرة والتجربة. لا يصبح الزمن مجرد تسلسل خطي فحسب، بل فضاء متعدد الأبعاد يمكن الإقامة فيه والعبور من خلاله والتجربة الفعلية لها، مما يشير إلى عدم قابليَّة فصل التجربة الزمانيَّة والمكانيَّة في ذاكرة الإنسان ووعيه.
الاستيقاظ السياسي عبر الاستعارات المكانيَّة
يقدم المقطع الأخير من القصيدة، ربما، إطاراً استعارياً أكثر تعقيداً، إذ يظهر الوعي السياسي عبر صور مكانيَّة. يخلق هذا التحول للوعي السياسي إلى تجربة مادية تعليقاً على كيفية مواجهة الأفراد للتغيير التاريخي. ويُؤشر الانتقال من براءة الطفولة إلى الوعي السياسي عبر استعارات مكانية متزايدة الضيق: "على لطمةِ الخدِّ/ حين يغيبُ العزيزُ/ وراء الغياهبِ/ مختلياً بالجدارِ/ وصفّارةِ العسسِ العسكريِّ". يقدم الإطار الاستعاري هنا القمع السياسي عبر مساحات متزايدة الضيق - من اللطمة على الخد إلى الحجز، وصولاً إلى المواجهة النهائية مع الجدار. تخلق "صفارة العسس العسكري" حدَّاً سمعيَّاً يعرّف أكثر هذه الفضاء من الوعي السياسي.
ثمَّ توسّع القصيدة هذا التمثيل المكاني للواقع السياسي: "حيث القطاراتُ تأخذُ أسرى ومعتقلينَ/ إلى نقرةٍ في الصحارى الغريبةِ/ تلك التي قضمتها الذئابُ/ وماتَ بأطرافها الهاربونْ". تصبح حركة المعتقلين السياسيين عبر الفضاء استعارة للتحول السياسي الأوسع في المجتمع. تمثل "النقرة" الصحراوية التي أكلتها الذئاب خلق العنف السياسي لمساحات من الغياب والفقدان. يؤسس الهامش الذي "مات بأطرافها الهاربون" جغرافية استعارية للمقاومة السياسية والقمع.
يقدم المقطع الأخير تبايناً حاداً مع فضاءات الطفولة المفتوحة في بداية القصيدة. كان الفضاء في البداية يتميز بالماء والسماء المفتوحة، بينما تقدم الخاتمة فضاءات متزايدة الضيق والتهديد. ويعكس هذا التحول المكاني بفعالية الاستيقاظ السياسي الذي يميز نهاية براءة الطفولة. ويظهر هذا الاستخدام للاستعارات المكانية لتمثيل الوعي السياسي مدى ارتباط فهمنا للواقعة السياسية بالتجربة المكانية. تقترح القصيدة أن الوعي السياسي نفسه هو نوع من الاستيقاظ المكاني - إدراك كيفية تشكيل السلطة والتحكم في الفضاء المادي، وكيف أن المقاومة غالباً ما تنطوي على التفاوض وتحدي هذه القيود المكانية.
لقد وظف هاشم شفيق الاستعارات التصورية لرسم لوحة متكاملة عن علاقة الإنسان بمكانه الأول. فالقصيدة لا تكتفي بسرد ذكريات الطفولة، بل تؤسس رؤية تتداخل فيها العناصر المادية مع التجربة الإنسانية. عبر تحويل البحر والبيت والجسد إلى فضاءات رمزية، يكشف الشاعر عن الطرق التي تتشكل بها ذاكرتنا وهويتنا. وتبلغ براعة القصيدة ذروتها في رصد التحول من عالم الطفولة المفتوح إلى واقع سياسي مقيّد، مما يجعل القارئ يدرك كيف يترك المكان بصماته العميقة على وعينا وإدراكنا للعالم. وهكذا تقدم القصيدة رؤية شاملة عن كيفية تشابك تجاربنا المادية والعاطفية والسياسية في نسيج واحد يشكل هويتنا وذاكرتنا.