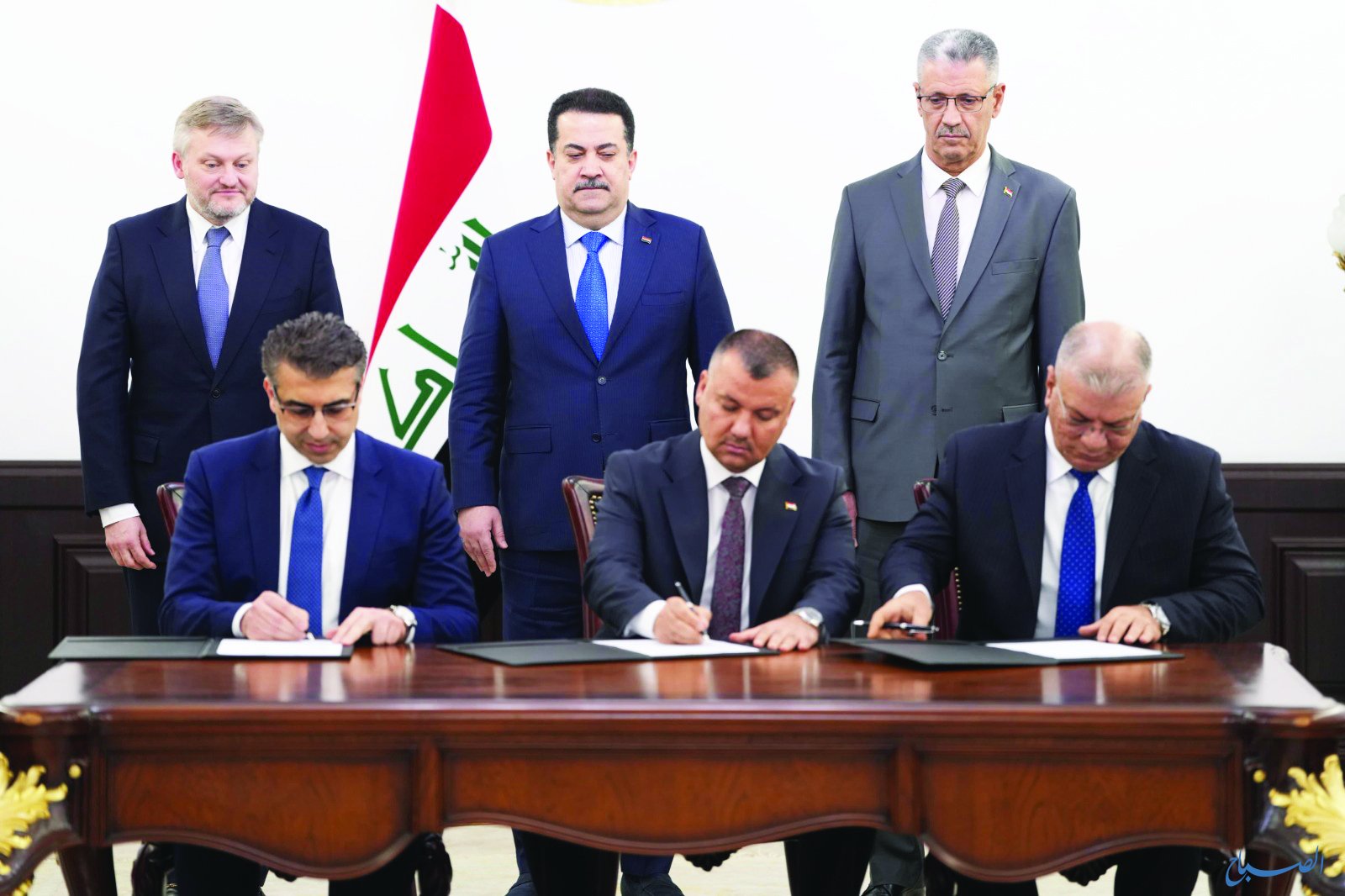سردٌ طويلٌ في الاستهلال.. حوارٌ قصيرٌ في الخاتمة
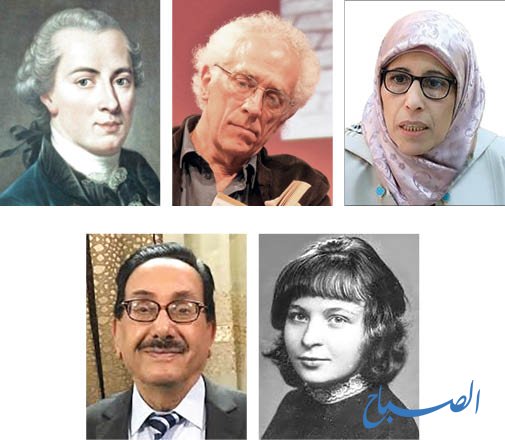
د. سلمان كاصد
من المنطق أن يتبع الباحث أصول الكتابة في الحقل الذي يشتغل فيه وخاصة في إطار الفضاء النقدي، بأن يستهل مقالته بمهاد نظري فيه علامات وإشارات إلى المنهج الذي سيتناول من خلاله موضوعه الرئيس، لكن أن تستغرق هذه المقدمة "الاستهلال النظري" في ثلثي مقالته فهذا مستغربٌ جدّاً، ويمكن أن يوصف بالاستسهال وعدم القدرة على تلخيص الأفكار بشكل دقيق وواضح، كي ينتقل إلى الموضوع الغاية الأساس من كتابة المقالة.
هذا ما جاء في قراءة الدكتورة نادية هناوي بمقالتها "تعقيب على مقالتين نقديتين: النقد الأدبي، ممارسة تتعدد.. خطاب يتمرد" التي نشرت في جريدة الصباح البغدادية يوم 13 شباط 2025.
وعلى وفق ما أشرت إليه في مقدمتي هذه من استسهال واسترسال طويل غير مستساغ بنائياً في تشييد نصٍّ يريد الكاتب أن يبدع فيه، فينسى غايته أي مركز مقصده؛ لذا تراهُ يذهب إلى ما هو خارج نصّه المراد توضيحه، ولهذا أجد أنني غير معنيٍّ هنا في مناقشة مقالة د. نادية هناوي، بما جاء فيها من شروحات وزيادات ومفاصل صارت متداولة في ساحة النقد النظري الذي تزخر بها الكتب العربيَّة الموضوعة والمترجمة، ومن هذه الزاوية أقول اختصاراً: تناولت الناقدة في مقدمتها (تاريخ الفلسفة الإغريقية، المدرستين السفسطائية والرواقية ثم المشائية، أرسطو وكتابه فن الشعر، أشعار هوميروس، واسخيلوس، وسوفوكليس ويوربيدس، والملحمة والمأساة، القرون الأولى للميلاد، لونجينوس وهوراس ثم انتقلت إلى النقد العربي القديم وترجمة أفلاطون وأرسطو وابن بري وشرح مقامات الحريري لابن الخشاب، وعبد اللطيف البغدادي ثم العصور الوسطى والعصور الحديثة، والمدرسة البنيوية وما بعدها، والمدرسة الفرنسية ونظريات التلقي ونقد استجابة القارئ، وتودوروف والفرنسيين والمدرسة الانجلو أميركية، والمدرسة الجديدة ونقاد بلاد المغرب، ونقاد بلاد المشرق، والدراسات البريطانية وما بعدها الفرنسية والاميركية، ودعوة عبدالله الغذامي في النقد الثقافي، وموت النقد والناقد، وجابر عصفور متذكرة آرثر ايزبرجر ومجلة فصول، وحوارات النقاد والقصاصين العراقيين ومنهم عبد الجبار عباس ومحمود أحمد السيد وشاؤول وشالوم وعبد الحق فاضل وعبد الملك نوري والتكرليين وعلي جواد الطاهر وفاضل ثامر). انتهت الأسماء التي تحدثت هناوي عنها في مقالتها.
ولذا وجب القول إنه كان هذا مسحاً نظرياً متراكماً لتاريخ عصور الفنون ونظريات النقد الادبي في التاريخ شرقه وغربه، ولكم الحكم على هذا العرض البانورامي الغريب حقاً الذي استغرق أكثر من ثلثي المقالة النقدية التي كتبتها الناقدة.
وبعد كل هذه المقدمة الاستعراضية الطويلة تتناول مقالتين في الربع الأخير من دراستها، الأولى لفاضل ثامر أطلقت عليها ممارسة تتعدد، والثانية للدكتور سلمان كاصد أطلقت عليها خطاب يتمرد.
تناولت هناوي قراءتي لمقالة فاضل ثامر عن النقد الفلسفي التي نشرتها في جريدة الصباح العراقية يوم الخميس 23/1 بعنوان (نقد النقد اشتغال في الأدبية لا الفلسفية).
ويمكنني أن أحدد عدداً من النقاط التي سأناقش ما جاء في مقالتها، وهي:
1: ترى د. هناوي أنني أعدت ما كتبه الناقد فاضل ثامر اجتراراً وتكراراً
وها أنذا قدمت لكم ما قالته في مقدمتها التي استلّتها من كتب لا حصر لها، ولا أريد اتهامها بالاجترار والتكرار المدرسي، الذي لم يعد خافياً على أي مشتغل في النقد الأدبي.
2: تدّعي د. هناوي أنني ناقشت هيكليّة مقالة فاضل ثامر التي يشاطرني العديد من النقاد بأنّها مقالة سريعة، لا ترقى لمستوى كاتبها، وأنني لم أناقش فحواها لأنها ليست فحوى كاتبها، بل فحوى نقاد الغرب الأوروبيين كون المقالة بمجملها مقولات لنقاد عالميين يتعارضون في المفاهيم بالمطلق حيث يستدرك أحدهم على الآخر في معارضة نقدية واضحة، لم يبنها الناقد فاضل ثامر في مقالته، كما تعيب على ما نصحت به في مقالتي أن نذهب عندما نناقش نقد النقد إلى (كولدمان ولوكاش والتوسير) كوني ما جمعت بين هؤلاء الثلاثة إلا لأنني أجدهم وقد اقتربوا في إطار المنهج السوسيولوجي البنائي وكثيراً ما عقبوا واستدركوا نظرياً على بعضهم، وبذلك هم خير مثال على الاختلاف في إطار الحقل النقدي الواحد، ولكن الغريب أنّها ترفض مني ذلك وترجع لتقول: (إننا نستغرب عدم إحالته إلى أصحاب نظريات القراءة والتلقي والاستقبال ونقد استجابة القارئ) وهي تقصد آيزر وياوس، إذ نجدها من جانبي رافضة ذات المقترح إلا أنه مقبول من جانبها، أي غرابة لا منطق في هذا الاشتغال الذي أجده لديها!.
3: في مقالتي أحلت موضوعة اللغات الثلاث: (لغة النص الأولى، لغة النقد الثانية، لغة نقد النقد الثالثة). إلى كتاب "نقد النقد في المغرب العربي" الذي نشر 2016 للناقدة الجزائرية بدرة قرقوي، وليست لفاضل ثامر، ومن هنا ادّعت د. هناوي أنّني أنكر على فاضل ثامر مساهماته في كتاباته المبكرة في هذا الحقل، قبل عقود وتحديداً بدراسته "النقد الأكاديمي في مواجهة شعرنا الحديث" والمنشورة في الأقلام ١٩٨٣، وهنا أشير للناقدة أن هذا الاختيار من لدنها، غير موفق فعلا، لأن مقالة الناقد فاضل ثامر لا تمت للنقد بصلة بل هي "عرض لأربع رسائل دكتوراه" لكل من:
1 - د. جلال الخياط في كتابه "الشعر العراقي الحديث. مراحله وتطوره". صدر عام 1970.
2 - يوسف الصايغ في كتابه "الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى 1958" صدر عام 1978.
3 - د. علي عباس علوان في كتابه "تطور الشعر الحديث في العراق" صدر عام 1975.
4 - د. محسن أطيمش في كتابه "دير الملاك.. دراسة نقديَّة للظواهر الفنيَّة في الشعر العراقي المعاصر" صدر عام 1982.
وفي ضوء ذلك نود أن نشكر فاضل ثامر لأنّه لخّص لنا بعرضه لهذه الكتب الأربعة، ما جاء فيها بـ (11) صفحة من الأقلام، حيث وصلت استلالاته منها ومن غيرها إلى (42) استلالاً.
ومع كل ذلك تقول د. هناوي: إنَّ الباحثة بدرة قرقوي عيال على مفاهيم ثامر. ومن المنطق أن نستنتج ونقول لها: إنّ ما بين كتابة قرقوي الأولى في 2016 وكتابة فاضل ثامر قبل ثلاثة أشهر، بون زمني شاسع وكبير، إذ يجد المتلقي الدراسة بأكملها في الرابط المرفق مع هذه المقالة والتي ادّعت هناوي أنّني لم أطلع عليها، وهي لم تعرفها أصلا.
4: من حسن حظي مع د. هناوي أنّها لم تتهمني بالسرقة من بحوثها، عندما كتبت مقالتي تعقيباً على مقالة الأخ ثامر، ولم أذهب بعيداً إلى عصور سحيقة كما فعلت، وما جئت به من أسماء في مقالتي، إنما أعدت كل الأسماء التي جاءت في مقالة فاضل ثامر، واليوم جئت بالأسماء كلها التي جاءت في مقالة هناوي.
5: تنكر د. هناوي أنني رفضت أن أصنّف "بارت و تودوروف و كولدمان" بالفلاسفة وهي ترى: (أن رؤاهم فلسفية مارسوها عبر التجريد والنظر وبالاستناد إلى ذلك التاريخ الضارب في القدم)، وبودي أن اقتطع جزءا من حوار تودوروف المنشور في مجلة فصول المصريَّة، والذي أجراه "جورجي كوسيكوف" لمجلة قضايا الأدب الروسية في 2006 والذي يقول فيه عن بارت: (لا أعتبر نفسي متخصصاً في إبداع بارت، بالرغم من أن شخصيته تركت لديَّ انطباعاً قوياً. أخشى ألا أجيبكم عن السؤال الذي طرحتموه، كما أنني لستُ واثقاً إن كان إبداعه يمتلك أي "تنظيم"، لعل من الممكن أن نطبق عليه تعبير الشاعرة الروسية تسيفتايفا: "ليست لديّ فلسفة، ولكنني أمتلك عوضاً عنها وجهة نظر"، ولغرابة هذه الباحثة د. هناوي، أنها توافقني من جانب ومن جانب آخر تقول "صحيح أن هؤلاء ليست لهم مدارس فلسفية، لكنهم لم يبتعدوا عن
الفلسفة".
6: تحدثت هناوي مستخدمة مفهوم تودوروف عن الحقيقة في كتابه (نقد النقد.. رواية تعلم) في التعليق على النصوص التي لا تهتم إلّا بالاستعانة بمفاهيم الفيلسوف الألماني "كانط" الجمالية، وطروحات الرومانسيين "شليغل ونوفاليس وشيلنغ" وهنا تتناقض الناقدة في هاتين الجملتين اللتين كتبتهما هي تحديداً في مقالتها:
أ - تقول: بدءاً حدّد تودوروف نقد النقد بأنه تعليق على النصوص، يهتم بالحقيقة.
ب- وتقول بعد ذلك: انتهى "تودوروف" بعد ذلك إلى أن النقد - ولم يقل نقد النقد - هو حوار.
كيف يحصل ذلك! والجملتان متناقضتان تماماً بين تحديد تودوروف لنقد النقد في (أ)، والى انه لم يقل نقد النقد في (ب)، وللتوضيح أيضاً أجد أن تودورف يعني بالحقيقة عدة معانٍ، ولكنه يقول: (ومن المهم بالنسبة للتحليل الأدبي معنيان الأول الحقيقة المرجعية أو اليقينية والثاني هو الكشف).
ويقترح نمطاً ثالثاً للحقيقة، وهي الحقيقة الدوغماتية التي لا علاقة لها بالنقد الأدبي - وهنا أدعي أنها لم تقرأ كتاب (نقد النقد.. رواية تعلم) بمجمله، بل قرأت مقدمته لأنَّ تودوروف أخذ يُحيل إلى ما هو خارج النص، والاقتراب من الرومانتيكية.
7: استخدمت الناقدة ألفاظاً لا تمت للحوار المعرفي بصلة مطلقاً وهي: (ما هكذا توردُ يا سعدُ الإبل، التكرار والخلط، زوبعة في فنجان، تعسفياً نقدياً).
ومن الغرابة أنَّ د. هناوي تزعم أنّها ناقدة حداثويَّة، تعيش في مستقبل النقد وتصوراته المعرفيَّة بينما تستشهد بمثل جاهلي، بدوي، متخلّف، وكأنّها تتصوّر مستقبلاً بدويّاً سيعيشه الفكر العربي، سيحيل العالم إلى صحراء فتسبقنا إليه.
عند هذه النقطة، أختم حواري بمقولة تلخص كل هذا الذي جاء في حوار د. هناوي، بالقول: "هذا هو آخر المراكب التي سيحرقها البحّار حتى أنه سيشعل نفسه معها".