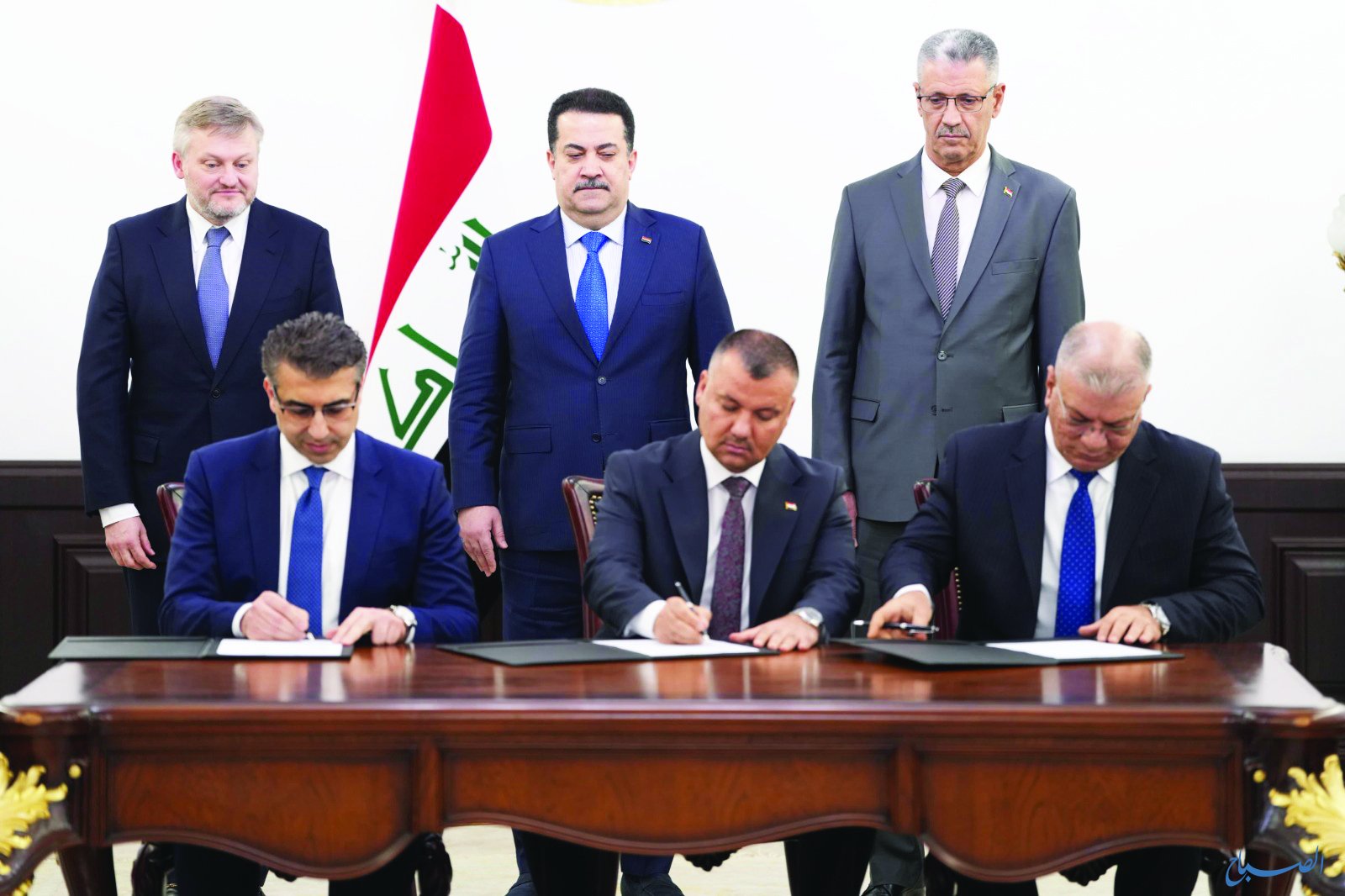الشعر ومعادلة فهم الحياة
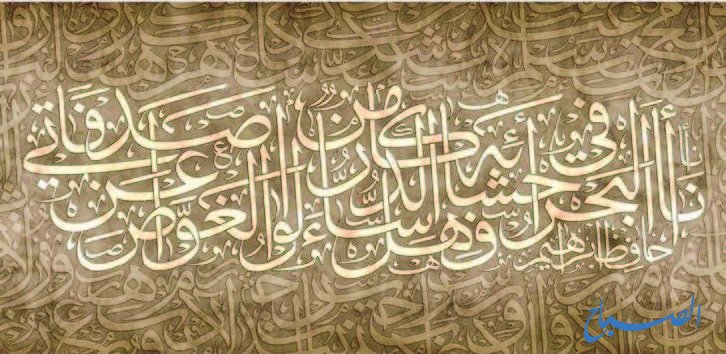
علي لفتة سعيد
الشعر تدوين، وكثيراً ما أكّدنا على هذه المفردة، وعدّدنا أشكاله, بنية كتابة، لعبة إنتاجية، تشكّل البناء/ بنية الكتابة. وهو أيضاً يمسّ الأجناس الأدبية الأخرى أيضاً، لكنه أيّ الشعر والأجناس الأخرى تعد تدويناً في كلّ الأحوال.
وهو أيضاً بالنسبة للشعراء محاولة لفهم العالم، فهم الداخل السيكولوجي من خلال ما يحيطه من مربّع حياتي أو الكون.
وبالنسبة للمتلقّين محاولة لاكتشاف العالم. وما بين الفهم والاكتشاف، تحصل المعادلة التي يمكن أن تكون مقلوبةَ الطرفين. الشاعر يريد اكتشاف العالم، والمتلقّي يريد فهم العالم من خلال آخر هو الشاعر. وفي الاثنين ثمة جسورٌ من المفردات التي تؤطرّها عملية الاشتغال، والقدرة على ممارسة هذا الاشتغال ليكون تدويناً إبداعياً.
ولكن السؤال العام الذي يمكن أن يكون خاصاً والعكس صحيح أيضاً: ما هي اشتراطات العمل، لكي نضبط طرفي المعادلة. المنطق الذي يحول الشعر إلى منطقٍ مقبولٍ، سواء في اللحظة الكتابية أو زمن التلقّي، والفهم الذي يحوّل المنطق إلى علاقةٍ زمكانية تتّصل بالبيئة والوعي الجمعي.
فكلاهما يشكّلان المركز المتفاعل مع الإنتاج، وبالنتيجة مع الاشتعال. فزمن التدوين يعتمد على مقدرة/ المنتج/ الشاعر على الإنتاج. ومقدرة الشاعر/ المنتج على بثّ النص إلى المتلقّي ليكون خطاباً بعد تلقّيه.
فهل فهم العالم يأتي من الشعر؟ وهل الشعر مجرّد تدوينٍ لماهية المخيّلة وفعالياتها؟ وهل هذه المعادلة التي يتم القبول بفرضيّتها هي الأصح» أم أن الفنون باتت أفكاراً كما هي الفعاليات الأخرى التي تعتمد على الموهبة، ومن ثم الاحتراف، كما هو السرّ في شعبية كرة القدم مثلا؟ أو أن شخصاً يتدرّب يومياً لبناء عضلاته، فهو يبدأ برفع حديدٍ بأوزانٍ قليلةٍ، حتى يصل إلى ما يستطيع من أوزانٍ ثقيلةٍ من أجل بناء/ تدوين العضلات، بطريقته البنائية، التي تعتمد على أسسٍ علميةٍ وليست مخيالية، لكنه بالنتيجة يريد عرض العضلات على المشاهد/ المتلقّي. وقد يشارك في مسابقاتٍ لكمال الأجسام أو رفع الأثقال وربما يمارس رياضة المصارعة، لعلّ أحداً يقول له، إن تدوينات العضلات ممتازة، لأن الاشتغال عليها كان صحيحاً.
إن معادلة فهم الشعر وتدوينه والعكس صحيح، تأتي من خلال المقدرة على فهم الشعر ذاته. ولأن غالبة الشعراء، لا يتفقون على إجابة سؤال: لماذا يكتبون الشعر، ولماذا لجؤوا إلى الاشتغال الشعري، وبالتالي تعدد الإجابات التي تكون واضحةً في بعضها وغامضةً لدى البعض الآخر. وربما هو ذات الأمر ينطبق على الأجناس الأدبية الأخرى، فإن القرّاء أيضا قد يجدون أنفسهم أمام هكذا سؤال: لماذا تقرأ الشعر؟.
فيجيب أنه لا يدري ولا يعلم لماذا يقرأ الشعر، ويستدرك البعض ربما لفهم العالم الذي يدوّنه الشاعر بطريقةٍ غير مباشرة، فنحن نعيش الواقع بالصورة المباشرة.
ولهذا نرى الشعراء مثلاً يتفنّنون بإجابة السؤال لماذا تكتب الشعر الذي أجرته مجلة الجديد اللندنية ويذكرون قول فالشاعر الألماني فريدرش هولدرلين الذي يجيب بقول أشبه بالوجود الحتمي :(إنني أعيش شعرياً على هذه الأرض. الشعر يرافقني لحظة تلو لحظة، حتى في النوم) بينما يقول الشاعر والباحث العراقي خزعل الماجدي في استطلاع لمجلة الجديد اللندنية :(أكتب الشعر لكي أشعر بالمعنى، أكتبه لأنه طاقتي اليومية المتدفقة من الينابيع السرية، أكتبه لأنه يعينني على خشونة أيامي وصرامة ما أكتبه خارجه، أكتبه لكي أحقق لماهيتي وذاتي امتلاء وجودهما، أكتبه لكي أهزم الماضي ولكي أصطاد المستقبل، أكتب الشعر لأني جعلت له وظيفة عملية محددة في حياتي وبها يكتمل الشعر عندي، أكتب الشعر لكي أشعر بفرادتي ولكي أدون أسطورتي الشخصية). بينما يعدّه آخرون، أنه حالةٌ روحيةٌ أو نفسيةٌ أو ميتافيزيقيةٌ أو دينيةٌ، أم بوصفه كتابةً وتوهّجاً لغوياً. هنا سرّ الشعر. كما يقول البعض الآخر وأعدّه سرّاً من أسرار الحياة، والحالة السيكولوجية التي لا تمتلك التحليل الثابت.
حتى إن ابن العربي يقول:
(إِنَّ الْوُجُودَ لَحَرْفٌ أَنْتَ مَعْنَاهُ
وَلَيْسَ لِي أَمَلٌ فِي الْكَوْنِ إِلَّاهُ
الْحَرْفُ مَعْنىً، وَمَعْنَى الْحَرْفِ سَاكِنُهُ
وَمَا تُشَاهِدُ عَيْنٌ غَيْرَ مَعْنَاهُ)
ويقول الشاعر والكاتب المغربي أحمد بلحاج آية وارهام في مقاله :»أسباب كتابة الشعر وقراءته» المنشور على موقع هسبريس (نكتب الشعر لتكثيف كمال إنسانيتنا ونقرأه لنرى العالم يحلم في دواخلنا بحلمنا..حين نكتب الشعر نروم أن نبرز كمال إنسانيتنا مكثَّفاً باللغة والخيال، وحين نقرأه نسعى إلى أن نحسَّ بالمتعةِ التي تُشبهُ ذوبانَ الذاتِ في بحرِ النِّرفانا، بل نقرأه لنرى العالمَ في دواخلنا يَحلُم بما نحلمُ به، ويرقص له وكأنه يصلي صلاةَ عِشقٍ لا نهائي).
إن هذه الإجابات تعني أن كتابة الشعر محاولةٌ لفهم العالم من خلال فهم الحالة الشخصية التي ترتبط بالميتافيزيقيا. وأيضاً ترتبط به كتدوينٍ مخلّص للحالة المخيالية التي يعيشها الشاعر/ المنتج. ولهذا فإن مفهوم الشعر أو فهمه يختلف من شاعرٍ وآخر، مثلما يختلف من ناقدٍ لآخر، ومن فيلسوف لآخر وبالنتيجة من متلقٍّ إلى آخر. ومنهم أفلاطون الذي يقول فلي كتابه «الجمهورية» ما يعني له الشعر من أنه (يقودنا إلى الشعور العميق بأحزان والآم الآخرين، وعليه فإنه يصغِّر نفوسنا ويضعف عزائمنا ويبعدنا عن أداء مهام واجباتنا. وإذاً يجب أن يكون الشعر مختصاً بتسابيح الآلهة فقط). ونذكر مقولة أرسطو الشهيرة إن (الشعر أكثر تفلسفًا من التاريخ؛ لأن الشعر يتعامل مع الكليات، والتاريخ يتناول الجزئيات) فرط الشعر بالتاريخ والتاريخ فعل الإنسان ومنهم
الشاعر.
معادلة الفهم والإفهام
إن الشعر وفق ما هو متيسّر من الفهم العام أمام الكثير من صراع الأقوال وتضادّها وتصارعها، يكون تدويناً للحياة وفهمها، مثلما يكون طريقاً لمعالجة الاحتقان الواقعي، من خلال فعل الخيال وطريقة التدوين، التي تحمل الدهشة. فالمتلقّي يبحث عما يشدّه من مفردات تقوده إلى فهم العملية التأويلية والقصدية التي تبديها وتظهرها كلكمات النصّ الشعري المدوّنة بطريقةٍ تفهم لعبة الشعر ويكون الإفهام علامة بارزة في المرام القصدي، وهو بالنتيجة يريد فهم العالم الذي يحيطه، ليكون منيباً عنه، من خلال فكّ أسرار الكلمات، وهو ما يعني أن فهم الحياة ممكنٌ من خلال التدوين. وهو ليس كلّ الفهم، بل هو جزءٌ من فهم منظومة الحياة من قبل المتلقّي الذي تتوسّع أمامه المقولات.
ولأنه تدوينٌ يأتي بعد الفهم، وفهمٌ يأتي باشتغالات التدوين، فإن المعادلة الكبرى هي كيفية فهم الاشتغال الشعري، لكي يكون مؤثّراً وقابلاً، لكي يكون بالتالي يكون إفهاماً للحياة، وله شأن مؤثّر في المتلقّي. من خلال الاحتكام لطرفيها: مكانة الشاعر التي كوّنها من تجربته وسعته ونشره وفهمه وتواصله، وكذلك قدرته على معرفة أسرار الاشتغال وإدارة اللعبة الإنتاجية التي تمنح الصورة النهائية شكل القصيدة التي تحمل الدهشة. وبالتالي إعطاء مزايا جديدةٍ لفاعلية النصّ الشعري، والدخول إلى معترك التأويل، الذي يبحث عنه المتلقّي الذي يبحث بدوره عن اشتغالٍ تدوينيّ ليفهم ما يريده الشاعر، ويساعده على التقرّب من الخفايا الميتافيزيقية والغرائبية في هذه الحياة.
إن هذه العلاقة بين الفهم والإفهام، تقود إلى معرفة السرّ في اختيار المفردات التي تكوّن القصيدة، سواء كانت عموديةً أو تفعيلةً أو نثراً، فالسرّ مخفيٌّ لا تعرف طريقة توضيحه، أو تشكيل خرائطه، وربما يمكن أن نطلق عليه السحرية، التي تحوم في المخيلة، لكي يكتب الشاعر هذا السطر أو ذاك. ولهذا فإن الإفهام يحتاج إلى التجربة، مثلما يحتاج إلى قوّة البلاغة في المقدرات وما تحمله من دهشة هذه البلاغة، فضلاً عن الحجّة المتورّدة في عملية الإقناع، وكذلك الشكل العام للنص، والاستنطاق المرجوّ من النص.
خاصة أن النص الشعري الحديث لم يعد كما كان في السابق، يعتمد على الاستماع والإلقاء الذي يجذب المتلقّي، فإن سوء الإلقاء خّربَ القصيدة، وأيضاً، فإن مساحات الاستماع قلّت وضاقت، وحلّت محلّها مساحات القراءة والتلقّي لما هو مدوّن. وهو ما يعني حصول التلقّي الإشكالي أيضاً، مثلما هو كائنٌ في إشكالية التدوين، وهو ما يعني الحاجة إلى الخروج على تقليدية القصيدة الإلقائية إلى التأمّلية. بل إن بعض الشعراء يبتعدون عن وضوح الشعر من قبل الآخرين، فيقسّم المتلقّين إلى أكثر من فئة. وهو ما قاله أدونيس في كتابه «زمن الشعر» حيث الخروج على كلّ شكل من أشكال فهم الشعر الحديث (أُفضّلُ أن ترفضني الثقافة البرجوازية الموروثة على أن تقبلني وتدجنني. وأفضّل أيضاً ألّا تفهمني الطبقات المسحوقة، في هذه المرحلة، على أنْ أُخاطبها بشعر ليس فيه من الشعر غير الاسم).
البيئة والاشتغال النثري
إن النظرة الفاحصة لأهمية النصّ الشعري الذي يتم تحديده بقصيدة النثر، متّبعاً خطى القصائد الأخرى، من قصيدة العمود والتفعيلة وغيرها، هو ما يمكن أن يعطيه الشاعر من تجربته لفهم النص الشعري وتدوينه من جهة، وفهمه للبيئة التي يعيش فيها، وممكنات الفكرة التي تستلّ من هذه البيئة، وهو ما يعني في ذات الوقت أن التجربة الشعرية تمنح النصّ شكله اللغوي، الذي لابد من توافر الرؤية الخاصة به كنصّ أوّلاً، ومن ثم كشاعرٍ يفهم المسؤولية في إنتاج النصّ وتصديره، وحتى توريده إلى الذات الشاعرة. وبالنتيجة فإن مقولة أبا العميْثَل لأبّي تمّام (لمَ لا تقول ما يُفهَم؟ فأجابه: ولمَ لا تفهم ما يُقال؟ ).. وهنا تدخل معادلة التدوين والفهم للنصّ الشعري، الذي بدوره يوصل إلى فهم الحياة، حيّز القبول بهكذا معادلة. وهو هنا مرتبط أساساً بالقدرة على الإنتاج الشعري، والقدرة على تكوين مواد أوّليةٍ للاشتغال الشعري، التي تكون موادّ خالصةً، تأخذ من الآخر المؤثّر ولا تكون مثله حتى لا تتشابه المنابع ولا المصبّات ولا الخضرة التي تعطيها النصوص المبدعة، التي تريد توسيع فهم
الحياة.
وهو مرتبطٌ بفهم النص الشعري من قبل المتلقّي، الذي يجد أن النصّ أمامه محتشدٌ بالقصديات وقابلٌ للتأويل، حتى لو كان بغير ما أراده المنتج/ الشاعر.
وهذا الارتباط بين فهم الشعر وطريقة الاشتغال، يأتي من خلال التفاعل بين مفهوم التدوين ومفهوم الغاية، التي بدورها تعطي مفهوماً للشاعر في كيفية فهم المحاكاة التي تعطيها المفردات في النص. حتى أن أرسطو قال في كتابه «فن الشعر» على أن الوزن لا يعطي المحاكات، لأن (من ينظم نظرية في الطب أو الطبيعة يسمى عادة شاعراً، ورغم ذلك فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنباذ وقليس إلّا في الوزن، ولهذا يخلق بنا أن نسمي أحدهما شاعراً (هوميروس) والآخر طبيعياً أولى منه شاعراً) وهو ما نؤكّد عليه من أن التأثّر موجودٌ، لكنه لا يكون متشابهاً مثل تشابه الأوزان في القصيدة العمودية، لكن المحاكاة تمنحها المفردات المغايرة بهدف الابتعاد عن التطابق. لذا فإن الاهتمام بالمعاني التي تولّدها المفردات، يعني الاهتمام بالاشتغال الشعري الذي يعطي مدلول الفهم لما حول الشاعر، وبالتالي مساعدة المتلقّي لفهم ما حوله من خلال الشاعر. لأنه أي الشاعر يولّد متعةً من أجل الوصول إلى لذّة الفهم التي تعطي إدراكها التفاعلي ما بين النصّ والتلقّي. وهو الأمر الذي ينعكس على المتعة التي يعطيها الاشتغال، والتي تعطيها فاعلية المفردات التي تساعد على فهم الحياة. وهو ما أكدته العمانية موزة الريامي في مقالها «فهم الشعر أسهل مما تظن» المنشور في موقع نادي كلمة من أن (واحدة من المتع العظيمة في قراءة الشعر هي أن تشعر بمعاني الكلمات كما تبدو في حياة كل شخص، وكذلك البدء في الانتقال إلى عالم أكثر نشاطاً وكَلفاً. الشعر يشعرنا بأن لغتنا المعتادة لها دلالة، وأنها أكثر حيويةًـ حتى أنها يمكن أن تكون كلمات نبيلة. الكلمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية تحمل في طيَّاتها مستودعات عميقة للتاريخ (الشخصي والجماعي) يمكن إحياؤها من خلال
قصيدة.).
لذا فإن ما يميّز الاشتغال أنه يعطي تدويناً إبداعياً، ويعطي فهماً للحياة، وإفهاماً للمعاني، من خلال قدرة المناورة على إنتاج النص الشعري، الذي يكون أصعب في قصيدة النثر منه في القصائد الأخرى، التي تعتمد على الموسيقى، والتي تعطي مفعول التفاعل الخارجي، في حين قصيدة النثر تعطي مفعول التفاعل الداخلي المنبعث إلى الخارج.