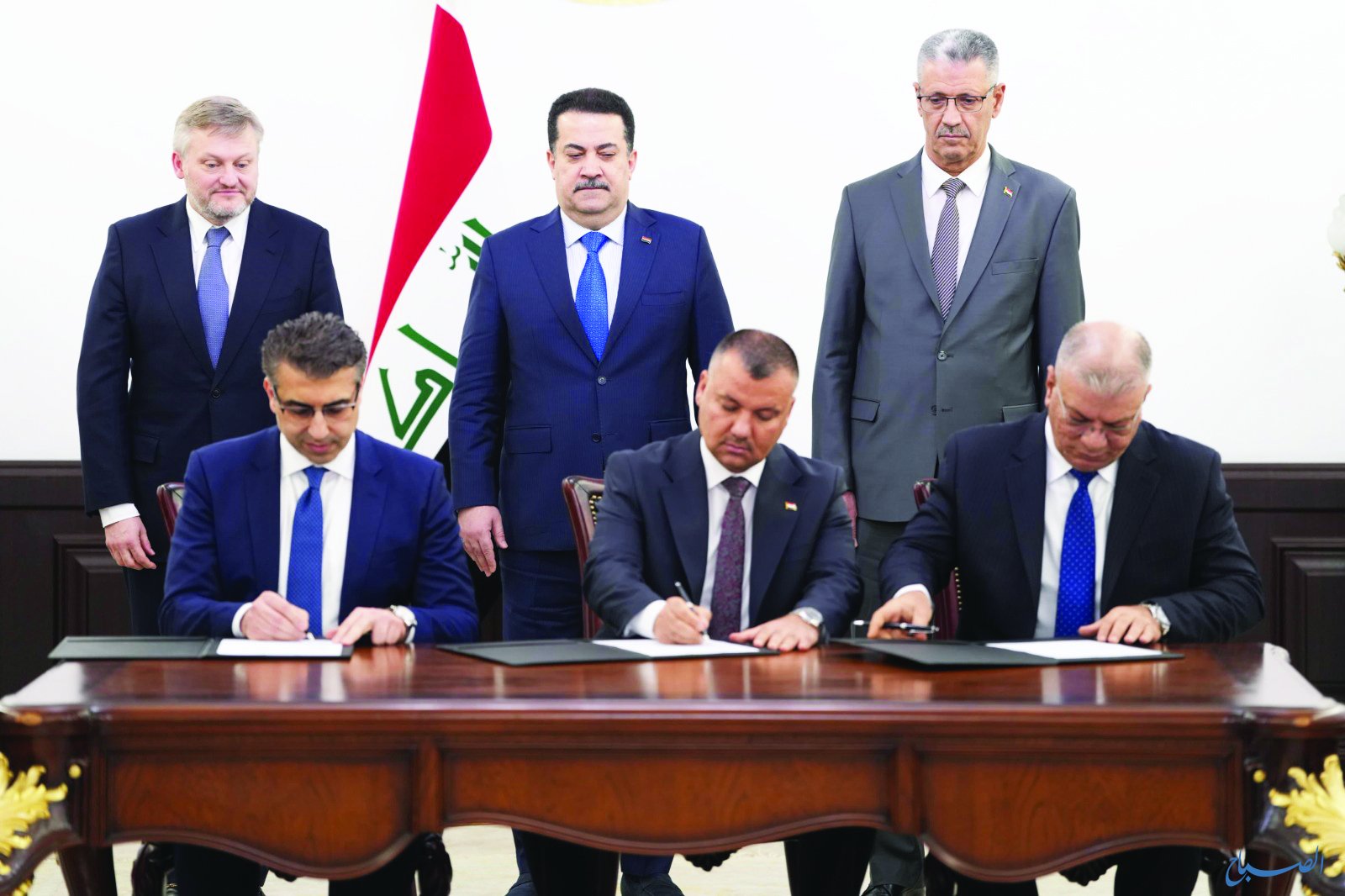كولاج تأويل.. دُخانٌ مُزيلٌ للجُّثَث
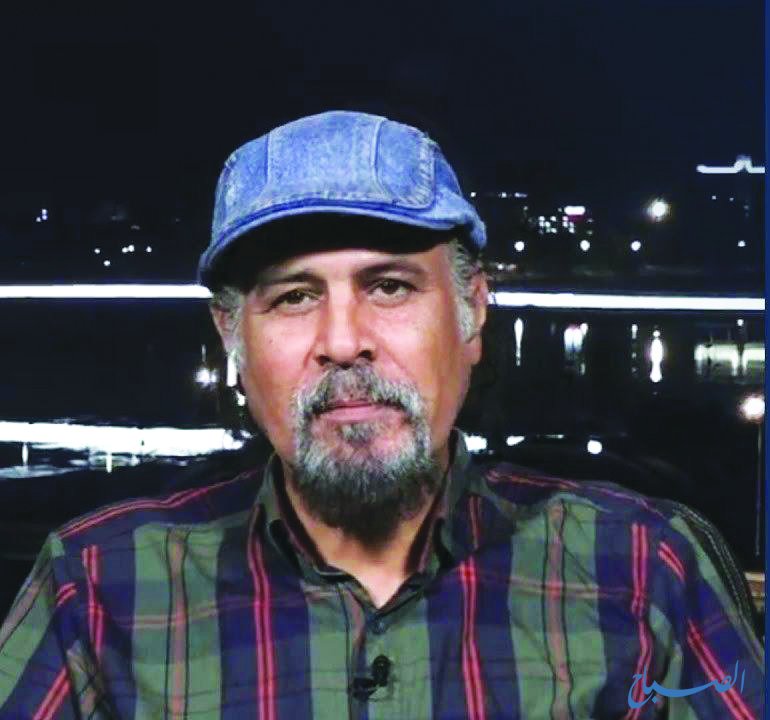
علي شبيب ورد
كثيرون هم الشعراء الذين يكتبون الشعر، غير أن الذين يعيشونه حياة وسياقا تعبيريا عن مواقفهم الإنسانية، تجاه معضلات الوجود بكل تنويعاتها، هم قليلون. فما جدوى الكتابة الخالية من رؤية تأمليّة فيما وراء الظواهر، بحثا في الدهاليز والأعماق، لاكتشاف الجواهر واللقى الكامنة؟ والشعر - على اختلاف اشكاله - نراه نتاجَ مخيلةٍ تمورُ في مرجلها، صورٌ عديدة لحوادث الفائت والراهن وتصورات الآتي، لكنها تمرُّ على مونيتير ذي بصيرةٍ "عاطفية/ ذهنية" ينتقي منها ما يصلح لنصِّ التدوين. فليس الشعرُ تعبيرا عن عواطف ذاتية، لا ترقى به الى ما هو عامٌّ يفضي به، الى طول زمن بقائه في الذاكرة، ولا هو اتباع لما هو ذهني، يوقعه في وعظيةٍ جامدةٍ مملةٍ. بل هو مزيجٌ متوازن بين ما هو وجداني وما هو عقلي، يبعد النصَّ عن الميل لأحدهما. ويأخذ به لسياقٍ سليمٍ مضيءٍ بأنساقٍ "سيميائية/ دلالية" مزدانة بجماليات أداءٍ اتصاليٍّ، جاذبٍ ومدهشٍ ومحرّضٍ للمتلقي. فكثيرة هي النصوص الشعرية التي لا تخلد كثيرا، جراء عدم توفرها على سياقٍ متوازن.
لسنا مع الخطاب الشعري المرتمي بين أحضان "ترغيب وترهيب" شتى السلطات، فلا خلود للشعر إلّا في تحرّرهِ للتعبيرِ عمّا هو انساني خالص، وليس في عبوديته لأغلال منفعةٍ أو سلطةٍ غاشمةٍ. وهذا الارتماء المخجل، نراهُ موتا للشعر قبل موت صاحبه، الذي لم يتمكن من تحرير نفسه فعلا من أية سلطة، وحتى من سلطة الموت، كي يعبر الموتَ حيا. حسب قول الشاعر والناقد الفرنسي ألان جوفروا "عبور الموت حيا، هو الرِّهانُ في حياةٍ محرّرةٍ فعلا من أيِّ دينٍ، من أيةِ سلطةٍ، ومن أية حتميةٍ"(مجلة الآخر الصادرة عن مؤسسة 40/ العدد 1 صيف 2011/ حوار أنطوان جوكي مع الشاعر والناقد الفرنسي ألان جوفروا / ص342). وما ذهبنا إليهِ أعلاه، هو ما يدعونا الى إجراءِ فحصٍ منقّبٍ في كتاب "مرايا عمر سعدون" للشاعر عدنان الفضلي. والذي ينطوي على ثلاثة كولاجات تأويل، يليها استدراك، ثمَّ ملحق رؤيوي. وكما يلي:
أجسادٌ تدوِّنُ القصائد
النصوص الواردة في الكتاب، هي قصائد احتجاج ثوريَّة، كتبها الشاعر جراء معايشةٍ يوميَّةٍ لأهم أحداث ساحات تشرين التي اكتظّت بالثائرين ضد الجوع والحرمان والفتك اليومي. وهي تعبير عن تجربة ميدانيَّة لبعض مجريات تظاهرات سلمية لشعبٍ يبحث عن وطنٍ حرٍّ يطاق، غير هذا الوطن المسلوب الإرادة، جراء هيمنة تابعين لخارجه، أشبعوه ذلّا وقهرا وسغبا. إنهم بحارة سفن الثورة لوطنٍ جديد معافى، هم أحفاد "زيوسدرا" بطل سفينة الطوفان، الذي انتقاهم ليكتبوا أساطير نبلهم ونقائهم وعشقهم لبلاد الرافدين. "سومريون../ كثيرا ما ضحكوا على تجارتهم الخاسرة/ ثوريونَ.. لا يريدُ الآخرونَ سماع نشيجهم الوطني/ مهمّشونَ.. لكنّهم غير مُقَمّطين/ لذلك اختارهم العراقُ بحّارةَ السّفنِ الثائرة". و"تنقطع خطوط بداياتهم حين يلمحونَ وجهَ أنكيدو يسيلُ على صدرِ تشرين" ولم يعلموا "أنَّ بعضَ الدينِ، قاتلٌ مُحترِفٌ!!" و"لأنهم.. يحرصون على ذاكرةِ دجلةَ../ خاليةً من ذكرى هولاكو../ ماتوا على الجسرِ" أحياءً، وأجسادُهم دوَّنتْ أساطيرَ القصائد.
أمكنة الهتاف والغناء والبسملة
شموعُ تشرينَ أضاءتْ أمكنة العتمة، ولهيبها الصّاعق، فضحَ الناهبين لزرقة السماء، بسواد تديُّنِهم، والمشوِّهين للصلصال، بصدأ عقولهم. وفتيانُ البلادِ، لا همَّ لهم، غير الهتاف والغناء بعد البسملة، ولا يملكون من بلادهم سوى "مساحةٍ قصيرةٍ/ تلك التي يهرول فيها الأولاد/ فما بين جسر الجمهورية وساحة التحرير/ هناكَ بضعة أمتارٍ من الدُّخانِ/ وغيمةٌ مسرعةٌ من الرّصاصِ.." وذاكرة الفتى عمر سعدون" محصورةٌ بين حدائقٍ وحرائقٍ/ لا الصُّراخُ ينقذهُ/ ولا الإشارةُ يفهمها الأوباشُ/ لذلك استدارَ عائدا الى الجسرِ/ وجوفُهُ مليءٌ بالبارودِ والدُّخانِ" وثمَّة فتيانٌ "كانوا في ساحةٍ ميسانية/ يرسمونَ العنادلَ و... ولِشِدَّةِ ولعهم بالغناء كانوا يحتسونَ دُموعَ أمَّهاتهم" و "حين أيقنَ أنْ لا جسرَ آخرَ في الناصرية/ يسمحُ بعبور حفنةِ أحلامهِ الى الضِّفَةِ الأخرى/ حزَمَ عمر سَّعدون جميعَ مراياهُ ومضى" وفتى سوق الشيوخ "رفضَ قداسةَ الخرافةِ/ ومازَجَ بين العطشِ والسراب/ ومضى الى السماء/ بجناحينِ من قصب" لذا فأمكنة تشرين أقدس من أروقة خرافاتهم.
صورة تشرين الشعرية
كثيرة هي المشاهد التي تتجلى فيها جماليات الصورة الشعرية في النصوص الماثلة، غير أننا ذكرنا خمسة نصوص منها وهي: "يوسف الذي لم يعرض عن هذا وذاك/ على قارعة أرضٍ تسمى العراق/ المدينة والزجاج الذي يمشي حافيا/ جمانة النهر والنوارس" فيوسف الزبيدي "وبرفقةِ حمامتين/ كان كلَّ يوم تشريني../ يُجَهِّزُ لجواد سليم/ وجبةَ غداءٍ ووجبةَ غناءٍ" وهو "لا ينتمي الى الوسادات النَّزِقةِ/ ولا يحتسي المشروبات الخاملة/ هو المُدمِنُ الوحيدُ../ الذي يشربُ دموعهُ، حينَ يرحلُ الشُّعَراءُ" يمثلُ يوسف نموذجا للنبلِ والشهامة والعشق للبلاد، التي أهملته في متاهةِ بئرِ المحوِ، لتفتح ذراعيها لأخوته الفاسدين. وفي نص آخر، تعلو الأسئلة الى روح جمانة التي ضحّتْ بنفسها لوطنها المثخنِ بالجراح والعتمِ والمآتمِ بينما هم ينعمون بملذّاتهم السِّرِّية. "لماذا يا جمانة.. بقيتِ مُصِرَّةً على الجسرِ/ وأنتِ تعرفينَ أنهم يتمرَّنونَ يوميا../ على قتلِ النَّوارس/ لماذا.. لماذا/ تبنين كلَّ هذه الأعشاشِ/ أَلَمْ يُخبروكِ بأنَّ../ لا مستقبلَ للبلابلِ في العراق؟".
استدراك:
ولاكتمال جدوى إجرائنا الفاحصِ، نستدرك قبل فوات الأوان، بالوقوف عند عنوان ومتن قصيدة الغلاف التي استحضرت أيقونةَ تشرين من عرين خلوده، بعنوانها "مرايا عمر سعدون". وذلك عبر الوقوف عند بانوراما المرايا العاكسة لموقف جيلٍ ثوريٍّ تمرَّدَ على القيود والمتاريس والخطوط الحمر والأسلاك الشائكة، باختلاف بؤر وثوبها وتغوِّلها على أعناق المخدوعين جهلا، بخرافاتها. فالعنوان كبنية سيميائية يتكون من تعبير مجازي هو "مرايا" عن رؤى الشاعر حول مجريات يوميات التشرينيين، وهم يواصلون توديعهم لأحدِ النوارس، كعمر سعدون أو سواه. وهذه البنية تخفي تحتها بنية دلالية ذات مسارب أفقية وعمودية تنفتح على لقى مضمرةٍ، تكشف للمتلقي معاني النص. وكل مرآةٍ تعكس رؤية معينة حول حادثٍ أو معضلةٍ، تتنافس فيما بينها لإنتاج منظومة بثٍّ اتصالي مؤثرة على القارئ ومحفِّزَةً له على القراءة المتأملة والتأويل الجاد. فالمرآة الأولى تشير الى عدم حيادية السماء كخيمةٍ للجميع، منذ بدءِ حراك تشرين ولما سيأتي مستقبلا.
وتُعَبِّر الثالثة، عن صورة شعرية لافتة، فهي تمسح دمعةً "جواد سليم" التي هوت على رأس "صفاء السراي" وتدلُّ على كفاءة الشاعر في انتاج سيناريو شعري نازحٍ للجمال. والرابعة تستل رذاذا من الفرات لريافة جروح شهداء مجزرة جسر الزيتون في الناصرية. والسابعة تربط ما بين تشرين السماء وتشرين الأرض في تضامنهما ضد الجور والحرمان. ولمَ لا؟ فالفاسدون في الأرض، فرضوا سلطتهم، بادِّعاء أنهم حماة سلطة السماء على الأرض. والتاسعة تحيلنا لنورسةٍ مسعفةٍ شهيدةٍ، مَزَّقتْ حجابَها لتضمِّدَ به جراح النورس الشهيد ثائر الطيب. وهذا النص وسواه من النصوص، هي شهادات احتجاج ضِدَّ جرائم لصوص الربِّ، والمؤدين السيِّئين جدا لأدوار غيرهم، والقاطنين في بيوت من زجاج لا تُخفي عوراتهم ولا دناءاتهم مهما تبرَّجوا. وهي تروي سيرة جيلٍ رأى العالمَ يعيش بمودَّةٍ ورحمة، لأنه ينعم بالحريات الانسانية الأساسية، "حرية الصحافة والتعبير وحرية كل شخص في أن يعبد الله على طريقته، والتحرّر من الحاجة، والتحرّر من الخوف" (كتاب دليل أكسفورد في الفلسفة, تحرير تِد هُنْدرتْش/ ترجمة نجيب الحصادي/ هيأة البحرين للثقافة والآثار/ ج1/ ص628).
ملحقٌ رؤيويٌّ:
بعد اجرائنا الفاحص أعلاه، نُشيدُ بكتاب "مرايا عمر سعدون" للشاعر عدنان الفضلي. لأنَّ نصوصه توثِّق حراكا وطنيّا مشرّفا في سفرِ العراق، بفضلِ ثورةِ جيلٍ نبيلٍ من فتيانٍ فادين، عَلَّموا آباءهم الصبرَ والثَّبات على درب الحرية. وكانوا أساتذةً أوفياءَ لهم داخل صفوف الشرف والكرامة والكبرياء في مدارس ساحات التحرير والحبوبي والساعة، وسواها، وانجلت الغشاوة عن عيون المخدوعين بأفيون "لا تفكِّرْ لها مُدَبِّر" فتبصّروا في الأمل. والنصوص استمدّتْ توهجها وكفاءتها الاتصالية، من كونها جاءت تعبيرا عن معايشة ميدانية للشاعر الذي لم يتغيب يوما عن ساحاتها. إنها اشهاريةً بامتياز وفاضحةً لردود أفعال زبانية السلطة، وكانت مجازر قتل التشرينيين، وصمة عار لهم ولجميع مصادر جبروتهم ضد الثورة، التي أورقت وردا وأينعت ثمارا وفاحت عطرا لذاكرة العراق. لقد مثُلَتْ النصوص أمام المتلقي بجرأةِ صياغةٍ وحسن تطَلُّعٍ وبلاغة إيحاءٍ، بإعلان تمرّدها على السكون وأكَّدَتْ براءتها من التَّعَكُّزِ على موسيقى القصيدة، نحو أراضٍ حرامٍ وعرةٍ.
وهكذا سياقٌ شعريٌّ، قدْ لا تُحبِّذُهُ الذائقة الخام المستسلمة لصرامة الوزن الشعري، المهيمن بأنغام موسيقاه الممتعة للسامع، والملبية لنزوات مشاعره ولجَبُلّةِ تآلفهِ مع المتعارف. وهو يتحدى ضراوة تضاريس الفُسحةِ الاتصالية مع المتلقي، بمغامرةٍ محفوفة باحتمال سوء الإصغاء. وذلك بالاعتماد على ما توفره طاقات السرد من حرية رؤية واتساع انزياح وتنوّع اشتغال، لبث شبكةٍ دلاليةٍ مدهشةٍ للمتلقي الفطن. وهذا التحرّر يأخذ الشاعر لكتابة النص المفتوح، غيرَ أنَّ هذا الانفتاح على "نصوص وخطابات غير شعرية سيجعلنا أمام تفاعلات جديدة تنتج عنها احتمالات شعرية جديدة كان من الصَّعبِ تصوّرها. وهكذا يمارسُ الشعرُ حيويتهُ وينبض من جديدٍ في أنسجةٍ نصيّةٍ وخطابية أخرى مجاورة، أفقيا وعموديا" (كتاب العقل الشعري لخزعل الماجدي/ دار الشؤون الثقافية العامة/ الكتاب الثاني/ بغداد 2004/ ص197). لقد نجح الشاعر في كتابة نصوصِ دخانٍ مُزيلٍ للجُثَثِ، ومفتوحةٍ كساحاتِ تشرينَ على المحتملِ والجديدِ من متغيرات فكرية واجتماعية وسياسية.