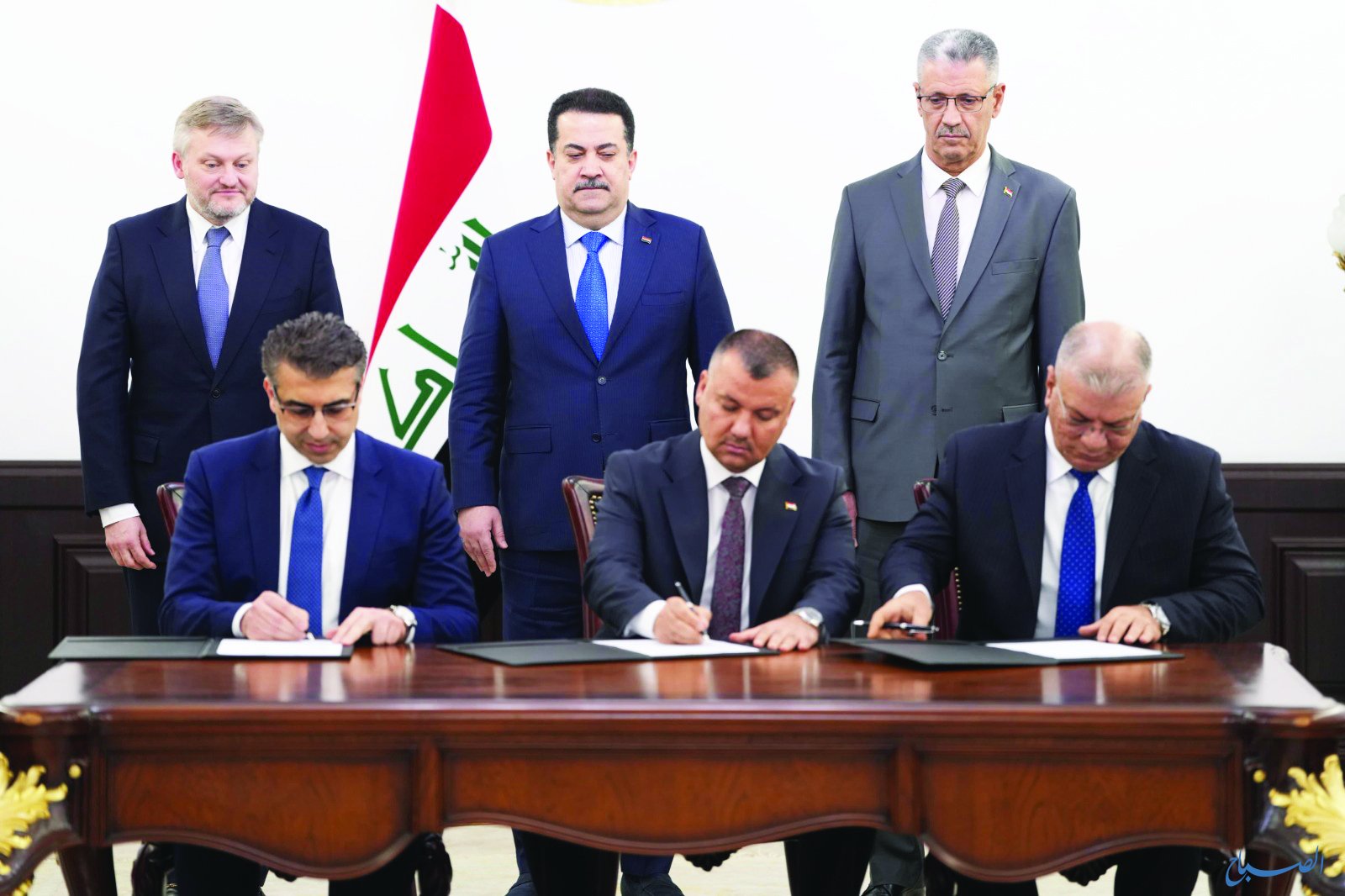تَيماء واستعادة الطوفان الملحميّ

شاكر الغزي
آخر أحد عشر بيتاً بحسب رواية الأصمعي، وبزيادة بيت عند غيره، من معلّقة امرئ القيس، تتحدّث عن السيل الجارف أو الطوفان الذي اجتاح بلدة تيماء، ابتداءً من وصف البرق الوامض والسحاب المتداني وسحّ المطر الغزير، ثمَّ اندفاع الطوفان المدمّر الذي ضاقت به الأودية، واقتلع الشجر من الجذور، وهدم حجارة القصور، وأفزع الطيور في أجوائها، وأخرج الحيوانات من أَخبائها، وجرف المتاع والسِّباع الغرقى وكأنّها عُروق بَقْلٍ هشّة!.
لا شكّ أنّ امرئ القيس نظم معلّقته مقاطع مقاطع على غرار المعلّقة الأولى، أعني ملحمة گلگامش؛ فجعل آخر مقطع وصفاً لطوفان تيماء محاكاةً للملحمة، واستعادةً لقصة الطوفان الأسطوريّة التي خَتمت بها الملحمة لوحها الحادي عشر.
والمعلّقات، هي مطوّلات ملحمية عربية نُسجت على منوال ملحمة گلگامش؛ وقد أحصى الدكتور إحسان الديك في بحثه القيِّم (علاقة المعلّقات بملحمة جلجامش) أربعة عشر وجهاً من أوجه التشابه بين الملحمة والمعلّقات، ولا سيّما المعلّقة المِعيار: معلَّقة امرئ القيس. يقول الدكتور إحسان: (ويقتفي حامل لواء الشعراء، وممثّل العقل الجمعي الجاهلي امرئ القيس خُطى جدّه شاعر الملحمة ونهجه، بأن ختم معلّقته بالحديث عن السيل الذي كان رمزاً أسطورياً للطوفان الرهيب الذي خُتمت به الملحمة، وكان تكراراً للنموذج الأصيل الكامن في اللاوعي البشري، نموذج الموت والانبعاث وتجدّد الحياة بعد الموت، ولقد كان امرئ القيس على علمٍ ودراية ووعي بحدث الطوفان بدليل شهرته عند الجاهليين وتعاور شعرائهم على توظيفه في أشعارهم... وقد ظهر جليّاً في شعر أمية بن أبي الصلت، وعدي بن زيد العبادي).
ثمّ يُكمل الدكتور الديك: (تشي الألفاظ والمعاني والرموز والصور التي ذكرها امرئ القيس في لوحة سيل المعلّقة بهذه المعرفة، وتتقاطع في كثير منها بما ورد في الملحمة).
وفي الملحمة، برز جبل (نصير) الذي أمسك بالسفينة، وفي سيل امرئ القيس برز جبل (ثَبير) رمزاً للثبات والنجاة. وفي الملحمة نجد الحمامة والسنونو والغراب التي أطلقها أُوتونَپشتِم لتأتيه بخبر اليابسة، وفي المعلّقة يذكر امرئ القيس طيور المَكاكيّ وهي تُغرِّد فرحة مُؤذنة بانتهاء السيل وعودة الحياة.
والملاحظ أنّ بين الرواة اختلاف كبير في ترتيب الأبيات الأخيرة، وفي ألفاظها كذلك، ويبدو أنّ هذا الاختلاف ناشئ عن محاولة الرواة تقديم المعلّقة بصورة متناسقة قابلة للفهم المنطقيّ. ويمكن إعادة ترتيب الأبيات الإثني عشر بناءً على التشبيهات التي بدأها الشاعر بـ(كأنَّ)، وهي تأتي بعد تأمّله، وهو يراقب البرق، كما يمكن الاستعانة بترتيب التوقيتات التي ذكرها في أبياته، وهي: (مع الليل، غُديَّة، غُدوة، أضحى، عشيَّة)، وهو ترتيب لم يُراعِه الرواة والشُّرَّاح.
تبدأ لوحة السيل بثوران البركان في الليلة الماضية، ثمّ تخبّط طيور المكاكيّ بسبب انبعاثات الدخان البركانيّ في الغُديّة، وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس، ثمّ استمرار البركان بقذف الحمم في الصحراء في الغداة، حتّى انسكاب المطر الغزير في الضحى بسبب المنخفض الجويّ الذي سبّبته حرارة البركان العالية، وحدوث الطوفان الذي خرّب مدينة تيماء واقتلع النخل والشجر وأغرق الحيوانات وجرفها وكأنّها جذور هشّة؛ إذ في المساء، كان الطوفان يغطّي نواحي تيماء من أقصاها إلى أقصاها.
يبادر امرئ القيس صاحبه الحارث بسؤاله: (أَحارِ ترى برقاً)؟ بمعنى: هل سمعت بحكاية البرق المعهود؟ وجاءت برقاً منكّرةً لغرض التهويل والتعظيم؛ ليُعلَم أنّ الحديث عن برق عظيمٍ ذي أهوال عهده الناس. وبما أنّك لم تسمع بخبره؛ فأنا (أُريكَ)، أي أخبرك بحكايته، فيشرع في السرد قائلاً: (وميضُهُ كلمع اليدين في الحَبِيِّ المُكلَّل)، أي اللمعان الناتج بفعْلِ عمَل القدرة الإلهية في السحاب المتداني المتراكم فوق بعضه كالإكليل.
علمياً، يحدث البرق لوجود فرقٍ في الشحنات ناتجٍ عن تداني سحابتين أو أكثر، والشَّحن يحدث نتيجة وجود جزيئات ماء صغيرة أو بلّورات جليدية فوق السحابة نفسها. وعليه، فالحَبيّ المُكلَّل هو السحاب المتداني الذي يحمل أعلاه قُطيرات ماء أو بلّورات جليدية صغيرة، وكأنّه إكليل مرصّع بحبّات الجواهر.
والأرجح أنّ وميض البرق هنا هو ثوَران بركانٍ على رأس جبل! وإلّا فكيف يُشبّه لمعان برق السحاب بنفسه. والوميض وهجُ احتراق الأجسام أو إشعاعها؛ ومنه قيل: وميض المنارة للضوء الخارج منها بفعل إشعال مصباح فيها بأوقات متقطّعة؛ ولذلك شبّهه امرئ القيس في البيت التالي بمصباح الراهب: (يُضيء سناهُ، أو مصابيحُ راهبٍ أَهانَ السِّليطَ في الذبال المُفتَّل)؛ بمعنى أنَّ مصابيح هذا الراهب تتّقد بتأجُّج وشدّة؛ لأنّه صبّ الزيت على الفتائل بغزارة ولم يبخل به. ومثلُها ثوران بركانِ أعلى الجبل؛ فهو متأجِّج بشدّة رغم تقطّعه، وجاءت مصابيح بالجمع، كناية عن تعدّد الومض.
قعد امرئ القيس لتأمّل هذا الوميض المتأجِّج في بادية نجد، وقعد أصحابه في بادية الكوفة وتأمّلوه أيضاً، رغم بعد المسافة بين مكاني التأمُّل (قعدتُ له، وصُحبتي بين ضارجٍ وبين العُذيبِ، بُعْدَ ما مُتأمَّلي). وقد حشد أسماء عدّة جبال في هذا المقطّع للتدليل على أنّ السبب الرئيسيّ وراء طوفان تيماء هو ثوران البراكين في رؤوس هذه الجبال؛ فقد وُصِفَ جبل قطَن ــ ذكره بقوله (علا قطنَاً) ــ بأنه جبل أحمر قريب الفوّارة! والمقصود أنّه جبل بركانيّ! ويكتسي الجبل باللون الأحمر بسبب الرماد البركاني الأحمر الذي يقذفه فيسيل على سفوحه. والفَوَّارة، قرية بالظهران، سُمّيت بذلك نسبة إلى مياهها التي تفور من تلقاء نفسها. والأصل أنَّ الفَوَّارَةُ في اللغة، تعني ما تقذفُ به القِدْرُ من فَوَرانها، أو هي ينبوع شديد الحرارة يفور بين حين وآخر قاذفاً ماءً ساخناً وبخاراً وأحياناً وَحْلاً. وأجزم أنَّ الفوّارة منطقة براكين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ﴿وفارَ التنّور﴾، أي: غلا واضطرب وارتفع ما في جوفه، والتنّور البركان! والعرب كانت تُسمّي البركان: جبل النار. وذكر ماكُوردي أنَّ الفوّارة أشبه ببركان صغير ينطلق منه البخار والماء الحارّ، وترتبط عادةً بنشاط بركانيّ.
تبدأ حكاية طوفان تيماء، مع حلول الليل؛ إذ ألقى أحد البراكين الثائرة ثِقله، وما في جوفه من المقذوفات والحمم؛ فأفزع الحيوانات النائمة المطمئنة، وأخرجها من منازلها فزِعةً بسبب الوميض الناريّ الذي أضاء الليل، ومذعورةً بسبب الحمم الملتهبة التي تساقطت عليها في منازلها الآمنة في بُسيان. وذلك معنى قوله: (وألقى ببُسْيانٍ، مع الليل، بَرْكَهُ؛ فأنزلَ منه العُصْم من كلِّ مَنزِل).
ثمَّ (ألقى بصحراءِ الغَبيطِ بَعاعَهُ نُزولَ اليمانيْ ذي العِياب المُحمَّل)، وبعاعه، أي ثقله ونفسه، والأصل فيه هو الإلحاح، والمعنى: أنّه ألحَّ بإلقاء مقذوفاته في صحراء الغبيط الواسعة حتّى صار منظرها يشبه ما نشره التاجر اليمانيُّ من بضاعته ومتاعه في حمرته وصفرته.
وقيل المراد ما أخرجه المطر من النبت! أي أنّ نزول المطر عمَّ هذه الصحراء بالخصب وأنواع النبات والنَّوْر، فكأنما نزل بها تاجر يمانيّ ونشر ما في عِيابه من البرود الملوّنة والمتاع.
وهذا المعنى مستبعد؛ لأنّه يشبّه البعاع الملوّن حال سقوطه الآن بنزول التاجر، لا ما سيترتَّب في المستقبل البعيد على نزول المطر. ثمَّ إنّ المطر الغزير، أو السيل، لا يُنبتان الأرض، وإن نبتت فذلك يكون بعد أسابيع وربّما أشهر، فكيف ساغ له أن يُشبّه صورةً غير كائنة بعدُ، بنشر اليماني لبضاعته المختلفة الأشكال والألوان.
وقد صرَّحت ملحمة گلگامش أنّ طلائع العاصفة المُسبّبة للطوفان بدأت في المساء: (في المساء قائد العاصفة الموكّل بالزوابع سيُمطركم بمطرٍ من قمح)، وذكر طه باقر أنّ ذلك تورية؛ فقد استعمل الكاتب كلمتين بابليتين تعنيان معنى مزدوجاً: إما الطعام أو الهلاك. وفسّر المفكّر عالم سبيط النيليّ تشبيه المطر بحبَّات القمح بأنَّه دالّ على تساقط حبّات الرماد والخَبَث المحترق التي يرمي بها البركان عادةً من مسافات بعيدة.
كما ذكرت الملحمة أنّ المطر سيستمرّ حتّى الفجر، ولكن حبّاته ستكون طيوراً وأسماكاً: (سوف يُسقط عليكم مطراً كثيراً، طيوراً متخفّيةً وأسماكاً، وحمّصاً عند الفجر)، وفسّره النيليّ بأنَّ الأجسام المتساقطة تشبه الطيور والأسماك والحُمّص؛ لأنّ أشكالها مختلفة وهي داكنة اللون سوداء قاتمة.
وذكر امرئ القيس الطيور المترنّحة عند الفجر، بسبب الدخان البركانيّ، بقوله: (كأنَّ مَكاكيّ الجِواءِ غُديَّةً صُبحْنَ سُلافاً من رحيقٍ مُفلفَل)، والمَكاكيّ نوع من الطيور، والجِواء موضع في القصيم. وقد تكون جمع جَوٍ، والجَوِيْ صفةٌ من الجوى، وهو شدّة الحرقة في الصدر، وهي بهذا المعنى صفةٌ للمكاكيّ، وإن وردت على نحو الإضافة؛ بدلالةِ قرينتين: الأولى، ذكر النحّاس أنه يُروى: كانَّ المكاكيَّ، بالتعريف وهذا يستلزم أن تُنصب الجِواء بعدها على النعت. والثانية، أنّ البيت فسّر سبب جوى المكاكيّ بأنّها سُقيت من شراب مُفلفل؛ أورثها الحُرقة في الصدور. بمعنى أنَّ هذه الطيور تتخبّط وتترنَّح في طيرانها مع بداية الفجر، عكس المعتاد من نشاط الطيور في هذا الوقت؛ بسبب الحرقة التي في صدروها وكأنْ سُقيت شراباً حارقاً، ولكنّ الأمر ليس كذلك! فحرقة قلوبها بسبب الحيرة والفزع والذعر ممّا استفاقت عليه من منظر مهول عند الفجر.
وهذا البيت لم يروه الاصمعيّ. فإنْ كان هذا مكانه، كما نرى، فهو تشبيهٌ كتشبيه الملحمة للمطر البركانيّ، أو ترنّحُ طيور الجوّ بسبب السحابة البركانيّة والتي ذكرتها الملحمة: (ولمّا بدت أنوار السحر، علت من الأفق البعيد غمامة ظلماء، وفي داخلها أَرعدَ الإله أَدَد). وإن كان مكانه في آخر المقطع؛ فهو كما قالوا أنّ المكاكيّ تُغرِّد، وكأنّها سكرى، فرِحةً بالخصب الذي سيكون بعد انحسار الطوفان، وهذه الصورة تشبه صورة الطيور التي أطلقها نوح، ومن قبله أُوتونَپشتِم، بعد انحسار الطوفان.
لعلَّ الجبل الأشهر في قصة طوفان امرئ القيس، هو المُجيمر، وهو جبل أسود صغير، لم يتغيّر اسمه إلى اليوم، يقع في نواحي نجد. يُشبه شكل المجمرة. وقد شبّهه امرئ القيس بفَلْكة المُغزل: (كأنَّ ذُرى رأس المُجيمرِ غُدوةً من السيلِ والأغثاءِ فَلْكةُ مُغْزل)؛ ومغزى هذا التشبيه أنَّ أعالي جبل المجيمر مستديرة ومرتفعة عمّا حولها من السيل والأغثاء (حَميلة السيل)، فبرزت وكأنّها فلكة لمَّا استدار السيل حولها.
وروى الأصمعي: (كأنَّ طَميَّة المُجيمر)، وطَميّة جبل في نواحي نجد. وحيث لا يسوغ إضافة المجيمر إلى طميّة وكلاهما جبل؛ عدَّ الأصمعيُّ المُجيمرَ أرضاً! والحال أنّه جبل معروف.
وبحسب الدكتور تنيضب الفايدي في (صيد الذاكرة)، فطَميّة جبل مخروطي له قمة مستطيلة، تميل صخوره إلى اللون الأحمر. يقع في منطقة القصيم، وقد ذكره أمرئ القيس في معلّقته مرَّة باسم (طميّة المجيمر) ومرّة باسم (المجيمر). وقد وصفه علماء الجيولوجيا بأنَّه من الجبال البركانية، وتوقّعوا أن يثور بركانه في عام 2014م، ولكنه لم يثر.
تروي الأساطير الشعبية أنّ جبل طميّة كان ضمن حَرَّة كَشَب، ولكنّه انتقل قريباً من جبل قطَن؛ لعلاقة حبّ بينهما! وبقي مكانه هناك يُعرف بمقلع طميّة، والغريب أنّ فوّهة هذا المقلع تتساوى تماماً مع قاعدة جبل طميّة.
وحول جبل طميَّة جُبيلات صغيرة، هي تكوينات بركانية على الأكثر، تقول الأسطورة أنهم أبناء طميِّة بعد أن تزوّجت من جبل آخر. والمراد من كونهم أبناء طميّة أنّها تكوينات بركانية من مقذوفاته خلال إحدى ثوراناته.
أمَّا مقلع طميَّة في الطائف، ويُسمّى أيضاً: بركان الوَعَبة. فهو عبارة عن فوّهة بركان خامد منذ مئات السنين، تعتبر من مخلفات براكين حَرَّة كَشَب المشهورة المتكونة في العصر الكمبري. ويعتقد بعض الباحثين أنّها تكوّنت نتيجة انفجار بركانيّ؛ فأكثر أحجارها من البازلت المتكوّن أثناء الطفح البركانيّ.
وهذا يجعلنا نحتمل أن يكون سيل طميّة الذي عناه امرئ القيس في بيته، هو سيل بركانيّ!.
ويمكن أن نستنتج من (طمم) ابن منظور في لسان العرب، أنّ طميّة، يمكن أن تكون حمولة ما علا فوق رأس جبل المجيمر من الأغثاء النارية العظيمة والمهولة، والتي ألقى بها من جوفه وباطنه، كما يلقي المتقيِّئ بَرْكه الذي في صدره، أو بَعاعه الذي في جوفه، وقد سال بعض هذا البعاع والبَرْك البركاني على سفوح الجبل فصار حول فوّهته (ذرى رأسه) وكأنّه فَلكة المُغزل، وهي الشَّعر والهلب الكثيف العالق في فم الفصيل، أو كلِّ جُدَيّ يُراد فصله عنّ أمّه (المُغْزِل: الظبية ذات الغزال) لئلّا يرتضعها. وعلى معنى استدارة فَلكة المِغزل فيمكن أن نفهم ذلك على أنّ السيل البركانيّ ينقذف من رأس الجبل على شكل حلقات مستديرة على سفوحه؛ مما يجعله مخطّطاً، وهذا ما أوحى لامرئ القيس بتشبيه جبل ثبير بأنّ عليه بجادٌ مزمَّل، أي وكأنّه ارتدى ثوباً مخطّطاً: (كأنَّ ثبيراً في عرانينِ وبْلهِ كبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزمَّل).
بل، ويمكن الاحتمال أنَّ البرق الذي وثّقه لنا امرئ القيس، وتأمّله هو وأصحابه من مكانين مختلفين بينهما مسافة كبيرة؛ لشدّة وميضه، هو نتيجةٌ لثوران عدّة جبال متقاربة في آن واحد، هي: قطَن، وطميَّة (رأس المجيمر)، وثَبير؛ ولذلك ذكرها معاً.
وبسبب الدخان البركانيّ المنبعث طيلة الليل؛ تكوّنت سحب كثيفة متدانية، وفي الضحى سحّ المطر منها بغزارة: (وأضحى يسحُّ الماء عن كلِّ فيقةٍ)، ثمّ سكن بمقدار فواق ناقة، ثمّ سحَّ ثانية؛ فاندفع السِّيل بقوّة جارفاً دوح الكنهبل: (يكبُّ على الأذقان دوح الكنهبل)، وهو شجر عظيم، اقتلعه السيل وألقاه على وجهه، وهادماً البيوت المسقّفة، إلّا ما كان مبنياً بالصخر الضَّخم: (ولا أُطُماً إلّا مشيداً بجندل)؛ فإنّه سَلِم لقوّته.
لم يترك هذا الطوفان في بلدة تيماء ــ تتبع حالياً لتبوك ــ شجراً ولا حجراً إلّا اقتلعه ودمّره، ولا بشراً ولا وحشاً إلّا أغرقه وجرفه. وفي الملحمة، نقرأ: (تحطّمت الأرض الفسيحة كما تتحطّم الجرّة، وظلّت زوابع الريح الممطرة تهبّ يوماً كاملاً، وازدادت شدّةً في مهبّها حتّى غطّت الجبال، وفتكت بالناس).
وفي آخر المعلقة، شبَّه السباع الغرقى مساءً بما نُبش من العنصل (كأنَّ السباعَ فيه غرقى، عشيَّةً، بأرجائهِ القصوى، أنابيشُ عُنصُل) وهو البصل البرّي، وقد ذكرت كلُّ الشُّروح أنّه يُعمَل منه الخلُّ العُنصلاتيّ، وهو أشدُّ الخلّ حموضةً! ولا يُقدَر على أكله. أي أنّ الطوفان جرف الحيوانات الغرقى وكأنّها جذور بقول رخوة، فضلاً عن أنّها ــ لو قُدّر انتشالها ــ لا يمكن أكلها لأنّها شديدة الحموضة بسبب السيل! وهذا يُذكّر بالمكاكيّ التي كأنْ سُقيت شراباً مفلفلاً حارقاً؛ وهذا فيما أفهم، بسبب أنَّ السيل حامضيّ، إذ اختلط سيل البركان ومقذوفاته ــ ومعظم الحجارة البركانية حِمضية ــ بطوفان الماء الذي أغرق السباع، كما أنّ الطيور أصابتها بعض حجارة البركان أو استنشقت دخان سحابته البركانية.
وفي الملحمة تشبيه مقارب، فهي تقول عن الغرقى: (لقد ملأوا اليمّ كبيض السمك)، وفي نصوص سومرية أقدم، نقرأ التشبيه التالي: (إنهم يملأون النهر كالفراشات، لقد تحاشدوا عند ضفّة النهر وكأنّهم أكلاك). وهذا المنظر هو نهاية لوحة الطوفان التي رسمها امرئ القيس.