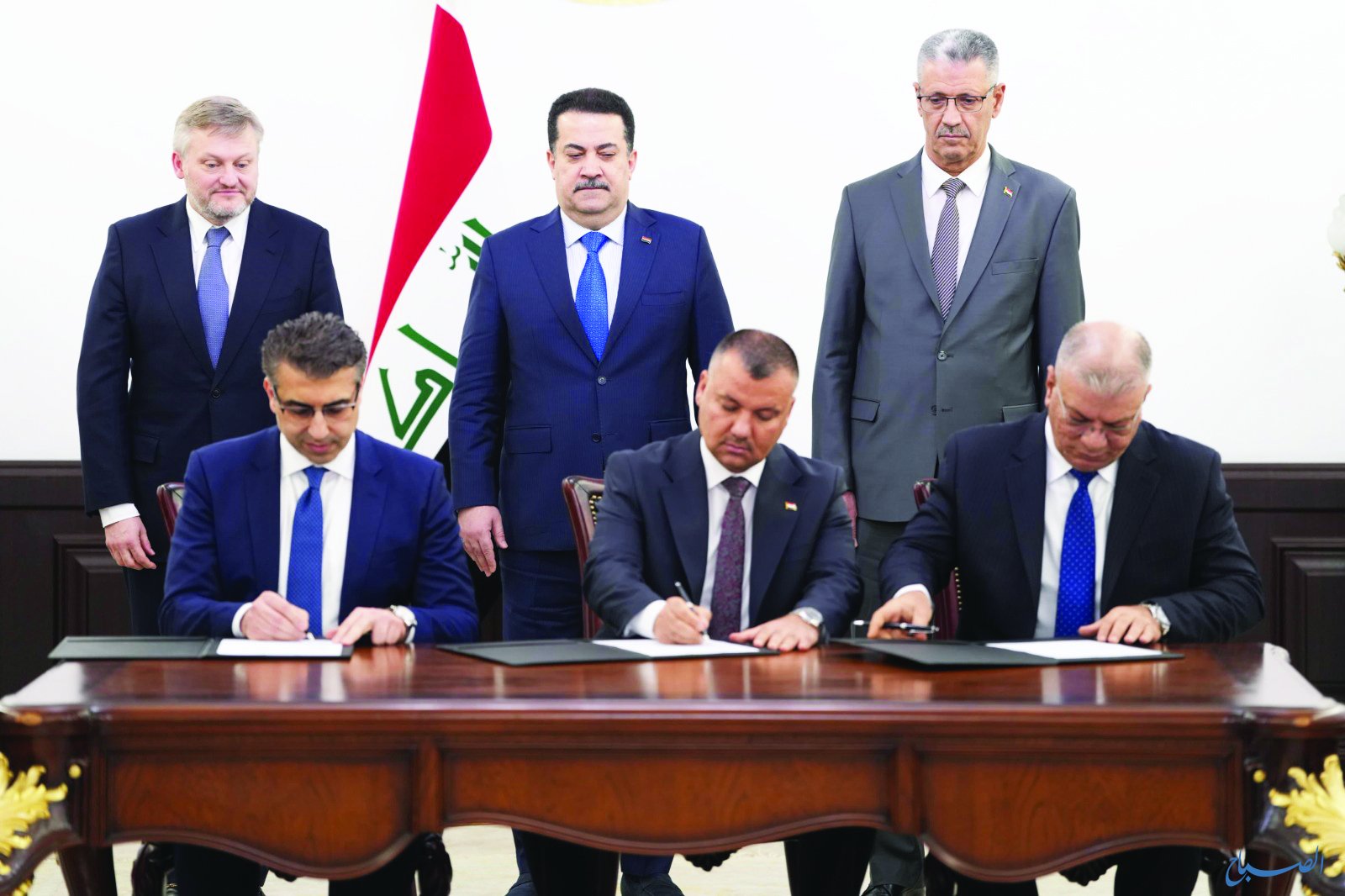أدوار مدرسة النجف الفلسفيَّة

د. عبد الجبار الرفاعي
عند تفحص عدة قرون في مسيرة مدرسة النجف العقليَّة، والوقوف على بعض آثار أعلامها في هذا الحقل، يلوح لنا أن الاهتمام بالمعقول اقترن بالاهتمام بالرياضيات، والهيئة، والطب، والكيمياء... وغيرها مما يشتمل عليه التراث العلمي، بيد أن هذه الاهتمامات كانت تدور في نسق مناهج البحث المتداولة في التراث، ولم يقدر لها أن تتواصل مع حركة تطور الاكتشافات العلمية الواسعة في حقل الطبيعة في أوروبا وقتئذٍ، كيما تفيد من أدوات وأساليب البحث العلمي الجديدة.
وهذا يعود لعدّة أسباب من أهمها: إنَّ النجف حاضرة تعنى بالدرس الشرعي، وإن كانت دائرة هذا الدرس تمتد عند القدماء لتستوعب شيئًا من مساحة التراث العلمي، فضلًا عن افتقار الدارس للمعرفة باللغات الأوروبية، وبدائية وسائل الاتصال آنئذٍ بين البلدان.
أما في حقل المعقول فأوضح ما نراه في تلك القرون، هو شيوع دراسة المنطق وعلم الكلام والتأليف فيهما، بينما لا نعثر إلا على تجارب محدودة في التأليف والدراسة في الفلسفة والعرفان، خلافًا لما نراه في القرن الرابع عشر الهجري، فإن الدور الجديد لمدرسة النجف الفلسفية بدأ بالعرفان مع المولى حسين قلي الهمداني، وإن كان البعد النظري في هذا العرفان ظل متواريًا لدى الهمداني وتلامذته وراء تجربتهم الصارمة في الارتياض الروحي.
ثم تبدت بالتدريج مظاهر الاهتمام بالفلسفة، وبرز الوجه النظري للعرفان بعد تعاطي دراسة متونه المشهورة، واقترن في هذا الدور العرفاني النظري للفلسفة، وبتعبير أدق تبلورت مناشط دارسي المعقول في النجف في النصف الأول من القرن الرابع عشر في مدرسة الحكمة المتعالية للملا صدرا الشيرازي. ولما كان العرفان النظري، خصوصًا تراث محيي الدين بن عربي، أحد المنابع الرئيسية التي استقى منها الشيرازي وأسس مدرسته، فقد كان من اللازم العودة إلى تلك المنابع والإحاطة بمعالمها، بموازاة دراسة الحكمة المتعالية.
في ضوء ذلك يمكن القول ان مدرسة النجف الفلسفية مرت بعدة أدوار، نستطيع أن نحددها بما يلي:
الدور الأول
يبدأ هذا الدور بوفود الطوسي إلى النجف وتأسيسه لمدرستها الدينية في العقد الخامس من القرن الخامس الهجري، ويمتد بعد وفاة الطوسي سنة 460هـ بامتداد تلامذته في هذه المدرسة. وقد اتسم هذا الدور بالاهتمام بعلم الكلام وظهور عدة مؤلفات للطوسي فيه.
الدور الثاني
لا يمكن الجزم بتحديد تاريخ دقيق لبدء هذا الدور، ولكن يعتبر النصف الثاني من القرن الثالث الهجري عصر ازدهار هذا المقطع من أدوار تطور الحكمة في مدرسة النجف، ففي سنة 751هـ هبط حيدر الآملي النجف، ومكث فترة طويلة هناك تعلم فيها الحكمة العرفانية على يد شيخه عبد الرحمن القدسي، ثم عكف متفرغًا لتدوين أعماله، التي ولدت في ثناياها الحكمة العرفانية عند الشيعة الإمامية. لذلك أضحى العرفانُ النظري أو الحكمة العرفانية هو السمة المميزة التي اتسم بها هذا الدور من أدوار مدرسة النجف الفلسفية، وقد تزامن ذلك مع نضوب الدرس الشرعي في مدرسة النجف، وازدهار مدرسة الحلة وظهور فقهاء كبار فيها ساهموا بإثراء الفقه الجعفري أفقيًّا ورأسيًّا، كابن إدريس، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي... وغيرهم. وكان حيدر الآملي قد تتلمذ لفخر المحققين في الدرس الشرعي لمدرسة الحلة قبل قدومه النجف.
من هنا لم يسجل التاريخ بروز أسماء أخرى في مدرسة النجف، وواصلت تجربة الآملي في القرن التالي، فلم يتجاوز دور الحكمة العرفانية القرن الثامن ولم يتمدد زمنيًّا على مدة طويلة؛ لأننا لا نعرف سوى حيدر الآملي، وقبله شيخه عبد الرحمن القدسي الذي تحدث هو عنه، من الأعلام المختصين بهذا الفن.
الدور الثالث
لا تسعفنا المصادر المتوفرة بمعلومات توضح أحوال مدرسة النجف في القرن التاسع، بيد أن هناك أكثر من دليل على حضور نشاط غير عادي لدراسة المعقول منذ القرن العاشر فما بعد، إذ لمعت فيه بعض الأسماء المشار إليها في الحلقة السابقة المنشورة الأسبوع الماضي في الجريدة. وانصب اهتمام هؤلاء على تدريس المنطق والتأليف فيه، مضافًا إلى علم الكلام والفلسفة أحيانًا، وأصبحت مشاغلُ الباحثين في المعقول في هذا الدور لا تقتصر على ذلك، بل تقترن بالرياضيات، والهيئة، وأشياء أخرى تتعلق بالتراث العلمي، مثل الطب وغيره أيضًا.
وزحف هذا الدور على القرون التالية في العاشر أيضًا فامتد ليشمل القرن الحادي عشر والثاني عشر ومعظم الثالث عشر.
الدور الرابع
يبدأ هذا الدور في نهاية القرن الثالث عشر بحضور سلسلة أساتذة متألهين في النجف، عرفوا بالارتياض الروحي وتهذيب النفس، وانهمكوا في التربية الروحية، بنحو أصبحوا على أعتاب مرحلة جديدة تزاوج فيها المعقولُ بالعرفان العملي، بل تجلى العرفان العملي كصبغة خاصة تلونت فيها شخصيات من يتعاطون دراسة الحكمة في النجف.
ويمكن اعتبار علي الشوشتري أول حلقة في هذه السلسلة، والذي كان معاصرًا لمرتضى الأنصاري، وكان يتبادل معه حضور الدروس، ففيما يحضر هو درس الفقه والأصول عند الأنصاري، التزم الأنصاري بحضور دروس الشوشتري الأسبوعية في الأخلاق وتهذيب النفس.
وبعد ستة أشهر من وفاة الأنصاري يلتحق به علي الشوشتري، إلا أنه قبل وفاته يكتب رسالةً إلى حسين قلي الهمداني يوعز لـه فيها بالتوجه نحو مقامات تهذيب النفس ويرشده إلى المنهج الرباني للسير والسلوك، علماً بأن الهمداني كان من الذين استلهموا من نمير الشوشتري قبل سنوات من وفاة الأنصاري، وبذلك أضحى الهمداني خليفته في مدرسته السلوكية، وأفلح في تربية طائفة كبيرة من التلاميذ، من أبرزهم جواد الملكي التبريزي، وأحمد الكربلائي، ومحمد سعيد الحبوبي، ومحمد البهاري، الذين امتدت وانتشرت بهم المدرسة السلوكية لحسين قلي الهمداني بعد وفاته سنة 1311هـ . فمثلًا جاء بعد أحمد الكربلائي تلميذُه علي القاضي التبريزي ومن بعد الأخير تلميذه صاحب الميزان محمد حسين الطباطبائي (الطهراني، محمد حسين. رسالة لُب اللباب في سير سلوك أولي الألباب. ترجمة: عباس نور الدين. بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1412هـ , ص122 ــ 124).
وعلى هذا يمكن تحديد بداية الدور الرابع والأخير لمدرسة النجف الفلسفية بهبوط الشوشتري وتلميذه الهمداني النجف، وانشغالهم بالارتياض الروحي، والدعوة لتهذيب النفس، وتأكيدهم على تعليم الأخلاق والتربية السلوكية، أما الجيل الذي جاء من بعدهم فبدأ يتعاطى تعليم الحكمة المتعالية مضافًا إلى مواصلة منحى تهذيب النفس والسير والسلوك السابق، وبرز من جديد الاهتمام بالمتون المتعارفة للعرفان النظري بعد أن اختفى ذلك لقرون عديدة منذ نهاية القرن الثامن. ولأجل أن تتكشف لنا أبعاد الصورة التي تمخّض عنها تطور الدرس الفلسفي في النجف، نوجز فترات الدور الرابع والملامح المميزة لكل فترة من هذه الفترات، كما يلي:
الفترة الأولى
كان العرفان العملي هو المنحى السائد في هذه الفترة، حيث أشرنا إلى تمحور جهود الشوشتري وتلميذه الهمداني حول السير والسلوك، وفي فضاء هذه المدرسة السلوكية تخرجت طائفة من معلمي الأخلاق والعرفان العملي المشهورين.
وفي هذه الفترة لا نجد حضورًا واضحًا لدراسة الفلسفة ومتون العرفان النظري، والمكوث سنوات عديدة في شرح عباراتها وتفكيك رموزها كما جرى في الفترة التالية، ومع خبرة حسين قلي الهمداني العميقة في مدرسة الحكمة المتعالية التي تلقاها على يد ملا هادي السبزواري لكن انصبّ اهتمامه على التربية، والتزكية، ورسم برنامج السير إلى الله تعالى وبيان منازله.
الفترة الثانية
تواصلت عملية التربية والتزكية مع تلامذة الهمداني، وانتشرت الدعوة لها زمانيًّا ومكانيًّا عبر هؤلاء التلاميذ وتلامذتهم، وأصبحت تعاليمُهم التربوية منهاجًا يهتدي به السائرون إلى الله تعالى، بيد أن الدرس الفلسفي أخذ ينتشر ويتعاظم الاهتمام به في هذه الفترة، وقد تبلور هذا الدرس في منهج محدد، بعد أن مكث قرونًا عديدة يتذبذب في نسق واحد؛ فإنه كان يطغى علمُ الكلام فيما تغيب الفلسفة في بعض أشواطه، وفي شوط آخر يسود العرفان النظري فيما يغيب ما سواه، وفي شوط ثالث يتذبذب الموقف بين خيارات متنوعة لا تمثل مدرسة بذاتها.
اختطت المدرسة الفلسفية النجفية لنفسها مسارًا تبنته في هذه الفترة، تمثّل في اتخاذ تراث ملا صدرا الشيرازي ومدرسته الفلسفية الحكمة المتعالية منهجًا للدرس الفلسفي، مضافًا إلى شيء من تراث مدرسة الحكمة العرفانية لابن عربي.
ويعود تبني المدرسة الفلسفية في النجف لهذا المنهج إلى وفود بعض أساتذة الفلسفة من إيران، مثل محمد باقر الإصطهباناتي وحسين البادكوبي، ممن تلقوا ذلك من مجموعة أساتذة بارعين للحكمة المتعالية والعرفان النظري في طهران، منهم: محمد رضا قمشئي، وعلي المدرس، وأبو الحسن جلوه... وغيرهم.
وكان هذا الاتجاه في دراسة المعقول قد شاع لدى دارسي الفلسفة في إيران قبل ذلك بفترة طويلة.
الفترة الثالثة
منذ منتصف القرن التاسع عشر جرت محاولات من قبل بعض الدارسين في العالم الإسلامي، ممن ابتعثوا إلى أوروبا، للتبشير بالفلسفة الأوروبية والدعوة إلى نقلها وتبني مناهجها، وفي بداية القرن العشرين حاول بعض المترجمين نقل بعض المؤلفات الفلسفية للعربية والفارسية، ثم اتسع نطاق عملية النقل بمرور الزمن، وتأسّست لأجلها مؤسسات ومراكز متخصصة ذات صبغة أكاديمية تُنفق عليها الجامعات ووزارات المعارف والتعليم العالي، وسياسية تنفق عليها بعض الأحزاب والفعاليات السياسية، ولا سيما الماركسية منها، فتمخضت بانتشار هذه الفلسفة وذيوع نظرياتها إرهاصات وإشكالات عقائديّة وفكريّة عمّت مساحات واسعة من المثقفين والطلاب، واخترقت أروقة الحوزات العلميّة. فوجد دارسو الفلسفة في الحوزة أنفسهم أمام تحدٍّ كبيرٍ لا يسعهم الوقوف منه موقف المتفرّج، لأنّه يهدد إيمان الناس وخصوصًا الناشئة، فاستجابت لهذا التحدي طائفة منهم، وانكبّوا على دراسة ما تُرجم من الفلسفة الأوروبية والمادية منها بالذات، ثم عملوا على تحليلها وتفكيك عناصرها الأساسية ونقدها.
لقد أنجز الدرس الفلسفي في النجف في هذه الفترة وظيفة مزدوجة، ففي الوقت الذي تواصلت فيه دراسة المتون التقليدية للحكمة المتعالية والعرفان النظري، عُني بعض دارسي الفلسفة بدراسة الفلسفة المادية ونقدها، عبر المؤلفات الكثيرة التي تناولت هذه المسألة، بدءًا بمؤلفات محمد جواد البلاغي، ومحمد حسين الطباطبائي، حتى مؤلفات محمد باقر الصدر.
وبعبارة أخرى كانت الفلسفةُ تجري عبر قناتين في حوزةِ النجف، في القناة الأولى يستمر النسق التقليدي في الدرس الفلسفي، فيما ترفد القناة الثانية الوعي العقائدي للمسلمين بعناصر القوة والثبات، وتسلّحه بمقوّمات الصمود، أي أنها كانت ذات وظيفة دفاعية وقائية من خلال قناتها الأخيرة.