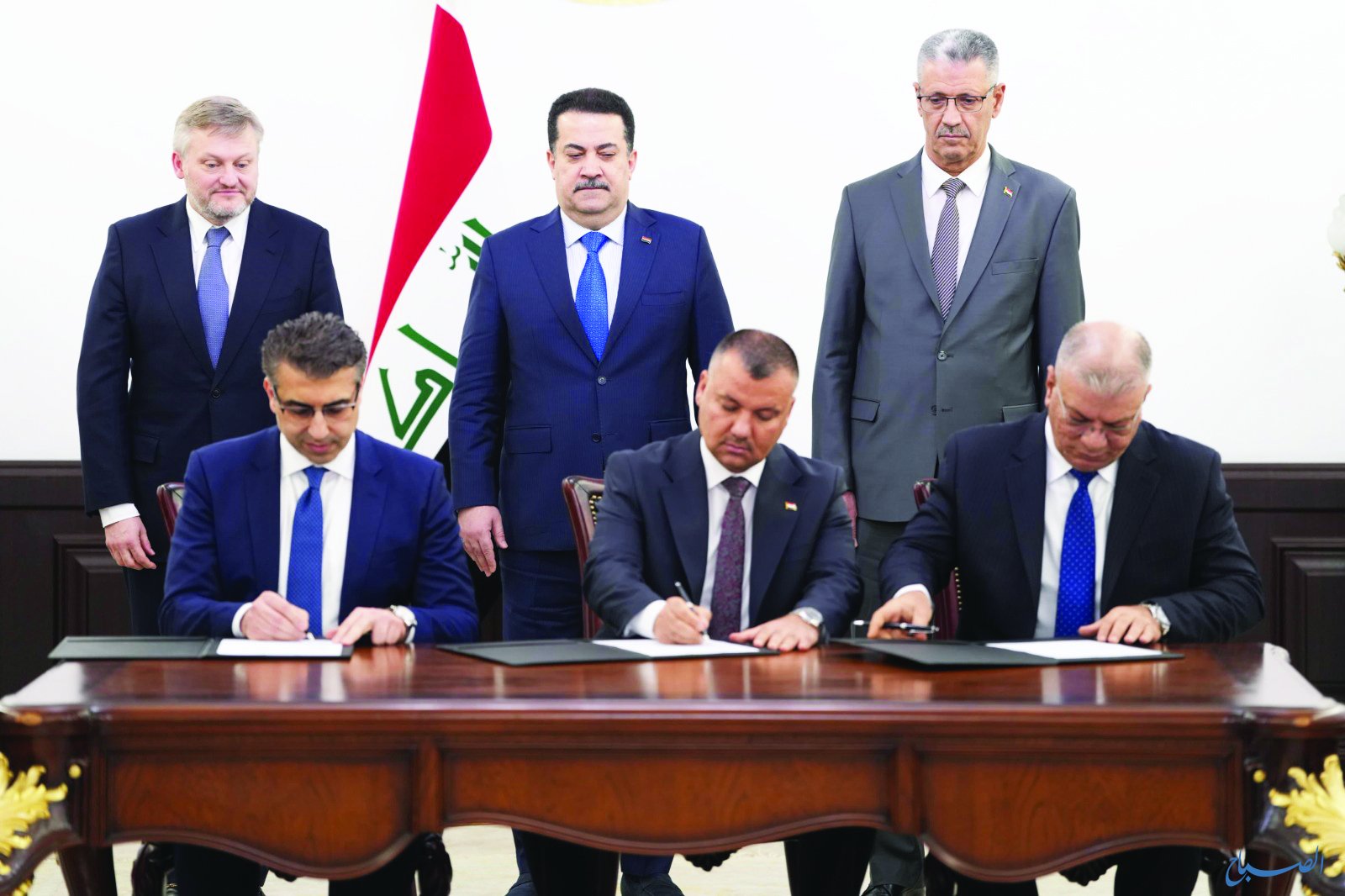الأقلمة وصناعة الأفلام السينمائيَّة

د. نادية هناوي
تعدُّ دراسات الأقلمة واحدة من الفروع المعرفيَّة التي انبثقت عن علم السرد ما بعد الكلاسيكي، وانطلقت على خلفيَّة الاعتراضات التي وجهت الى دراسات التناص. وأول من وضع أساساتها توماس ليتش عام 2008 حين أسس مجلة تحمل اسم (الأقلمة Adaptation) وكتب مقالاً افتتاحياً وضع فيه اللبنات الرئيسة لهذا النوع من الدراسات. وشهدت المجلة تطوراً غير متوقع في السنوات الأخيرة. وتحتل اليوم موقعاً خاصَّاً على خريطة المنجز النقدي الانجلوامريكي، لا بسبب وتيرتها البحثيَّة المتسارعة حسب، بل أيضا تمثيلها بالدرجة الأساس للنقد الأمريكي الخالص.
وليس هذا التطور في مضمار دراسات الأقلمة محض صدفة ولا هو مبني على فراغ، وإنما هو تأسيس معرفي، بُني على خلفيَّة ما أفرزته الفلسفة البراغماتيَّة الجديدة من توجهات في مجال دراسة تاريخ الأفكار. ولقد أفادت دراسات الأقلمة من فلاسفة أمريكان لهم طروحاتهم في هذا المجال، منهم ارثر لوفجوي (1873 - 1962) وله كتاب (مقالات في تاريخ الأفكار) 1948.
وكانت لمقالات جون دراكاكيس المنشورة عام 1985 تحت عنوان (شكسبيريات بديلة) دورٌ في تمهيد الطريق نحو الانفتاح والتعدد على مستوى الممارسة والتجريد مع الاهتمام بالتاريخ الأدبي كونه هو الذي يحدد نقاط قوة الأدب وضعفه. وما بين التاريخ والفلسفة ذاب النظر النقدي العلمي داخلهما. ولم يعد ممكناً في دراسة النقد الأدبي والنظريَّة الأدبيَّة الاستغناء عن تاريخ الأدب وتاريخ الأفكار وبراغماتيَّة العلم.
ولقد كان هذا الحال معاكساً الدراسات الثقافيَّة التي انبثقت في بريطانيا، وآثرت التجريد والمراجعة الجذريَّة لتاريخ الأفكار وتبنت الماديَّة الثقافيَّة لريموند ويليامز، وفيها العلاقة عمليَّة وماديَّة بين النص الأدبي وغير الأدبي. ولقد خالف هذا الحال الدراسات التاريخيَّة التي انحصرت في إطار الدوائر الأكاديميَّة التي أنتجتها، وسعت إلى التجديد عبر رفض النظريات التقليديَّة، واتخذت من السرد طريقاً لبلوغ التجديد بعيداً عن الماركسية والبنيوية وما بعد البنيوية والتفكيكيَّة.
ولقد هيأ هذا كله الأجواء لأن تأخذ دراسات الأقلمة حيزا خاصا ومستقلا جنبا إلى جنب الدراسات الأدبيَّة والثقافيَّة والتاريخيَّة. وإذا كان ظهور مجلات تيل كيل Tel Quel والشاشة Screen والتمثيل Represention قد ساهم في توسيع نطاق الدراسات الثقافيَّة باتجاه التعدد والتنوع، فإن مجلة (الأقلمة) – وهي على نهجها في انتظام الصدور، والعمل بشكل متسلسل وفعّال- استطاعت تأسيس هذا النوع الجديد من الدراسات. ومن الطبيعي أن تتجه المدرسة الانجلوامريكية إلى تبنيه وهي التي عملت بجد واجتهاد على انتهاج التعددية، فأزالت الفواصل الحدية بين صنوف المعرفة الإنسانية.
صحيح أن الدراسات الثقافيَّة عُنيت بالتعددية عبر مدِّ الصلات بين الأدب والحقول المجاورة كالثقافة الشعبية ووسائل الإعلام والنسوية وربطت بين الإنتاج الصناعي والأدب، بيد أن دراسات الأقلمة استندت في مرجعياتها إلى فكر ساندرز بيرس وفلسفة وليم جيمس واستمدت تعدديتها من الفلسفة البراغماتية الجديدة عند كل من جون ديوي وريشارد رورتي وستانلي فيش وريشارد شوسترمان وكرستوفر نوريس الذي تحمَّس لفكرة التقاطع في العلم وفلسفة العلم والنظريَّة الأدبيَّة.
واستعانت هذه الدارسات أيضا بآراء نقاد الأدب الانجليزي مثل أرمسترونغ ريشاردز( 1893-1979) ووليم امبسون(1906-1984) وغيرهما ممن اهتم بالنقد العملي والنقد الجديد والنظريات العمليَّة في الجمع بين الأدب والحقول المعرفيَّة الأخرى.
ولقد تنامت نزعة تجاوز الحدود المعرفيَّة عند غالبية نقاد الأدب الأمريكان، فعنوا بالمرجع والانطولوجيا بدلا من السياق التاريخي والمحتوى الايديولوجي فضلا عن تفضيلهم الممارسة على التجريد. ويعد ديفيد هيرمان من أهم الداعين والمطبقين للتعددية، ففي كتابه( منطق القصة)2002 جمع بين العقل والعمل والأدب والأفكار كما أن الامريكي يوري لوتمان من المتقدمين في عدِّ السرد نظاماً نموذجياً من الدرجة الأولى. ولقد كانت دراسات الأقلمة حصيلة هذه التنامي في النزعة نحو التعدد، وعادة ما تكون تعدديتها قائمة بصورة عمليَّة على الجمع بين النظريَّة السرديَّة ومجال أو أكثر من المجالات المعرفيَّة.
ويعدُّ كتاب (نظريَّة السرد والأقلمة) للأمريكي جيسون ميتيل واحداً من هذه الدراسات، صدر عام 2017 ويدور موضوعه حول تعميق الفهم بالكيفيَّة التي يمكن لوسائط الإعلام أنْ تؤقلم من خلالها القصص والروايات. وطبَّق ذلك على رواية للكاتبة الأمريكيَّة سوزان اورليان عنوانها (سارق الأوركيد the orchid thief) 1998 تمت أقلمتها بفيلم سينمائي عنوانه
adaptation) 2002) للمخرج سبايك جونز، وسيناريو تشارلي كوفمان. والفيلم من إنتاج هوليوود وبطولة ممثلين من الفئة الأولى في الشهرة وهم ميريل ستريب ونيكولاس كيج وكريس كوبر وكارا سايمون.
ومما يقتضيه هذا التأقلم وجود وسيط الكتروني مع جملة من المتغيرات، تجعل النص الأصلي معدلا ومختلفا بدرجة ما عن صورته الأصلية، وبحسب طبيعة صناعة الوسيط. أما تبحث عنه دراسات الأقلمة فهو معرفة ما يجري من عمليات معقدة تطرأ على البنى والشخصيات والازمنة والامكنة والحوارات عند أقلمة القصة والرواية بالفيلم.
ويتفنن صناع الأفلام بعمليات الأقلمة كي تكون منتجاتهم مناسبة، لأن يتلقاها جمهور السينما والتلفزيون. وما يركز ميتيل النظر عليه هو كيف يمكن الوفاء للمصدر الأصلي، فيحتفظ بروح مادته عند تصنيعه من جديد وبشكل مستقل ضمن الوسيط الإعلامي الذي يعمل فيه.
وبالطبع يشجع هذا المسعى على الوعي النظري بما للأقلمة السرديَّة من أوجه متعددة في عمليَّة تحويل النص الأصلي (الرواية) إلى نص معدَّل (فيلم أو لعبة فديوية أو أغنية أو رسوم متحركة). ويضرب ميتيل مثالا عمليا على ما تقدم بعمليَّة تثبيت مقبض جديد للباب؛ إذ يمكن ببساطة وضع القطعة في الموضع المناسب عبر اتباع تعليمات محددة تأتي مرفقة بعدة المقبض. ومع ذلك يكون مهماً من أجل عودة المقبض الى مكانه الفهم العملي للمبدأ الفيزيائي المسمى المرونة. وهو لا يختصُّ بالمقابض والنوابض وحدها، بل يتسع لمجالاتٍ وتخصصاتٍ أخرى.
ويرى ميتيل أنَّ فهم مبدأ المرونة مفيد إنْ نحن أردنا أنْ نضعَ مقبضاً خاصَّاً بنا للباب هواية أو احترافاً هندسياً أو كنَّا نريد كتابة موضوع لبحثٍ نظري يقارب الخصائص المرنة للمواد المختلفة ضمن بيئات ووسائط متنوعة. وبهذه الطريقة يتمُّ الانتقال بالنظريَّة من الخاص إلى العام، وبالشكل الذي يعزز الفهم العملي ويمكِّن من التحليل النقدي التجريدي للأفكار.
والهدف الذي إليه يسعى ميتيل هو وضع مقاربة عمليَّة للكيفيَّة المرنة في تطبيق النظريَّة السرديَّة على الفيلم السينمائي من أجل تحليله تحليلاً أدبياً لا بقصد وضع دليلٍ يعلِّم المؤلفين الصاعدين في مجال صناعة الأفلام كيفيَّة كتابة السيناريوهات، إنما بقصد معرفة ما جرى على النص الأصلي من عمليات تحويرٍ قد تصل به إلى حد التشويه.
وقبل التطرق إلى نظريات الأقلمة، وقف المؤلف عند أسس النظريَّة السرديَّة فوجد أنَّ مركزها هو النص. ورفض تسميته بـ(العمل) موافقاً رولان بارت رأيه في أن العمل الفني أو الثقافي هو كائنٌ ثابتٌ بينما النصُّ بنية ديناميَّة وممارسة ثقافيَّة. وبالنظر إلى الفيلم نصاً يكون تحليله على وفق مواضعات تحليل النص الأدبي من ناحية منهجيات التفكير وآليات المشاهدة والإنتاج والتلقي والتداول الثقافي.
أما لماذا النظريَّة السرديَّة وحدها دون غيرها من النظريات الأخر؟ فيجيب ميتيل: (معظم النظريات هي تفسيرية تسعى لتحليل معاني الفيلم وربطها بقضايا ثقافيَّة أوسع مثل الهوية والجندر والنسوية وما بعد الكولونيالية أو أنماط الهيمنة والايديولوجيا في حين أن النظريَّة السرديَّة تتخذ نهجاً مختلفاً في دراسة الدلالات. وهي بدلاً من أنْ تسأل: ما معنى هذا الفيلم؟ فإنَّها تسأل: كيف حقق هذا الفيلم بناء المعنى؟)