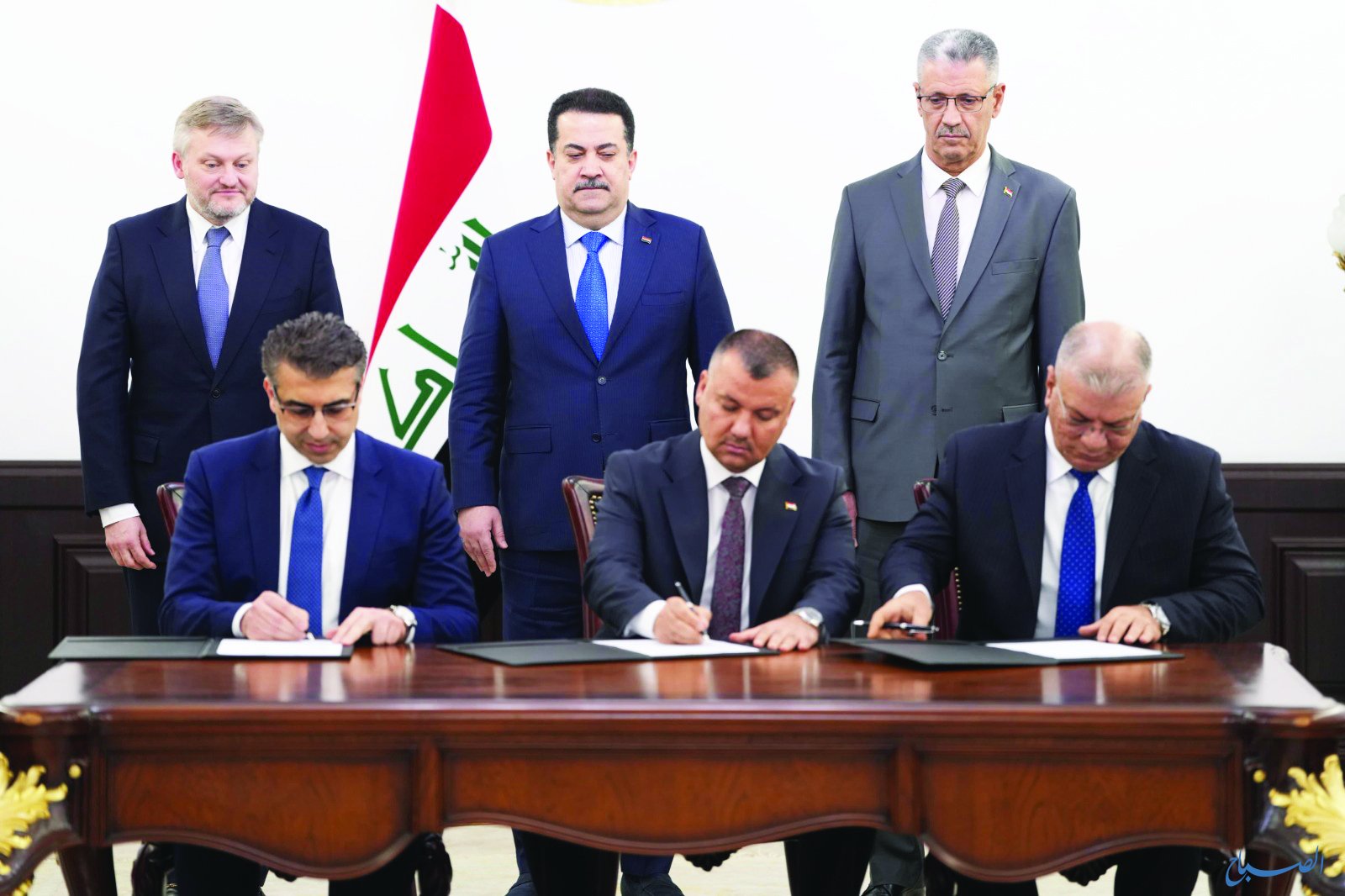سيغموند فرويد.. التفكير خارج علم النفس

عبد الغفار العطوي
سيغموند فرويد (1856 - 1939) الطبيب وعالم النفس والمفكر النمساوي الأشهر في العصر الحديث والمعاصر، ذاع صيته في العالم بوصفه مبتكراً للتحليل النفسي، وأدهش في السبر العميق في كشوفاته النفسيَّة من خلال مقارنته في مفاهيم تعلقت باللاوعي الذي يحرك الوعي في عالم الإنسان النفسي، فكان لهذه المفاهيم صدى واسع في تعميق مدارك الإنسان وعلاقاته بعالمه الغامض، ومما زاد في انتشار طريقته في التحليل النفسي، إضافة لجدته في علم النفس من خلال اتخاذ مفهومٍ متميزٍ في نسبة سلوك الإنسان المرضي نحو اللاوعي، فقد ابتكر نظرياته بالاعتماد على مسائل محرمة تتعلق بمفهوم "الجنس" محركاً لدوافع الإنسان ورغباته في التصرف على ضوء تلك الدوافع.
وبذلك رسخ فرويد علم التحليل النفسي في آخر وأدق مفصل من مفاصل العلم النفسي، وهو بذلك قد جازف بكل ما يملك من ثقافة وعلم ومركز علمي وأكاديمي، لكي يقوي ذلك العلم البكر، ويحفظه بما طرحه من جرأة في ظل الثقافة المحافظة في العالم الغربي، بداية القرن العشرين. ولعل فرويد في مسعاه في الحفاظ على ذروة علم التحليل النفسي متوقدة، سار في رؤيته العلميَّة والفكريَّة بأكثر الأساليب التواءً وغموضاً، حرصاً منه على أنْ يرسي قواعد متينة للتحليل النفسي، ويثبت مكانته المنهجيَّة والعلميَّة، وموقعه المهني مع إدراكه للصعوبات التي كانت تحفّه من كل جانبٍ تتمثل في الطرح الصادم لأفكاره حول الجنس والجنسانيَّة وتاريخيهما المكتظين بالقوانين الأبويَّة التي تحدد مفهوم السلطة، والمحرمات الناتجة عن الإزاحات والاستعارات التي يقيمها القانون الأبوي المشرعن لها، بل قد شكلت لوحة الميثيولوجيا الإغريقيَّة القديمة التي وظفها في دعم ما أراد أنْ يعلن عنه من علاقة الجنس بالتفسير الأسطوري في "أوديب" بوصفها أسطورة نجحت نظرياته النفسيَّة في الاستناد عليها في دراساته من أنْ يغذ إسهاماته في ترصين علم التحليل النفسي في الوصول إلى فهم النفس البشريَّة.
ويمكن القول إنَّ شيوع التحليل النفسي بهذه السرعة المذهلة مردّه إلى شخصيَّة فرويد المعقدة، وإلى طريقته في اقتحام عالمه بما لا يمكن لغيره فعله، وهو ربما يعكس تردده ولفه ودورانه الشائكين، ولإحساسه بحراجة أفكاره الصادمة وسط مجتمعٍ تغلب عليه الثقافة الدينيَّة المحافظة التي لا تقبل في إثارة مفاهيم خادشة.
بيد أنَّ فرويد نجح نجاحاً منقطع النظير في إقناع المحافل الأكاديميَّة المحليَّة والدوليَّة، كذلك الجامعات في أنَّ التطرق إلى الجنس مسألة لا تضر المجتمعات الغربيَّة ما دامت تخدم علم النفس في ميادينه المختلفة التي تعملُ على خدمة المجتمعات الغربيَّة والعالميَّة، وفرويد وهو يخطو على وفق ذلك التصرف الدقيق المتقن والحذر، قد ورط نفسه في أخريات سنيه في مساهمات فكريَّة كان يحرص على دفعها نحو الخلف حيث الإهمال المتعمد من قبله، فقد كان مدركاً أنَّ العمل على بقاء التحليل النفسي على قيد العمل مهمته الأولى في نشاطه العلمي والطبي، وأنَّ الدفاع من أجل أن يصلبَ عود التحليل النفسي، ويقف على ساقيه ستكون عمليَّة محفوفة بالمخاطرة، وأنَّ النجاح في ذلك الدفاع يعني الاستمرار في أنْ يخرجَ للعلن معتقداتِه الفكريَّة التي تربط بين كونه عالم نفس، ومفكر حضارة، وهو ما قام في تأجيله إلى حين يستكمل مهامه في أنْ يستتب لعلم التحليل النفسي الفوز بالمكانة المرموقة.
ولعلَّ فرويد قد تحسَّسَ تلك المحاولات في أنْ يجد منفذاً لها في الأخير، بمساعدة الشوط الذي أنجزه التحليل النفسي بالربط بين الجنس الذي كان مجرد حضوره الثقافي يشكلُ صدمة في الثقافة الغربيَّة التقليديَّة آنذاك، واستطاع بعد ذلك أنْ يشقَّ له طريقاً منهجياً في علم النفس عن طريق قبوله كموضوعٍ ملزمٍ في تدريسه، وعدَّه نمطاً من أنماط التحليل الحضاري، لهذا تناول فرويد في كتبه "مستقبل وهم- عام 1927" و"قلق في الحضارة -عام 1929"، و"موسى والتوحيد- عام 1939" التي بقيت تلك الكتب مهملة، أسيرة الظل، ولم يتسن لأحد الجرأة في استخراجها للعامة، بل بقيت راقدة في إهمالٍ في أوساط الفكر الأكاديمي والجامعي نظراً لما تحتويه من آراءٍ مواجهة لما هو متعارفٌ على حساسيتها.
ويقال إنَّ موقف الأوساط الثقافيَّة والفكريَّة العربيَّة كانت متحفظة على أغلب كتابات فرويد، ومتوجسة من الفرويديَّة وأتباعها الذين قاموا بترجمة مؤلفات فرويد النفسيَّة بحذرٍ شديد، لما تحتويه من رؤى غير مقبولة في البيئة العربيَّة، وذلك لارتباطها بعدة مفاهيم كالجنس والأساطير ومعالجاته للعلاقة اللاواعية بين الإبن وأمه وأبيه قاعدتها الدوافع اللبيديَّة وسفاح القربى.. الخ.
لكنَّ انضمام التحليل النفسي الفرويدي إلى طابور الاعتراف بعلميته وظهور أصوات معتمدة ورصينة من الباحثين وعلماء النفس اتخذوا التحليل النفسي الفرويدي طريقاً سالكة في البحث النفسي سهل مهمة الترجمة نحو العربيَّة، وأزالت تلك الترجمة الشكوك حول تحفظات المحافل العربيَّة حول ما أشيع حول إلحاديَّة منهجيَّة فرويد، لكنَّ الأمر كان عصياً حول بقيَّة مؤلفاته التي تناولت فكرة الدين في كتبه الثلاثة، ولم يستطع أحد إزالة المخاوف التي تعرضت لها تلك المؤلفات، ووجدت صعوبة الترجمة التي تعطي لفرويد أنْ يظهر وجهه الآخر، من حيث إنَّ التناول لجملة من الحقائق المتعلقة بالدين وبحبوحته الصريحة في التعامل مع مفاهيم القداسة على أنها من فواعل الدين جعل البيئة العربيَّة تنفر من قراءتها، إلا بعد مرور عقودٍ من صدورها، وفي حدود ترجمة ضيقة (تحملها المفكر اللبناني جورج طرابيشي) المثقف المتنور الذي تفهم أنَّ الإقدام على ترجمتها يعني إعلاء سلطة العقل ولا حجة تسمو على حجته، وفرويد حين تناول تلك الموضوعات القلقة، فمن باب معرفته أنَّ مشكلة الدين لا يمكن قهرها بسهولة، مع أنَّ فرويد يوقن في قرارة نفسه المشترك بين مشكلة الإنسان ومشكلة الدين في العالم، لهذا هو أيد مقولة الكاتب الفرنسي رومان رولان، في مفهوم الوهم والأوهام، ما يعزى لمستقبلنا الذي نعيشه كوهمٍ كبيرٍ، لهذا بدا القلق في حياة الإنسان هو عبارة وهم الحضارة ووهم التاريخ والدين في مقدمة تلك الأوهام، والشكوك التي افترضها من هذا القلق أوصلته لنقد حقيقة شخصيَّة النبي موسى من كون فرويد ينتمي للطائفة اليهوديَّة التي ترفض أنْ يختفي (الله) اليهودي عن ساحة المستقبل، مثلما لا يحق له التخلي عن الماضي، ولأنَّ الله بنظر اليهود هو إلهٌ شديدُ المراس كانت الحقيقة التي ينتجها هي من سنخ ذلك الإله (يهوه) لذا واجه فرويد حقيقة شخصيَّة موسى بمزيدٍ من القلق والاستنكار، ورفض أنْ ينتمي موسى للطائفة اليهوديَّة، وافترضه من حكايات أهل مصر بكل تفاصيله.