الكاتب.. الكتابة.. والتجربة الإنسانيَّة
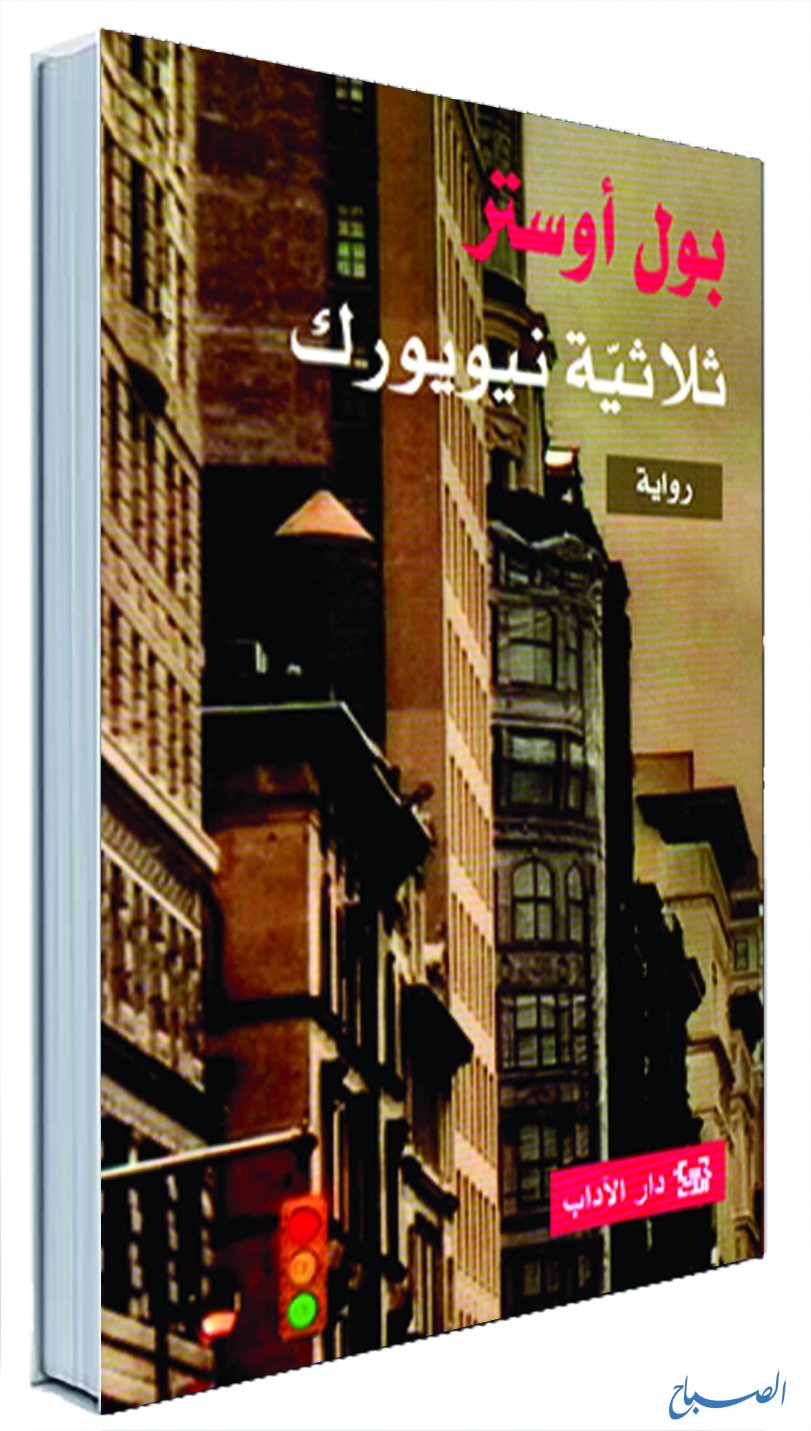
لؤي حمزة عباس
تستعيد (مارغريت دورا) معنى أن نكتب مستجيبين، في كل مرة يتجدد فيها فعل الكتابة، لنداء عميق، تسهم الحياة بتعميق حضوره ومنحه من القدرة ما يحرّره من محدوديَّة الأثر، لتكون الكتابة توجهاً لإنتاج الحياة والانشغال بها، واصطفاء بليغاً لإشاراتها يملك أن يحيل الإنسان لمساحات مضيئة شاسعة، أو يرتفع به للأزمان الأولى للذاكرة البشريَّة، فـ «أن أكون وحدي مع الكتاب الذي لم أكتبه بعد، هو أن أكون ما زلت في الإغفاءة الأولى للبشريَّة»(1)،
إذ تتآزر الموجودات لحظة الكتابة، في سبيل تحقيق مجهوليَّة الكاتب، وملاعبة غيابه شبه الكامل، حيث لا تبدو في قلب عملية الكتابة ثمة حياة خاصة، مثل ذلك ما يدوّنه (بول أوستر) في (ثلاثيَّة نيويورك)، راصداً القدرة الاستحواذيَّة للكتابة، فـ «الكتابة عمل انعزالي يستولي على حياتك. وبمعنى من المعاني فإنَّه ليس للكاتب حياة خاصة به، وحتى حينما يكون هناك فإنَّه ليس هناك حقاً».
إن ما يرصده (أوستر) هو ما تسعى (مارغريت دورا) إلى التقاطه والارتفاع به مضيئة من حياتها الخاصة جانبها القصي، ذلك الذي يتكشف بالعزلة مستعاداً على نحو بليغ. إنّها تخلق في كلِّ مرّةٍ عزلتها منفصلةً عن كلِّ شيءٍ ومتوحدةً معه في آن، فالعزلة هنا وجه فاعل من وجوه استعادة السؤال وتأمين الطرائق المثلى، والشخصية بوصف أدق، لاجتياز النفق.
إنَّ للعزلة والمجهوليَّة معنىً مضاعفاً يمدّ، مثل مياه جوفيَّة، تصوراتنا عن الكتابة بالحياة، ويوطد أفعالنا، فيكون بمقدورهما أن تحققا فاعليتهما في تأمين حضور الكاتب وتجديد وعيه، ومن ثم رفد قدرته على النظر إلى التجربة الإنسانيَّة بتدفقها وحيوية عناصرها، فتكون العزلةُ بذلك رديفاً لمراقبة الأثر، والمجهوليَّةُ حضوراً، إنّهما بمعنى ما، تنشدان معاً أهدافاً بعيدة تُضيء في قلب التجربة. يقتضي تأمل سؤال العلاقة، وتلمّس مختلف وجوهه، توجّهاً مبدئياً لوعي العملية الكتابيَّة نفسها، بوصفها وظيفةً أخرى تقترحها الحياة لمراقبة حركةٍ خفيَّةٍ فيها، ففي حال توجه الكتابة لإضاءة ما هو مضاء فعلاً، مرصود ومتعيّن، مكتشفٌ، بجملة أخرى، وممارَس، تعمد عبر فاعليةٍ خاصةٍ إلى خلقه من جديد، فمن مسافة فاصلة، عميقة وضيقة مثل نفق سري، تتشكّل العلاقة القديمة بين متلازمين: الكتابة والواقع، إذ تملك هذه الثنائيَّة، بما تقترحه وتُديم من خلاله اقتراح حياتها، من تقنّعٍ ومراوغةٍ وانفلات أن تستحكم على نحو دائم بأفعالنا، طقوس كتابتنا ـ حيث لا طقوس تُستعاد بشكل دائم ـ مؤثِرة طرقاً لا نهائيَّة، مرئيَّة مرّةً ولا مرئيَّة مرّات، للوصول إلى أهدافها، الممكنة منها والمستحيلة، إذ تكاد تكون الكتابة نفسها واحدةً من اجتراحات الممكن البشري لرصد ما يحيطه، وما يتفتق داخله من مستحيل. إنّها الشكل الأصعب للمهمة، فما معنى أن يكون الأدب ـ حسب بارت ـ واقعياً قطعاً، من حيث أنّه لا يتخذ إلا الواقع موضوعَ رغبةٍ، وهو، في الآن نفسه، ودونما تناقض، ليس بالواقعي، لأنّه يعتقد أن الرغبة بالمستحيل أمر ممكن؟.
إنَّ استعادة سؤال العلاقة بين الكتابة والواقع مازالت تمثل سمةً من سمات العملية الإبداعيَّة التي تتعدّى بقوة حضورها إمكانية الوقوف المجزوء على كلٍّ من طرفي العلاقة، في سبيل ملاحظة حيويَّة كلٍّ منهما في إثراء السؤال وقدرتهما على استعادته، خصائص النص وخصائص الواقع، إلى ما يحدّد تلك العلاقة من أثر منجز، عند كلِّ مواجهة بينهما، قراءته لمستويات الفكر وآليَّات مواجهته وتلقيه للواقع والنص في وقت واحد. إنَّ الفكر، بدوره، لا ينفصل عن الواقع أو النص ولا يتعالى عليهما في سبيل معاينة الواقعة الأدبية واستجلاء كوامنها، إنما يُقدّم، عبر تعدّد وجوه تلك الواقعة وامتداد آفاقها، معالجاته لفاعليَّة العلاقة وحساسيَّة مظاهرها.
إنَّ التوجّه لقراءة الواقع بوصفه منظومةً نصيَّةً يستعيد، على الدوام، صوت (مايكل أنجلو) وهو يخترق صلابة الصخر، مثلما يخترق ركام القرون ليُلقي بموعظة المرمر العريق حيث الفكرة الكامنة أبداً، في قلب الصخر، وحيث اليد، يد الفنان الخبيرة تمتد مستجيبةً لسحر الرخام، مشكّلةً مرأىً جديداً للمسافة الحرجة بين النص والواقع.
إنَّ القابلية الحركيَّة للمسافة تمثل وجهاً آخر يملك أن يقترح أثر نصٍّ بعينه، فهو ينظّم، قبل ذلك، حساسيَّة العلاقة وهي تتسع أو تضيق بين نقطتين، ففي الوقت الذي تمثل فيه نقطة التجريد إمكانية نظر النص إلى مراياه الخاصة، تُعلن نقطة التسجيل، قابلية النص التي تشفّ معها النسائج النصيَّة إلى الدرجة التي يكون بمستطاعنا، على نحو يسير، إبصار ما يقع وراءها من شظايا الواقع، إنها تغيب عندئذ، مغيرةً تدرّج وظائفها في سلّم الرسالة، فتدفع (الشعريَّة) خارج أولويات المقاصد الأدبيَّة في سبيل تحقيق أهداف تظلُّ على الدوام وراء إمكانية النص الأدبي على النظر إلى مياهه الخاصة. إنّنا نواجه، في محاولة منتظمة للنظر، طريقتين لاستعادة الواقع وضبط وحداته لاستنباط ما تنطوي عليه من دروس وعبر، تعمد الطريقة الأولى لتنظيم الوقائع الحياتية بوصفها حوادث، كبرى أو صغرى، بمقدورها إذا ما شُكّلت بأنساق معينة أن تُفضي للكشف عن أنفسها، وكشف ما يصبُّ فيها وما ينبعث منها، من شبكة علاقات تمثل على الدوام مقومات الظاهرة وعوامل إنتاجها. إن الوقائع هنا تُنتقى لتمثل تاريخاً محدّداً يظلُّ أمينا لمجرى تراتبي متوال، تتقدم السوابق فيه على اللواحق، ويسلّم الأجداد فيه وصاياهم للأحفاد.
أما الطريقة الثانية فإنما تكون بالتوجيه الواعي للمباني الحكائيَّة، بمقدرتها على إدراك مرجعها والتقاط وحدات دقيقة من مجرى الوقع العظيم، وتنظيمها بالطريقة التي يكون بمستطاعها الافصاح عما لم يسجله التاريخ، وما لم ينتبه الأجداد لأدواره الحاسمة. من هنا، ومن منظور بنيوي، تكون «وقائع الحياة بالنسبة إلى التاريخ كالقصة إلى العقدة. التاريخ يختار حوادث الوجود وينظمها، والعقدة تختار حوادث القصة وتنظمها. ففن القصة، إذن، أوضح في إعادة التنظيم المصطنع للتتابع التاريخي الذي يخلق قصة في العقدة»(2).
وهو ما يدفع القصة على نحو واضح، لاجتناب الطرق المستقيمة الآمنة في سعيها لاستبصار ما يقع خلف العادي واليومي والمألوف، ما يشققه وينّشقّ عنه، مقترحةً من الطرق الدالة لوعي الواقع وإعادة إنتاجه ما يدفعها لكي تكون مدار قراءات لامنتهية.
ولما كان الواقع مركزاً مهماً لإنتاج النصوص، وتنظيم قدرات كتّابها على استعادة فاعلية الأثر والقادر على الامتداد لتفاصيل التجربة الانسانيَّة باتساع آفاقها واقتراح سبل إنتاجها، كان لنا أن ننظر لوجوه العلاقة بوصفها منظومةً تسعى إلى إدراك مستويات العملية الإبداعيَّة وتلمّس خصائصها، مثلما هي فاعلة في اقتراح مستويات النص، تحديد طبقاته المرئية وغير المرئية، باشتباك علاقاته الحضوريَّة والغيابيَّة، وبما ينطوي عليه مظهراه التركيبي والدلالي، بما يمنح علاقات التشكيل والبناء سمتها الحركيَّة، المتغيّرة، داخل حقل كتابي معين، فتملك أن تُضيء خصوصية ارتباطها مع مرجعها الواقعي من خلال ما يلحظ من وعي لاستثمار حركة عناصره، إنها تفتح وقتئذ للأدب مجالاً للتحوّل، والتغيّر، والتنويع، في انتقالة حيّة من المعلوم إلى المجهول، بما يمكّننا من استعارة جملة (ناتالي ساروت) وهي تتأمل حيوية الانتقال الدائم من المرئي إلى المخفي بوصفها «ما يجعل الأدب، كسائر الفنون، في حالة تحوّلٍ مستمر»(3).
إننا في الوقت الذي نتوجّه فيه لمعاينة النصوص وملاعبة احتمالاتها نُعلن مقاصدنا في استعادة إنتاج علاقتها الحرجة، عبر فاعلية القراءة، مع خزانة مراجعها وفحص تواريخها الشخصية، وهي تولد وتنمو لتقيم علاقاتها غير المنتهية مع ما حولها، لتوفير فرصةٍ جديدةٍ لمعاينة السؤال، هل نعمد، عندما نسعى لتجديد سبل النظر إلى النص الأدبي، إلى تجديد وعينا لإشكالية العلاقة بينه وبين الواقع؟.
إنَّنا نُديم، بإمكانيةٍ ما، حساسيَّة المسافة الفاصلة، مثلما نُديم فاعلية السؤال في الامتداد إلى الواقع الذي لا يكون من دون النص إلا واقعا موحشاً، أفرغت عصور التجربة الإنسانيَّة شرايينه من دماء المفاجأة والترقّب. إنَّ النصَّ نفسه يظلُّ على الدوام بحاجة إلى ما يجدّد فيه دفق تلك الدماء، فهو يخضع، بوصفه كائناً من دم وخيال لاشتراطات الحياة ويضمحل بانسحابها عنه، فإنَّ كلَّ عملٍ جديدٍ كما تؤكد (ناتالي ساروت) «بمجرد ما يتم استيعابه واستهلاكه، يغيّر الوقع الذي نعرف، فيُصبح جزءاً من ذلك الواقع المرئي الذي لم يعد يُغري بالاستكشاف»(4). إنَّه يُطلق بذرته لاستكشاف آخر تتواصل عبره متوالية الأثر الأدبي مثلما تُستدعى فيه قابليات الواقع بوصفه شبكة واقعات صغرى، تتواشج في نسج المرئي، تلك التي يعمل الأدب على تلمّس دفائنها، وتحسّس قوة الحياة في جذورها، وهو يسعى لتجديد نظرته للتجربة الإنسانيّة بما يقترحه من طرائق للوعي، والمحاورة، والتشكيل: وعي التجربة، وإقامة الحوار معها، ومن ثم تشكيلها في منظومات لغويَّة.
***
1 - مارغريت دوراس، الكتابة، ت: هدى حسين، سلسلة كتاب شرقيات للجميع (26) القاهرة 1996 ص 28.
2 - روبرت شولز، البنيوية في الأدب، ت: حنا عبود، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1984، ص: 97
3 - ناتالي ساروت، الرواية والواقع، ت: رشيد بنحدو، الموسوعة الصغيرة، بغداد 1990 ص 24.
4 - م. س، ص: 25.





