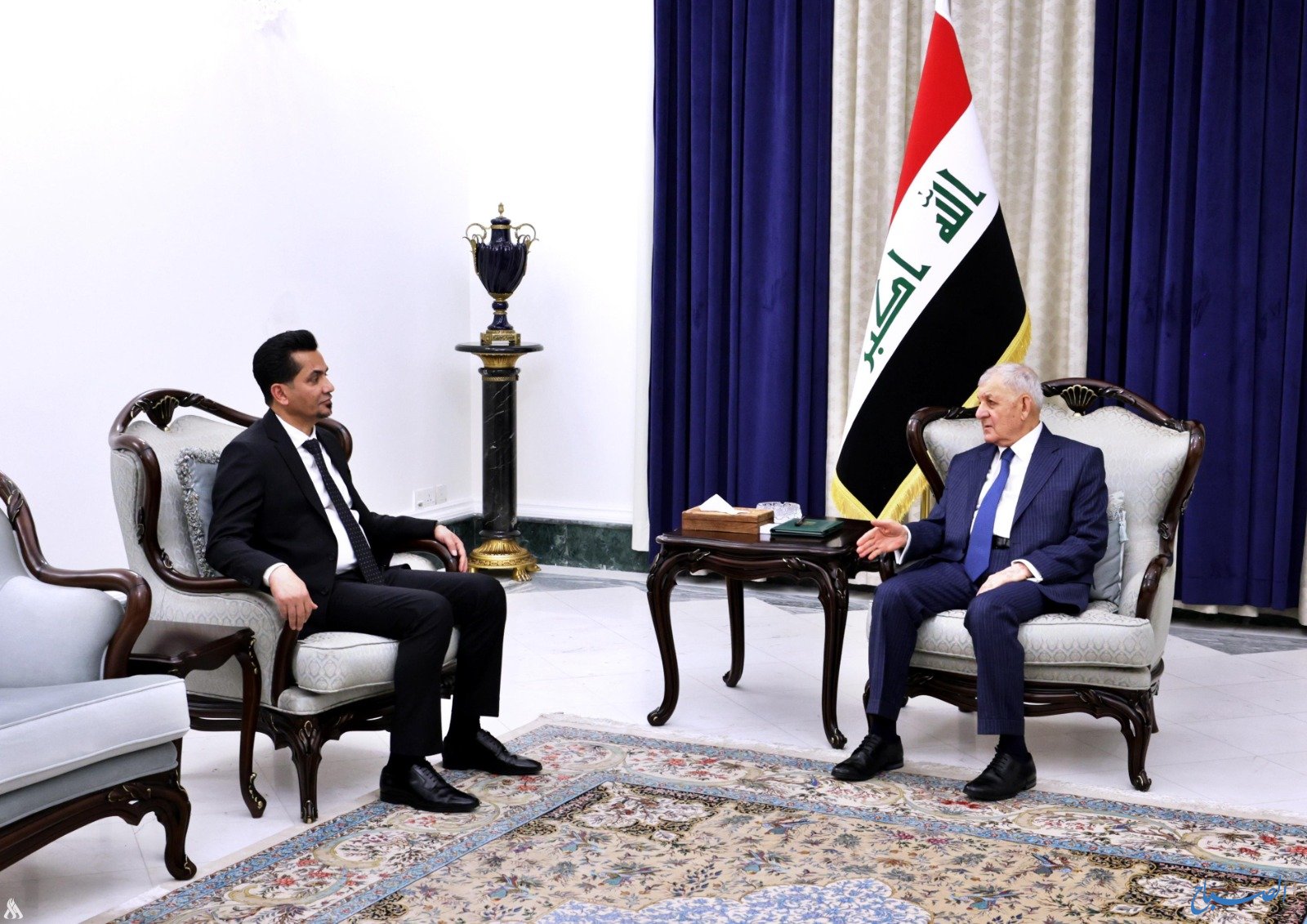حامد سعيد.. البستان المهشَّم والرشاقة الثقيلة

علي وجيه
رقَّ الزجاجُ ورقّتِ الخمرُ
فتشابها، فتشاكلَ الأمرُ
فكأنّما خمرٌ ولا قدحٌ
وكأنّما قدحٌ ولا خمرُ
- السُّهروردي المقتول-
عن التجربة
ينشأُ الفنان حامد سعيد (أبو الخصيب ١٩٧٦)، نشأةً كلاسيكيّة بالنسبةِ لتشكيليّي البصرة، الحصار الاقتصادي، التتلمذ على يد أهم البصريين المحلّيين، الذين فتكَ بهم مفهوم المركز والهامش، فالبصريُّ يبقى بصريّاً حتى يكون في بغداد (إسماعيل فتّاح الترك، محمّد مهر الدين، مثالاً..)، بينما يُمكن أن يبقى فنّانون بِسِمة المحلّية، وإن كانوا مميّزين بشكلٍ مُفرط، وعلى رأسهم أستاذه الفنّان المُختلف عدنان عبد سلمان.
ينشأ، ويدرسُ أكاديميّاً في البصرة، بدرسٍ صلبٍ ودؤوب، إلى جانب زملاء يكبره بعضهم ويزامله آخرون، لكنّهم جيلٌ خطر، في الأداء والعرض والمفهوم، ولي عودةٌ لمشاغلهم إن سمحَ الوقت والمزاج، ومن ضمنهم: أسامة حمدي، حيدر السعد، د.ياسين وامي، د.ناصر سماري، وآخرون.
الارتماء في حضن الجغرافيا
فيما رأيتُ من تجارب مبكّرة لحامد سعيد، كانت البيئة، بيئة أبي الخصيب، بنخلها وصبيتها وزوارقها، هي المتحكّمة بمشغله بشكلٍ مباشر، فضلاً عن الجهد الأكاديميّ، من رسم البورتريه والطبيعة الصامتة واللاند سكيب، لكنَّ فنّاناً معرفياً، لم يكن ليكتفي بهذا المشغل الاعتيادي، أو بمعنى أدق “المُعتاد”، فمهما اختلفتَ بداخل هذا المشغل فأنتَ ذو بدايةٍ واضحة ونهاية واضحة.
دراسة سعيد الماجستير في الإسكندرية، مع عنوانٍ مثير ذهنيّاً “الجدار مثيراً تشكيلياً في الرسم العراقيّ المعاصر”، جعله يعود هذه المرّة، بعيداً عن حرفنة الأداء، لفهم المشهد التشكيليّ العراقيّ من زاويةٍ أخرى، زاوية الانتقال في مدرسة التصوير العراقيّة من الواسطي إلى جواد سليم، ثمّ اللحظة المعرفيّة الفارقة: شاكر حسن آل سعيد، ثم ما ترتب بعدَهُ.
لكنَّ المفارقة الأولى والأخيرة أننا لم نرَ جداراً في مشغل حامد سعيد.
رائحة الشتاء
مثل تجمعٍ غنوصيّ، يتجمّعُ البصريون حولَ نفسهم.
وفي شتاء عام ٢٠١٢، بدأت تجربة حامد بالاتضاح مع معرضٍ شخصيّ حمل عنوان (رائحة الشتاء)، وهو عنوان مجموعة قصصية شهيرة للقاص الرائد الراحل محمود عبد الوهاب، وبطريقةٍ ما يتعاضد مشغلا محمود عبد الوهاب مع حامد سعيد: الحضور الشخصيّ المركزيّ في الوسط الثقافيّ البصريّ، ثمّ الشحّ بالإنتاج، وعدم وجود الطاقة الإشهارية للمشغل، إشارات فحسب، وهذا ما اشتغل عليه الراحل عبد الوهاب، ويشتغل عليه حامد أيضاً.
أتذكّرُ تماماً هذا المعرض، العمل القائم على الحذف، الشحّ باللون والكتلة، ترك غالبيّة الفضاء البصريّ في اللوحة فضاءً فارغاً، حتى ليمتدّ العمل إلى الجدار، أو إلى العمل المجاور له بطريقةٍ مُستفزِّةٍ بصريّاً، لكنّ هذا الشحّ، في حينها، والإشارة، كانت ثقيلة قياساً بما وصلت إليه التجربة الآن.
بل أزعم أن الحفر على هذا المشغل لم يكن ليصلَ إلى المستوى الحالي، إلاّ بأزمة كوفيد، التي أجلست الفنّانين في مشاغلهم.
لا جاذبية
يبدو أنّ عمل حامد سعيد، وتفحّصه نماذج من التشكيل العراقي إبّان دراسته الماجستير، جعلتْهُ يضيقُ بهذه النماذج لفرط “ثقلها”، اللوحة المملوءة لوناً، دراما، كتلاً، سطحاً خشناً، وهذا ما اتضح بشكلٍ وافٍ في معرضه (لا جاذبية)، دار الأندى، عمّان ٢٠٢٣.
ضمّ هذا المعرض الذي استرعى انتباه الكتّاب والنقّاد، لفرطِ رشاقته، يذهبُ الفنّان العراقيّ لعمّان حاملاً الحكاية كاملةً، بكلّ إداناتها وتجسيمها وصراخها، لكنَّ أعمال حامد، كانت تشيرُ وتصفُ ولا تصرخ ولا تقول.
لكنَّ الانتقالة التي بدأت تتبلور بشكلٍ حاد، هو بالمادّة: ففضلاً عن أعماله المرسومة بالكانفاس، وبالزيت والأكريليك، لكنَّ ثمّة مجموعتين ورقيتين: الأولى بكارتون السجائر الاعتياديّ، عملاً وإطاراً، والآخر بورقٍ كانسون وفابريانو، لكنّها بإطارٍ وباس بارت تو بذات الكارتون، وهذه كانت بادرة رثاء عوالم حامد التي قدّمها، والتي ستصلُ أقصاها في مشاركته التالية، تلك التي كانت مُختلفةً بشكلٍ شبه جذريّ، عمّا تقدّم ما بين (رائحة الشتاء) و (لا جاذبيّة).
(جنّة عدن)
في معرض (أكد)، ببغداد، اشتركَ حامد سعيد بمعرضٍ جماعيّ في رثاء للأهوار، التي تعرّضت عام ٢٠٢٣ إلى شحٍّ عالٍ في منسوب المياه، هدّدها بشكلٍ يشبه بكثير بما تعرّضت له بزمن الديكتاتوريّة، وفيما رسم زملاؤه وزميلاتُهُ سرديّة الأهوار بين سحرها وجفافها، اختارَ أن يمضي حامد بتقشّفه إلى أقصاه، فانتقلَ بأعمال كارتون السجائر العاديّ، وهذه المرّة بمادّة أكثر هشاشة بكثير من الكارتون نفسه: بلاستيك البقالة الأسود الرث، وشكّل به كائنات الأهوار: الطير والسمك، الطنطل والفالة، البشر، ومضى بالقلم يحفرُ، بطريقةٍ غرافيكيّة هشّة وعابرة وجريحة على سطح الكارتون الأسمر، بـ١٦ عملاً، اتّخذت جداراً منفصلاً، فكلّ عناصر الأعمال كانت بطريقةٍ ما عناصرَ ميّتة، ذات استعمالٍ واحد، عابرة، لا تفكّر بالمُتحفية، وهذا العمل اشتركَ في ذهنيّة حامد باللحظة الأدائيّة للعمل، أكثر من اللحظة الخالدة التي يصبو لها الفنّان، يذكّر ذلك بكثيرٍ في الوشاح – الكانفاس الذي وضعَهُ على ظهره وارتقى الزقّورة في ذي قار، بعملٍ أدائيّ، شخصيّ، شبه مرسوم.
العابرُ والمُقيم من الأشياء يشتغلُ في ثنائيّة واضحة لدى حامد، صاحب الذهن الأكاديميّ المُتحفيّ، يعرفُ أن البورتريه سيحتلُّ جدارَ صاحب البورتريه، ولقطة الطبيعة ستمضي إلى إطارٍ أنيقٍ سميك، لكن العملَ – الموقف، هو عابر، فحينَ تعودُ المياه إلى الأهوار سينتفي دور الصرخة، إلى حدٍّ ما، وحين ينمو البستان، كذلك، فالعملُ لدى حامد هو لحظة أدائه، ولحظة تلقّيه، وهذا ما شرحه بشكلٍ مكثّف في لقاءٍ تلفزيونيّ جمعني وإياه، في
“الصالون”.
بالنسبة لرجلٍ ولد في أبي الخصيب، صادقَ نخلها وسمكها، ومضى في أنهارها الصغيرة في كلّ ظهيراته، صانعاً تماثيلَ بدائية بطفولته، فهذه خيوطٌ فولاذيّة تربطُهُ بالتجربة بشكلٍ يجعلُهُ أميناً لهذه الجغرافياً.
مدينة وريف – بهجة ورثاء
كما يحضرُ الريفُ بشكل مكثّف في أعماله، تحضرُ المدينة، لكنهما على طرفيْ نقيض، كما يحضران في ذهنِ البصريّ، وهو يرى صراع الريف والمدينة أمام عينيه.
تحضرُ المدينة مُبهِجةً، لونيّاً وتوزيعاً، أطفالاً وسيارات ومبانيَ، والريفُ يحضرُ، في تلك السنوات، أعني حتى ٢٠٢٤، بلمسةٍ حزينة، النخلةُ نخلة: لكنّها مِسْوَدَّة، والطيرُ كذلك، لكنّ منقاره متهشّم، ولا تعلمُ بالضبط إن كان يغردُ أم يصرخ، يغنّي للنخلة أم يبكيها.
ثقافياً، تشكّل المدينة والريف ثنائيّة في أعمال حامد سعيد تسترعي الانتباه، خصوصاً حين نرى الخارطة الجغرافية: بين النشأة الريفية في أبي الخصيب، الدراسة في المدينة ثم افتتاح غاليري فيها، الدراسة في الخارج، التردّد على بغداد التي تهشّم فيها مفهوما المركز – الهامش، وصار الفنّان البصريّ عراقياً – من ناحية التداول – وإن بقي في أبي الخصيب، أو مركز البصرة، حيث يقعُ الغاليري.
بستانُ القرية
حينَ حملتْني قدماي، لأشاهد معرضه الأخير (بستان القرية) – المركز الثقافيّ الفرنسي، بغداد، لم يستطع حامد خداعي بألوانه السارّة، وشفّافيته في الأداء على الأعمال، كان قصيدةَ رثاء ملوّنة، لكنّها كانت تحتاجُ إلى معرفة مشغله بشكلٍ دقيق.
في مقالٍ له، أطلق الفنّان شاكر حسن آل سعيد مفهوم (خزانة العلامات)، على ما يحملُهُ الفنّان، ويستخدمه، من عناصر لتؤدي عملية خِطابيّة اللوحة، مثلما أن شاكراً لديه مفردة الجدار، الحرف، الرقم، السهم، ومثلما أن ضياء العزّاوي لديه المستطيل المتنافذ لونياً، والعيون السومرية الواسعة، ومثلما أن سالم الدبّاغ لديه المربّع والأبيض والأسود، لكنّ خزانة علامات حامد سعيد هي خزانةٌ سائلة، لا تستطيعُ الإمساك بها، تتسرّبُ من يديكَ وتلقّيكَ مثل الماء، يتجاورُ البرتقاليّ الحاد، مع السماويّ، وما بيهما خطّان نحيلان، شحيحان ليُشيرا لطفلٍ لاعبٍ في بستان، أو سيّارة غير مكتملة، أو جذع نخلة
وحيد.
في هذا المعرض، اكتملت خزانةُ العلامات لدى حامد نطقاً وأسلوبَ أداء، أدخلَ مواضيعَ عديدة، في هذا المعرض، عن طريق الإشارة الشحيحة، وحين تركَ الأعمالَ بلا تأطير، امتدّ كلّ عملٍ على آخر مثل المسبحة، لتكونَ منظومة خطابيّة عن (بستان القرية)، لا بوصفه (البصرة – جنّة البستان)، كما يسمّي مهدي محمّد علي سرديّته عن المدينة، لكن بوصفه رثاءً، بين البستان في ذاكرة الطفل الخصيبيّ حامد سعيد، وفيما يراه من زحف المدينة على فطرة الريف، وزحف
لصلابة الريف على رقّة المدينة، وبين الحِدّة والشفافية، قدَّم حامد سعيد درسَ رشاقته الثقيل، وهو يُجبرُ كلّ المواد على أن تكون بشفّافية الألوان المائيّة، وإن كانت زيتاً، العصفورُ مبهج، بعد التمعّن: ستجده ميّتاً، الطفلُ يلعب، بعد التمعّن ستجدُ النهر ملوّثاً، هو لا يرسمُ بستانَهُ، إنّهُ يتذكّرهُ، يرثيه، يصبو إليه، خصوصاً حين يستقرّ أغلب يومه بمدرسة ضاجّة، أو مرسمٍ في أكثر مناطق البصرة ازدحاماً: أعني الجزائر.
الشكل – الإشارة – العلامة
في زمن الفوتوغراف، وهذا سؤالٌ استفزّني شخصياً طويلاً، وقمتُ باستفزاز عددٍ كبير من أصدقائي الفنّانين، في التلفزيون وخارجه: ماذا بقيَ لرسمه؟
كيف أرسم نهراً ملوّثاً، في حين أستطيعُ التقاط صورة له؟ كيف يمكن أن أهزَّ الضمير بشأن مجزرة، كما فعلَ بيكاسو في الغورنيكا، بينما تستطيعُ مشاهدة المجزرة بتقنية الفيديو الهائلة؟
يكونُ ذلك عبر: الشِعرية المغايرة، وهذا ما اصطلحه باول تسيلان، في كتابته عن الهولوكوست “نعم، بإمكاننا كتابة الشعر بعدها، لكن: بشِعرية مُغايرة”.
استفزاز التلقّي إشارياً، خصوصاً مع عينٍ مورسَ ضدّها العمى البَصَريّ، أعني العين العربيّة، ثمّ تعرّضت مع بداية القرن العشرين وصولاً لليوم إلى “الصُراخ البَصَري”، أن يُجسَّم ويُشخَّص كلّ شيء كما يجب، عليها أن تتعرّض للشحّ، والاختزال، والرشاقة، لتُكملَ العين، اتّصالاً بالذهن: منظومةَ تلقّيها، بإكمال الحذف الذي يقصدُهُ الفنّان.
وإن كانت الخمرةُ رقّت، والزجاجُ كذلك، وأرّقت السهرورديّ المقتول، المذكور بالعتبة الأولى في المقال، فإنَّ العملَ الشحيح، بإشاراته الشحيحة، عن البستان الشحيح المرثيّ المؤبَّن، هو استفزازٌ لمَن يراه، بطريقةٍ تعملُ تماماً باتجاه: الشِعرية المُغايرة، التي أزعمُ أنَّ حامد سعيد يشتغلُ وفقَها، بخوارزميّة منافسة ضمن حقل لا يوجد فيه غير حامد حالياً، خصوصاً في معرضه الأخير.