حين يكون الخوف نظاماً سرديّاً
ثقافة
2021/02/16
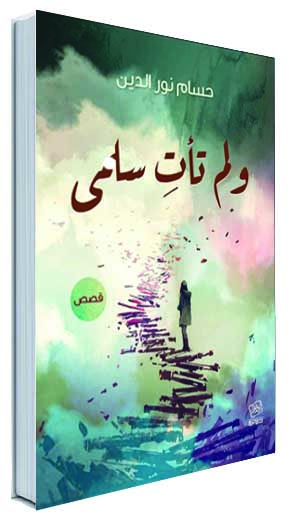
+A
-A
د. حنان الشرنوبي
إذا كان للحب ضروب وصنوف تلهم الأدباء والفنانين في تصوير دقائق الحب وعواطفه وأهوائه، فإن للخوف لغة لا تقل عنه شغفًا ولا إمتاعًا ولا جمالًا، إذ ينعكس كلاهما من معاني الآلام والمحن، فنجدهما ينبثقان من أساسٍ واحدٍ ترجع إليه النفوس الإنسانية، فأصبح الخوف يندرج تحت نمط من الثقافة المُسَلّم بها.
وعنوان مجموعتِنا (ولم تأتِ سلمى)، الواو فيها تشي بما قبلها من قلق وطول انتظار انتهى بنتيجة تقريرية شبه يائسة. أما عن اختيار اسم (سلمى) فهو- في أغلب ظني- رمزٌ له دلالته.
يكشف البحثُ في مدلولات أسماء النساء وأسرار توظيفها أهميةً، تحدّث فيها النقاد المتقدمون عن دلالات الكلمة وإيحاءاتها، ورمزيتها، فالجاحظ كان يرى أن (الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هي البيان وحده).
ونتوقف عند بعض الأسماء مثل: (فاطمة، سعاد، سلمى). فكما أن الأولى ترمز إلى الابتعاد والقطيعة، والثانية تشير إلى الهناء والسعادة، فإن (سلمى) توحي بالسّلْم والسلامة. وإذا كانت هذه الأسماء تُستعمل رمزًا منذ أدب العصر الجاهلي، فإنها مازالت منتشرة حتى عصرنا المعاصر كما في الفلوكلور الشعبي (سلمى يا سلامة.. رحنا وجينا بالسلامة) ولكن السارد هنا ذكر أن الجميع قد عاد إلا سلماه التي لم تأتِ، وفي هذا ما يثير ذهن المتلقي.. لماذا لم تأتِ؟ ويجيب عن هذه الأسئلة متن المجموعة التي اتكأت على ثيمة الخوف.
والمجموعة تشمل قضايا وإسقاطات عدة، حتى أن السارد استعمل بعض القصص التي تنحاز لأدب الطفل، وإن كانت تلمّح لغير ذلك مثل (حكاية أمير). أيضًا اتكأت على مواجهة الخرافة كما في قصة (حبل الخوف) والخطاب النسوي يتجلى بقوة في قصة المجموعة (ولم تأتِ سلمى) وما فيها من ترقب تكرر في أكثر من موضع تصريحًا لا تلميحًا، ففي قصة (في انتظار يونس) نجد أن الطبقة المتوسطة الكادحة أصبحت تنتظر معجزة الفرج المقترنة باسم يونس (ع) - مثيرة فكرة (في انتظار جودو) - غير أن هذا الضيق ليس نتاج ذنب اقترفه أصحاب الطبقة الكادحة لتُعاقَب وتنظر الفرج، والأمر نفسه مع قصة (بنت البواب) التي تعرّض بالسلطة الاجتماعية وقهرها للطبقة الدنيا.. ونلاحظ أن في قصة (جارتي) التي يقول فيها البطل: (خانتني الحبيبة، سافر الصديق، لم تعد لأيامي بهجة، يكرهني زميل عملي، يفصلنا هواءٌ مسموم، والوحدة بصدري تتنفس، بينما تنشغل أمي بأختي، وأبي صار يحتكر بماله السوق، ويتلاعب، متعللًا بأن الكل الآن يستثمر.. الكل صارت تمتطيه شهوة، وأنا اليوم اشتهي لون طفولتي، هل تدرين أني كلما مشيت في طريقٍ، انكمش، فأعود، صرت يا جارتي كالصغير الذي يهاب العسكر.)
وفي المقطع السابق نجد أن السارد اختصر حياته وما حولها في سبعة أسطر عن ماضيه وحاضره وما بينهما من غربةٍ ملموسة داخل وطنه اكتست بالانكماش والخوف. فمن هذه الجارة التي يناجيها دومًا؟ فتخبره بأنها (موجودة طول الوقت، لا تغادر إلا ساعة بالنهار.. وتبتسم دوما وقت الغارات ناظرة إلى صورة الشهيد التي تكاد تنطق).
ومن هذه القصة إلى ومضة تابعة كُثفت لثلاث كلمات..
(مات مقاومًا؛ فعاش)..
فهل المقاوم هو الجندي في ساحة المعركة أم المواطن البسيط الذي يقاوم ليحيا!؟
المجموعة افتُتِحت بإجمال تَبِعته قصص تفصيلية. بدأها ببنت البواب التي تصرخ لحظة انتهاك عرضها (آآآه يا أمي) ولكن الصرخة في رأيي تتسع لـ (آااه يا بلد) (آآآآه يا وطن)..
وطنٌ لن يقتص لها من المغتصب صاحب السيارة الفارهة.. لن تستطع فيه أن تخبر أمها لترحمها وتحتويها.. أليس التكتم هو حال وطننا؟!
ويتكرر الأمر في (حكاية أمير) حين نستشعر معاناة طفل مطحون انشغل بالمذاكرة تحت عمود الإنارة فيهيم مع لافتة إعلانية عن الشكولاتة كطيف عابر يحلم أن يتذوقها يومًا ما فيحُول الحلم بينه وبين المذاكرة وصناعة مستقبله.. وهذا ما كان مع صاحبة (فتافيت حلم) حينما أفاقت على ارتعاشة الخوف ورفضت تحقيق حلمها البسيط في التهام (ساندويتش) من محلات الوجبات السريعة المشهورة، إذ رأت أنياب الفقر وهي تلتهم إخوتها الصغار بلا رحمة. فكانت الومضة التالية بمثابة تعليق يؤكد رسالته منبهًا بثورة الجياع تحت عنوان (نذير):
لم يشبع الشبعان، وظل يجوع الجائع، فانفجرت أحشاء العدل..
والحلم بالشكولاتة عند أمير هو الحلم بالوجبة الساخنة مع الفتاة وهو يونس المنتظر ومعه الخلاص..
فالسارد ينتظر صديقه الغني الذي سينهي معاناته.. فيضطر أن يمنح أسرته أملا زائفا.. إذ لا صديق له يحمل هذا الاسم ليخرجهم من ظلمات الضيق إلى نور الحياة.. حيث انتظار المعجزة. فالأب لا يملك سوى الوهم وآخر لا يملك إلا ذكرى باعها اضطرارًا، ولأنه يؤمن أن قيمة الإنسان في ماضيه ولا وجود له إلا بذكرياته غير أن حاجته المالية قتلته حين برقت اشياؤه في لمعان ووقاحة..
وفي خطابه النِسوي تتجسد سلمى.. المرأة التي تنحني (بهدوء) لمناولة زوجها الحذاء - والهدوء هنا علامة (الاعتياد والتقبُّل) -. في الوقت الذي يسلبها الزوجُ الأمان مستبدلًا إياه بالخوف والتيه.. إذ يذكرها دومًا أنها ضيفة مؤقتة عندما يقول (في منزلي) ولا حق لها في هذا المكان.. وعندما يشعر بحبها ويودّ أن يمسح على شعرها ويُهدي كفها قبلة اعتذار، فإن شيئًا ما- رسّخه المجتمع - سيمنعه.
هي عادات موروثة ومكتسبة من مجتمعات أوطاننا الشرقية التي اعتادت سرد عباراتها على مسامع أبنائها (لا تبكِ، لا تعبر عن مشاعرك) وكأن فيها ما ينتقص من رجولته وكرامته..
والخوف هنا من الذات والقدرة على مواجهتها..
والملاحظ أن بعض عناوين القصص تحمل معاني الخوف مثل قصة (البعبع) وبطلها الشيخ الذي يدرك تمامًا ما تفعله زوجته من أجل الحصول على المال.. يظل ساكنًا في ظاهره حينما تصرخ به الزوجة (الفقراء لن يعاقبهم الله.. مهما فعلوا).
فعلوا ماذا؟! سرقوا حقهم المسلوب.. حاربوا من أجل البقاء..
الفقر (عجز) و (عوَز) فإما يفعل أي شيء أو يقبل ويستسلم وينكمش فيلزم الصمت. فالإنسان في المجموعة كورقة في مهب الريح لا حياة له ولا يعرف مصيره بين لحظة وضحاها.
كما تفردت المجموعة بالتنوع والتعدد بين الومضة والقصة القصيرة والقصيرة جدا الذي أثراها وعبّر عن عدم الاستقرار والاستقلال لكل فئات وأعمار الطبقة المتوسطة التي كادت أن تتلاشى..
وبهذا تعددت أوجه الخوف وصنوفه فأحيانًا يكون الخوف من مواجهة الذات وأحيانًا من أنياب الفقر وتارةً من الغد المجهول، وكلها تندرج تحت الخوف من المجتمع.. فإن استطعنا مواجهة المجتمع ليمنح (سلمى) الأمان والحرية.. ستأتي إلى أوطاننا برفقة يونس المنتظر.
أخبار اليوم


تقرير السوق المفتوح لعام 2024: نظرة على أكثر السيارات طلبًا في العراق وتوجهات السوق
2025/03/13 علوم وتكنلوجيا


