اقتصاد ما لا يضيّع
ثقافة
2021/03/17
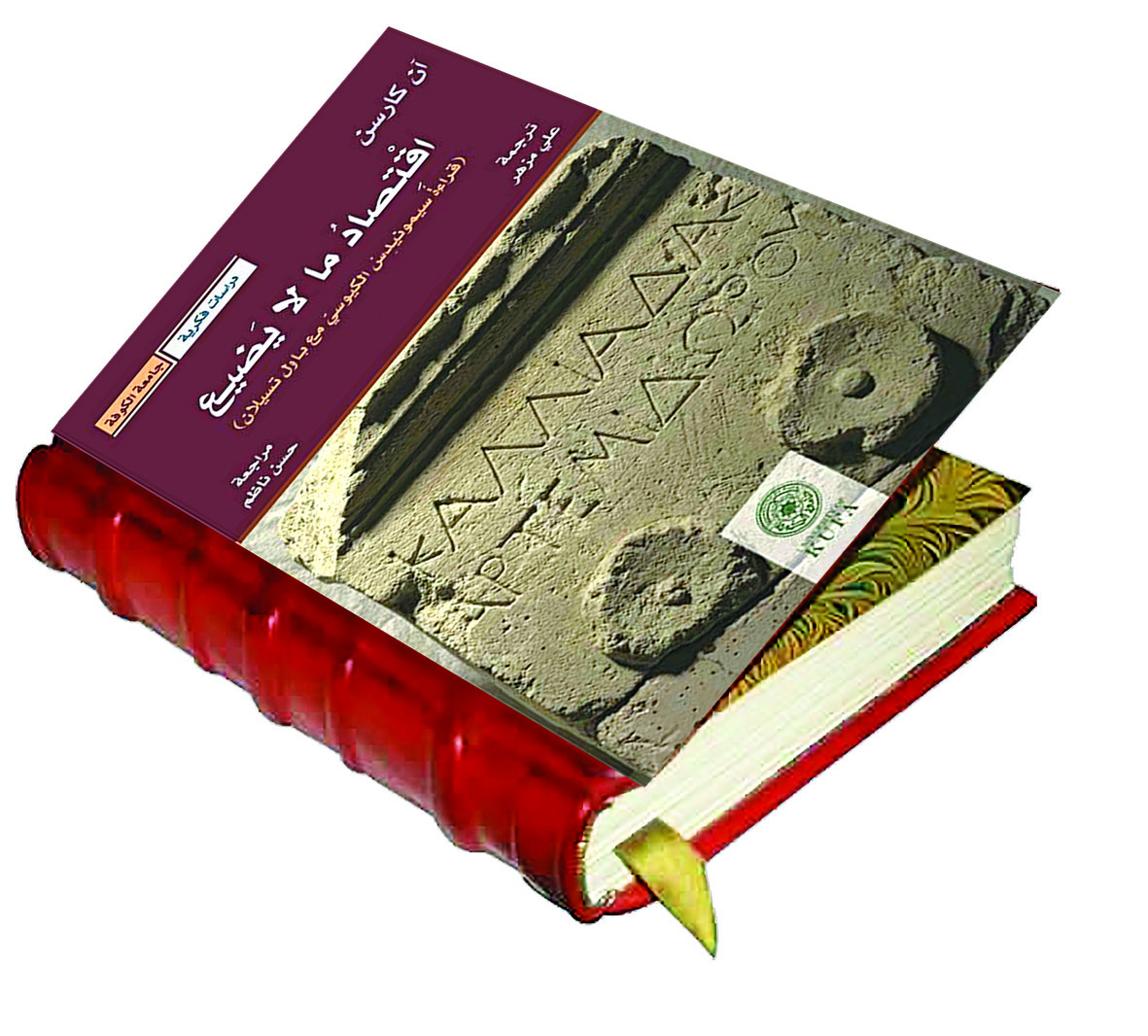
+A
-A
عبدالزهرة زكي
يروي فيدروس عن الشاعر الإغريقي سيمونيدس أنه توفي نتيجة تحطم سفينة كان مسافراً على متنها. وفي هذه الحكاية كان المسافرون الآخرون يحاولون إنقاذ أمتعتهم وممتلكاتهم فيما ظل الشاعر وحده واقفاً حيث هو غير عابئ بما يحصل، حتى أن المسافرين ظلوا مندهشين لعدم مبالاته ويسألونه عن سبب سكونه فكان يرد: كل ما هو أنا هو معي.
تستعاد هذه الحكاية بكتاب معاصر (اقتصاد ما لا يضيَّع) لمؤلفته الشاعرة الكندية آن كارسن، وهي أكاديمية باحثة ومترجمة في الكلاسيكيات الإغريقية. الكتاب صدر عام 1999 عن مطبعة جامعة برينستون بينما صدر عربياً عن سلسلة دراسات فكرية (جامعة الكوفة) وضمن منشورات دار الرافدين عام
2018 بترجمة موفقة من قبل الشاعر والمترجم علي مزهر ومراجعة د.حسن ناظم.
سأعود لهذه الحكاية، ولكن بعد حين.
هذا كتاب يأتي بفكرةٍ تدرسُ المؤلفة بموجبها تجربةَ شاعرَين، أولهما قديم إغريقي سيمونيدس الكيوسي وثانيهما معاصر ألماني باول سيلان، إذ تقيم تقابلا ما بينهما بالاعتماد على نصوصهما الشعرية وآرائهما وسيرةِ كل منهما وبالانطلاق من رؤية اقتصادية لما هو (لا يُضيَّع)؛ الشعر، واللغة الجمالية بسياقها الشعري. إذ تؤكد المؤلفة في مستهَلِّ الكتاب أن "الاقتصادَ هو مجاز القيمة الفكرية والجمالية والأخلاقية".
تورد كارسن إشارةً من معلق قديم (كاليماخوس) يؤكد فيها أن "سيمونيدس هو الشاعرُ الأول الذي استحدث حساباتٍ مفصَّلةً لتأليف الأغاني والقصائد لقاءَ ثمن". وتحتمل المؤلفةُ أن ليس من المستبعد أن يكون سيمونيدس هو أول من جعل الشعرَ حرفةً. وقبل هذا كان الشعر لدى الإغريق يُقدم من قبل الشعراء على شكلِ هباتٍ تقابلها هبات المستفيدين من الشعر التي تأتي على شكل ضيافة منزلية أو مقايضة بالطعام وسواه. سيمونيدس هو من أوائل الشعراء الذين تقاضوا المال كأجر لما يؤلفون.
تنقل كارسن عن هيرودوت، وهو مؤرخ إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، أي في العصر ذاتِه الذي عاش فيه سيمونيدس، أن الشاعر تقاضى عن قصيدة واحدة ما يعادل ما كان قد تقاضاه طبيبٌ مشهور خلال عام كامل، 28 ألف دراخم، وأكثر بكثير مما تقاضاه النحات الإغريقي فيدياس كأجرٍ عن عمله على تمثال الإلهة أثينا المرصَّع بالذهب والفضة متضمنا كلفة المواد وأجور العاملين.
جاءت المؤلفة بهذه القرائن التاريخية وذلك في سياق تأكيد قيمة الفنون اللفظية، ومن أبرزها الشعر، في مجتمع أثينا آنذاك.
يشير الكتاب إلى مثال آخر يؤكد فيه سقراط أن جورجياس وبروديكوس حصلا لقاءَ حكمتِهما على أكثر مما حصل عليه حرفيٌّ من صنعته لو اشتغل هذا الحرفي لثمانية وعشرين عاماً. إنه مجتمع ارتقاء ثقافي، يتيح فيه توقيرُ الآدابِ والمعرفة فرصاً واسعة للتنمية الثقافية. وكتاب آن كارسن لا يكتفي بسرد جوانب من تاريخ تسليع الكتابة الأدبية والفكرية، فهو عمل فكري فلسفي بجانب منه وهو محاولة جادة من جانب آخر في اقتفاء أثر هذا التغيّر الاقتصادي الحاصل مع تسليع الثقافة في بنية نصوص الشعر التي خلفها شاعر قديم.
لم يحفظ التاريخ الكثيرَ من شعر سيمونيدس. ما تبقى من هذا التراث هو بعضُ القصائد والكثيرُ من الأبيات التي ذكرتها مؤلفاتُ فلاسفةٍ وحكماء ومؤرخين إغريق. بينما ما زال علماء الآثار في سعي من أجل الحصول على نماذج أخرى من شعره. والتصور النقدي السائد عنه في ضوء المتاح من شعره هو بساطة أسلوبه التعبيري ورقّة لغته. ومن امتيازات سيمونيدوس هو ابتكاره أربعة أحرف في أبجدية لغته، وهو أول شاعر بدأ بتأليف الشعر ليُقرأ لا ليُنشَد، ولعل ما يساعد في ذلك هو فيض العاطفة الطافح مما كتبه من مراثٍ تحيي ذكرى المحاربين الذين قضوا في المعارك وتمتلك القدرة على استدرار مشاعر قرائها، وهذا من دواعي شعبيته في عصره، ومن بين هذه المراثي مما لم يتضمنه كتاب (اقتصاد ما لا يضيع) يأتي هذا البيت الذي أتوقع أنه وُضع على شاهدة قبر أحد المقاتلين:
أيها المارُّ
أبلِغْهم هناك في لاكديمون
أننا، طاعة لأمرهم، راقدون هنا.
أورد هذا البيت تأكيداً على الاقتصاد اللغوي والتعبيري الذي هو من امتيازات المتاح من شعر سيمونيدوس، وهذا البيت هو تكثيف لرسالة مما يخلفه قتلى الحرب باقتضاب شديد، فليس لدى القتيل ما يمكن أن يبذره من كلمات. ثمة هدف واحد يحاول ضمانَ الذكر الخالد من خلال هذه الجملة الشعرية المؤلمة، هذا كل ما يتبقى لقتيل في حرب.
في هذا الكتاب الممتع تقيم الكاتبة تقابلاً ما بين شاعرين؛ الإغريقي القديم سيمونيدوس والمعاصر الروماني الألماني باول سيلان. ربما أخفقت في التعرّف على جدية هذه المقابلة التي لا تكفي المقارباتُ الحياتية ومصادفاتُها لتأكيدها، لكن أتوقع أن البساطة المبكرة التي بدأ بها سيلان تجربته الشعرية، ثم اقتران شهرته بمرثيته لوالديه، اللذين عانيا محنة القمع النازي لليهود، هما خط واصل ما بين التجربتين. أشير هنا إلى مطلع المرثية:
أيها الحليب الصباحي الأسود نشربك في الأماسي
نشربك في الظهيرة والصباحات
نشربك في الغروب
نشرب ونشرب.
تجربة سيلان بما خلصت إليه هي أعقد من أن تساعدنا على فهم التقابل مع الشاعر الإغريقي، إنها تجربة مركبة توزعت فيها المؤثرات ما بين المرجعية اليهودية والأصل الروماني (الكرواتي) واللغة والشعر الألمانيين ثم السريالية الفرنسية، إنها مركبٌ صعب نجمت عنه تجربة شعرية بالغة التعقيد وشديدة الغموض والحدة.
لقد بدأت المقال بالإشارة لحكاية السفينة والغرق، وهي حكاية توصف في الكتاب بكونها حكاية خرافية، وهذا ممكن، لكنها تظل أقرب إلى ما يمكن أن نسميه في ثقافتنا العربية بـ (الرواية الموضوعة)، وهو تعبير مأخوذ (بتحوير) من الفقه الديني.
يمكن للحكاية أن تمدَّ جسراً ما بين الشاعرين عبر القرون، ذلك ما يعبر عنه الاغتراب (بالمفهوم الماركسي)، اغتراب الصلة ما بين الشاعر الإغريقي والسلعة الشعرية عند التحول من اقتصاد التهادي بالنسبة للشعراء نحو اقتصاد التسليع، واغتراب سيمونيدوس بعد ذلك ما بين زملاء رحلة الغرق مقابل مشكلة باول سيلان ازاء اللغة الألمانية،
وهي مشكلة يجري التعبير عنها في مناسبات مختلفة بقلق واضح، يقول سيلان مرة: "ليس ثمة في العالم ما يتخلى الشاعر بموجبه عن الكتابة ولا حتى إن كان يهودياً ولغة قصائده ألمانية"، لكنه في أكثر من مرة يلجأ للتبرير، تبرير عيشه في لغة كالألمانية مقابل مرجعيته اليهودية، ففي واحدة من رسائله التي كتبها من المانيا لزوجته في باريس يقول: "الألمانية التي أتحدثها ليست هي نفسها اللغة التي يتحدث بها الشعب الألماني هنا"، اغتراب وحاجة مستمرة للتبرير.
لكن في حكاية السفينة والغرق ثمة ما يجمع الشاعر الإغريقي، لحظة مواجهة الموت في السفينة، بالشعراء عموماً إذا ما أخذنا بمبدأ اقتصاد ما لا يُضيَّع. ذلك أن كلَّ ما هو الشاعرُ كامنٌ فيه، في أعماقه، بحيث لا يمكن أن يُضيَّع.
أخبار اليوم


تقرير السوق المفتوح لعام 2024: نظرة على أكثر السيارات طلبًا في العراق وتوجهات السوق
2025/03/13 علوم وتكنلوجيا


