رواية سوريَّة عن قطط إسطنبول المشرّدة بين الحدائق والمقابر
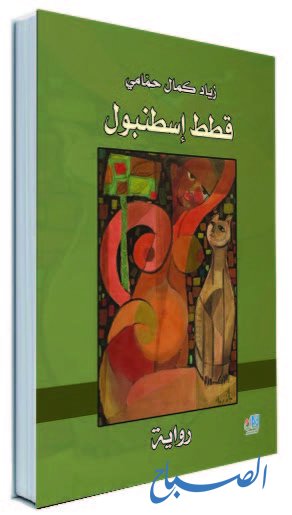
أحمد رجب شلتوت
يذهب المستعرب “روجر آلن” في كتابه “الرواية العربيَّة” إلى أنَّ الرواية هي الطريقة التي يخاطب بها المجتمع نفسه، ويربط بين الرواية والظروف التي يعيش في ظلها المجتمع، ولعلَّ هذا المفهوم يفسِّر غزارة الإنتاج الروائي السوري في السنوات العشر الأخيرة، فالروائي يبدو وكأنه لسان حال المجتمع الذي يعاني ويلات الحرب والشتات، فجاءت الرواية لتضعنا في عمق المأساة التي يعيشها الإنسان السوري اللاجئ، ومن أحدث النماذج التي تعاملت مع قضية النفي واللجوء رواية “قطط إسطنبول” للروائي السوري “زياد كمال حمامي”، وقد صدرت مؤخراً في تركيا عن دار نشر تعاني أيضاً الشتات (نون4 للنشر والتوزيع).
تشير الرواية إلى المنفى بداية من العنوان “قطط إسطنبول”، والعنوان هنا مخادع، فالمدينة التي توصف بأنها “عاصمة قطط العالم”، تحنو على القطط الحقيقية، بينما المشردون والمنفيون من القطط المجازية غير مرحّب بهم، لذلك يتم ترحيلهم إلى قاع المدينة، عند أطراف ضاحية “أسنيورت”، في المكان الذي أصبح معروفاً بحيّ الغجر، تقول الرواية إنه “كان قبل الحرب مجردَ وادٍ للذئاب الضالة، والقطط الشاردة، شيّدت فيه معالمُ المدينة وتحوّلت إلى مرتع للمهرّبين والمزوّرين وقوّاد الدعارة وسماسرة الاتجار بالبشر”، وهناك في إسطنبول “كل شيء ممكن، لا يعرف المرء ماذا يمكن أن يتعرض له، ثمة مفاجآت كثيرة. لا أحد هنا تهمه دموع الآخرين، جوعهم، معاناتهم، وكل من فيها لاهث، لا يرى غير وجهه”. لذلك يستهل الراوي العليم روايته بقوله: “ليس لدى المشردين مأوى في ليالي البؤس، غير ظلام الحدائق بعد منتصف الليل، أو مقابرِ المدن تحت الجسور الرَّطِبة أو الأماكن المهجورة، يتشابهون مع الكلاب الضالة وقطط الليل، إذ لا فرق بين المقبرة والحديقة”، هكذا تمهّد عتبة الاستهلال للحكاية بالتأكيد على بؤس حياة المنفيين.
تبدو إسطنبول كلها كمقبرة للمنفيين، الراوي يلتقط أحدهم، “اللولو” قط مشرد في المنفى وفي الحديقة يلتقي الصبيّة شام، تبدو له شبه ميتة، كانت تصيح بجنون: “أنا شام.. أنا لستُ داعرة”. ويصحبها إلى حيث تقيم في بيت الشابات، تسكن فيه عدة صبايا عربيات تمارسنَ الدعارة، شام إحداهنَّ، وهو دون أن يدري يردها إليه. وهناك يلتقى اليمنية والعراقية واللبنانية والسورية كلهنَّ دفعتهنَّ الحرب إلى المنفى ليصرنَ بغايا، وحينما تتركه شام وتغلق باب حجرتها يغادر المكان، تصفه الرواية “يمشي متهالكاً مثل حمار”، وهو أيضاً يصف نفسه ذات الوصف حينما يكتشف أنه أعاد الصبية إلى بيت دعارة، وهو التصرف الذي يندم عليه حتى قرر في النهاية أن يكون رجلاً ويساعدها على التخلص من عارها.
أيام شامية
تواصل الرواية استعراض أحوال المنفيين من خلال حركة اللولو وشام في المكان، فترسم صورة لقاع المدينة الهامشية ولمجتمع الظل في المنفى، ويستعيدان الوطن عبر تدفق متواصل للذكريات.
أما اللولو فقد كان قبل المنفى عازفاً، لكنَّ القمع والفساد الذي يمارسه النظام الحاكم يبدو وكأنه سفاح قربى من نوع آخر، فيحلم اللولو بوطن آخر، وتأتي الحرب لتدفعه إلى النزوح، فيجد الموسيقي نفسه وقد أصبح قطاً مشرداً بصحبة الآنسة “هند خانم”، وهي قطته الأثيرة، والكائن الوحيد الذي يشاركه الحياة في القبو الذي يسكنه. ويراها مختلفة عن كل القطط التي تعج بها إسطنبول.
يشبّه اللولو نفسه بسمكة تحاصرها شبكة صياد حالم بصيدٍ ثمين، لذلك فهو “يسبحُ في الأعماق مثل سمكة صغيرة، خائفاً، مسلوباً، جسداً ضعيفاً بلا هوية، يدمى قلبه مع كلّ خفقة، ويفرّ من نفسه إلى نفسه في ليالي الوجع”.
وفي المنافي لا يلتقي المشردون إلا في فضاء مفتوح، فليس ثمة بيت، ولا خصوصية للبشر أو للأماكن، لذلك لم تهتم الرواية بوصف المقهى وكأنَّ “أيام شامية”- مكان لقاء اللولو والمنفيين- لا يختلف عن غيره من المقاهي، والشارع كذلك لا يختلف عن سواه، وعموماً لم تتوقف الرواية طويلاً عند تفاصيل أماكن المنفى، اكتفت فقط برصد ما يؤكد تيه المنفي أو بؤس حاله. فليس لدى المشرد من الوقت أو المزاج ما يسمح بتأمل تضاريس الأماكن، وليس ثمة فرصة للاستمتاع بجمال، فقط وقائع حاضر بائس، وطوفان ذكريات يغمره.
رفاق المقهى شاعر ومخرج تلفزيوني واليبرودي الذي كان مليونيراً قبل الحرب، وعبود الأقرع الذي يعده اللولو الظلَّ الذي لا يمكن التخلي عنه، وفي المقهى يحكي “عبود الأقرع” أنه كان مسجوناً دون ذنب، فهو يعمل دون إذن رسمي في ورشة خياطة داهمتها الشرطة وقبضت على العاملين هناك دون إذن، صاحب الورشة قدم الرشوة لمدير المخفر ليفرج عن العمال وبالطبع يخصم قيمة الرشوة من أجر العمال.
يحكون عن عذابات الحصول على الكيملك أو بطاقة حماية دولية مُؤقتة، وتعني أنَّ حاملها لاجئ مؤقت، وكان منحها في بداية الحرب ميسوراً لكن مع طول أمد الحرب واستمرار تدفق اللاجئين أوقفوها، يصفها اللولو بأنها هوية مذلة.
ويتذكرون نادر الرحال زميل بدايات درب اللجوء، وكان شاعراً تغنت قصائده بالحب والحرية، لكنَّ قصائده ومقالاته الأخيرة خلقت له أعداء كثيرين، لكنه في النهاية مات غريقاً، ولم تصرح الرواية بطريقة غرقه، لكن تصفه بأنه شاعر حالم مات من الجوع والبرد، ودفنوه في مقابر الغرباء. بعده يموت “عمرو الأشقر” الذي قفز من الطابق السادس، تقول الرواية إنه مات قهراً ألف مرة، ولم تكتب الصحف خبره، فموته مثل حياته لا يهم أحداً.
شام والذئاب
اللولو الذي يعاني التعب والإرهاق والجوع، يعمل في غسل الصحون في أحد المطاعم، يحكي للأقرع عن بيت الشابات ويصف الصبايا بالأسيرات وأنهنَّ لاجئات مقهورات ثم يسأله: لماذا لا ننقذهنَّ؟ فيردّ عليه بأنَّ بيوت الدعارة في إسطنبول، فمن ننقذ ومن نترك؟ ثم يضيف: إذا استطعنا أن ننقذ أنفسَنا، فهذا هو النصر المبين.
أمّا شام ( ولنلاحظ دلالة الاسم) فقد فقدت الأب مبكراً تعيش في كنف زوج أمها صفوان، كان عقيماً فلم يكن لها منه إخوة، وكان بلا ضمير انتهك جسد الطفلة وأفقدها عذريتها، احتفظت بسرِّها حتى كبرت وتقدم لها من يريد الزواج منها، خافت اكتشاف السر فاستجابت لغواية “تاجار” وهو ذئب بشري آخر، عرفته عبر الإنترنت وادعى أنه يحبها وعرض عليها الزواج، وقام بتسهيل هروبها إلى إسطنبول، فسافرت إليه هرباً بسرها، وهناك وجدته قواداً أجبرها على ممارسة الدعارة ضمن شبكة يقودها الرئيس بارو.
شام التي لم تسلّم جسدها طواعية أبداً، تتمرَّد على المهنة وترفض الاستمرار فيعاقبونها بالحبس والتعذيب، وفي محبسها تدرك أنها مجرّد سمكةٍ صغيرة دخلت شبكة صيّاد محترف، يرميها تحت أقدام مَن يريد، وتحت وطأة التعذيب تحاول إقناع نفسها بمواصلة حرفتها، وبعدما كانت تصرخ أنا لست بداعرة، قالت لنفسها: أنا لست داعرة منفردة، واحدة، أنا ضمن حلقة كبيرة، واسعة، منظمة، وكلّ مَن في هذه الحلقات مجرد فرد عابر، هكذا تحاول إقناع نفسها بقبول الواقع، لكنها في النهاية تقرر أنَّ الموت أشرف لها من أن تعيش العمر كله عاهرة، وتستمر في المقاومة، ولم يتضامن معها بحق إلا جسدها الذي أعلن المرض حتى لا يكون صالحاً للانتهاك اليومي.
منفى بديل
المنفى كان جحيماً، فليالي إسطنبول تنضح بالفراغ، وتلعنُ الغريبَ لأنه لا يرى في الظلام، واللاجئون يصبحون ورقة رابحة في الانتخابات ويتسابق المرشحون في منح الوعود للناخبين بالتخلص من اللاجئين الذين يقتسمون معهم القوت وفرص العمل، فتعلو الصيحات “فليرحل اللاجئون”، ويستمر الشحن للناخبين فتوجهوا صوب المحال التي تضع أسماء عربية، وقاموا بتحطيمها وكسْرِ أبوابها الزجاجية، والاعتداء على أصحابها.
وفي موضع آخر تشير الرواية لجريمة اغتصاب طفلة سوريّة في العاشرة من عمرها من قبل مواطن في الخمسين من عمره، وأنَّ صبياً لم يتعدَ الخامسة عشرة قتله الشرطي بالرصاص لأنه ركض خوفاً من الترحيل حينما أمره الشرطي بالتوقف، وشاب انتحر بسبب فشله في الحصول على بطاقة الكيملك.
والمنفيون كذلك لم يكونوا ملائكة، فبعضهم عملوا عيوناً للشرطة التركية وأبلغوا عن زملاء المنفى، وبعضهم يتاجر في أغذية منتهية الصلاحية، ومن كان في الوطن ممرضاً يدّعي في المنفى أنه طبيب للأمراض الجلدية، وهناك أيضاً الشيخ الذي يؤسس جمعيّة خيريّة أسماها “برّ الشام”، ويجمع أموال الزكاة والصدقات بحجّة إيصالها للاجئين حسب زعمه. ثم يتبين أنه محتال لا يُحسن حتّى تلاوة دعاء دفن الميت.
لذلك يسعى اللولو نحو منفى بديل، فيدخر الأموال ويتفق مع من يستطيعون تهريبه إلى دولة أوروبية أخرى، غير مبال هو وصحبه باللصوص وقطاع الطرق، وحرس الحدود المسلحين، والكمائن التي تنصبها الأفاعي والعقارب السامة، في الغابات الكثيفة، تلك التي لا تؤدي إلى أي طريق. والمهربون يقولون دائماً: “واصلوا المشي وانتبهوا أن يكشفنا أحد”، وفي النهاية يتم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود الدولية، وقد تم نهب كل ما يملكونه من مال حتى جوازات سفرهم وهويات الحماية الدولية للاجئين مزقت كلهاً، وأحرقت أمام أعينهم.
حينئذ فقط يبدو الوطن فردوساً مفقوداً، ويتذكر أدق تفاصيل حلب، وأبوابها التسعة، يقول: “لقد أصبح كل باب من أبواب حلب فجاً عميقاً في قلبي، واسعاً وطويلاً وحاداً”، ويقارن بين المجد الغابر للمدينة وحاضرها “ولكن آه يا أمي، صارت حلب اليوم تأكل أولادها، تهربهم، ترسلهم بعيداً، تتخلى عنهم، تهبهم بلا ثمن، وهنا، فيما كانت بعض هذه الولايات تابعة لها، أصبحنا فيها مجرد قطط تائهة”.
هكذا يصبح مهيأ نفسياً لرحلة العودة، ويستعيد مقولة صديقه اليبرودي “كن رجلاً”، ويقرر أن يكون كذلك، وأن يخوض حربه الأخيرة من أجل إنقاذ شام وأيضاً إنقاذ روحه، وتنتهي الرواية نهاية مفتوحة، فمعطيات الواقع لا توحي بالنصر، والقعود عن المعركة استسلام واستمرار لبؤس المنفى، لكن يبقى الأمل في أن يظل صامداً مسكوناً بالروح الجديدة حتى يتمكن من تغيير الواقع وإزالة آثار كل أنواع السفاح، وأخيراً استعادة شام وقد برئت تماماً وتطهّرت روحها.





