الإفلاس الفكري مدخلاً لتأنيث العالم
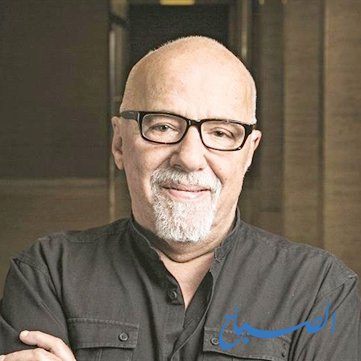
جينا سلطان
قرن «كولن ولسون» سقوط الحضارة بتردي الذائقة الفكرية، وتخبطها بين النزعة الكلاسيكية القائمة على مفاهيم الجمال والإشراق الداخلي، والإرث الفرويدي المتأتي عن الغوص في متاهات النفوس المعتمة، والمرتبط بثنائية العنف والجنس. بينما سعى الكاتب الفرانكفوني أمين معلوف إلى إعلان إفلاس الحضارة الغربية، والمتناسل عن سقوط الإمبراطوريات الكبرى، كنتيجة حتمية لبلوغ عتبة التخمة والإشباع، وبالتالي مواجهة الخواء.
يُعتبر معلوف مؤرخ اللحظة في أعماله الروائية، وبالتالي يغدو استخدامه مصطلح الغادريان، وهم الحراس القيمون على حفظ النوع البشري من الاندثار، اعترافاً بعجز متعاظم عن استيعاب مخزون العنف الهائل لديهم.
يُضاف إليه فشل الايديولوجيات القائمة على تصارع الأضداد بتقديم تفسير مقنع للمعاناة المتحكمة بالشرطية الإنسانية. فيتبلور إحساس بالنقص لقصور المفكرين عن إعطاء حلول تضبط الانتشار النووي الجامح، والمترافق بتصاعد التوق للسعادة والمتعة، ورفعهما إلى مصاف الهاجس الأساسي للوجود.
تعيدنا كلمة الغريب في اللغات الإنسانية، التي استقامت حين بلبل الله الألسنة، فتسامق برج العرفان في النفوس التواقة إلى بارئها، إلى الإنسان المفارق في طبيعته وعاداته ومسلكه لثقافة القطيع، فيصب اغترابه ضمن بوتقة التميز والإبداع.. بالمقابل، يعكس اضطهاد الغرباء تقوقعاً حول الذات، وتضخماً في ظلمات النفس الرافضة لتقبل الانفتاح على الآخر المختلف، فتتبدى العنصرية وجهاً للإبادة الجماعية والحروب والتكفير والإذلال الجمعي للشعوب. وهو ما يشكل مدخلاً لمعاينة أفول الحضارة وسقوطها في مستنقع العنف والترهيب، الذي يمكن أن تختزله قنبلة نووية في أيدٍ تفتقر إلى الحكمة.
يرد معلوف في روايته إخوتنا الغرباء ولادة مشروع الرواية إلى نواقص التاريخ، استناداً إلى مقولة «نوفاليس» في «الشذرات». ويتخذها مدخلا لتأطير هواجس الخلود بالنزوع نحو إطالة أمد الحياة، مهما كان الثمن، والبقاء في شباب أبدي، حتى لو تحولت تلك الرغبة إلى حاجة ملحة ومدمرة. وتناسباً مع إيمانه بدوره كمؤرخ يقسم روايته إلى أربع مفكرات، يدون فيها الرسام “ألك” انطباعات بسيطة حول الترقب الجمعي لنهاية العالم بفعل قنبلة نووية. ويستنسخ بطله هذا من كتابه “الهويات القاتلة”، فيمنحه عبر الهوية المزدوجة دور مراقب حيادي، يتأمل في عزلته تخبط البشرية تحت وطأة الغوايات الكبرى والطموحات القاتلة.
يتدرج معلوف في ترميز فصوله من الغشاوة المستقرة فوق البصيرة المشوشة بالترهيب، الذي يجسده تهديد القنبلة النووية، إلى تجلي الحقيقة التي تضع نقطة الختام لمسير الحضارة القائمة على ثنائية العنف والخذلان. ليشير في الفصل الثالث إلى الخلاص القادم عبر وسائط خارجية تنتمي إلى عالم البحر، الذي يجسد الوفرة والغموض والاتساع، لتبرز من خلف الستار حاكمة جديدة للأرض تدعى إلكترا، تستبدل الوجه المذكر للحضارة بآخر مؤنث يمجد الحكمة والرحمة. وكأن مؤرخ اللحظة يتبنى رؤى باولو كويلهو وتبشيره بعودة الإنسانية إلى نقطة البداية، بعد الاستدارة الكاملة للزمن، لتدخل البشرية سن الرشد في عهد أمومي.
يبتدئ معلوف فصل الغشاوات بعبارة توراتية وردت على لسان الملك جون “السماء المكفهرة لن تصحو إلا بعد عاصفة”. ويؤرخ غضب الطبيعة المتصل بتهديد القنبلة النووية ببدايات الخريف، في جزيرة منعزلة يتقاسم ملكيتها “ألك” مع جارته الروائية “إيف”، التي تعتبر أيقونة جيل سُلبت مثله العليا، واُنتزعت منه بهجة الحياة المتمثلة في ترقب الأفراح القادمة. فبعد أن كتبت روايتها الوحيدة “المستقبل لم يعد يسكن في هذا العنوان” تركت وظيفتها في الجامعة، وطافت حول العالم، ثم ركنت إلى عزلة الجزيرة لتواجه فناء العالم مع “ألك”، بعد اجتماع مقومات أزمة كبرى بفعل الإصرار الأمريكي على جمع الأسلحة النووية.
يسمي معلوف أوصياء الأرض الذين يديرون العالم بـ”امبيدوقليس”، ويمنحهم القدرة على التحكم بمقومات الحضارة، القائمة على الكهرباء والهاتف والانترنت. بحيث يشلون مفاصل الحياة الصناعية والعسكرية، ويضعون أرباب الدول أمام مأزق فقدان السيطرة على شعوبهم وإدارة مصالحهم. وبينما ينسب دور الشرطي العالمي إلى الراعي الأمريكي، والإرهابي إلى المشير “سارداروف” في جبال القوقاز، يمنح الغادريان أسماء وملامح يونانية قديمة.
تقع رواية “إيف” تحت بند انجلاء الأوهام، وتبنى على فرضية وجود مستويين متوازيين من البشرية، تعيش إحداهما في النور، رغم أنها حاملة للظلام، وتتوارى الأخرى في الظلمة، مع أنها حاملة للنور.
وبالتالي تزدوج المسرحية البشرية فوق خشبة الأرض لتنجز عرضين متزامنين، الأول سطحي مجرد من الوعي ويعكس الصيرورة البشرية، والثاني باطني، ويحمل الحكمة والخلاص. فيصبح لقاء البشر بقاطني المستوي الموازي لعالمهم مماثلاً للقائهم بمستقبلهم.
تجسد شخصية “إيف” مفهوم التخمة الاستهلاكية، التي يبلغها الإنسان قبل أن يلتهمه الخواء. إذ تنتفي عندها الأسباب الباعثة على مقت عصرها أو على الأقل النظر إليه بريبة. فالعالم الذي ترعرعت في كنفه كان يقدم لمعاصرين كثيرين، رجالا ونساء، مباهج فكرية وحسية ما كان ليحلم بها أحد من الأجيال السابقة، ابتداء برحلات إلى أقاصي الأرض، ووسائل اتصال تلغي المسافات، وأجهزة ذكية لتسيير الحياة اليومية، وانتهاء بإتاحة الاستماع والاطلاع على مجمل الأعمال والمعارف، التي راكمها الجنس البشري منذ بدء الخليقة. ومع أن ذلك كان بمثابة الجنة للشابة الجامحة “إيف”، المحبة للسهر والمتسمة بشهية عارمة للمعرفة، إلا أنها تنبأت بزوال البشرية.
تقدم فرضية السفن الراسيات، التي تسلل منها الأوصياء إلى اليابسة، مدخلا للتطرق إلى تبعات استخدام تقنيات الذكاء الصنعي المتقدمة جداً، في ترميم الأجساد المتهالكة وصيانتها. فتغدو رغبة البشر في الخلود سبيلهم إلى العبودية، لأن مجرد القناعة بأن أحدهم، سواء كان رجلا، أم حزبا، أم شعبا، أو جماعة، بمقدوره شفاؤهم من جميع أمراضهم وإطالة أعمارهم، يجعلهم على استعداد لئن يصبحوا عبدته وعبيده. وبالتالي، تتحول الأمة الغريبة، التي لم يفطن لوجودها أحد، إلى قوة كلية القدرة بالنسبة للبشر. وهذا ما ينعكس في سياق اعتراف بـ “مخلصين” مختلفين، يختزلون البشر بجميع شعوبهم إلى مرتبة سكان أصليين، ويحولون التاريخ الإنساني بأبطال وقديسيه وغزاته إلى فصل ثانوي من المغامرة الكونية. ليتحقق مجدداً عند معظم المجتمعات البشرية، ما شهدته شعوب الأزتيك والأنكا على يد الفاتحين الإسبان، من تبخيس مفاجئ لمعارفهم ورؤيتهم للعالم، وهويتهم ومكانتهم. شهد “ألك” ظاهرتين بمنتهى الوضوح، تمثلت الأولى في الانتصار الحاسم لأمة أصبحت خلال عقود قليلة القوة العظمى الوحيدة، والحضارة الوحيدة أيضا. بينما تبدت الثانية بانتصار أمة امبيدوقليس، والذي حصل بطريقة مباغتة، لم تسبقها مراحل انحطاط طويلة، تهيئ الحضارات الفاقدة لمرتبتها للاعتياد على تهميش موقعها والاذعان لانتفاء أهميتها.
وينعكس مشهد الإذعان باعتلاء ملكة الأوصياء “إلكترا” المنبر لمخاطبة الجموع البشرية المحتشدة أمامها، ومطالبتهم بالرشد، الذي ينصب الموت عدواً أوحد للطرفين. فإذا أخذنا بعين الاعتبار رمزية عقدة إلكترا في الأساطير اليونانية، التي ترتبط بإزاحة الأم والتعلق بالأب، لربما بدا عندئذ المسعى الروائي لمعلوف أكثر وضوحاً.





