قراءة في كتاب.. {الفكر السياسي الإسلامي بين الموروث وتحديَّات العصر}
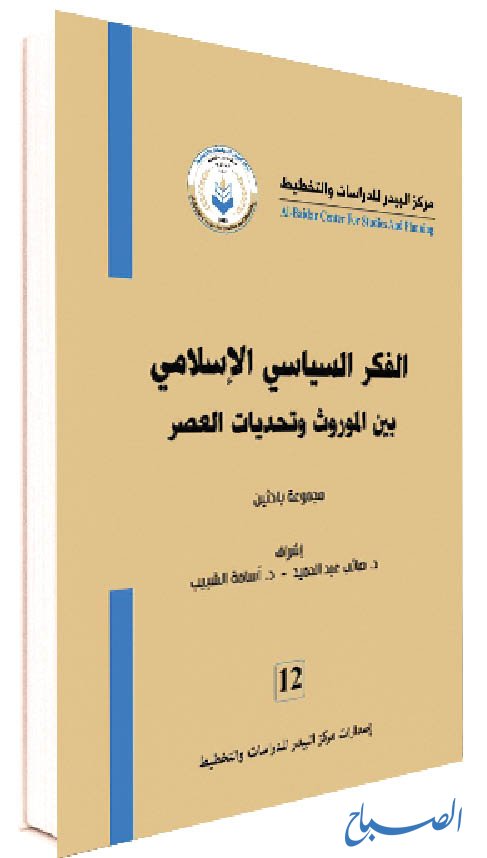
د. عبد الخالق كاظم ابراهيم
تصوير: نهاد العزاوي
"صدر مؤخراً كتاب "الفكر السياسي الإسلامي بين الموروث وتحديات العصر" عن مركز البيدر للدراسات والتخطيط – بغداد، 2025. بإشراف: د. صائب عبد الحميد، و: د. أسامة الشبيب. ويأتي الكتاب في إطار محاولة جادة لتجديد الفقه السياسي الإسلامي في ضوء المتغيرات البنيويَّة التي طالت الدولة، والمجتمع، ومفاهيم السلطة والشرعية السياسية في العالم المعاصر، من خلال قراءة نقدية للموروث، واستيعاب التحديات الفكرية والواقعية في السياق المعاصر؛ ولذلك فإن الحاجة الى فكر سياسي قائم على أسس متينة ورصينة، ليس بابا من أبواب الترف الفكري، بل يعد حاجة أساسية لكل نظام سياسي يتولى او يطمح ان يتولى إدارة شؤون الحكم والدولة والمجتمع. كما ان الفكر السياسي ليس وليد النظرية وحدها، بل هو وليد أسئلة الحياة الكبرى، وليد التحديات الجادة التي تواجه الوضع القائم، فما أصل نشوء السلطة وما أساس شرعيتها؟ وما السبيل الى تأسيس الدولة؟ ومن الذي يتولى الحكم في الدولة وكيف تدار شؤونها؟ وما طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب او الامة؟ ما أدوات الحكم والسلطة وما العلاقة بين مؤسساتها الرئيسة؟ كيف يكون نظام القضاء وكيف تسير عجلة الاقتصاد وعلى أي مذهب اقتصادي؟ وما الأسس في العلاقات الخارجية للدولة؟ ونحوها من الأسئلة الرئيسة والمتفرعة الكثيرة.
يتكون الكتاب من أحد عشر فصلاً، وهو نتاج مجموعة من الباحثين من مشارب مختلفة، جمعتهم الرغبة في الإجابة عن أسئلة محوريّة تتعلق بالتحديات المعاصرة، ويأتي الكتاب في ظل لحظة فكريّة حرجة، تعيش فيها المجتمعات الإسلامية صراعاً داخلياً بين استدعاء الموروث ومحاولة مواكبة التحديث السياسي. ولا يكتفي الكتاب بعرض المقولات التراثيّة في الفكر السياسي، بل يتجاوزها إلى مساءلة بنيتها، وتحليل جذورها، وقياس مدى قابليتها للتأقلم مع الدولة الحديثة ومفاهيم مثل الديمقراطية، والمواطنة، والتعددية السياسية، والعقد الاجتماعي. فاذا كان من المنطقي ان يتأسس الفكر السياسي في الإسلام على ركيزتين أساسيتين؛ المصدر التشريعي المتمثل بالكتاب والسنة، ثم النتاج الفقهي والفكري المتقدم في الحقبة الأولى من تاريخ الإسلام وما بعدها، فإن ثمة مصدرا جديدا خارجيا، بالغ الأثر، لا يمكن تجنبه او تجاهله، متمثلا بالواقع السياسي العالمي المعاصر، وكل ما افرزه من نظريات ومفاهيم رافقته وطبعته بطابعها.
ويُعد الكتاب من الإصدارات الجادة التي تعكس حراكاً علمياً نقدياً في حقل الفقه السياسي الإسلامي، ويضم مجموعة من الدراسات المتنوعة التي تناولت إشكاليات معقدة في الفكر السياسي الإسلامي من منظور مقاصدي، تحليلي، واجتماعي، مع سعي واضح لتجديد أدوات الفهم السياسي المعاصر انطلاقاً من الموروث الديني، ويعكس في الوقت ذاته صراعاً داخلياً بين التمسّك بالموروث والانفتاح على الحداثة. ويتميز الكتاب بتعدد مناهجه، سواء كانت دراسات فقهيّة تأصيليّة، او مقاصديّة تجديديّة، او سوسيولوجية سياسية، ويتضمن مقاربات نقدية تستفيد من الفلسفة السياسية الحديثة، كما أنه يُنتج تفاعلاً بين الفكرين السني والشيعي بطريقة علمية مسؤولة، مما يمنحه طابعاً وحدوياً وموسوعياً في آنٍ معاً. والكتاب لا يُقدّم إجابات جاهزة، بل يفتح فضاءً للنقاش، ويؤسس لما يمكن تسميته "فقهاً سياسياً نقدياً". ينتمي إلى مدرسة التفكير المزدوج التي تجمع بين الحفاظ على المرجعية التراثية والانفتاح على قيم الدولة المدنية.
وتناولت المحاور الرئيسة للكتاب التحولات التاريخية لمفهوم الولاية في الفقه الشيعي، ابتداءً من الإمامة المعصومة وصولا إلى ولاية الفقيه عند الإمام الخميني، والاختلاف بين رؤى المرجعيات الدينية الشيعية المتعددة. ويعالج إشكالية تعدد الفقهاء، وحدود الصلاحيات، والفروق بين النصب والانتخاب. ويتناول القواعد الفقهية السياسية والتفريق بين الثابت والمتغير في الفقه السياسي، ويؤكد مركزية العقل والمصلحة في الاجتهاد السياسي، مبرزاً إمكانات التحديث الفقهي المنبثق من مقاصد الشريعة. ويرصد بعض القواعد الأصولية التي يمكن إعادة تفعيلها في المجال السياسي، ويدعو إلى تأسيس فقه سياسي يتجاوز النزعة النصوصية وضرورة اعتماد مقاربة مقاصدية تميز بين الثوابت القيمية والمتغيرات الإجرائية، كون الجمود على حرفية الفتاوى يؤدي إلى تكلس فقهي يعجز عن مواكبة الدولة الحديثة. اما الفقه السياسي الإسلامي في ضوء مقاصد الشريعة فينطلق من التأسيس لفكر سياسي مقاصدي، قادر على تجاوز الأطر الحرفية، ويتبنى نظرية "الشرعية العقلانية" في الحكم، إذ إن غياب البعد المقاصدي في الفقه السياسي أدى إلى نتائج سلطوية. الامر الذي يؤكد ضرورة اعتماد التعاقد الاجتماعي والاختيار الشعبي، وعقلنة الفقه السياسي وربطه بمقاصد العدالة، والشورى، وكرامة الإنسان.
ويعرض الكتاب الى مفهوم التعددية السياسية وفق رؤية فقهية تؤسس للقبول بالتعدد في المجتمع المسلم، وينتقد الفهم الإقصائي الذي تبنته بعض حركات الإسلام السياسي، وبيّن قابلية الفقه الإسلامي -بقراءته المقاصدية- لاستيعاب التعدد والاختلاف، ورفض الانغلاق المذهبي والسياسي، وبناء شرعية سياسية تعددية داخل المرجعية الإسلامية. ويناقش ازدواجية الخطاب الإسلامي بين الدولة الدينية والدولة المدنية، ويوضح أن أغلب أحزاب الإسلام السياسي تتبنى خطاباً دينياً لكنها تمارس سياسية براغماتية. ويحاول تفكيك الخطاب المزدوج لبعض الإسلاميين بين الدين والمدنية.
اما إشكالية الدولة الوطنية فيستعرض التحدي الذي تواجهه مفاهيم الأمة والشريعة أمام صعود الدولة الوطنية الحديثة، مبرزاً التوتر بين الهوية الإسلامية والهوية الوطنية. مبيّناً أن المفهوم الإسلامي للدولة لا يتنافى مع الانتماء الوطني شريطة أن لا يُقصي المرجعية القيمية للإسلام، فالدولة الوطنية أصبحت ضرورة واقعية رغم تباينها مع المفهوم الإسلامي التقليدي. ويتطرق الى المواطنة ونظرية ولاية الفقيه من خلال حقوق غير المسلمين والمخالفين ضمن دولة إسلامية تخضع لولاية الفقيه، محاولاً استكشاف إمكان المواءمة بين المفهومين وصياغة فهم مدني للولاية يراعي حقوق الجميع. أما الإسلام السياسي والعلمانية فيعرض من خلاله الى تاريخ العلاقة الجدليّة بينهما، مشدداً على ضرورة إنتاج أنموذج توافقي يتجاوز التناقض الصدامي، ويقوم على التمايز لا التضاد، يحترم الدين ولا يختزل السياسة في الطابع الديني.
ويسعى الكتاب الى قراءة مفهوم المستبد العادل كأداة لتبرير التسلّط باسم الدين، وبيان تحوله إلى إشكالية في الوعي السياسي الإسلامي. ويحلل مفهوم "المستبد العادل" كمفارقة بنيويَّة أنتجها فقه الضرورات. ويحلل الديمقراطية في الفقه السياسي السّني، اذ يرصد محاولات مواءمة الديمقراطية مع الفقه السّني، مع التركيز على التجاذب بين مفهوم "الشورى" و"التفويض الشعبي". وبيان القبول المشروط لها ضمن ضوابط الشريعة.
ويتناول الكتاب في محطته الأخيرة الإسلام السياسي في خطاب السيد السيستاني من خلال رؤيته التي تتميز بـ "اللا عنف السياسي" و"الحياد النسبي"، ويرى أن المرجعية يجب أن تبقى ضابطة للمجتمع، لا شريكاً في السلطة التنفيذية، بوصفها أنموذجاً "غير سلطوي" يكتفي بالدور التوجيهي، مما يفتح أفقاً جديداً للعلاقة بين الدين والسياسة؛ مما يجعله مثالاً على التوازن بين الفقه والواقع
السياسي.





