سُبُلٌ مُقترَحة إلى الحُرّيَّة
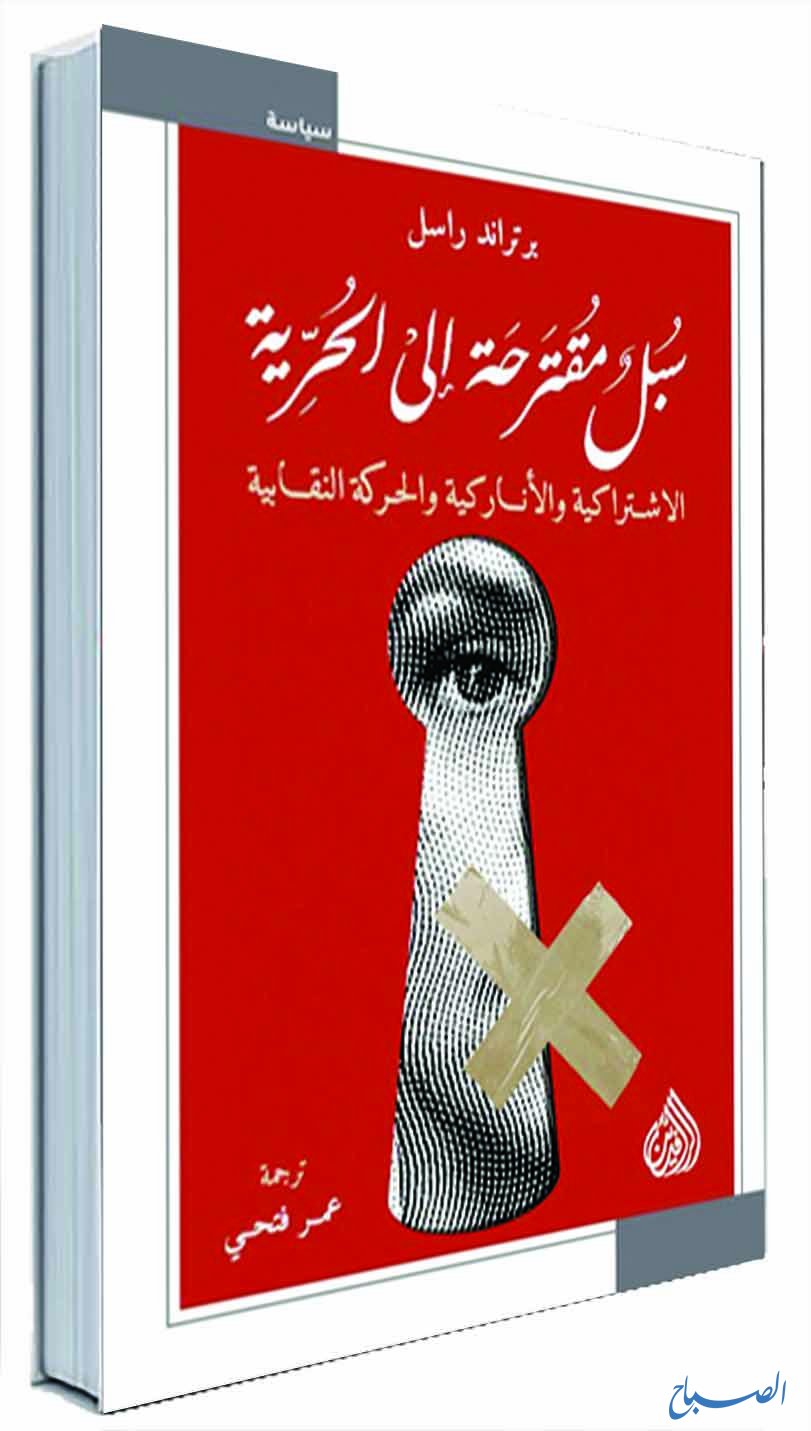
ترجمة: عمر فتحي
مقدمة
إن محاولة تصوّر نظام للمجتمع البشريّ أفضل من الفوضى المدمرة والقاسية التي ما زالت تعاني منها البشريّة حتى الآن ليست حديثة بأي حال من الأحوال، فهي على الأقل قديمة قِدم أفلاطون، الذي وضعت «جمهوريته» النموذج المثالي لليوتوبيا (المدينة الفاضلة) للفلاسفة اللاحقين.
إن من يتأمل العالم في ضوء هدفٍ أسمى- سواء أكان ما يسعى إليه هو الفكر، أم الفن، أم الحب، أم السعادة البسيطة، أم جميعهم- لا بد أن يشعر بأسفٍ شديد نتيجة للشرور التي يسمح البشر باستمرارها دون داعٍ، وأن يشعر كذلك -إذا كان رجلًا ذا همة وطاقة- برغبة ملحة في توجيه وإرشاد البشر لتحقيق الخير الذي يلهم رؤيته الإبداعية الخلّاقة.
كانت هذه الرغبة بالتحديد هي القوة الأساسية التي تحرّك رواد الاشتراكية والأناركية، مثلما حركت مخترعي فكرة المجتمعات المثالية أو المدن الفاضلة في الماضي.
وفي ذلك، لا يوجد شيء. لكن الجديد في الاشتراكية والأناركية هو تلك العلاقة الوثيقة لهدفها الأسمى بمعاناة البشر الحالية، والتي مكّنت الحركات السياسية القوية من الانبثاق والنمو من آمال المفكرين المنعزلين. هذا هو ما يجعل الاشتراكية والأناركية مهمتَين، وهذا ما يجعلهما خطرتَيْن على أولئك الذين يستفيدون، بوعي أو بغير وعي، من شرور نظام مجتمعنا الحالي.
إن الغالبية العظمى من الرجال والنساء، في الأوقات العادية، يعيشون في الحياة بشكل عام دون أي تفكير أو نقد سواء لظروفهم الخاصة أو لظروف العالم بأسره. فهم يجدون أنفسهم قد ولدوا في مكان معين في المجتمع، ويقبلون ما يظهر لهم كل يوم، دون أي جهد فكري يتجاوز ما يتطلبه الحاضر المباشر. وهم يسعون، بشكل غريزي مثلهم -تقريبًا- مثل الحيوانات، إلى تلبية احتياجات اللحظة الحالية، دون الكثير من التفكير، ودون الانتباه إلى أنه من خلال الجهد الكافي، يمكن تغيير ظروف حياتهم بأكملها. بينما تقوم نسبة معينة من الناس، بدافع الطموح الشخصي، ببذل الجهد -على مستوى الفكر والفعل- اللازم لوضع أنفسها بين أفراد المجتمع الأكثر حظًّا، فإن القليل من هذه النسبة يهتمون بجديّة بتحقيق جميع المزايا التي يسعون إلى تحقيقها لأنفسهم للناس جميعًا. إذا فقط عدد قليل للغاية واستثنائي من البشر هم الذين لديهم هذا النوع من الحب تجاه البشريّة بشكل عام بحيث يجعلهم غير قادرين على تحمل ذلك الحجم الهائل من الشر والمعاناة، بغض النظر عن أي علاقة قد تربطهما بحياتهم. سوف يسعى هؤلاء القلائل، مدفوعين بالتعاطف، بالفكر أولًا ثم بالعمل، إلى طريقة ما للهروب، إلى نظام جديد للمجتمع يمكن من خلاله أن تصبح الحياة أكثر ثراءً، وأكثر بهجة، وأقل امتلاءً بالشرور مما هي عليه في الوقت الحاضر. لكن في الماضي، فشل هؤلاء الرجال، عمومًا، في إثارة اهتمام وانتباه ضحايا المظالم التي كانوا يرغبون في تصحيحها. فقد كانت القطاعات الأكثر بؤسًا من البشر جاهلة وغير مبالية من شدة الكدح والعناء، وخطر العقاب الفوري من قِبل أصحاب السلطة، وكذلك غير موثوقة أخلاقيًا بسبب فقدان احترام الذات الناتج عن اذلالها وتدهورها.
إن خلق أي جهد أو مسعى واعٍ ومدروس بين هذه الطبقات قد يبدو مهمة ميؤوسا منها، وقد أثبت الماضي ذلك بالفعل بشكل عام. لكن العالم الحديث، من خلال زيادة التعليم وارتفاع مستوى الراحة بين العاملين بالأجور، أنتج ظروفًا جديدة أكثر ملاءمة من أي وقت مضى للمطالبة بإعادة البناء والإعمار الجذري. إن الاشتراكيين في المقام الأول، وبدرجة أقل الأناركيين (باعتبارهم بشكل رئيسي مصدر إلهام للحركة النقابيّة)، هم الذين أصبحوا من دعاة هذا المطلب.
ربما يكون أكثر ما يلفت الانتباه فيما يتعلق بكل من الاشتراكية والأناركية هو ارتباط حركة شعبيّة واسعة النطاق بمبادئ وأهداف تهدف إلى عالم أفضل. لقد أُوضِحَت تلك المبادئ والأهداف، في المقام الأول، من قبل الكُتّاب المنفردين، إلا أن أقسامًا كبيرة من الطبقات العاملة قبلتها كدليل ومرشد لها في الشؤون العملية للعالم. هذا واضح فيما يتعلق بالاشتراكية، ولكن فيما يتعلق بالأناركية فإن هذا صحيح فقط مع بعض التعديلات. إن الأناركية في حد ذاتها لم تكن أبدًا مذهبًا ذائع الانتشار، بل اكتسبت شعبيّة فقط في الشكل المُعدَّل لها متمثلًا في الحركة النقابيّة. وعلى عكس الاشتراكية والأناركية، فإن الحركة النقابيّة هي في الأساس ليست نتيجة لفكرة، بل لمنظمة، إذ نشأت النقابات العمالية أولًا، وكانت أفكار الحركة النقابيّة هي تلك التي بدت مناسبة لهذه المنظمات في رأي النقابات العمالية الفرنسية الأكثر تقدمًا. لكن الأفكار، في الأساس، مشتقة من الأناركية، والرجال الذين جعلوها مقبولة هم، في الغالب، أناركيون. وهكذا يمكننا أن نعتبر الحركة النقابيّة أناركية الشعب، على عكس أناركية الأفراد المعزولين التي اتسمت بحياة غير مستقرة طوال العقود الماضية. من خلال هذا الرأي، نجد في الأناركية النقابيّة نفس تركيبة المبادئ والتنظيم كما نجدها في الأحزاب السياسية الاشتراكية. ومن هذا المنطلق سنُجري دراستنا لهذه الحركات.
تنبثق الاشتراكية والأناركية، في شكلهما الحديث، من زعيمين، هما ماركس وباكونين على التوالي، اللذين خاضا معركة استمرت طوال حياتهما، وبلغت ذروتها بانشقاق في منظمة الأممية الأولى. سنبدأ دراستنا مع هذين الرجلين من خلال تناول تعاليمهما أولًا، ثم المنظمات التي أسساها أو ألهماها.
سيقودنا هذا إلى انتشار الاشتراكية في السنوات الأخيرة، ومن ثم إلى الثورة النقابية ضد التأكيد الاشتراكي أهمية الدولة والفعل السياسي، وإلى بعض الحركات خارج فرنسا التي لها بعض التقارب مع الحركة النقابيّة، ولا سيما إتحاد عمال الصناعة العالمي في أمريكا والاشتراكية النقابية في إنجلترا. ومن هذا المسح التاريخي سوف ننتقل إلى دراسة بعض المشكلات الأكثر أهمية وإلحاحًا في المستقبل، وسنحاول أن نقرر في أي الجوانب سيكون العالم أكثر سعادة إذا تم تحقيق أهداف الاشتراكيين أو النقابيين.
رأيي الخاص -الذي لا مانع من أن أشير إليه في البداية- هو أن الأناركية المحضة، على الرغم من أنها ينبغي أن تكون الغاية النهائية، والتي يجب على المجتمع أن يقترب نحوها باستمرار، هي مستحيلة حاليًا، ولن تستمر لأكثر من عام أو اثنين على الأكثر إذا تم تبنيها. من ناحية أخرى، يبدو لي أن كلًا من الاشتراكية الماركسية والحركة النقابية، على الرغم من العديد من العوائق والعيوب، قادرتان على خلق عالمٍ أسعد وأفضل من ذلك الذي نعيش فيه. ومع ذلك، لا اعتبر أيًا منهما أفضل نظام عملي ممكن. فبينما الاشتراكية الماركسية أخشى أنها ستعطي الكثير من السلطة للدولة، فإن الحركة النقابية التي تهدف إلى إلغاء الدولة ستجد نفسها -كما أعتقد- مجبرة على إعادة بناء سلطة مركزيّة من أجل وضع حد لمنافسات المجموعات المختلفة من المنتجين. إن أفضل نظام عملي، في رأيي، هو نظام الاشتراكية النقابية، الذي يأخذ ما هو صالح في كلٍّ من ادعاءات اشتراكية الدولة والخوف النقابي من الدولة، من خلال اعتماد نظام فيدرالي بين المهن لأسباب مشابهة لتلك التي ترجح الفيدرالية بين الدول. وستظهر أسباب وأسس هذه الاستنتاجات ونحن نمضي قدمًا.
قبل أن نشرع في تناول تاريخ الحركات الحديثة التي تهدف إلى إعادة الإعمار الجذري، سيكون من الأهمية بمكان أن نتأمل بعض السمات الشخصية التي تميز معظم المُصلحين السياسيين الراديكاليين، والتي يُساء فهمها كثيرًا من قِبل عموم الناس لأسباب أخرى إلى جانب مجرد التحيز. وأرغب في أن أكون منصفًا بقدر ما استطيع في تناول هذه الأسباب، من أجل إظهار أنها في الواقع لا ينبغي أن تكون فعّالة.
إن قادة حركات التغيير الجذري هم، بشكل عام، رجالٌ ذوو إيثار غير عادي تمامًا، كما يتضح من النظر في مسارات حياتهم المهنية، فعلى الرغم من أنه من الواضح أنهم يمتلكون نفس القدر من القدرات التي يتمتع بها العديد من الرجال الذين يرتقون إلى مناصب السلطة والنفوذ، فإنهم لا يصبحون مؤثرين في الحوادث المؤقتة، ولا يحققون ثروة أو يحظون بتصفيق وتقدير الجماهير مثل معاصريهم. إن الرجال الذين لديهم القدرة على الظفر بهذه الامتيازات، والذين يعملون -على الأقل- بجِدٍّ مثل أولئك الذين ظفروا بها، ولكنهم يتبنون عن عمد مسارًا يجعل الظفر بها مستحيلًا، يجب أن نحكم بأن لديهم هدفًا في الحياة غير التقدم الشخصي، فبغض النظر عن أي قدر من المصلحة الذاتية قد يدخل في تفاصيل حياتهم، لا بد أن يكون دافعهم الأساسي خارج الذات. لقد عانى رواد الاشتراكية والأناركية والنقابية، في الغالب، من السجن والنفي والفقر، عن عمد لأنهم لم يتخلوا عن دعوتهم، وبهذا السلوك أظهروا أن الأمل الذي كان يلهمهم لم يكن لأنفسهم فقط بل للبشريّة جمعاء.
ولكن على الرغم من أن الرغبة في اسعاد ورفاهية الإنسان هي التي تحدد في الأساس الخطوط العريضة لحياة هؤلاء الرجال، غالبًا ما يحدث أن تكون الكراهية، في تفاصيل كلامهم وكتاباتهم، أكثر وضوحًا من الحب. إذ من شبه المؤكد أن المُصلح السياسي الراديكالي الذي نفد صبره -وبدون بعض نفاد الصبر لن يكون المرء فعالًا- سيُقاد إلى الكراهية من قِبل المعارضات وخيبات الأمل التي يواجهها في مساعيه لتحقيق السعادة للعالم، وكلما زاد يقينه من صفاء دوافعه وصحة عقيدته، زاد سخطه عندما تُرفَض تعاليمه، وهو غالبًا ما ينجح في تحقيق موقف من التسامح الفلسفي فيما يتعلق بلا مبالاة الجماهير، وحتى فيما يتعلق بالمعارضة الصادقة للمدافعين المزعومين عن الوضع الراهن. لكن الأشخاص الذين يلاحظون أنه من المستحيل مسامحتهم هم أولئك الذين يشعرون بنفس الرغبة في تحسين المجتمع كما يشعر بها هو نفسه، لكنهم لا يقبلون طريقته في تحقيق هذه الغاية. إن الإيمان الشديد الذي يمكّنه من تحمل الاضطهاد في سبيل معتقداته يجعله يعتبر هذه المعتقدات واضحة جدًا لدرجة أن أي رجل مفكر يرفضها يجب أن يكون غير صادق، ويجب أن يكون مدفوعًا بدافع خبيث وخائن للقضية. ومن هنا تنشأ روح الطائفة، تلك الدوغمائية المريرة التي هي لعنة أولئك الذين يتمسكون بقوة بعقيدة لا تحظى بشعبية. صحيح أنه توجد العديد من الإغراءات الحقيقية للخيانة بحيث يكون الشك أمرًا طبيعيًا. وحتى بين القادة، من المؤكد أن الطموح، الذي يحتقرونه عند اختيارهم مسارهم المهني، سيعود في شكل جديد، أي في الرغبة في السيادة الفكرية والسلطة الاستبدادية داخل طائفتهم. ينتج عن هذه الأسباب أن دُعاة الإصلاح الجذري يقسّمون أنفسهم إلى مذاهب متعارضة، يكرهون بعضهم بعضًا بكراهية مريرة، ويتهمون بعضهم بعضًا في كثير من الأحيان بجرائم من قبيل أنهم يعملون لصالح الشرطة، ويطالبون أي متحدث أو كاتب يعجبوا به، بأنه يجب أن يتوافق تمامًا مع تحيزاتهم وأن يجعل كل تعاليمه خدمًا لاعتقادهم بأن الحقيقة الدقيقة يمكن العثور عليها في حدود عقيدتهم. والنتيجة التي تظهر من جراء ذلك للشخص غير المدقق هي أن الرجال الذين ضحوا بالكثير من خلال رغبتهم في إفادة البشّة، يبدو أنهم مدفوعون بالكراهية أكثر من الحب. والمطالبة بالدوغمائية تخنق أي ممارسة حرة للعقل. هذا السبب، بالإضافة إلى التحيز الاقتصادي، جعل من الصعب على «المثقفين» التعاون عمليًا مع الإصلاحيين الأكثر راديكالية، على الرغم من أنهم قد يتعاطفون مع أهدافهم الرئيسية بل وحتى مع معظم برنامجهم.
أحد الأسباب الأخرى لسوء الحكم على المُصلحين الراديكاليين من قبل الرجال العاديين هو أنهم ينظرون إلى المجتمع القائم من الخارج، مع العداء تجاه مؤسساته، وعلى الرغم من أنهم، في الغالب، لديهم إيمان أكثر من غيرهم بالقدرة المتأصلة في الطبيعة البشريّة على عيش حياة طيبة، فإنهم يدركون تمامًا القسوة والقمع الناجمين عن المؤسسات والمنظومات القائمة لدرجة أنهم يعطون انطباعًا خاطئًا ومُضللًا تمامًا بالتشاؤم والسلبية.
إن معظم البشر لديهم بشكل غريزي نهجان مختلفان تمامًا للسلوك، أحدهما تجاه أولئك الذين يعتبرونهم رفقاء أو زملاء أو أصدقاء، أو بطريقة ما أعضاء من نفس «القطيع»، والآخر تجاه من يعتبرونهم أعداء أو منبوذين أو يشكلون خطرًا على المجتمع. يميل المصلحون الراديكاليون إلى التركيز على سلوك المجتمع تجاه الفئة الأخيرة، أي فئة أولئك الذين يشعر «القطيع» تجاههم بالبُغض أو العداوة. تشمل هذه الفئة بالطبع الأعداء في الحرب والمجرمين، وفي أذهان أولئك الذين يعتبرون الحفاظ على النظام الحالي أمرًا ضروريا لسلامتهم أو امتيازاتهم، فهي تشمل جميع الذين يدافعون عن أي تغيير سياسي أو اقتصادي كبير، وجميع الفئات التي من المرجح، بسبب فقرها أو أي سبب آخر، أن تشعر بدرجة خطيرة من السخط. نادرًا ما يفكر المواطن العادي في مثل هؤلاء الأفراد أو هذه الفئات، ويسير في حياته معتقدًا أنه وأصدقاؤه أُناسٌ طيبون، لأنهم لا يرغبون في إيذاء أولئك الذين لا يشعرون بأي عداء جماعي تجاههم. لكن الرجل الذي ينصب اهتمامه على علاقات مجموعة ما مع أولئك الذين تكرههم أو تخافهم سيحكم على الأمر بشكل مختلف تمامًا.
يمكن في هذه العلاقات أن تظهر شراسة مرعبة، ويبرز فيها جانب قبيح للغاية من الطبيعة البشرية. لقد عرف معارضو الرأسمالية، من خلال دراسة بعض الوقائع التاريخية، أن هذه الشراسة غالبًا ما كان يُظهرها الرأسماليون والدولة تجاه الطبقات العاملة، لا سيما عندما يتجرؤون على الاحتجاج ضد المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها والتي أدت إليها النزعة الصناعية. ومن ثم، ينشأ موقف مختلف تمامًا عن موقف المواطن العادي الميسور تجاه المجتمع الحالي، موقف صحيح مثل موقفه بنفس القدر، وربما أيضًا غير صحيح بنفس القدر، ولكنه قائم أيضًا على الحقائق، حقائق تتعلق بعلاقاته بأعدائه بدلًا من أصدقائه.
إن الحرب بين الفئات أو الطبقات، مثل الحرب بين الدول، تنتج رأيين متعارضين، كل منهما صحيح بنفس القدر وغير صحيح بنفس القدر، إذ إن مواطن الدولة التي تكون في حالة حرب، عندما يفكر في أبناء وطنه، يفكر فيهم في المقام الأول كما كان يراهم من خلال تجاربه، أي في تعاملهم مع أصدقائهم، وفي علاقاتهم الأسرية، وهلم جرًّا، فهم يبدون له ككل على أنهم أناسٌ طيبون ومحترمون. لكن الدولة التي تكون بلاده في حالة حرب معها تنظر إلى أبناء وطنه أولئك من خلال بيئة ذات مجموعة مختلفة تمامًا من التجارب، أي كما يظهرون في ضراوة المعركة، أو في غزو واخضاع منطقة معادية، أو في خداع دبلوماسي خبيث.
إن هؤلاء الرجال الذين تكون هذه الحقائق منطبقة عليهم هم نفس الرجال الذين يعرفهم أبناء وطنهم كأزواج أو آباء أو أصدقاء، لكن يُحكَم عليهم بشكل مختلف لأن هذا الحكم يتم بناءً على وقائع وحقائق مختلفة. وهذا هو الحال مع أولئك الذين ينظرون إلى الرأسمالي من وجهة نظر العامل الثائر، إنهم يبدون متشائمين وعلى ضلال بشكل لا يمكن تصوره بالنسبة إلى الرأسمالي، لأن الحقائق التي تستند إليها وجهة نظرهم هي حقائق إما إنه لا يعرفها أو عادة ما يتجاهلها. غير أن الرؤية من الخارج صحيحة تمامًا مثل الرؤية من الداخل، كلتاهما ضروريتان للحقيقة الكاملة، والاشتراكي، الذي يركز على الرؤية الخارجية، ليس متشائمًا ولكنه مجرد صديق للعاملين، يغضبه رؤية البؤس غير الضروري الذي تسببه الرأسمالية لهم. لقد وضعتُ هذه التأملات العامة في بداية دراستنا، لأوضح للقارئ أنه مهما كان مقدار الفظاظة والكراهية التي قد تبدو في الحركات التي سنتناولها، فهي ليست فظاظة أو كراهية، بل حب، فهذا هو نبعها الرئيسي.
فمن الصعب ألا نكره من يُشوِّه ويؤلم ذلك الذي نحبه، وعلى الرغم من أنه صعب، فإنه ليس مستحيلًا لكنه يتطلب اتساعًا في النظرة وشمولية في الفهم، وهذان شيئان ليس من السهل الحفاظ عليهما وسط صراع بائس، وإذا كان الاشتراكيون والأناركيون لا يحافظون على الحكمة المطلقة دائمًا، فإنهم لا يختلفون في ذلك عن خصومهم، لكنهم أظهروا، من خلال مصدر إلهامهم، أنهم متفوقون على أولئك الذين يذعنون بجهل أو بضعف للظلم والقمع اللذين يتم من خلالهما الحفاظ على النظام القائم.





