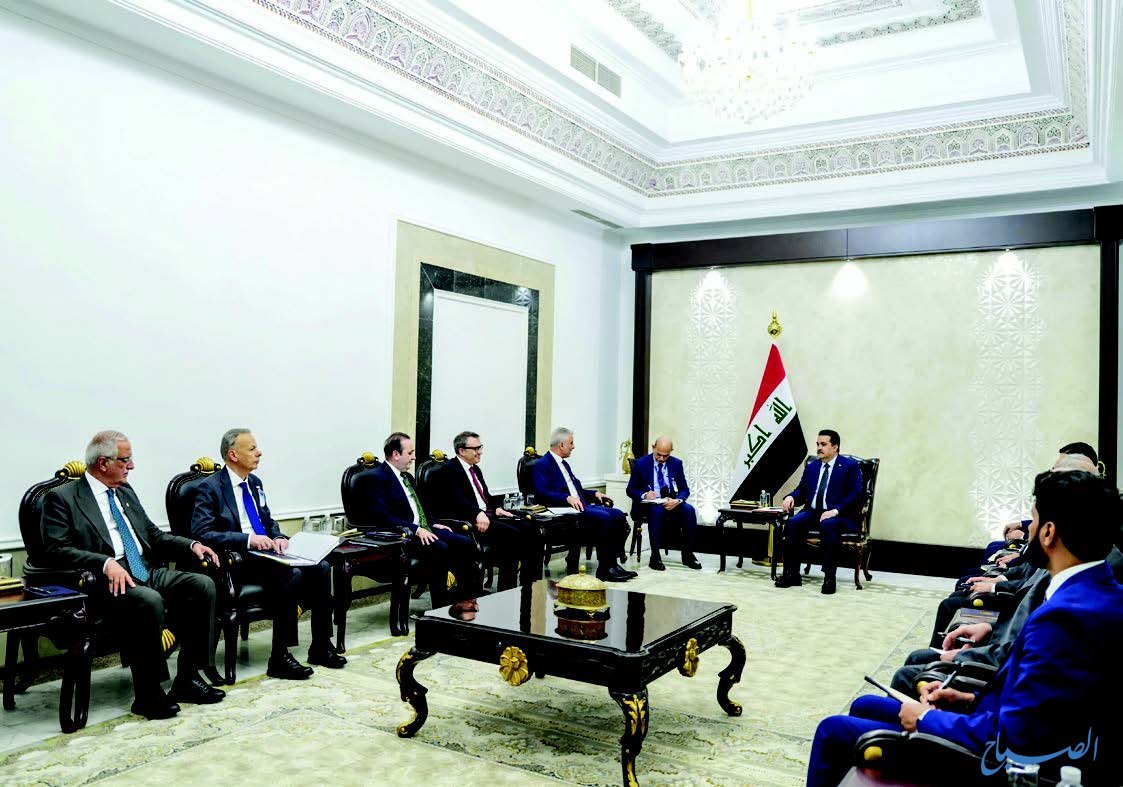فصل من رواية {فورور} للروائي نزار عبد الستار

تصدر قريبا عن دار نوفل / هاشيت أنطوان رواية “فورور” للكاتب العراقي نزار عبد الستار. في هذه الرواية التي تقع في 184 صفحة، لا يتخيّل نزار عبد الستار ما حدث، بل ما كان يفترض أن يحدث مع بطل لا يزال طفلا يبحث عن رائحة أمّه. يقتفيها من خلال بحثه عن مشلح من الفرو لامس كتفيها ذات يوم قبل أن ينتقل من كتف إلى آخر في أوساط طبقة المشاهير والأثرياء.
في ما يلي مقتطف حصري من الرواية تنشره صحيفة الصباح العراقية، في ملحقها الثقافي الأسبوعي.
قُبلةُ فيلمون وهبي
في سنة 1956، شنقوا أبي لأنّه قتل اثنين من أصدقائه رميًا بالرصاص خلال عشاء سمك، على ضفاف دجلة.
كنتُ على وشك بلوغ السادسة، أسكن مع أمّي وخالتي بدريّة بيتًا صغيرًا من غرفتين في منطقة الكرّادة ببغداد، لا يبعد كثيرًا عن كباريه «مولان روج» الذي يقع عند تقاطع أربعة شوارع ويتميّز بدهانه الأحمر. على سطح المدخل، تُوجد طاحونةُ رياحٍ هولنديةٌ كبيرةٌ مرسومةٌ على لوحٍ خشبي يتوهّج ليلًا بالنيونات. أمّي وحيدة جميل تملكُ خفّة دمٍ تُوازي عذوبة صوتها، وحدّة حركاتها الكوميديّة. صاخبة التعابير، وهادئة الأوتار. اسكتشاتها الغنائيّة تُخرجها من أنوثتها لثوانٍ، ثم تُرجعها إلى رقّتها الناعسة. زيارتي الأولى والأخيرة إلى الكباريه كانت يوم عادتْ إلى عملها بعد ثلاثة أشهرٍ من إعدام أبي. ارتدتْ فستانًا أخضر اللون، عاريَ الكتفيْن، مُطرّزًا بخيوطٍ لامعةٍ في حلقةٍ عند الكاحلين. غنّت مونولوج فكاهيًّا يمدح قيادةَ النساء السيّارات. تحرّكت بخفةٍ بالكعب العالي، وتمايلت بقوامها الفاتن، بينما الصالةُ تضجُّ بهتافات الإعجاب، والتصفيق الحارّ. عندما نزلتْ لتسلّم على معجبيها، احتفى بها رجلٌ ضخمٌ أخذ يُقبّل يدَها بشراهةٍ وانفعال. لهجته لم تكن مفهومة، له شاربان كثيفان ولامعان معقوفان إلى الأعلى مثل قرنَي ثور. شعره مفروقٌ من المنتصف كالنساء. يضع وردة قرنفلٍ في عروة جاكيته. نمتُ يومها في غرفة ملابس الراقصات. حملتني خالتي بدريّة على صدرها لنعود إلى البيت، وفي الطريق سألتُ أمّي عن هذا الرجل المخيف الذي قبّل يدها بجنون، فضحكت قائلةً بفخر «إنّه الموسيقار اللبنانيّ الكبير فيلمون وهبي».
عندما أكملتُ سنتي الدراسيّة الأولى في لندن، قرأتُ اسم خالتي بدريّة في إعلانٍ عن حفلٍ موسيقيّ نشرته جريدة «النهار» اللبنانيّة. بدت نسخةً متهرئةً لكنّها ليست قديمة، رأيتها أمامي على الطاولة في صالون حلاقة مكسيم السوريّ. خبرا وفاة أمّي وعمّي غانم قرأتهما في جريدة، لذلك هزّني اسم خالتي في «النهار»، كأنّه نعي. لم أكن أملكُ المالَ، ولكي لا أفكّر كثيرًا وتخمد عاطفتي، اتصلتُ من هاتف صالون الحلاقة بصديقٍ جزائري اسمه رابح المقراني، حصلتُ منه على ثمن تذكرة ذهابٍ إلى بيروت مع 200 باوند إضافية.
قبل سفري بيومٍ، أعطاني رابح عنوان صديقٍ لبنانيّ اسمه داود يسكن منطقة باب إدريس. ذهبتُ إليه ما إنْ وصلتُ إلى بيروت، يوم الأربعاء 2 أغسطس، وفي ذهني أنّه سيُوصلني إلى عاليه. وجدتُ أنّ داود قد جهّز لي غرفةً في بيته، وما أحرجني كثيرًا أنّ الرجل كان قد تزوّج قبل شهرين. داود ووردة يعملان في «البنك اللبنانيّ الفرنسيّ». يخرجان ويعودان معًا، لكنّ ذلك لم يكن مريحًا، فتعمّدت مغادرةَ البيت صباحًا بعد تناول الفطور الذي تتركه لي وردة على طاولة المطبخ، وأتسكّع في بيروت إلى ما بعد العاشرة ليلًا.
وجدتُ خالتي تعزف على الكمان خلف رفيق حبيقة في حفلة فريد الأطرش يوم السبت 5 أغسطس 1972 على مدرّج لبنان في عاليه. وقفتُ في الخارج لساعةٍ، لأنّني لم أقطع تذكرةً، وانتهزتُ الفوضى التي حصلت حين اشتعل مجسّمٌ كبيرٌ يحمل اسم فريد الأطرش بالمفرقعات النارية، للتسلّل إلى المدرّج. وصلتُ إلى شخصٍ من منظّمي الحفل، عرف خالتي وساعدني في الدخول إلى كواليس المسرح المخصّصة للموسيقيّين، بعدما أخذ منّي وعدًا بأن أبقى في مكاني حتى انتهاء الحفل. كدنا نقع أرضًا أنا وبدريّة وكمانها حين فقدت توازنها وهي تحضُنني، بعدما قلتُ لها بصوتٍ بكائيّ «أنا صابر عفيف يا خالتي». بدتْ قريبةَ الشبه بأمّي. رشيقةٌ وقصيرة، تقلّد قصّة شعر ميراي ماتيو. أخبرتني بعد ذلك بيومين أنّ عمرها 48 سنة. لم تملك الوقتَ لتغيّر تايور الفرقة الأسود، لأنّهم أبلغوها بأنّ شابًّا ينتظرها منذ ساعة عند تمثال الرومانيّ العاري. قبل أن نغادر المدرّج إلى بيروت، جرّتني للسلام على فريد الأطرش. نبّهتني بسبّابتها «إيّاكَ أن تُعلمه أنّكَ ابن وحيدة. قلبه ضعيف. سيتألّم وتزول عنه فرحة الحفلة. قل له إنّكَ معجَبٌ من بغداد».
قبّل فريد الأطرش يدَ خالتي ورأسها، وشكرها كأنّها هي التي لحّنت أغنية «عش أنت». فتح عينيه وهو يمدّ لي أصابعه الباردة الشبيهة بقصبات العنب. استجبتُ لسحبه الخفيف، وعانقني، بينما هو يغصّ بكركرة ضحكته التي تبلع الكلمات ويُخبرني أنّه غنّى لبغداد في أوبريت بساط الريح.
حين جرّنا الحديث، في طريق العودة، إلى أوضح ذكرى أملكها، وهي تقبيل فيلمون وهبي يد أمّي، أخذت بدرية تسيل دموعًا وكأنّها نافورة إيروس في ميدان بيكاديللي. وجدتُها تتهم مريم فخر الدين بأنّها سبب تعاسة أختها، وقالت بمرارة إنّ حزن وحيدة على ما جرى لها في القاهرة جعل مرض السكّري يتسلّل إليها، وقد ساعدها فيلمون وهبي بعد تدهور صحّتها وأسكنها في كفرشيما، إلّا أنّ ملاك الموت تمسّك برأيه، وأخذها معه. لم تسألني بدريّة أين كنتُ؟ وكيف عثرتُ عليها؟ وماذا فعلتُ حتى صرتُ هذا الشابّ الوسيم؟ لم أجد الوقت كي أُخبرها أنّ ما جاء بي إلى لبنان حنيني لدفء صدرها. قبل وصولنا إلى بيروت، عدّدتْ لي أفضال فيلمون وهبي عليها، وكيف أنّه وفّر لها العمل مع فيروز، وفي حفلات نجاة الصغيرة، وعبد الحليم حافظ في لبنان، وأنّ عليَّ مقابلته لشكره على سلوكه النبيل مع أمّي.
لم يكنْ فيلمون وهبي الوحيد الذي أُعجب بوحيدة جميل في تلك الليلة. عندما سألتُ خالتي بدريّة، ونحن في شقتها بشارع غورو بالجميزة، عن علاقة مريم فخر الدين بتعاسة أمّي، عادت بي مجدّدًا إلى انبهار فيلمون وهبي وتقبيله يدَ وحيدة جميل. وفي ظهيرة اليوم نفسه توقّفت سيارة موسكوفيتش سوداء عليها علم الاتحاد السوفيتيّ أمام البيت، ونزل منها الملحق العسكريّ في السفارة السوفيتيّة وهو يحمل صندوقًا مستطيلًا أحمر اللون عليه شعار المطرقة والمنجل وتحته كُتب بالعربية «يا عمّال العالم اتحدوا». ظنّت خالتي أنّ الصندوق يحتوي على بندقية كلاشنكوف، وهو ما أخبرتْ به الملحقَ العسكريّ الذي ضحك كثيرًا وهو يشرب القهوة من يدها. كانت أمّي نائمةً وأنا إلى جوارها على السرير وقد نشرتُ تحتي دائرةً كبيرةً من البول. تقول خالتي إنّ وحيدة، لارتباكها، ارتدت الفستان الأخضر نفسه، لأنّها ظنّت أنّ السفارة تطلبها لحفلة. الملحق العسكري وقف باحترام حين دخلت وقدّم إليها الصندوق قائلًا بلغةٍ عربيّةٍ مضروبةٍ بقنبلةٍ يدويّة، إنّه هديّة من وزير دفاع الاتحاد السوفيتي السيد غيورغي جوكوف. بقيت أمّي مذهولةً وغير قادرةٍ على النطق. فتحتِ الصندوق وهي مرتبكة. راوحت بين قدميها خشية فقد التوازن. تلمّست الفورور السواريه الشنشيلا البيج بانبهارٍ غيبوبيّ. أخذت دموعها تتدفّق وهي لا تعرف على ماذا حصلت. ظنّتْه معطفًا. كان وزير الدفاع السوفيتي في زيارةٍ قصيرةٍ إلى بغداد عندما أخذه رئيس الوزراء نوري السعيد الذي يحمل أيضًا حقيبة وزارة الدفاع إلى كباريه «مولان روج» لأنّه أحمر اللون. من مقصورةٍ عليا لكبار المسؤولين، شاهد السيد جوكوف أمّي تُغنّي وترقص في فقرتها عن النساء وقيادة السيّارات فأُعجب بها، وقرّر إرسال الفورور السواريه الشنشيلا الذي جلبه من موسكو ليهديه إلى الأميرة عابدية بنت الملك علي إلى مونولوجيست كباريه «مولان روج» وحيدة جميل، تعبيرًا عن إعجاب الاتحاد السوفيتي بقيادة الرفيق نيكيتا سيرغيفيتش خروتشوف بنضال المرأة العراقيّة من أجل الحريّة. هذا ما قاله الملحق العسكريّ بصعوبةٍ لأمّي وخالتي وهو يشرب القهوة في بيتنا بالكرّادة.
الفورور السواريه الشنشيلا البيج الذي أهداه وزير الدفاع السوفيتيّ إلى أمّي هو الذي جعل وحيدة جميل تتقبّل إغراءات فيلمون وهبي ونصائح مدرّبتها المصريّة سعاد بسيوني وتتطلّع إلى الانتقال لبيروت كي تنضمّ إلى فرقة فريد الأطرش الذي كان يستخدم العديد من المونولوجيستات والراقصات في حفلاته وأفلامه بلبنان. اعتقدت أنّها بالفورور الراقي لن تكون أقلّ شأنًا من نعيمة عاكف، وسعاد حسني، وشادية. بقي فيلمون وهبي في بغداد خمسة أشهر، وبدأ بتدريب أمّي وتثقيفها، قبل أن يحصل على موافقة فريد الأطرش التي جاءت بعد ذلك بشهرين، أي حين استمع في القاهرة إلى أمّي وهي تؤدّي مونولوج باللهجة المصريّة في رسالةٍ صوتيّةٍ من بغداد بثّتها إذاعة «صوت العرب». حصلت وحيدة على تدريباتٍ مكثّفةٍ في الموسيقى والإتيكيت، وتلقّت دروسًا للمحادثة باللغتين الإنكليزيّة والفرنسيّة، وجعلها فيلمون وهبي توقّع مع بدريّة على عقدٍ لسنتين يُلزمهما البقاء في لبنان. هذا ما قالته لي خالتي وأنا معها في المطبخ أساعدها في إعداد وجبة العشاء.
أمضيتُ مع بدريّة أربعةَ أيّام فقط. خفتُ أن تورّطني بأحزانٍ أخرى، ومن حُسن حظّي أنّها نسيتْ اللهجة البغداديّة. لم أغادرْ شارع غورو إلّا للذهاب إلى باب إدريس في 6 أغسطس، لتوديع داود ووردة وجلب حقيبتي. طلبتُ من خالتي طبخ الأرزّ يوميًا. أنا لا أحبُّ الثوم، ولكنّني أردتُه منها مع البصل من أجل تحصيل رائحةٍ طويلة الأمد. كنتُ أغافلها وأرفع غطاء الطنجرة وهي على النار كي تنتشر نكهات البخار وتصل إليّ في الشرفة. أتلوّى جوعًا لكلّ ما فاتني، أيام عشتُ وحيدًا بلا أمّ، ولا خالة، ولا بيت.
حين قررتُ السفر لرؤية بدريّة، لم أتخيّلْ ما سأشعر به تجاهها. كان اللقاء بالنسبة إلى عواطفي اليابسة يُشبه أن يُريني أحدهم صورةً فوتوغرافيةً لها وهي امرأةٌ حقيقيّة، ويقول لي هذه خالتكَ. شيءٌ باردٌ ليس فيه دقّاتُ قلبٍ قويّة. لم أفكّر بأنّني سألتقي بالجانب الحقيقيّ من حياتي، لأن كلَّ ما عشته مع وحيدة وبدريّة ليس أكثر من ست سنوات، منها خمسٌ لا ذاكرة لي فيها، ولكنّني أحببتُ بدريّة، وشعرتُ بفرحةٍ ثقيلةٍ لأنّها خالتي.
لم نتكلّم عمّا سنفعله لاحقًا. انتظرتُ أن تسألني عن خططي بعد الانتهاء من دراستي، وإن كنتُ أرغب في العودة إلى بيروت للعيش معها أم لا؟ ولكنّها نسيتْ عرض هذا عليّ. في اليومين الأوّلين تخطّيت كل ترسّبات يُتمي، واعتقدتُ أنّني أعيش النهاية السعيدة. لم أعرفْ أيَّ شيءٍ عمّا فعلتْه هنا في السنوات الماضية، إلّا أنّ ذلك لم يكن مهمًّا. خفَّ رأسي، وأحببتُ النوم، وتنفّستُ بعمق، وأكلتُ الكثير من الفواكه، وعشقتُ تبّولتها، والشاي الذي تحضّره، وطعم أصابعها في الطعام، ورائحتها في الشقّة، وصوتها وهي تناديني، ووقع خطواتها على البلاط. في اليومين الأخيرين غلبني الحزنُ، لأنّني توقّعتُ أن تقول لي «لا تعدْ إلى لندن يا صابر»، إلّا أنَّ ذلك لم يحدثْ.
كتبتُ لها رقمَ تلفون صالون حلاقة مكسيم السوريّ. لكن فاتها فعل الشيء نفسه معي. ربّما لأنها لا تستخدم تلفون شقّتها سوى للعمل.
قطعتْ لي تذكرةَ العودة إلى لندن، وأعطتني 500 ليرة.