لماذا حوّلتنا الرأسمالية إلى كائنات نرجسية؟
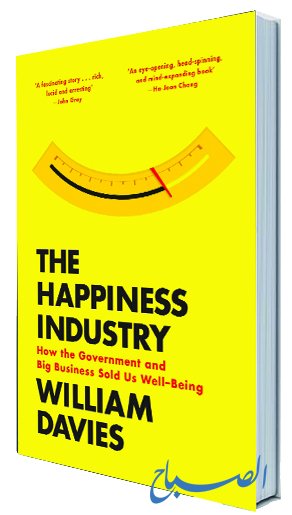
تيري إيغلتون
ترجمة: حيّان الغربيّ
يرى وليام ديفيز في كتابه الموسوم “صانع السعادة”، الصادر عام 2015، أن عصرنا الراهن يتسم بالهوس بالذات إلى حدّ ما، فلم تعد الأفكار أو الأفعال هي المهمة، وإنما المشاعر والأحاسيس.
لا يرقى شكٌّ إلى أن السعادة هي الهدف الذي تشخص إليه جميع الأبصار، وتكمن المشكلة الرئيسة في تحديد ماهية السعادة، وهي إشكالية لم يسبق أن اتفق بشأنها المفكّرون الأخلاقيون وربما لن يفعلوا أبداً. فهل السعادة شعورٌ ذاتي محض؟ أم لعلّه بالإمكان إخضاعها للقياس؟ هل ينعم المرء بالسعادة من دون أن يدرك؟ أم أننا لا يمكن أن نحيا سعداء إلا إن كنا لا نعلم ذلك حقاً؟ وبالتالي، هل يمكن للمرء أن يكون تعيساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى في حين أنه على قناعةٍ تامةٍ بأنه يرفل بالنشوة؟
لقد انتقل مفهوم السعادة، في زمننا هذا، من كونه مجالاً خاصاً إلى نطاق الحيّز العام، وعلى حدّ تعبير وليام ديفيز في دراسته الفذّة هذه، يتزايد إقبال الشركات على تعيين مديرين للسعادة ومسؤولين عنها، لا بل إن لدى “غوغل” مسؤولاً للدعم المعنوي ومهمّته الأساسية رفع الروح المعنوية للشركة. إذن، لربما ينبغي على بنك إنكلترا أن ينظر في تعيين مهرّج لمساعدة الاستشاريين المختصين في مضمار السعادة وهم يسدون النصائح للأشخاص ممن طُردوا من منازلهم بشأن كيفية مواصلة حياتهم على الصعيد العاطفي. قبل بضعة أعوام، قامت الخطوط الجوية البريطانية بتجريب “بطانية السعادة”، التي يتحوّل لونها من الأحمر إلى الأزرق كلّما ازداد المسافر استرخاءً، وهكذا يغدو مستوى رضا المسافرين معلوماً بالنسبة لمضيفي ومضيفات الطيران. وها هو الدواء المضاد للاكتئاب “ويلبوترين” يبشّر المستهلكين بالتخفيف من الأعراض الرئيسة للكآبة التي تهيمن على المرء بعد خسارة أحد أحبائه. ولدى الإعلان عن هذا الدواء، ساد افتراضٌ بأنه سيكون على درجةٍ عاليةٍ من النجاعة لدرجة أن الجمعية الأميركية للأطباء النفسيين قد خلصت إلى أن الحزن على وفاة أحد المقرّبين للمرء لما يزيد على أسبوعين قد يعني أنه يعاني مرضاً نفسياً. إذن، يجسّد التفجّع لخسارة الأحباء تهديداً يتربّص بالصحة النفسية للإنسان.
لا غرابة في أن مفهوم السعادة قد نُقل إلى الفضاء العام نظراً للانتشار الملحوظ للاضطراب الروحاني في شتى أرجاء العالم. فزهاء ثلث البالغين الأميركيين، وما يقرب من نصف البريطانيين، يعتقدون أنهم يرزحون تحت وطأة الاكتئاب بعض الأحيان. وعلى الرغم من مرور ما يربو على نصف قرنٍ على اكتشاف مضادات الاكتئاب، إلا أن أحداً لا يعلم كيف تؤدي هذه الأدوية وظيفتها. ترفع الأعمال التي لا يتمتع فيها الأفراد إلا بالقليل من السيطرة من خطر الإصابة بأمراض القلب (على النقيض من ذلك، من الواضح أن التعاونيات تعود بالفائدة على الصحة الإنسانية). وغالباً ما أسهم ما يسمى بـ: “التقشّف” في رفع معدلات الأمراض بين الناس، لابل قاد بعضهم إلى التهلكة. وتشكّل أجواء الإجحاف وعدم المساواة واسعة النطاق في دولٍ مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة مرتعاً للمشكلات والأمراض النفسية مقارنةً بالدول التي تتميز بمستويات أعلى من العدالة الاجتماعية كالسويد على سبيل المثال. وتقدّر التكاليف التي يتكبّدها الاقتصاد الأميركي جرّاء المرض والتغيّب عن العمل والحضور لمجرّد الحضور من دون أي حوافز أخرى بنحو 550 مليار دولار سنوياً.
ثمة دليلٌ على أن أخلاق المنافسة قد تطلق العنان للمرض النفسي لدى الفائزين أيضاً، إذ لا يقتصر ضررها على الخاسرين فحسب، فهذا هو ما يحدث في عالم التنافس الرياضي على أقل تقدير. وعلى الرغم من النقض الحيّ الذي يشكّله ما يعرف بـ: “دونالد ترمب” في هذا المقام، إلا أنه من المرجح أن اللهاث وراء المال والمركز الاجتماعي والسلطة يتناسب طرداً مع فقدان المرء لإحساسه بالقيمة. ونظراً إلى أن الثقافة الأميركية قد بلغت مستوىً مرضياً من التفاؤل، يجنح الأميركيون إلى التقليل من شأن كآبتهم في حين أنه من المرجح بالنسبة للفرنسيين أن يقلّوا من الإقرار بالسعادة طالما ساد لديهم الاشتباه باتصافها بالبساطة. إنها ذلك الشيء الذي يرتدي سترةً مخططة ويضع أنفاً مستعاراً أحمر اللون ليثب في وجهك بغتةً مع دنو البرامج الترفيهية من نهايتها.
تلعب السعادة دوراً بارزاً في المشاريع التجارية إذ تحقق إنتاجية العامل السعيد زيادةً بنسبة قدرها 12 بالمئة مقارنةً ببقية أقرانه. وهكذا، يغدو أحد علوم العواطف البشرية، أو ما يدعوه ديفيز بـ: “مراقبة المشاعر وإدارتها وحكمها وتنظيمها”، واحداً من أسرع المعارف المناورة نمواً وتطوراً، الأمر الذي يجري تطبيقه ضمن أبحاث التسوّق، إذ يجري تنفيذ برامج مكثّفة لفحص أوجه المستهلكين مما يمكّن المعنيين من تحديد حالاتهم العاطفية ويحثّ علماء الأعصاب الأكثر براءةً على الزعم بأنهم على وشك اكتشاف الزر “اشترِ” في الدماغ البشري.
يوفّر علم النفس طريقةً موثوقةً لحرف الانتباه عن القضايا الاجتماعية، ففي أعقاب الانهيار الاقتصادي الذي شهده العام 2008، خلص بعض علماء النفس إلى أن المشكلة لم تكمن في البنوك والمصارف وإنما في الأدمغة. لابد أن وول ستريت قد ابتليت بالنوع الخطأ من الكيمياء العصبية، إذ إن ثمة إفراطاً في تعاطي التستسرون لدى التجار والمتداولين، بينما انتشر الكوكايين بمعدلات مرتفعة في صفوف المصرفيين. وهكذا، نُفذ مسحٌ لأدمغة المتداولين لتطوير عقاقير تبشّر بالارتقاء بمستوى صناعة القرار. إذاً، لا يجري التركيز في العالم النرجسي للرأسمالية المتأخرة على الأفكار أو الأفعال، وإنما على المشاعر. وبما أن أحداً لا يمكنه أن يناقشك في شعورك الخاص، إذاً سيسهل عليك أن تقيه شر الجدال والتشكيك. وبالتالي، لقد غدا بمقدور الرجال والنساء المضي قدماً بأسلوب المراقبة المستمرة للذات باستخدام تطبيقات لتعقب التغييرات الطارئة على أمزجتهم/ أمزجتهن. لقد مهّدت الأنا المتوحشة المستبدة التي سادت النمط القديم للرأسمالية المبكرة الطريق وصولاً إلى الهوس بالذات الذي يسم الرأسمالية الحالية. إذاً، لعلّه من الواضح أن اليقظة ستقودك إلى الجنون.
ما يبيّنه المؤلّف في كتابه هذا هو أن الرأسمالية قد أرست دعائم النقد الموجه إليها بصورةٍ ما، إذ إن المشاعر والصداقة والإبداع والمسؤولية الأخلاقية وغيرها من الأمور التي اعتاد النظام أن ينظر إليها بعين الريبة قد تكافلت فيما بينها الآن بغية الارتقاء بالأرباح إلى حدودها القصوى. وبالتالي، لربما ثمة من يسوق الحجة بأن توفير المنتجات المجانية للمستهلك إن هو إلا وسيلة لتأسيس علاقة أوثق معه. وقد درج بعض أرباب العمل على تسمية زيادات الرواتب التي يمنحونها لموظفيهم بـ: “المكرمة” أملاً في انتزاع شعورهم بالامتنان وإقناعهم ببذل المزيد من الجهود في العمل.
يبدو أنه ليس متعذراً تطبيق الذرائعية على أي أمر، ومع ذلك، الأصل في فكرة السعادة هي أنها تشكّل غايةً بحدّ ذاتها بدلاً من كونها وسيلةً لتحقيق السلطة والثروة والمكانة.
لقد دأب الفكر الأخلاقي، بدايةً من أرسطو، مروراً بتوما الأكويني، وصولاً إلى هيغل وماركس، على تحديد تحقيق الذات الإنسانية على أنه ينطلق من ممارسة الفضيلة، الأمر الذي يجري بذاته ولذاته من دون أي غايةٍ أخرى. فكيفية بلوغ السعادة تشكّل القضية المركزية التي يتمحور حولها علم الأخلاق، ولكن ثمة سؤالاً يعجز عن تقديم الإجابة له: “لماذا نحقق السعادة؟”.
ويرفض هذا المنحى الفكري عينه الفصل بين السعادة والظروف المادية التي تكتنفها، إذ لا يمكن للرجال والنساء أن يكونوا سعداء/ يكن سعيدات إلا ضمن ظروفٍ اجتماعيةٍ معينة. تتوقف السعادة على النشاط الذي نقوم به بالفعل فهي ليست مجرد حالةٍ ذهنية خاصة، إذ إننا فاعلون عمليون ولسنا مجرد حالاتٍ متجسّدة aللوعي. فالعبد الذي ما فتئ يتلقّى ضرباً مبرحاً قد يدعي بأنه راضٍ مسرورٌ ولكنّ مردّ ذلك ربما إلى أنه لم يسبق أن اطلع على أوضاعٍ بخلاف تلك التي يعيشها. وبهذا المعنى، ليست السعادة شأناً ذاتياً بالكامل، فقد يعتقد المرء أنه في غاية السعادة ولكن لا لشيءٍ إلا نتيجةً لوقوعه ضحيةً لخداع الذات. بيد أن السعادة أيضاً ليست أمراً موضوعياً بمعنى أنها تنجم عن جزءٍ محدد من الدماغ كما يتصوّر عددٌ من علماء الأعصاب على ما يبدو، فلعلّهم قد نسوا، كما يؤكّد المؤلف، أن “العمليات العقلية” لدى المرء تتوقف على الأفعال التي يمارسها والتي تتجذّر ضمن علاقاته الاجتماعية وتستهدي بأغراضٍ ونوايا ينبغي تفسيرها.
تُحدد السعادة من قبل باحثي الأسواق الاستهلاكية وعلماء النفس الموظفين لدى الشركات الناشطة في الأسواق عينها بوصفها شعوراً إيجابياً متواصلاً ينتاب الإنسان. ولكن يبدو أن ملايين الأفراد لا يراودهم هذا الشعور الإيجابي المنتظم على الإطلاق، ومن غير المرجح أن تنفرج أساريرهم جرّاء تقنيات التحكم بالذهن التي تحرضهم على العمل بجدٍّ أكبر أو رفع معدلات الاستهلاك. فلاشك أن المرء لن يشعر بالسعادة الحقّة إن كان ضحيةً للإجحاف والاستغلال، الأمر الذي تميل تقنيات السعادة إلى غضّ نظرها عنها. ولهذا، حين يتطرّق أرسطو إلى علم الرفاهية فهو يخلع عليه اسم: “السياسة”.
لا يبدي علماء الأعصاب أو واضعو السياسات الإعلانية أو مروجو اليقظة اهتماماً كبيراً على هذا الصعيد، ولذلك يجانب قدرٌ كبيرٌ من عملهم الصوابَ على نحوٍ مثيرٍ للدهشة.





