بين الغزالي وديكارت وقبلهما فلاسفة اليونان لذَّة الشك.. العقل في أرجوحة الوعي
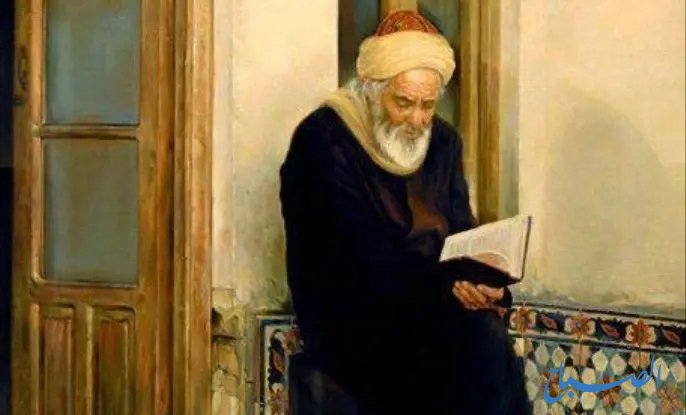
البصرة: صفاء ذياب
هل يمكن أن نكون على يقين؟ وما اليقين نفسه؟ نحن كائنات تعيش في حالةٍ من التردّد حتى وإن كنّا واثقين من أمرٍ ما، فالتاريخ، مهما كان، لا يمكن أن يكون يقيناً، والحادثة التي نراها في هذه اللحظ، ستصبح تاريخاً بعد لحظةٍ واحدة، وبمجرّد أن يبدأ تناقلها، ستكون عرضةً للزيادة والنقصان، وهذا ما يفعله المؤرّخ بأشكاله المتعددة، إن كان متخصصاً، أو إنساناً عادياً ينقل واقعة ما من زمن لزمن آخر.
فالشك واليقين ضدّان يسيران في اتجاه واحد، وفي اتجاهين متعاكسين، في الوقت نفسه، لهذا تكون الرؤية بالعين المجرّدة مجرّد مرآة ربّما تختلف أبعادها كلّما مرَّى عليها الزمن.
وما يحدث الآن من صراعات سياسية ودينية ومجتمعية، منبعه الشك بأشكاله المختلفة، أو عدم اليقين من جهة تجاه أخرى... فاختلاف وجهات النظر الدينية منبعه اختلاف رجال الحديث وناقليه، واختلاف مبادئ هذا الحزب السياسي عن ذاك، اختلاف في تفسير الواقعة التاريخية، أو وجهة النظر لتلك الشخصية السياسية... واختلاف رؤية الشباب في مرحلة زمنية ما كان بسبب تفسيرهم للزمن الذي يعيشون فيه.. فالشك هو السبب الأول في الانقلابات والتحوّلات السياسية والفكرية والدينية والثقافية.
ما الشك؟
الشك في لسان العرب: “نقيضُ اليقين. فهو تجويزٌ لأمريْن لا مَزِيَّة لأحدهما على الآخر، أو أن يبقى الإنسانُ متوقّفاً بين النّفي والإثبات” .
أما اصطلاحاً، فننقل رأي الباحثة هدى بنت فهد العجيل، التي تشير إلى أنَّ الشك هو التردد بين المتناقضين بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، عرّف ذلك الجرجاني في معجمه الفلسفي «التعريفات» وعدّه بعض الفلاسفة حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفي ويتوقف عن الحكم بالتالي اليقين بالشيء. وله- أي الشك- عدة خصائص «كما يرى الجرجاني» تمثّلت في الأربع التالية:
1 - توقف الشخص الشاك عن إصدار أحكامه سواءً بالقبول أو بالرفض.
2 - قدرة الشخص الشاك على الاختيار والانتقاء بين النقيضين، ولكنّه برغم ذلك يرفضهما معاً، وبدون هذه القدرة لا يكون الموقف شكاً، وإنما عجز.
3 - إنَّ الشك تعبير عن الحرية الذاتية للفرد، وهذه الخاصية نتيجة حتمية للخاصيتين السابقتين، فما دام الإنسان الشاك يرفض الانحياز إلى أحد النقيضين، وما دامت لديه القدرة على الاختيار والانتقاء بينهما، لكنّه رفض كليهما معاً، فالأمر يعني بالضرورة أنَّ مثل هذا الشخص يمارس نوعاً من الحرية الذاتية في أن يحكم أو لا يحكم، وأنّه اختار ألَّا يحكم قطعياً واتخذ موقف الشك بإرادته الحرة من دون أي إجبار.
4 - الشك ليس جهلاً، فالشك موقف عقلي واعٍ واتجاه فلسفي يتخذه صاحبه بعد تفكير عميق وتدبُّر طويل، وبالتالي يجب على الشخص الشاك ألَّا يقف صامتاً وهو يرفض، وإنَّما عليه أن يناقش كل الآراء ويفنّدها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى نقيضها ويفنّدها أيضاً.
في حين أنّنا نقف على اليقين في الضفة الأخرى، بتعريفه الواضح: هو الإقرار بصحة موقف معين، والتأكد من صواب الأدلة المدعمة لهذا الموقف دون غيره من المواقف الأخرى، وأهم خاصيتين لليقين:
1 - الانحياز الواضح والصريح لأحد مواقف أو أطراف المشكلة، وترجيحه بالأدلة الكافية عن غيره من المواقف والأطراف الأخرى.
2 - القدرة على الاختيار وعلى إثبات صحة أحد النقيضين والانحياز له دون الآخر لكن بالأدلة المدعمة لهذا الانحياز، وبمختلف البراهين الممكنة، أي أنَّ الموقف اليقين يتسم بالحرية في الاختيار. وهذه الخاصية تعود بنا لمطلع المقال أنَّنا بالشك نخطو أولى خطواتنا نحو المعرفة، اليقين شبه التام يشلُّ عقولنا، ويقف بينها وبين التفكير بحرية مطلقة فهل معنى اليقين هنا بخواصه يبطل ذلك..؟! ماذا عن ديكارت ومنهجه في الشك؟
ديكارت والشك
على الرغم من أنَّ ديكارت هو أوّل من طرح مفهوم الشك في الفلسفة الحديثة، غير أن الكثير من الباحثين يؤكّدون أنه استلهم هذا المفهوم من الإمام أبي حامد الغزالي.
يتحدّث الباحث يوسف بن عبد العزيز عن هذا الموضوع، مبيّناً أنَّ ما يجب لفت النظر إليه هنا أنَّ ديكارت لم يكن، على عكس ما ينظر إليه كثير من غير المتخصصين والمهتمين بالفلسفة، رائدَ، أو مؤسسَ الشك لذاته، بقدر ما كان رائد التخلّص من الشك العقيم المتخم باللاأدرية، وصولاً إلى اليقين، من خلال اتخاذ الشك منهجاً للوصول إلى اليقين ذاته.
وحتى أبو حامد الغزالي الذي ينظر إليه على أنه سلف ديكارت في الشك المنهجي، لم يوصله شكّه إلى يقين فلسفي أو منطقي مؤسس على برهان قاطع، كما فعل ديكارت، بل كل ما فعله، أعني الغزالي للتخلص من أدواء الشك، أنَّه ارتمى في أحضان التصوّف كما هو معلوم من سيرته!
مضيفاً: إنَّ الشك، قبل أن يكون فلسفياً، فهو إيماني؛ ذلك أنَّ الإيمان يجب أن يكون عن يقين بصحة ما يؤمن به الإنسان. يترتب على هذه الحقيقة أنَّ الشك يصبح حينها جزءاً من عملية الإيمان نفسها.
ويقارن الكاتب والبروفيسور اليمني حبيب عبد الرب سروري بين البيئة التعليمية الغربية، ومثيلتها العربية بقوله: “يعود الطالب في الغرب من المدرسة وقد تعلم كيف يكون فضولياً جدّاً، شكّاكاً جدّاً، وكيف يستخف بأيِّ تفسير أو إجابة تأتيه من خارج المختبرات العلمية، يعود من المدرسة بعد أن تعلّم كيف يرفض ألف مسلّمة ومسلمة، وكيف تكون (لا) هي الجواب الأول والأساس والمعتمد لأيّة معلومة تأتيه في حين يعود الطالب العربي بعد أن ازدادت حصيلته من التفسيرات اللاعلمية، الخرافية السحرية عن الكون والحياة والإنسان والماضي والمستقبل” .
بدءاً من ديكارت
وضع ديكارت في كتابه الشهير “مقالة في الطريقة” أربع قواعد للتفكير:
- لا أقبل أي شيء على أنّه حق ما لم يتبيّن لي بالبداهة أنّه كذلك
- أجزِّئ المعضلات المبحوثة إلى ما يمكن من أقسام لحل هذه المعضلات.
- أسوق أفكاري بالترتيب، مبتدئاً بأبسط الأشياء وأيسرها علماً، ثم أرتقي إلى المواضيع المعقدة.
- أجري في كل مجال إحصاءات وافية ومراجعات شاملة.
هذه الطرق تستلزم وسيلتين: الحدس ويعني به الوعي المتيقظ الواضح الذي لا يدع مجالاً للشك، والثانية هي الاستنتاج، ويعني استخلاص شيء جديد من شيء نعرفه تمام المعرفة.
حجج الشك
في كتاب (الشك واليقين) يورد المؤلف مرجعيات الحجج التي جمعها قدماء الشكّاك من اليونان وخلَّفوها لمن جاء بعدهم إلى الأربعة التالية:
أولاً: الأخطاء التي يقع فيها الناس، ومنها أخطاء الحواس، وأخطاء الوجدان في اليقظة والمنام، وأخطاء الذاكرة، وأخطاء الاستدلال، وهذيان المحمومين، وتخيلات المجانين. إن البرج المربع يبدو لنا عن بُعد مستديراً، والمجذاف يبدو منكسراً في الماء، ومتى سارت بنا مركبة أو سفينة بدَا الطريق وبدَا الشاطئ كأنّه يسير. ونحن جميعاً نعتقد بحقيقة ما يتراءى لنا من الصور في الأحلام، فلِمَ لا تكون اليقظة وهماً كالحلم؟ والذي نسميه مجنوناً لا يعرف أنّه مجنون، بل يظن نفسه عاقلا،ً فما يدرينا أنَّ عقلنا ليس جنوناً؟ ولما كان التصديق مصاحباً لتصوراتنا جميعاً، فبأيّة علامة نميز الحق من الباطل؟ وما الذي يضمن لنا أننا لا نخطئ دائماً؟
ثانياً: اختلاف الناس في إحساساتهم وآرائهم وعقائدهم وأخلاقهم وعاداتهم، حتّى ليمتنع التوفيق فيما بينها على من يحاوله، والمذاهب الاعتقادية متعارضة يهدم بعضها بعضاً، ومع ذلك فكلٌ مقتنع برأيه متعصب له. إن هذا الاختلاف الشامل دليل ساطع على عدم وجود حقيقة بالذات، أو على عدم استطاعتنا الوصول إليها إن وجدت.
ثالثاً: امتناع البرهان التام، فإنَّ البرهنة على قضية ما تستلزم الاستناد إلى قضية أخرى، وهذه تستلزم الاستناد على ثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية. فنحن مسوقون إلى التسلسل من دون أن نستطيع الوقوف عند حد وإرساء العلم على أساس.
رابعاً: امتناع التدليل على صدق العقل، وهذا الدليل واجب؛ إذ من الخلف الوثوق بالعقل قبل الاستيثاق من إمكان الوثوق به، ولا نستوثق من هذا الإمكان إلَّا بالعقل، ولا يصح أن يكون العقل حكماً في صدقه هو، أو نقع في دور لا مخرج منه.
والشكّاك لا ينكرون شعورهم باليقين الأوّلي الحاصل لجميع الناس بالإحساسات الظاهرة والباطنة؛ إذ إنَّ التصديق بها طبيعي لا يقاوم، وكان شأنهم معها كشأن جميع الناس في الحياة العادية. وقد روي أنَّ إمامهم «بيرون» اضطر ذات يوم إلى الهرب من كلب، فأخذ يركض وهو يقول: «ما أصعب التخلص من الطبع!» ولكنهم يقولون: إنَّهم يمتحنون هذا اليقين الأولي فلا يجدون له مبرراً يحيله يقينيّاً عقليّاً، وإنَّ الموقف الحكيم في هذا الامتحان أو البحث النقدي اللاحق على التصديق الأولي إنَّما هو تعليق الحكم والقول «لا أدري». فالشاك يعلم مثلاً أنَّ هذا الشيء يبدو له أبيض، وهو يصرح بذلك، ولكنّه لا يؤكد أنَّ الشيء في ذاته أبيض، فكانت في ذهنه فجوة بين المعرفة النقدية والحياة العملية، وكانت هذه الفجوة مثار اعتراض قوي على الشكاك هو وقوعهم في التناقض.
فنحن ننظر للشباب، في وقتنا الحاضر، على أنّهم رافضين لكل شيء قديم، مطالبين بتغييره بما يلائم زمنهم، غير أنّنا ننسى أن الشك مرحلة من مراحل اليقين، هذا الذين يمكن أن يصلوا إليه من خلال التجربة والحياة التي ستجبرهم على تقبّل تفاصيل كثيرة لم يكونوا مقتنعين بها. وهنا سيبدؤون مرحلة أخرى من مراحل الوصول إمّا إلى الشك التام، أو ضفاف اليقين، التي لم يصل لها الأغلب الأعم من الناس.





