الوقوع في أسر الكتب
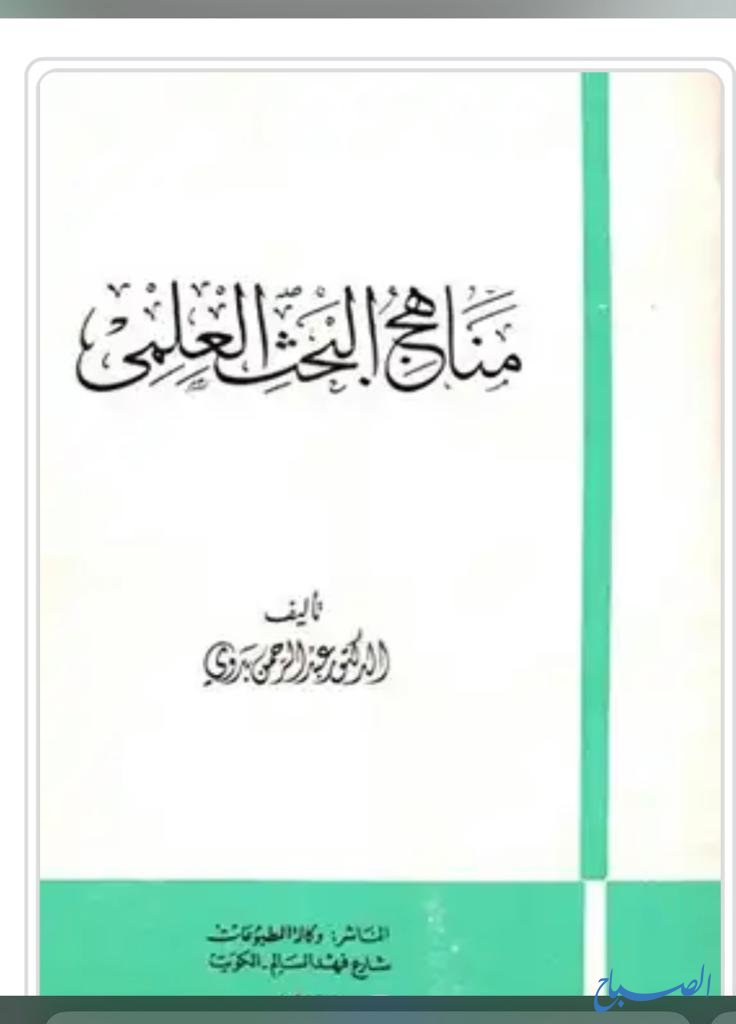
د. عبد الجبار الرفاعي
وقعت أسيرا للكتب في حياتي. أشعر بوحشة مريرة في بيت يخلو من الكتب، أحتاج الوجود المادي للكتب أكثر من احتياجي لمختلف الأشياء الكماليَّة في البيت، وحتى بعض الأشياء الضروريَّة. حيثما أكون تصاحبني الكتب، في سفري بوسائل النقل، وإقامتي بالفنادق وأي محل أقيم فيه خارج البيت. لا أتردد للمقاهي وليس لدي هوايات خارج الكتب. أقرأ الصحافة منذ الصف الرابع إعدادي «العاشر»، وما زلت حتى اليوم تأكل قراءة الصحف والأخبار عبر الأنترنيت ما لا يقل عن ساعتين يوميا، الصفحات الوحيدة المنسيَّة في قراءتي الصحف والمجلات الأسبوعيَّة هي صفحات الرياضة.
الشغف بالكتب قديم يعود لمرحلة مبكرة من حياتي، والادمان على حضورها الدائم ترسخ بمرور الأيام. أعيش مع الكتب وكأنّها كائنات حيّة تتكلم بلغة أتحسسها وأسكن إليها، وإن كنت لا أجيدها. تتكلم الكتب وهي صامتة على رفوف المكتبة، أتحسس كأنّها ترقبني برفق وهي مبعثرة في غرف البيت، وتفيض الهدوء حين تلبث بجواري على الدوام حتى في غرفة النوم. بعض الكتب تمكث مهملة سنوات لم أقرأها، وجود الكتاب يشعرني بالأمن النفسي، ويؤنسني حين أشعر بوحشة الوجود.
الكتاب الذي أقتنيه أو يهدى لي، أقرأ مقدمته ومحتوياته، وأتعرف عليه بالتدريج كما أتعرف على الأصدقاء.
إن كان لا فائدة فيه، لا يضيف لمعرفتي شيئًا، ولا يغذّي لغتي، ولا يؤنسني، أشعر بأنّه عبء على المكتبة، وأحيانًا كأني أحمله على أكتافي، فأطرده من المكتبة حتى لو اشتريته بثمن كبير.
الحافز الذي يغويني بشراء الكتاب هو الحاجة النفسيَّة الشديدة له، والشعور بأنّه أحد مهدئات الاكتئاب.
أتساءل لماذا الاستمرار باقتناء الكتب وتكديسها بهذه الطريقة الغرائبيَّة، أليس هذا السلوك يثير أكثر من استفهام، إن كنت غير محتاج لها آنيًا، وأحيانًا متأكد من عدم توفر فرصة قريبة لمطالعتها؟ لم أجد جوابًا منطقيًا، سوى إدراك حاجتي لها، التي لا أعرف بواعثها بوضوح، أتحسس الاحتياج العاطفي لها أكثر من العقلي. مضافًا إلى وهم يتملكني، وربما يتملك غيري من عشّاق الكتاب، بأن امتلاك الكتاب يعني الامتلاء بالضوء الذي ينبع منه، وينكشف فيه شيء مما هو محتجب في الذات والآخر والعالَم من حولنا.
بداية مطالعاتي كنت أبحث عن أي كتاب أقرأ عنه أو أسمع به أو أراه، أسعى مباشرة لشرائه عندما أمتلك ثمنه، إلا أني غادرت هذا النوع من الولع الفوضوي بالكتاب منذ نصف قرن تقريبًا. تواصل الولع بشكل مختلف ولم ينطفئ، أصبحت أنتقي عناوين أحسبها نوعية، وطالما خذلتني توقعاتي بمضمون الكتب وقيمتها الفكرية والابداعية. ما يخدعني من العناوين يؤذيني، أحاول أتريث وأدقق لأرى ربما يكون حكمي متسرعًا على كتاب واحد، فأحاول تكرار التجربة مع كتاب ثان وثالث للكاتب ذاته، عندما أتأكد من وهن قلمه أهمله للأبد. لا أظن تحررت أو أتحرر تمامًا من الولع بالكتب، مازلتُ عندما أكون في مجلس وأرى كتابًا بيد أحد الجالسين أو على منضدة، يقودني الفضول للتعرف عليه بطريقة لا أرتضيها أحيانًا. الشعور بالحرج من إنسان ألتقيته أول مرة، يدعوني للتردد بطلب الإذن من صاحبه، والمغامرة بسؤاله عن الكتاب وإمكان الاطلاع على عنوانه ومحتوياته. حاولت التخلص من هذه العادة، إلا أني فشلت، مثلما فشلت بالتخلص من ادمان مصاحبة الكتب حيثما أكون.
حين أظفر بكتاب أبحث عنه مدة طويلة أعيش حالةَ ابتهاج تتواصل أيامًا، وحين أتردد بشراء كتاب لم أعثر عليه لاحقًا، ربما ألبث سنوات أشعر بالضجر كلما تذكرت لحظة الاعراض عن شرائه، أو لم تسعفني قدرتي المالية لتأمين ثمنه ذلك الوقت. أتذكر أول زياراتي لشارع المتنبي سنة 1973 عندما كنت طالبًا ببغداد، لم تكن المكتبات في الشارع بهذه الكثافة وهذا الحضور الواسع المتنوع اليوم. دخلت المكتبة العصرية للحاج صادق القاموسي، الذي لم يكن يعرفني ولا أعرف عنه شيئًا وقتئذ، رأيته والشيخ أحمد الوائلي جالسين يتحدثان، بعد السلام عليهما، سألت القاموسي عن كتاب رأيته بتجليد أنيق في عدة مجلدات بحجم الموسوعات على أعلى رف في المكتبة، فأجاب: هذه «دائرة المعارف: قاموس عام لكل فن ومطلب» لبطرس البستاني، وذكر رقمًا كبيرًا ثمنًا لها، وأضاف: أنت لا تحتاجها بهذا العمر. لم يكن في جيبي سوى بضعة دنانير، ما تبقى من سلفة شهرية تمنح لطلاب الجامعات والمعاهد تلك الأيام. لم تمت هذه القصة في ذاكرتي، ظلت ترافقني حتى اليوم، كلما تذكرت ذلك الموقف الذي مضى عليه نصف قرن أتمنى لو اشتريتها ساعتها، وأحيانًا أتحسر للعجز عن اقتناء دائرة معارف البستاني. لو كنت قادرًا على ثمنها واشتريتها ربما تكون أحد محطات الاستراحة في حياتي، ولعلها تجدد بهجتي بمشاهدتي لها راقدة على رفوف المكتبة، وإن كنت لا أقرأها، ولا أعود إليها إلا نادرًا.
كنت أتردد على مكتبة الصديق عصام الطيار «أبو جعفر» وغيره في سوق الكتب بقم أكثر من مرة في الأسبوع قبل أكثر من ربع قرن.
عصام مثقف أخلاقي مهذب، قارئ متمرس، خبير بعناوين الكتب ومحتوياتها، أعود إليه للتعرف على مضمون الكتاب وقيمته العلمية، رأيت في مكتبته للبيع «دائرة المعارف الإسلامية» في طبعتها العربية الثانية المنقحة في تسعينيات القرن الماضي، بترجمة: أحمد الشنتناوي، وإبراهيم زكي خورشيد، وعبد الحميد يونس، سألته عنها، فأجابني: هذه الطبعة في 13 مجلدًا، توقفتْ عند حرف الشين، وهي أجود من الطبعة الأولى بكثير بما تشتمل عليه من تنقيحات وتعليقات مهمة. ذلك اليوم ترددت بشرائها عندما رأيتها مطبوعة بورق غير جيد على الرغم من امتلاكي لثمنها. ندمت بعد أيام، لما عدت للأخ أبي جعفر وأخبرني أنه باعها، تألمت لما فرطت فيه. الغريب تنامي هذا الندم بمرور الأيام، كنت كمن يفتقد كنزًا زهد فيه وهو بثمن زهيد. كلما تذكرت ذلك اتأسف، أعرف لا يتسع وقتي لمطالعتها، ولا أحتاجها كثيرًا. هذه مواقف ربما تبدو غريبة لأكثر القراء، غير أني عشتها، أظن تشبع الإنسان بمناخات الكتب تجعله يتحسسها بوصفها ملاذًا يأوي إليه أوقات الضنك، أو كأنها مرآة يرى فيها الصورة المحببة لوجوده.
ورطني شغف الكتب بموقف محرج، كاد يودي بحياتي. بداية شهر ابريل/ نيسان 1980، بعد وصولي للكويت هاربًا من بطش صدام حسين بعشرة أيام، اكتريت سيارة أجرة من منطقة الصليبة، حيث بيت أخي الحاج أبو عادل الذي أقمت فيه، إلى شارع فهد السالم المعروف بشارع الجهراء في الكويت. ذهبت إلى مكتبة «وكالة المطبوعات»، وهي مكتبة تعرفت عليها قبل سنوات في زيارة سابقة للكويت، من أهم اصداراتها سلسلة الأعمال الثمينة لأستاذ الفلسفة الشهير د. عبد الرحمن بدوي، عندما كان أستاذًا في جامعة الكويت.
دخلت المكتبة التي تتألف من طابق أرضي لبيع اللوازم المدرسية والقرطاسية، ومخزن واسع للكتب تحت الأرض، يتسع لعدد كبير من المطبوعات اللبنانية والمصرية ومختلف البلاد العربية. كانت مكتبة غنية متنوعة، تتراكم على رفوفها كثيرٌ من الكتب الثمينة، مما كنت أسمع بها ولم أطلع عليها من قبل، بعد تزايد عدد عناوين الكتب الممنوعة من دخول العراق. وصلت المكتبة الساعة العاشرة صباحًا، وانغمرت في كنوز رفوفها، أمسك كتابًا يستدرجني عنوانه فأبحث عن مضمونه، أقرأ المحتويات، وأقلب صفحاته، أقرأ نص الغلاف الأخير، وأحيانًا أقرأ مقدمة المؤلف. شغلتني كتب مهمة، وفرحت بعناوين أمضيت عدة سنوات في البحث عنها.
لم أتنبه إلا بمضي نحو خمس ساعات من الأُنس بمعاشرة الكتب، خرجت من المخزن لأغادر المكتبة وجدتها مقفلة. لم يكن صاحب المكتبة عبد الله حرمي يعلم بوجودي، أغلق الباب الذي كان من الزجاج، وخرج ليستريح الظهر في بيته، من دون أن يطفئ الانارة أو المراوح في المكتبة. قلقت لشعوري بتوريط نفسي بموقف شديد الحرج، ظننت يرتاب صاحب المكتبة بعد عودته، لحظة يراني وكأني استغفلته بالبقاء بمكتبته، وربما يشاهدني شرطي من وراء الزجاج فيظن أني سارق، وسرعان ما يقودوني إلى السجن. المشكلة كانت بدخولي للكويت من دون جواز سفر، وليست لدي أية وثيقة تدلل على اقامتي القانونية في البلد، المصير الحتمي لحالات كهذه التسفير للعراق، وسأكون صيدًا ثمينًا لجلادي نظام صدام، لو حدث ذلك قد ينتهي مصيري إلى أن أقضي تحت سياط هؤلاء. لبثت أترقب عودة صاحب المكتبة بوجل، لحظة دخوله المكتبة الساعة الرابعة والنصف عصرًا، لم أتحسسه إذ كنت أواصل السياحة بين الكتب في السرداب، صعدت ففوجئت بوجوده، كان الطابق الأول لوكالة المطبوعات مزدحمًا بأشخاص يبتاعون قرطاسية.
خرجت من المكتبة بهدوء، من دون أن يتنبه هو لخروجي، بعد خطوات شعرت بحرج أخلاقي لمكوثي بمكتبته، وتقليب الكتب والاطلاع عليها عند غيابه من دون إذنه. قررت العودة مهما كانت العواقب، عدت مسرعًا وقلت له: أعتذر منك، مكثتُ في المكتبة عندما أغلقتَ حضرتك الباب الخارجي، لم أكن أعلم بمغادرتك لاستراحة الظهر، ولم تعلم بوجودي لحظة اغلاقك المكتبة. ظهر على وجه عبد الله حرمي الذهول والخجل، أجابني بلطف معربًا عن أسفه لما حدث. لن أنسى موقف هذا الرجل المهذب بعد مضي كل هذه السنوات، كان بإمكان صاحب وكالة المطبوعات اتهامي وتسليمي للشرطة، ووفقًا للقانون سأُرحّل للعراق، وأغلب الظن يكون مصيري الإعدام. أنقذني هذا الرجل النبيل من مغامرة لم أكن مضطرًا أن أزج نفسي فيها بلا حساب للوضع الطارئ الذي كنت فيه، كان يمكن أن تودي تلك المغامرة إلى الهلاك.
أخبار اليوم


لجنة العمل لـ «الصباح»: مقاعد حج وتعيينات وقطع أراض لذوي الاحتياجات الخاصة
2025/01/15 الثانية والثالثة


