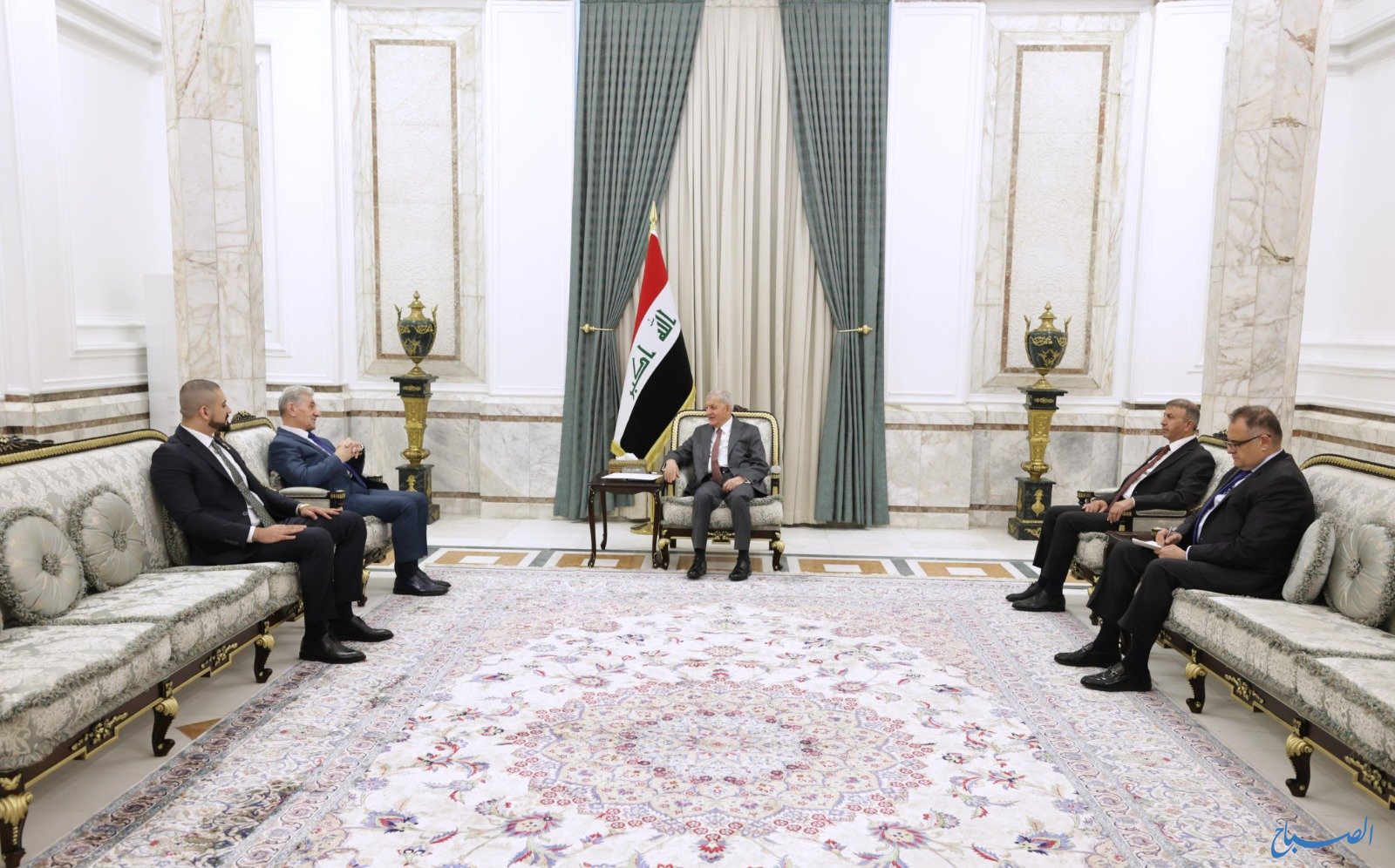لا شيءَ أكثر أهمية من متعة اللعب

في إحدى محاضرات الجامعة في مرحلة الماجستير، كان الأستاذ أحمد الطريسي يحدثنا عن الرؤيا في الأدب. كنا مفتونين بطريقته في قراءة النصوص الأدبيّة، بتخريجاته العميقة للصور الفنيّة، كان يرينا ما لم نكن نراه في النص، أي نص، مما قد رافقنا في سني عمرنا وحفظناه عن ظهر قلب. أفكاره لم تكن تثنينا عن محاولة إيجاد قراءتنا الخاصة للأدب. ونجد متعة بالغة في اكتشاف ما إذا كان سيذهب حيث ذهبنا أو أنه سيأخذنا في مسار آخر لم نتوقعه، وكثيرا ما كان يفعل. لا يريد أحمد الطريسي أن يحصرنا في فضاء أفكاره وحدها بقدر ما أراد ألا نستسلم للظاهر وحسب. كان لا يريد أن يجعل من نفسه ملهما بقدر ما أراد أن نستمد الإلهام من الأدب ذاته، أن تكون لكل منا نظرته المغايرة التي يستخلص بها معاني ممكنة لا تشترط موافقة الآخرين بالضرورة ما لم تناقض البداهة وإلا حلت الفوضى، لأن القول بلا نهائية معاني النص – كما قيل - لا تعني سوى الفوضى.
لسنوات طويلة، كان علينا أن نتذكر إحساس السعادة الذي نخرج به بعد كل محاضرة للطريسي، ذلك الإحساس الذي يقودنا إلى استنطاق الأدب وكأننا في موعد مع صديق حميم نفضي إليه بقدر ما يفضي إلينا. إنها الطريقة الوحيدة التي تجعل سلطة النص هي العليا، وليس لشيء آخر سلطة عليه باستثاء ذاته.
مَن مِن طلبة أحمد الطريسي وقتئذ لم يتأثر بروحه الطفولية، وهو على مشارف السبعين، إذ تجده يضحك فرحا لمعنى جديد، أو تأويل ثاوٍ، أو استنتاج غير مسبوق، أتى به أحد طلبته؟ عهد إلينا مرة تقديم قراءات لنصوص نختارها، فاخترتُ قصيدته «عمي مساء». عثرتُ عليها معلّقة في صحيفة قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب في جامعة السلطان قابوس، فأحسست أنني أتحدّى الرجل عندما أريه في نصّه ما لا يمكنه مخالفتي فيه وإن أخطأت، طالما هذا نهجه! ضحك ضحكته العذبة عندما قرأ ما كتبت، وقال: «لا أستطيع أن أعلّق لأنني لا أجيد قراءة نصوصي». فهل أصبتُ يومها في قراءتي؟ هذا ما لن أعرفه أبدا، ولكني واسيت نفسي بما كان يقوله دائما: «لا توجد قراءة خاطئة، ولكن توجد قراءة حسنة، وأخرى أحسن منها»، فعرفت أن لي حسنة واحدة على الأقل.
سبقت معرفتي بالطريسي معرفتي بتلميذِهِ الناقد المغربي عبدالرحيم جيران، الرجل الذي شكّل امتدادا لمدرسة الطريسي في قراءة الأدب ونظرياته بجسارة تخلخل الثابت والمستقر، وبصبر لافت لا يكتفي بالنص منفردا ولكن بالنص في مراياه المتعددة، فيُشيّد من فعل القراءة قلعة تستمد متانتها من روافد ما أنتجته المخيّلة البشرية. ولكم أدهشتني قدرته على جمع المشتت وتنظيم المتفرق، ولا نستغرب أن يلجأ لعلوم الطبيعة قارئا وباحثا من أجل التحقق من فرضية نقديّة أو فكرة
أدبيّة.
كانت لحظة اكتشافي عبدالرحيم جيران لحظة فارقة في مرحلة دراستي للدكتوراه ثم في مشروعي البحثي من بعد. إنه رجل يجعلني أخجل مما أعتقد اني أعرفه، لاكتشف أن المعرفة يمكن أن تأتي من حيث لا أتوقع، إذ يذيب الحواجز بين الممكن وغير الممكن. وإن كنت أنسى، فلست أنسى الساعات الطوال وهو يجلس فيها منصتا لتلميذته تقرأ عليه فصولا مما كتبتْ في أطروحتها، بذهن حاضر وملاحظات دقيقة، فعرفت أن الأستاذ مثله يقدّس ما يفعل، على الرغم من العارض الصّحي الذي ألمّ بعينيه وحرمه لفترة من الوقت القراءة والكتابة.
يعلمنا جيران شجاعة المساءلة، وهو إذ ذاك يعرف كيف يغذّي في طلابه مواطن الثقة في أنفسهم. أتذكّر رحلة الصبر التي كابدها وهو يجمع شتات ما كُتب في اللغات الأخرى عن الذاكرة؛ حتى ينجز كتابه المهم «الذاكرة في الحكي الروائي؛ الإتيان إلى الماضي من المستقبل»(1). وفي مساء من مساءات مدينة «مارتيل» في الشمال المغربي بينما كنا نمشي كدأبنا بعد كل لقاء، قال: «تستطيعين أن تبني عليه وتنجزي كتابا يضيف إلى أفكاره». لم يكن يتحدّى، بل كان يحرّض في تلميذته أقصى ما في وسعها من ممكنات. فهل كنت أمشي بعد هذه العبارة؟ كنت أطير!
تعلمتُ من جيران إذن معنى أن يكون المرء صبورا في رحلة البحث والمعرفة، وجسورا في محاورة فكر الآخر بعد مُدارسة وفهم. وفي حوار مشترك بيننا تحت عنوان «حوار بين جيلين»(2) نشرته صحيفة الدستور المصرية، سألتُه نصيحةً للباحث الشاب، فقال: «ينبغي لكلِّ شابٍّ أن يعثر على الرسالة المقذوفة في بحر المعرفة بنفسه؛ فهذا جزء لا يُستهان به من تكوُّن شخصيته المعرفيَّة. لكن لن يتيسَّر له هذا إلَّا بعد إتقان فنّ التلمذة. ولا أقصد بهذا الأخير اتِّباع هذا أو ذاك من الأساتذة أو التحوُّل إلى مريد له في الحياة والمعرفة، وإنّما إتقان محاورة فكره، وكيف يمكن تأسيس مسافة حياله بغية تأسيس التراكم الذي هو عنوان المعرفة الجيِّدة. ولا ينبغي تلقِّي الغير، الغربيّ أو غيره، إلَّا بمراعاة تقليد التلمذة هذا. ما كان لي أن أحاور تودوروف وغريماس وبول ريكور وغيرهم لولا أنَّني قضيت زمانَا طويلًا في التلمذة على أعمالهم قبل أن أختطَّ لنفسي طريقًا خاصًّا بي. وما أخشاه على شباب اليوم هو ألَّا تتاح لهم هذه التلمذة بفعل عدم قدرتهم على التمييز بين زمان الميديا وزمان المعرفة؛ فزمان الأولى فوريُّ متسارع يمحو فيه اللاحق السابق من دون أن يترك له فرصة أن يستقرَّ ويأخذ حقَّه اللازم في تشكيل الوعي، بينما زمان الثانية بطيء لا يقاس بالدقائق والساعات، بل بالأعوام والعقود. ولهذا أخشى أن يُتلقَّى الغير من متاح زمان الميديا، لا من خلال زمان المعرفة، فتنتج عن هذا معرفة مشوَّهة. ومعنى هذا أنَّ على الشابّ- وهو يسعى إلى العثور على رسالته الخاصَّة- أن يُؤمن بطول النفس، وبناء ذاته وفق زمان ممتدٍّ، وألَّا يتسرَّع في جني النتائج».
وبين الطريسي وجيران، كانت الفرصة مواتية دوما للقاء عبدالفتاح كيليطو، سواء عبر كتبه أو عبر لقاءات مباشرة يطول فيها الحديث بيننا أو يقصر، ولكني لا أنسى أهمَّ قاعدة كانت تُوجّه مشروعه الأدبي والفكري، وهي أنَّه كان يتوجّه للقارئ العام في كل ما كتب ويكتب(3). حتى عندما أنجز أطروحة الدكتوراه كان مشغولا بالقارئ العام أكثر مما شغلته لجنة المناقشة وشروطها الأكاديمية الصارمة(4)؛ ولهذا نعزو أسلوبه المختلف في الكتابة النقدية. في الكويت عندما التقيتُ كيليطو للمرة الثانية في مارس من عام 2019 في مهرجان المعنى الذي نظمته مكتبة تكوين(5) ، كنت أحدّثه عن كتبه بمحبّة كبيرة، فنظر إليّ وسأل مباغتا: «لماذا تحبين كتبي؟» كدتُ أقول له بتهوّر: ومن لا يحب كتبك؟! ولكني عرفت أنه يسأل ليعرف، كما لو كان كاتبا – لشدّة تواضعه – يستغرب أن الناس هنا يُقبلون على كتبه، وكما لو أنه ليس كيليطو. كان عليّ أن أفكّر في إجابة بديلة وسريعة، فلم أجد أفضل من القول: «لأنك تكتب بشكل مختلف». وسرّ اختلافه أنه يكتب وكأنه يلعب، أو يلعب بينما يكتب؛ فهو يقول في أحد حواراته: «صدّقني أنه لولا وجه اللعب الذي تتخذه الكتابة، لما كتبت. ما جدوى الكتابة إذا لم نلعب في الوقت ذاته بالكلمات والصور والذاكرة»(6). فهل يمكن أن أتجاهل مقولته هذه في كتاب يحمل عنوان «لا شيء أكثر أهمية من متعة اللعب»؟! وهي عبارة وإن كانت مُستلّة من أحد مقالات هذا الكتاب يتحدّث عن لعبة كرة القدم في السرد العماني، غير أن اللّعب مدرسة في الكتابة أيضا كما يعلمنا كيليطو، وطريقة سحرية تمنح الكتابة مبرر استمراريّتها، وتضفي على ألعاب الطفولة امتدادا ولكن في الخفاء، كما يقول جيمس ماثيو باري: «ما عكّر صفو طفولتي، هو إحساسي بأن الزمان الذي عليّ أن أتخلّى فيه عن لعبي كان قد أوشك، وقد كان ذلك يبدو لي أمرا لا يطاق. لذا قررت أن أواصل اللعب في خفاء»(7).
تذكّرت الطريسي وجيران وكيليطو ومقولة ماثيو باري وأنا أهُمُّ بتحضير هذا الكتاب للنشر، وتساءلت إلى أي حد يُقدّم قراءة للنصوص كما كانت تلهمني دروس هؤلاء؟ وأجدني أقول: لي حسنة واحدة على الأقل، وعسى أن يجد فيه القارئ أكثر. مع يقيني أن لا شيء ثابت يروم أن يصبح مادة للتطبيق في هذا الكتاب الذي تلتئم فيه عشرة مقالات تتناول نصوصا سرديّة يجتمع بعضها في سياق المعالجة الواحدة، ويستأثر بعضها الآخر بمعالجته منفردا، وقد نُشر معظمها في صحف ومجلات, وكان أربعة منها ضمن المقالات العشرة التي فازت بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها التاسعة 2022م في مجال المقالة عن فرع الآداب.
في المقال الأول «كرة القدم في السرد العماني» سعيت إلى بحث أشكال حضور اللعبة الشهيرة في السرد العماني، وعمدت إلى بناء المقال بناءً يحاكي مباراة كرة قدم مكونة من شوطين، وفاصلة زمنية تفصل بينهما، وأشواط إضافية، ووقت بدل ضائع. غير أني بعدما نشرت هذا المقال، عثرت مصادفة على نصين أدبيين للشاعرين سيف الرحبي وسماء عيسى يتحدثان فيهما عن شغفهما بكرة القدم، فأفردت لهما مقالا مستقلا عنونته بـ «كرة القدم بين سيف الرحبي وسماء عيسى»، وربطته بسابقه بعنوان فرعي، هو: «اللاعب رقم 12»؛ وذلك لأن الشاعرين انطلقا في كتابة مادتيهما عن كرة القدم من موقعهما مُشجّعَين في المدرّجات بين الجماهير، فكان هذا المقال الثاني.
ومثلما تتبعت في المقال الأول كرة القدم في السرد العماني، رحت أتتبع في المقال الثالث حضور «السيل في السرد العماني» أيضا، أرقب أشكال توظيفه ومدى تأثيره في أحداث السرد ومصائر الشخصيات، فعثرت على صيد وافر من النصوص السرديّة العمانية التي عملت على تسريد السيل في تضاعيفها.
أما في المقال الرابع، فقد اجترحتُ مصطلحا لمقاربة الأعمال القصصيّة للأديب العماني الراحل عبدالعزيز الفارسي، وهو «شنصنة السرد»؛ نسبة إلى مدينة «شناص» العمانية التي ينتمي إليها الكاتب الراحل، بغية الوصول إلى السّمات التي ميّزت كتابته انطلاقا من المكان وشخصيّاته، فصبغَتها بحالة خاصة لم تتكرّر لدى غيره من كتّاب السّرد في عمان، فكان عنوان المقال «عبدالعزيز الفارسي وشنصنة السرد».
وتناولتُ في المقال الخامس كتاب «في- أثر عنايات الزيات» للكاتبة والشاعرة المصريّة إيمان مرسال، في رحلة تتبعها لأثر الروائيّة المصريّة عنايات الزيات التي تركت رواية وحيدة غير منشورة عنوانها «الحب والصمت»، قبل أن تنتحر في عام 1963م (8)، وما أحدثته مرسال بكتابها إذ زحزحت الكاتبة المغمورة من الهامش إلى المركز، وعنونتُ المقال بـ «عنايات الزيات: من الهامش إلى المتن».
وعدتُ في المقال السادس إلى مجموعة القاص العماني مازن حبيب «البطاقة الشخصيّة للعمانيين» الصادرة في عام 2014، واخترت منها قصته «النبأ الأخير»، لأراقب الفرق بين عطل آلة الفكرة، وعطل فكرة الآلة، من خلال بطل القصة، مذيع نشرات الأخبار، الذي قرّر أن يخالف قواعد مهمّته المرسومة بدقة ويفضي إلى المشاهدين بخبر خاص. في حين اخترت للمقال السابع قصة «رجلٌ عارٍ يعانق الإسفلت» للقاص المغربي- أحمد بوزفور من مجموعته «إني رأيتكما معا» الصادرة في عام 2020، ورحت أنظر في بناء القصة وتمرحلها من نواة صغيرة إلى وحدة تكتنفها طبقات من التلقي الافتراضي والواقعي بحثا عن الحدود الفاصلة بين الحقيقة والخيال.
واقتربت في المقال الثامن من «خميس أورويل»، بطل قصة محمود الرحبي - التي حملت العنوان نفسه في مجموعته القصصيّة «ثلاث قصص جبلية» الصادرة في عام 2020 - بينما تتقاذفه تناقضات القنوات الإخباريّة بين مقهيين قَصَدَهما في بادئ الأمر لتزجية الوقت، قبل أن تتسبب هذه القنوات (بتعبير أدق هاتان القناتان كما سنرى) بين المقهى والآخر في إصابته بالقلق والتشوّش، وعنونت المقال بـ «خميس أورويل بين الجزيرة والعربية».
أما في المقال التاسع، فعاينت تعدد أشكال حضور الخوف في مجموعة «وقت قصير للهلع» ليحيى سلام المنذري» الصادرة في عام 2022م، واختلاف طرائق التعبير عنه بين شخصية وأخرى، وصولا عند ظاهرة القصديّة في مشروع المنذري الكتابي، وعنونت المقال بـ «كتابة الخوف في مجموعة «وقت قصير للهلع» للقاص العماني يحيى سلام المنذري. وفي المقال العاشر والأخير اخترت مقاربة قصة «أحلام أسامة» للقاص الإنجليزي جون ريفنسكروفت من مجموعته القصصيّة «قتل الأرانب» الصادرة في عام 2005، التي صوّر فيها حادثة الحادي عشر من سبتمبر من وجهة نظر أربع شخصيات تحلم، فماثل في كتابته بين موضوع القصة وبنائها الفني القائم على التقطيعات، وربط المنطقي الواقعي بالحلمي الفنتازي.
وقد حَكَم اختيار هذه المقالات العشرة بين دفتي هذا الكتاب، اشتغالها جميعا على جنس القصة القصيرة في الأغلب الأعم، بالإضافة إلى نصوص سردية أخرى عصيّة على التصنيف كما هو حال كتاب إيمان مرسال «في أثر عنايات الزيات»، الذي لا يمكن عدّه باطمئنان رواية أو سيرة غيرية. أما المقالات التي تناولت عدة نصوص سردية في سياق معالجة الموضوع الواحد، فقد غلبت عليها النصوص القصصيّة، ما عدا بعض نماذج روائية أو نصوص أدبيّة لم يكن ممكنا تجاوزها.
فإذن، أضع ين يديك، أيها القارئ الكريم، عشر نظرات في السرد، على أمل أن تجد في قراءتها شيئا من متعة اللعب.
الهوامش:
1 - صدر عن دار الكتاب الجديد المتحدة في عام 2019م.
2 - نشرته صحيفة الدستور المصرية في ثلاث حلقات في يونيو من عام 2021.
3 - راجع المحاورة التي أجريتُها معه بعنوان «والله إن هذه الحكاية لحكايته» المنشورة في جريدة عُمان بتاريخ 3 يناير 2022
4 - المرجع نفسه.
5 - بعد مرة أولى في مؤسسة بيت الزبير بمسقط في نوفمبر من عام 2018.
6 - أمينة عاشور: كيليطو .. موضع أسئلة، ترجمة عبدالسلام بنعبدالعالي، دار توبقال، الدار البيضاء، 2017، ص7
7 - المرجع نفسه، ص5
8 - نُشرت روايتها بعد انتحارها بأربعة أعوام في عام 1967م.