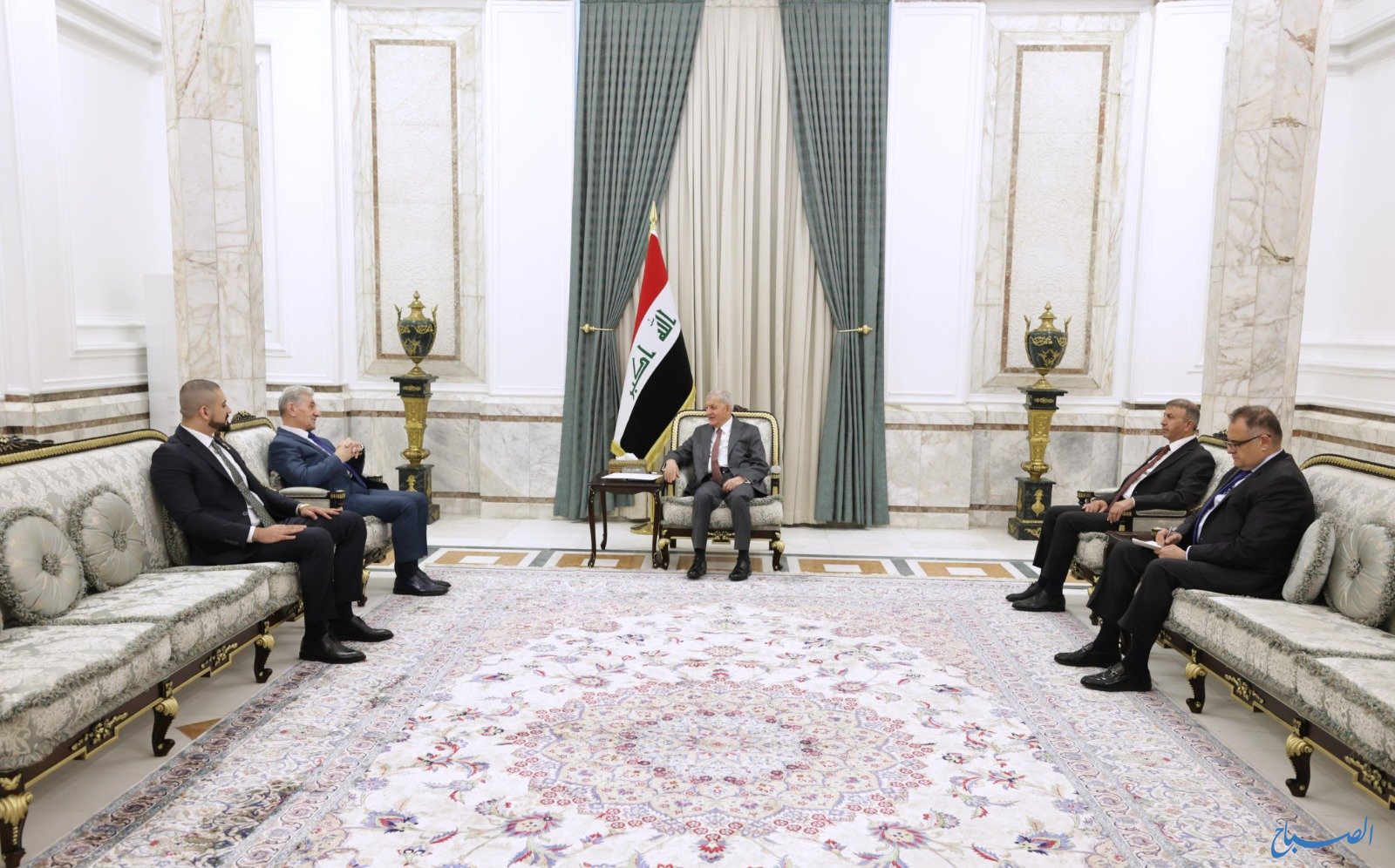اعتراضات وردود على {الدين والظمأ الأنطولوجي}

د. ضياء خضير
في الجزء الأخير من كتاب الدكتور عبد الجبار الرفاعي (الدين والظمأ الآيديولوجي) الذي كانت دراسته جزءاً من كتابنا الذي نعده لقراءة خطابه الديني قراءة نقدية، نقرأ مجموعة من الحوارات التي أجريت معه، والقراءات المقرّظة والناقدة لبعض ما ورد فيه لدى صدور طبعته الأولى عام 2015. وما يلفت الانتباه بين هذه المقالات اثنتان كتبهما الدكتور فالح مهدي المقيم في فرنسا، والدكتور ناظم عودة المقيم في السويد، بوصفهما نوعا من المقاربات النقدية المختلفة في فلسفتها ومنهجها وآفاق فهمها للدين ودوره في الحياة البشرية، ورؤيتها للمقولات الأساسية التي تنهض عليها فلسفة الدكتور عبد الجبار الدينية ونظريته الكلامية الجديدة في هذا الكتاب، وفي غيره من كتبه المختلفة.
والدكتور الرفاعي الذي يعلن بروحه المتسامح المنفتح على الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر ترحيبَه بالاختلاف في الرأي وحرصه على الأخذ بكل ما هو صائبٌ من الأفكار والملاحظات حتى إذا كان مخالفًا، يريد بعرضه لهذه المقالات في ملحق الكتاب أن يشرك القارئ معه، ويرى ردةَ فعله على ما يقوله هؤلاء الكتاب ورده عليهم، ودفاعه عما يعدّه أساسًيا في موقفه الإيماني من الدين، وحاجة الإنسان ذات الطبيعة الأنطلوجية الراسخة إليه.
وعلى الرغم من المقدمات التي يجري فيها الثناء والإشادة المتبادلة بين الرفاعي وناقديه، وهو ثناء صادق وحقيقي ولا مجال فيه لمجاملة، فلا بدّ من الاعتراف بأن الدكتور فالح والدكتور ناظم يتكلمان لغة مختلفة، ويستندان إلى منهج مباين بشكل جذري لمنهج الدكتور عبد الجبار في هذا الكتاب، منْطَلَقًا وأسسا معرفية وفلسفية. ونظرًا لوجود مشتركات في أغلب النقاط المثارة في المقالين، فإننا سنكتفي هنا بمناقشة جانب من الأسئلة التي يطرحها المقال الأول دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية المقال الثاني وأهميته الاستثنائية.
ومنذ البدء نرى أن ما ذكرناه آنفًا في عبارة المناطقة الخاصة بـ (المصادرة على المطلوب) يتكرر هنا على نحو ما، في طبيعة الرد العام الذي يقدمه الدكتور عبد الجبار على الاعتراضات الأساسية الموجهة لخطابه الديني من هذين الباحثين.
فالإجابة على كون الإيمان الديني، وما يرتبط به من ظمأ وجودي، قد لا يلبي مطالب المنطق والتطورات الثقافية والفنية والعلمية التي يشهدها العصر، والتي لا يستطيع الدين اللحاق بها في إصرارها ومثابرتها على الكشف عن أسرار الكون والنفس البشرية (وهي الأطروحة الأساسية التي يتضمنها مقال الدكتور ناظم عودة، والمستندة في رؤيتها إلى ما كان الفيلسوف الألماني نيتشه يقول به من أن الفن والموسيقى والثقافة يمكن أن تقدم بديلا عن الدين، بعد تجاوزه الشخصي له وإعلانه المعروف عن موت الإله)، هذه الإجابة لا تفعل أحيانا غير إعادة التمسك بالإيمان المستند إلى معرفة لدنية وعرفانية منفتحة، تستمد جذوتها ونارها الأولى عند الدكتور عبد الجبار من إيمان الأم الأمية التي لا سند لها غير إحساسها الفطري السليم بوجود خالق مدبر وعادل لهذا الكون، على الرغم من الفقر والخصاصة المادية، وصعوبة الحياة التي عاشتها مع زوجها وأولادها في ذلك الريف الجنوبي العراقي المدقع.
وهو مثال ليس فريدًا في حياة العراقيين الفقراء في الريف والمدن الجنوبية المتهالكة بشكل عام، فأمه هي أم جميع العراقيين الذي رضعوا مثله الإيمان مع الحليب الذي غذى أجسادهم الضعيفة وتجارب طفولتهم الواعية وغير الواعية.
ولا يكاد الدكتور عبد الجبار في مجمل إجابته عليهما ان يفعل سوى إعادة القول بأن إيمانه بالله ودين الإسلام في صورته النقية المجردة كما يتصورها ستظل هي هي، ولا سبيل إلى تغيير نهجه وطريقته فيها.
أي أنه يتحرك بطريقة دائرية يتصل منتهاها بمبتداها من الناحيتين الزمنية والموضوعية، على نحو لا شك فيه، ولا برء منه. وذلك يقع فيما يشبه ما يسميه بول ريكور في كتابه (صراع التأويلات) بالدائرة الهرمونيوطيقية التي تقوم على الإعلان الذي يقول: "لكي نفهم يجب أن نؤمن، ولكي نؤمن يجب أن نفهم"(1) غير أن هذا الفهم لا بدّ أن يكون مختلفًا بحيث نضطر معه إلى القول بأن جانبًا من النقد الذي يوجه لهذا النوع من الخطاب الديني يأتي من خارج الدائرة التي يتحرك فيها صاحبه.
والدكتور فالح مهدي يقول إن الدكتور عبد الجبار يقوم من خلال ممارسته للصلاه والطقوس الدينية بإعادة بناء العقلية الدائرية القائمة على المقايضة (أعطني لأعطيك)، في حين أن إلله لا يحتاج إلى طقوس وعبادات. وهو، كما نعتقد، نوع من التبسيط لتجربة الرجل وإجحاف بحق خطابه التنويري الذي يمثل صوتًا مغايرًا لما اعتدنا عليه في العراق من خطابات دينية وفكرية لها صلة بالدين وفلسفته، بصرف النظر عن ممارسته أو عدم ممارسته للصلاه أو أية طقوس دينية أخرى.
علما بأن الصلاة ليست بالنسبة لرجل مؤمن مثل عبد الجبار الرفاعي طقسا عاديا تتم ممارسته دون وعي أو كنوع من إسقاط فرض وواجب، بل هي لحظات تأمل وإعادة شحن للطاقة الروحية المتجددة فيه خلال لقائه اليومي الخاص مع خالقه، مع ما يرافق ذلك عنده وعند غيره من المؤمنين الحقيقيين من انتشاء وغبطة روحية لا يمكن لأحد أن يصادرها عليه بأسئلة واعتراضات من هذا النوع. والدكتور فالح الذي يقول بأنه سيغرد منفردًا اعتمادًا على منهجه الذي يدرس الظاهرة الدينية في ضوء المكان، (2) يسجل اعتراضه ذا الطبيعة المنهجية والفكرية الصارمة على عديد من المسلمات التي يتأسس عليها خطاب الدكتور الرفاعي الديني، بدءًا من مقولة الظمأ الأنطولوجي والفقر الوجودي الذي يتخذ عنده شكلًا عموديًا يغتني بإنتاج حيّز المكان العمودي، خلافا للفقر الذي ينطوي عليه حيز الدكتور الرفاعي الأفقي! ومصطلح (العمودي والأفقي)، الذي يعيد الدكتور فالح ذكره هنا ذو علاقة بالثنائيات التي مرّ معنا بأنها قد تتحول إلى ضرب من محاولات لاختزال تجارب فكرية وحياتية كاملة وتحويلها إلى معادلة رياضية محددة، بحيث يصبح منهج الدراسة مجالا ثابتا تخضع فيه أعمال الآخرين المدروسة من قبل الدكتور الرفاعي والدكتور فالح نفسه للتصنيف والوضع في خانات ضيقة.
وهو خلاف "التعميم" الذي يرى الدكتور فالح أن الدكتور الرفاعي يخطئ في استخدامه بتوسع غير مفهوم لدى الكلام عن الإنسان على سبيل المثال. فهو استخدام غير دقيق في تقدير الدكتور فالح، من الناحية الاجتماعية، والأنثروبولوجية، والثقافية والنفسية؛ لأن الناس، كما يقول، مشاربُ واتجاهات وليسوا كأسنان المشط. (3)
في حين يبدو إصرار الدكتور الرفاعي على هذا التعميم الذي "لو بطل تبطل العلوم" كما يقول، ناتجا عن التباس وسوء فهم للمقصود بالتعميم.
فالكلمة أو المصطلح واحد، ولكن المفهوم مختلف في طبيعة الاستخدام عند الطرفين فيما يبدو. فهذا التعميم الذي يمكن أن ينقل الوقائع التاريخية والعلمية من الجزئي إلى الكلي، ومن وحدة الوقائع إلى وحدة القوانين وشمولها بالفعل، كما يوضح الدكتور الرفاعي، يمكن أن يكون في نفس الوقت عائقًا أبستمولوجيا حينما يكون استخدامه استجابة لمتعة عقلية خالصة، يصبح فيها القياس متسرعا وسهلا يعوق الوصول إلى حقيقة الظواهر المدروسة، كما أوضح ذلك غاستون باشلار بالقول إن "هناك في الواقع متعة عقلية خطرة في تعميم متسرع وسهل. وعلى التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية أن يمتحن كلّ إغراءات السهولة. فبهذا الشرط سنصل إلى نظرية التجريد العلمي السليم والديناميكي حقا"(4)
وما يقال، مثلا، على مستوى هذا القياس المعمم لدى الفقهاء فيما يتعلق بتحليل شرب النبيذ أو تحريمه (ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام)، يمكن يمدّ به القياس بهذه الطريقة الكمية ليكون فيها العسل محرمًا مع أنه شفاء للناس، لأن الكثير منه يمكن أن يكون مضرًا أو قاتلًا، هو الآخر. ولذلك فهو قياس فاسد يمكن أن يقود إليه القول نفسه بهذا التعميم.
وهذا اللبس يطال، بدرجة ما، أيضا حوارَ الطرفين حول "الأنا الخاصة" والاختلاف بين الذات والهوية، باعتبار أن الذات كما يقول فالح مهدي بطبيعتها شخصية، وما دامت كما يصفها إناءً يستقر فيها الوعي، أو الشعور والاستجابات لخبرات وتجارب تنطوي على ألمٍ وسرور وتبدأ حينما يدرك المرء نفسه بنفسه، فإنها لا بدّ أن تتداخل، والحال هذه مع الهوية، فالوعي ليس مجردًا أو فارغًا، ولا بدّ أن يكون وعيًا بشيء، أيّ بثقافة وتجربة هي التي تتشكل منها الهوية وتسهم في تشكيل الذات في الوقت نفسه. وهو ما يحيل إلى نوع من الاشتراك والتداخل بين المفهومين، وليس إلى وحدتهما وفقًا لحديث الدكتور فالح عنهما، على الرغم من أن لفظ الذات لدى بعض الفلاسفة ورجال الدين كالقديس أوغسطين لا يتضمن سوى معنى الوجود. والدكتور فتحي المسكيني الذي يعارض الذات بالهوية في كتابه (الهوية والحرية)، حيث الهوية عنده هي نحن دون أي جهد وجودي خاص، في حين أن الذات هي ما نستطيع أن نكون دون أن نجرؤ بعد على الاطلاع به. وهو يُرجع فكرة اختراع الهوية إلى الحداثة التي اخترعتْ كذلك مقولات السيادة والوطن والعلَم. ولأن حداثتنا مستعارة ومشوهة ومهترئة، كما يقول، باتت الهوية معضلة وإشكالية. (5)
أما الجدل حول (معنى المعنى)، الذي يظل بلا معنى عند الدكتور فالح مهدي، وعلى نحو ما عند الدكتور ناظم عودة، فلا يزيد ردُّ الدكتور الرفاعي عليهما فيه هذا المعنى وضوحًا. فالاستشهاد بنصوص فيها تعريفات بلاغية لعبد القاهر الجرجاني الذي استخدم معنى المعنى في بحوثه البلاغية أول مرة في القرن الخامس الهجري، أو الاكتفاء بالقول بـ (فائض المعنى) كبديل عنه أو مرادف له، وحتى الإحالة إلى مفكرين وفلاسفة وأهل عرفان ومتصوفة عالجوا هذا المعنى، ومعنى المعنى بطرائقهم الخاصة، أقول إن كل ذلك لم يرفع الغموض عن المصطلح المتعلق أساسًا بقضية التوصيل في اللغة، وليس بالتعريفات البلاغية التي لجأ إليها الدكتور الرفاعي. فالمنعرج اللغوي الذي تتألف منه بنية عقولنا الحالية، هو المشكلة الأساسية التي دار حولها الكلام عن المعنى، ومعنى المعنى. وهي ليست مشكلةً بلاغية أونحويةً، أو قضية تتعلق بفائض المعنى. ونحن نعرف كيف حاول أوغدن وريشاردز منذ بداية القرن الماضي في كتابهما المعروف (The meaning of meaning) الذي صدر عام 1923 إلقاءَ الضوء على مشكلة التوصيل هذه. وهما يريان بأن المشكلة الرئيسية في التواصل البشري هي ميلُ المتحدث إلى التعامل مع الكلمات كما لو كانت أشياء في الواقع. فنحن نميل إلى الخلط بين "الرمز" أو "الكلمة"من ناحية، وبين الشيء في الواقع، من ناحية ثانية.
وقد أدى تفسيرهما لخرافة المعنى الصحيح، أو معنى المعنى إلى دحض فكرة أن الكلمات تمتلك معنى واحدًا. وبدلاً من ذلك، يتمّ تحديد معنى الكلمات النسبي، كما يقولان، من خلال التجارب السابقة والحالية للمتحدثين الذين يواجهون هذه الكلمات في سياقات أدبية محددة. وبما أن المتحدثين يفسرون الكلمات بخلفية من التجارب الفريدة الخاصة بكل واحد منهم، فإن كل متحدث ملزم بتفسير نفس الكلمة بطريقة مختلفة أيضا. ولذلك فإن سوء الفهم في هذا المعنى ينجم عن وجود مراجع مختلفة لنفس الرمز أو الكلمة. وكوندياك يقول لنا في تعليقه على المثالية الديكارتية مايلي: "هناك لغتان ينبغي أن نميّز بينهما بعناية: الأولى تنطبق على الأشياء، وهذه لغة الفكر الاسمي، والثانية لا تنطبق إلا على الكيفية التي بها نتصور تلك الأشياء، وهي اللغة التي يجب أن نستخدمها". (6)
وهو ما أدى إلى بقاء معنى المعنى، وليس المعنى وحده الشغلَ الشاغل لكثير من الباحثين والمفكرين كالأمريكي نعوم چومسكي الذي تبنى منذ صدور كتابه البنى النحوية عام 1957 منهجًا لغويًا افتراضيا استتدلاليا معقدا استبعد فيه أية اعتبارات ذات علاقة بالمعنى والتركيز، بدلا من ذلك، على الشكل، وجعل اللغة مادةَ بحثٍ مستقلة عن السياق وعن مستخدمها. (7)
والفرنسي جاك دريدا الذي ظهر هو الآخر في النصف الثاني من القرن الماضي ليقوم بتفكيك هذا المعنى ووضع علاقة الكلمات بالأشياء في إطار جديد لا مجال للحديث عنه هنا بالتفصيل. غير أنه يتجاوز في حصيلته النهائية المقصود بالاستخدامات البلاغية التقليدية الخاصة بالاستعارة والكناية والمعنى أو معنى المعنى المتصل بهما في الكلمة المفردة أو الجملة الكاملة كما هو موضح في كتاب عبد القاهر الجرجاني (دلائل الإعجاز)، لأنه يتصل بفلسفة اللغة وعلاقتها بمدى وثوقية معرفتنا بالوجود عموما، وما إذا كانت هذه اللغة قادرة بالفعل على نقل صورة الأشياء في هذا الكون كما هي، وليس كما تبدو لنا في مرايا الكلمات الزلقة وغير الثابتة في دلالاتها، وما تتأدى به الحال من إرجاء وتأجيل دائمين لمعنى المدلول الذي يشير إليه الدال اللغوي...إلخ.
وإذا عدنا إلى الجدل ذي الطبيعة اللاهوتية العقدية الخاصة بعلاقة اللفظ بالمعنى الذي كان يجري في القرون الوسطى الأوربية على سبيل المثال، ومدى مطابقة اللفظ للمعنى فيما يتصل بكلمة الله، مثلا، ]وهو جدل له انعكاسات أو صور مشابهة في تراثنا الكلامي الخاص بالمعتزلة في مسألة الصفات]، نجدهم يقولون أنْ "لا لفظ أو لا شيء يقال على الله كما ينبغي لله"، إذ يصبح اللفظ ملائما لله بعد تحويل معناه أو اكتشاف معنى معناه؛ مثال ذلك لفظ "الغضب"، فما هو في الله سوى القدرة على العقاب دون الاضطراب الحاصل فينا، ومثل "الغيرة"، فما هي سوى العدالة مجردة.. وهكذا لا تصبح الألفاظ صالحةً للدلالة على الله إلا بشرط أن نستبعد من مدلولها ما يلازمه من نقص في المخلوقات، وحينئذ يتاح لنا التأمل في الله دون محاولة التعبير عنه، بحيث يتلخص موقفنا في هذه العبارة الجامعة: "إن تصورنا لله أكثر حقيّة من تسميتنا له، وأن وجود الله أكثرُ حقيّة من تصورنا له"؛ وهذا هو الموقف الحق من التجسيم والتشبيه من جهة، وبين التنزيه المطلق على طريقة أفلوطين. (8)
أما ما يذكره الدكتور فالح من أن الالتزام الديني يتعارض مع الحرية، فإنه يبدو صحيحًا من الناحية النظرية المجردة، أيضا. إذ ليس هناك حرية مطلقة لا يحددها أو يعقلها التزام من نوع ما من الناحية العملية، وإلا تحولت إلى فوضى أو إلى عبء على صاحبها بالمفهوم السارتري. وما دام التزام الدكتور عبد الجبار التزامًا ذاتيًا واعيًا بنفسه، وليس مفروضًا عليه من أحد، وأن فيه من المساحات المنفتحة على الذات وعلى الآخر ما يتيح له شيئا من الحركة الحرة، فهو بعيد إذن عن التناقض، أو التعارض مع هذه الحرية بالطريقة التي نراها لدى متدينين آخرين أغلقوا الأبواب والنوافذ على قلوبهم وعقولهم وأرواحهم، ولم يستطيعوا الحركة إلا بإيحاء يأتي من زعمائهم الروحيين، أو من معتقداتهم وطقوسهم الدينية الضيقة نفسها. وعمانوئيل كانت نفسه كان يفرق بين دين العبيد الذين لا يعرفون الدين إلا من خلال الطقوس، ودين الأحرار الذين يؤمنون بمقدرات نفوسهم عن طريق الإرادة الخيرة التي تخلص العباد من كل تصورات خرافية. وكانت هو الذي نبهنا منذ القرن الثامن عشر كيف نجمع بين حاجة البشر إلى تقديس شيء ما، وبين إحساسهم الأصلي بالحرية. وفي عبارات تذكّرنا بما قاله ابن رشد في مستهلّ فصل المقال من ضرورة التوفيق بين الحكمة والشريعة، ينبّهنا فيلسوفُ ألمانيا الكبير أيضا إلى أنّ "بحثا في الكتاب المقدّس عن ذلك المعنى الذي يكون في تناغم مع أقدس ما يعلّمه العقل، هو ليس فقط مباحاً، بل هو بالحري ينبغي أن يُعتبر بمثابة واجب". (9) ومعروف لنا أيضًا موقف هيجل من الحرية التي تتحدى الرغبات المفروضة من قبل المنطق، وكيف أن الدين يحتل عنده مرحلة وسطى بين الحس والفكر الخالص. وبقدر ما سيحتفظ ببعد حسي يحيله على الفن، بقدر ما سيتعلق ببعد روحي مطلق، يصله بصلب الانشغالات الفلسفية. ففي الدين، يتمكن الفرد من العبور عبر وجوده الطبيعي، نحو وعي خالص يمكّن الذات من تحقيق وعيها بماهيتها وبالماهية الإلهية في الوقت نفسه. (10)
—————
1 - نفسه، 447
2 - نفسه 275
3 - نفسه 276
4 - أنظر، محمد وقيدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، دار الطليعة، بيروت، 1980 ص114 )
5 - أنظر الفصل الأول من كتاب فتحي المسكيني، الهوية والحرية - نحو أنوار جديدة، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، 2011
6 - محمد هشام، مرجع سابق، وانظر مصدره، Condillac, Traité des systèms
7 - The meaning of meaning, C. K. Ogden, I. A. Richards, 1989 Harcourt,Brace&World,Inc. New york) .
وأنظر، تيرينس موور وكريستين كارلينغ، فهم اللغة، نحو علم لغة لما بعد مرحلة چومسكي، ترجمة د حامد حسين الحجاج، بغداد 1998، ص 22 – 23، وكذلك كتاب طه عبد الرحمن، المنطق والنحو الصوري، دار الطليعة بيروت، 1983
8 - يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، دار المعارف بمصر، 1957، ص 27
9 - عمانويل كانت، الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2012 ، ص 163
10 - أنظر الفصل الأول من كتاب فتحي المسكيني، الهوية والحرية - نحو أنوار جديدة، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، 2011