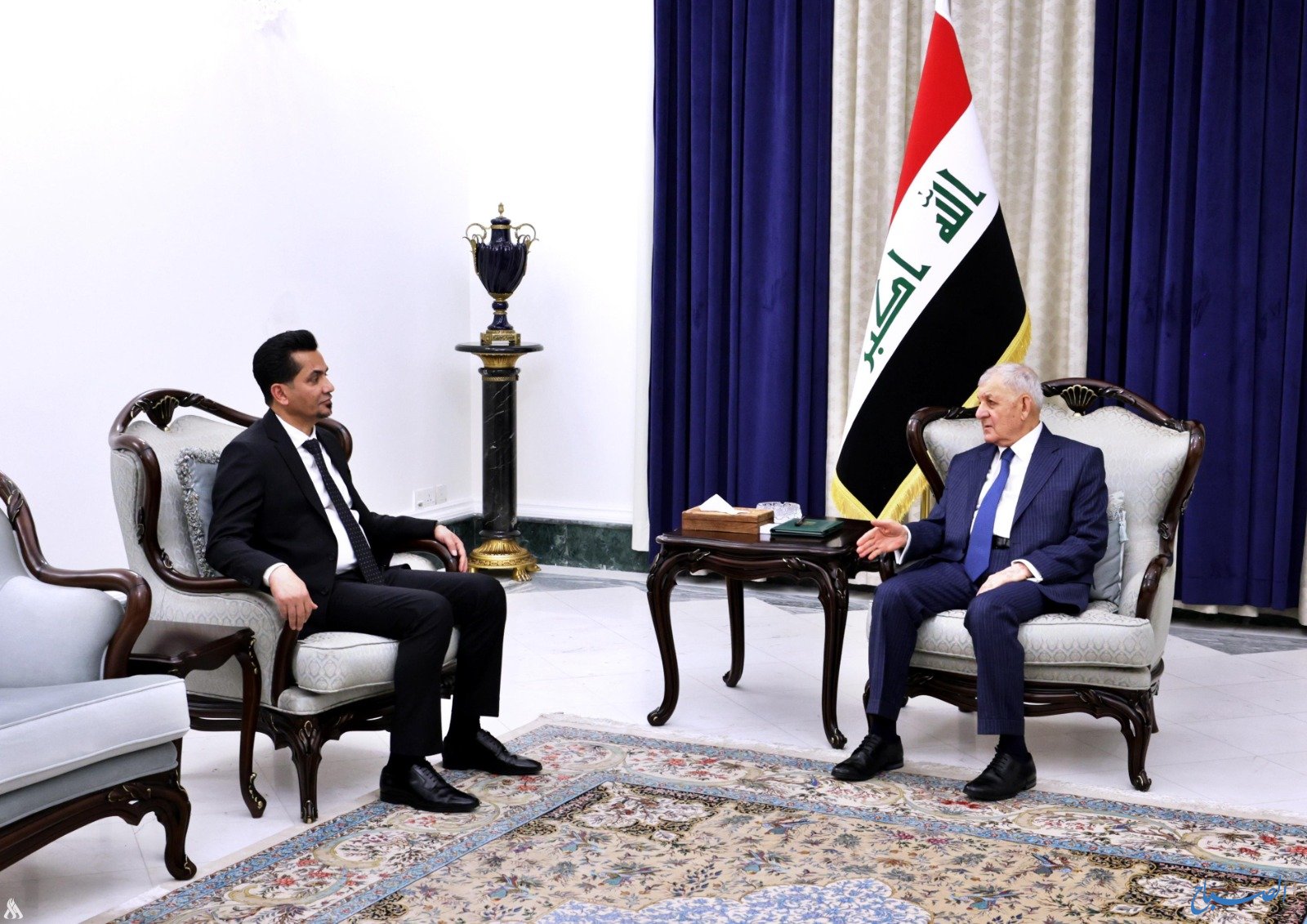باسم فرات: قصائدي عن المكان أقربُ إليّ من قصائد الحبّ
ثقافة
2019/06/01

+A
-A
حاوره في البصرة: حسن جوان
شاعرٌ ورحّالة، يرى في الأمكنة قصائد وأرحاماً تعيد ولادته، وتمنحه دهشة القصيدة وكشوفها البكر. اعتاد بعدسته أن يروي ببراعة لا تقلّ عن سرد انطباعاته اليومية على موقعه الإلكتروني لكل مدينة أو هامش مُغيّب عن خرائط العالم، مكوّناً ركاماً من الخبرات وحفراً في عادات الشعوب النائية في أصقاع الأرض، فضلاً عن توصيف للطبيعة والطبائع والتاريخ على مدار رحلاته التي لا تستقر على حال من القلق الباحث والمكتشف. أصدر ما يزيد عن واحد وعشرين كتاباً في الشعر والسيرة وأدب الرحلات، وحظيت تجربته الفريدة الممزوجة بالشعر والتاريخ وجغرافيا المجتمعات باهتمام عشرات النقاد من أمثال الناقد حاتم الصكر وفاضل ثامر و د. حسن ناظم، الشاعر سركون بولص والناقد مارك بيري، الشاعر البريطاني ستيفن ووتس، الشاعر أليستر باتيرسون رئيس تحرير مجلة شعر النيوزيلندية، الشاعر الأمريكي لويس سكوت، الشاعر والناقد النيوزيلندي طوني بَيَر،هاميش وييات (كاهن وأستاذ دراما من نيوزيلندا)، تيري لوك (شاعر وأستاذ- نيوزيلندا)، تريفور ريفنز (شاعر ومحرر نيوزيلندي)، عيسى بلاطة، الشاعرة النيوزيلندية روبن فراي، الشاعرة والناقدة الدكتورة أَنا جاكسون. التقيناه عبر هذا الحوار الذي خصّ به “الصباح”:
*ابتدأت كتابة الشعر في سنّ مبكرة ووسمت قصيدتك خصائصُ ومؤثرات تحمل طابعاً ثمانينياً رغم بروزك ضمن الجيل التسعيني، أين تنتمي قصيدتك فنياً؟
-بداياتي كانت واضحة من حيث التأثر بالقصيدة الثمانينية في بعض خصائصها، لكنني لا أستطيع أن أنسب نفسي إلى جيل رغم اختلاطي المبكر بالوسط الأدبي ومحاولاتي المبكرة مع القصيدة، حيث قرأت التراث وكتبت أشكال القصيدة العربية عبر تنوعاتها الموزونة في عمود شعري أو قصيدة تفعيلة، ثم بدأت عندي محاولات في كتابة قصيدة النثر وبدأت بالنشر في النصف الثاني من عقد الثمانينيات آنذاك..
*لماذا ملت اخيراً بعد تجريبك الأشكال الشعرية القديمة والحديثة إلى قصيدة النثر، هل وجدتها أقرب إلى نفسك وأكثر مواكبة في فضائها التعبيري؟
-نعم لقد وجدت نفسي قريبًا أكثر، أو لنقل أن قصيدة النثر تمثلني وتُعَبّر عني أكثر، على أنني لا مشكلة لدي مع بقية أشكال القصيدة، وأرى أن الإبداع موجود في كل تلك الأشكال، على الرغم من أن هناك بعض الاعتراضات على إطلاق تسمية “قصيدة نثر” على الأشكال التي تُكتب لدينا، على سبيل المثال الشاعر الراحل سركون بولص كان معترضاً ويسمي ما نكتبه “الشعر الحر”..
*نعم هنالك إشكال عام حول ما يطلق عليه قصيدة نثر عراقياً وحتى عربياً إلّا مع بعض الاستثناءات، فهي شكل مختلف عن قصيدة النثر الأميركية أو الأوربية، هل يمكن أن تنتصر الاعتراضات تلك أمام أيّة مقارنة؟
-حتى وإن كانت هذه المقارنة تمثل إشكاليّة من حيث تكوينها أو صيرورتها في مجتمعات أخرى، لكن الاطلاع على التراث العربي سيزوّد النقاش بمناهل أخرى محلية، هذه المعرفة قد تفسر رغبتنا في تحريك الشكل القديم والثورة عليه، فلا يمكنك في النهاية أن تثور على شيء أنت تجهله، فهذه حماقة. أعتقد أنني كنت محظوظًاً في محطات كثيرة من حياتي ذلك لأنني قرأت التراث بشكل جيد على مختلف حقبه المتقدمة والمتاخرة...
*هل تدين لأحد هؤلاء الذين صادفتهم في قراءتك التراث بتكوين وعيك الأدبي؟
-أنا مدين لهم بذلك، في مساحات الفكر والتاريخ والفلسفة،”أبو نؤاس” و”أبو تمام” و”المتنبي” و”المعرّي”. كنت أقرأ لهم منطلقاً من هوسي برصد العوامل المحيطة بالشعراء والمفكرين التي أدت إلى تكوينهم، أسال نفسي عن أسرارهم. كنت أخشى أن يمضي الزمن بي دون أن أحقق شيئاً ولو بسيطًاً جدًّا، مثل هؤلاء العظماء، وجدت أنّ أبا نواس والمتنبي والمعري وأبا تمام يملكون ثقافة موسوعية، فأيقنت أن قارئ الإبداع الأدبي لا يمكن أن يكون مثقفًا، إذا لم يقرأ الفلسفة والفكر، والفنون التشكيلية والبصرية والنظريات العلمية كذلك، لأنها جزء من ثقافة شاملة واحدة في أيامنا هذه. تأثرت ايضاً بشكل خاص بالسياب شاعراً ومثقفاً ومنه بدأ تأثري بقصيدة التفعيلة التي ما لبث أن راودني هاجس ملحّ بالبحث عن شكل أخير للكتابة أنتمي إليه
كليّاً...
*كيف انتقلت في ما بعد من خلفية شعرية وتجريب متواصل لقرابة العقدين من حياتك الى أدب الرّحلات الذي فزت بجائزة فيه عن إحدى مشاركاتك، هل تعدّ نفسك ناثرًا ورحالة أم شاعر رحلات ؟
-أتذكر في هذا المقام الشاعر “طرفة بن العبد” وتمرده، حيث كان أكثر من تأثرت بمعلقته وأنا فتى غضاً، كما أذهلتني تجربة الصعاليك وأميرهم عروة بن الورد، وكذلك المتنبي الذي كان قلقاً وقد عبر عن ذلك القلق بأروع ما يمكن. هذا الحلم حفر عميقًا في روحي، وهذه الأمثلة من التمرد والقلق وحب الكشف، قادتني إلى هوسِ باكتشاف المجتمعات النائية والغريبة، التي قرأنا عن بعضها في أدب مبدعيها، ولأني أغمس قلبي في التفرد، لم أعشق مدن الضوء التي هي محط هوى وأحلام الجموع، وأنا لا أنتمي للجموع، أنتمي لذاتي، فكان حلمي الذي حققت شيئًا منه وهو أن أسافر إلى بلدان كثيرة، وأن تكون ليست من بلدان المركز بل الأطراف والهوامش، وأعيش حيوات كثيرة..
*إذاً، نحن إزاء شطرين من باسم فرات، شطره الذي يحاول أن يعالج قلقه لغويّاً وشطره الآخر الذي يحاول أن يطلق حلمه مكانيّاً، هل هذان صراعان يفضيان الى تصالح بين مكوّنَي اللغة والمكان؟
-ذكرت في نقاش مع ناقد صديق أنني أتصالح مع ذاتي في المكان ببساطة ومدة وجيزة، وأودّ أن أخبرك أنني لا أقرأ عادة، أي شيء عن أي مكان أنوي الانتقال اليه مسبقاً، لان القراءة قد تفسد دهشتي الأولى وكشوفي الخاصة ولذلك غالباً ما أفعل العكس، بمعنى انني اذهب الى المكان واختبر نفسي فيه ثم اقرأ عنه بعد ذلك. عشت طفولة بحرمان مبكر من الأبوين، ربما كل مكان يعيد اليّ دهشة الطفولة المحرومة تلك وتعويضاً بطريقة ما. هذا الحرمان في مقابل التصالح مع المكان، ثم القلق المعرفي الذي ينضمّ إلى هذه الثنائية تجعلني أردد قول الشاعر الفرنسي أرثر رامبو حين قال “ لا تبلى ثيابي في مكان واحد” كانت لدي خشية كبيرة وأنا طفل أن أقضي حياتي في مكان واحد، أن أعيش حياة تقليدية تتمثل بعمل وتكوين أسرة وتكديس أطفال ومن ثم أموال، وأعيش دوامة الحياة التي يعيشها الناس جميعاً، إلّا أقلية تَكاد تشكل خروجاً (صعلكة) على أعراف المجتمع
(القبيلة)..
*مازلت أسال عن المشترك النفسي بين قلق الشعر وقلق المكان لديك؟
-المكان يمنحني قصيدة جديدة دائمًا، حتى إنني أجد قصائدي في المكان أقرب لي من قصائد الحب، كلّ مكان جديد يحوّل قلقي من الثبوت إلى قصيدة متحركة، مكتشفة،وتعويضاً عميقاً عن فقدانات كثيرة، تصالحي مع المكان يمنحني فرصة لرؤية جمال لا يراه كثير من الناس، وأقول هذا عن تجربة.
*ما هي الأماكن التي منحتك سلاماً داخليّاً أكثر من غيرها أو انفعالاً مُنتجاً؟
-هيروشيما.. ربّما لأنها أول مدينة في العالم اخترتها بارادتي، بعد ضيق خياراتنا كمهاجرين مُكدّسين في عمّان، هيروشيما أرض منبسطة يحيطها بحر من جانب وجبال من جانبها الآخر وتزينها ستة أنهر، هذه المدينة منحتني أملًا هائلاً وتفاؤلاً، عندما ترى صور الدمار الذي خلفته القنبلة النووية يمكنك المقارنة بصورتها الآن وقد تحوّلت الى مدينة خضراء وعاصمة للسلام العالمي. كذلك أحدثت تطوراً كبيراً في تجربتي
الشعرية.
*بوصفك متصالحاً مع كل هذه العواصم العالمية، هل يخطر لك أن تقارن بين هذه المدن وبين مدن وطنك الأول، لنقل بطريقة أخرى.. هل لقلبك الجوّاب من مركز يؤوب اليه حنينك؟
-بلا شك أن العراق هو حنيني الدائم، هناك من يستخدم مصطلحات مثل الانسان الكوني والعالمي وكل هذه فيها مبالغات ومجازات لا أكثر، هناك أمثلة كثيرة على ان الشعور العميق للعراقيين هو واحد، وحدث مثل فوز فريق كرة القدم ببطولة آسيا، أو فاجعة مؤلمة مثل فاجعة الكرادة وَحَّدَتْ مشاعر العراقيين جميعًا، وقد لاحظت ذلك بقوة وأنا في
نيوزيلاندا.
لذا أعتقد ان فكرة الانسان بلا وطن هي كذبة، مهما كانت مساحته من الانتماء المنفتح عالمياً، هناك دائمًا وطن وهناك انتماء انساني بإزاء ذلك يتساوى في إدانة الشر، وفي دعمه للخير في أي بقعة من العالم.
*كلمة في ما يخص الشعر والمكان في شخص باسم فرات فأنت تتفرد بخاصة قراءة شعرية المكان ؟
-ما لا تستطيع أن تقوله في حديثك اليومي هو شعر، لا قيمة لأي موضوع فلسفي أو فكري أو إنساني إلا بطريقة معالجته بمعنى في الكيفية. ليست كل كتابة في المكان أو توصيف سردي له ينتج أدباً، كل المنتجات الفنية والشعرية والبصرية هي كيفيات مصاغة فنيًّا عبر معالجات معينة، نجح مبدعها فمنحنا عملاً فنيّاً، من هنا تراني أتعامل مع المكان شعريّاً.
*كيف وجدت مدن العراق بعد غياب سنوات طويلة، ما الذي لاحظته مراصدك الشخصية كرحالة يعود الى ذات المكان الذي فارقه؟
- فارقت العراق 18 عاماً و 25 يوما بالتمام، ويمكنني التحدث عن بغداد، والبصرة وعن مدينتي كربلاء، حينما عدت لأول مرة في العام 2011 كان المشهد مرعباً وكئيباً، لكنه بدأ بالانفتاح رويداً رويداً مع زيارتي لأماكن حميمة مثل الكرادة ببغداد، شعرت حينها أن بغداد هي امرأة جميلة لكنها مثقلة بحزن طويل.
وعندما زرت البصرة كان المشهد متشابهاً فضلًا عن ألم دفين يسكنها آنذاك، لكنني عندما أقارن بغداد والبصرة عام 2011 ببغداد والبصرة الآن (2019) فإن المشهد يختلف تماماً، هناك حياة كبيرة الآن وهذا أمل كبير، وقد افرحني كثيراً مشهد الشباب المتحمس في مهرجان النخيلة (في كربلاء) الذي حضرته وهم يرتلون حُبّ العراق عبر العمل التطوعي، وازدياد الوعي بالبيئة والفنون، والرغبة في العمل الجماعي، هذا الشعور بعث فيّ أملًا كبيرًا وتفاؤلًا في مستقبل
أفضل.