يوم كان الإنسان قادراً على التواصل
آراء
2020/05/22
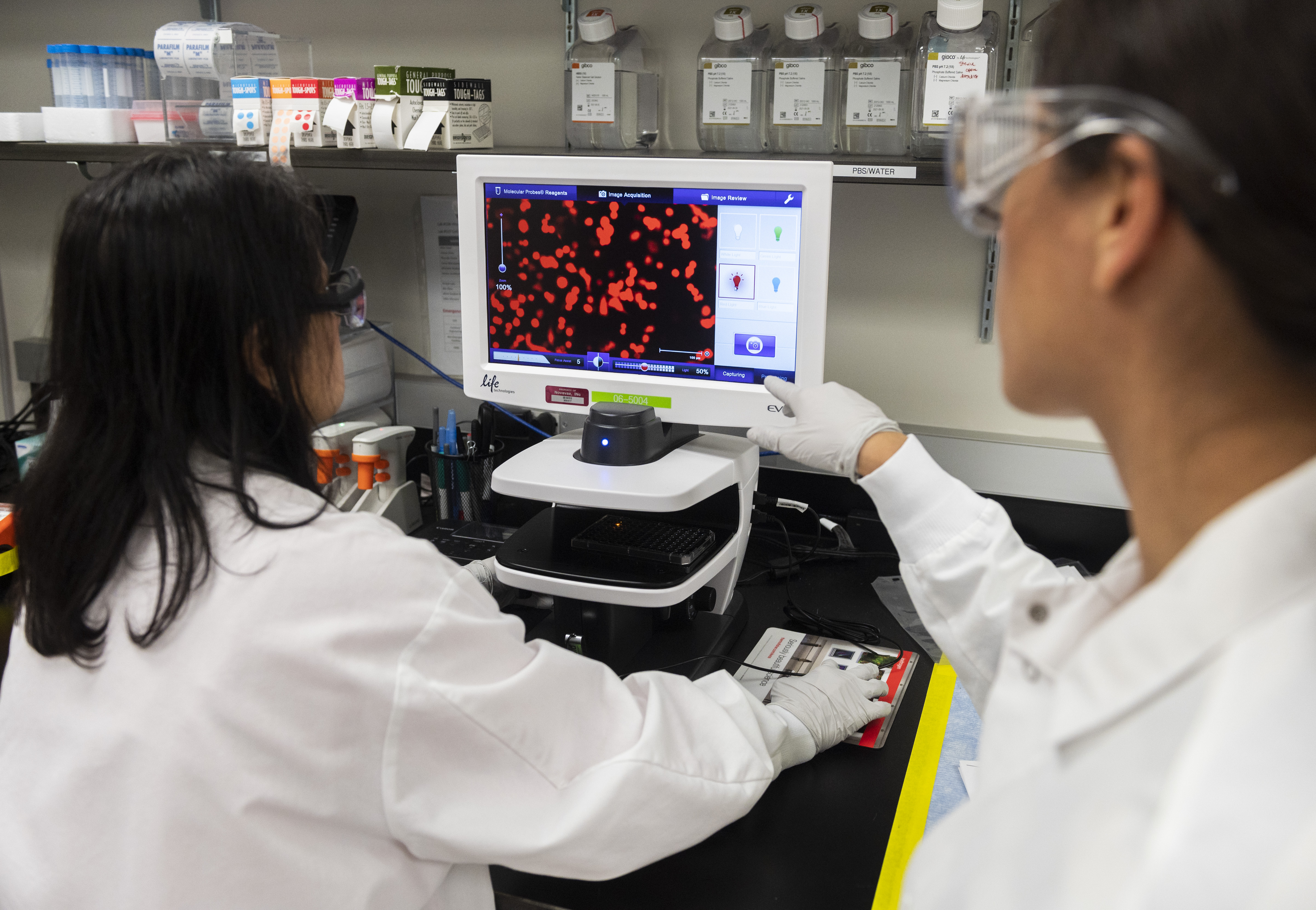
+A
-A
محمد طاهر العصفور*
يوم كان الإنسان قادرًا على التواصل كان الزمن، لذا كانت اللغة هي الوجود والزمن؛ لأنَّ فاعلية اللغة هي الأقدر على أداء التواصل، ومن هنا كانت اللغة التي هي مجلى الحقيقة، فلا وجود خارج اللغة، فكل الأبعاد التي تراها بعيدة ومتناثرة تضم أطرافها اللغة وفق علاقة الدال والمدلول، ولأن العربية من أقدم اللغات الحية فإنه من المفيد أن نفهم ما هي اللغة وما العربية أيضًا.
ويمكننا القول إنَّ القرآن الكريم في لغته التامة التي نزل بها جعل اللسان العربي لسانًا واحدًا غير الذي تحدث عنه أبو عمرو ابن العلاء، إذ قال: "ما لسان حُمير وأقاصي اليمن بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا"، ونحن إذا تأملنا الحال رأينا أن مصدر العربية واحد ما لبث أن تشظّى، ثم إذا ما نزل القرآن الكريم أعاد ذلك البناء، فكانت العربية لغة القرآن، والقرآن لغة العرب، وإن الذي نقل العربية من التشظي إلى الجمع، وجعلها من أقدم اللغات الحية هو القرآن الكريم، ذلك أن اللغة -أيّ لغة- تحمل في ذاتها خصائص التصدي بحكم التغير.
ونحن إذا أردنا العودة إلى قول الرسول (ص) في "إنما العربية اللسان"، فإنَّ البحث في أصول أولئك الأقوام هو بحث لساني لا عرقي، وإنَّ الذي يحفظ تراث هذه الأمة هو لسانها، وإنَّ التاريخ الذي سجل تراث العرب هو اللسان، فن قول الشعر، فالشعر ديوان العرب وسجل أيامها.
ومفاد القول إنَّ القيم الاجتماعية التي كان يتحلى بها العربي لا تعود إلى عرق، وإنما إلى خصائص مجتمع اتسم بها بحكم ظروف ما، غير أن ما يجمع تلك التجمعات البشرية هو اللسان لا شيء آخر، لكن هذا اللسان تعرض إلى تشظٍّ كما ذكرنا، وكان سيؤول إلى لغات مختلفة، وإنما الذي أعاد الحياة إلى العربية هو القرآن الكريم، القرآن الكريم كان نصًا صادمًا مذهلًا جعل العرب يتساءلون حيارى عن القيم الجمالية التي اتسم بها، إنه زلزال ثقافي ومعرفي وليس بلاغًا فحسب، فكانت رسالة القرآن الكريم هي النص الذي جعل العرب ينظرون إلى الفصاحة على نحو آخر من التأمل، حتى إن رجلًا ممن يُعتدّ بذوقه في الفصاحة والبيان، وهو الوليد بن المغيرة.
قد قارب الأمر ليس كما قاربه غيره من رجال العرب، ولم يُسمِّ قول الله تعالى بالشعر، بل قال: "والله لقد سمعتُ من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الأنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوةً، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمُغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه". ثم انصرف إلى منزله، فقالت قريش صبأ والله الوليد، وهو ريحانة قريش، والله لتصبأنَّ قريش كلهم، فقال أبو جهل: "أنا أكفيكموه".
فانطلق فقعد إلى جنب عمه الوليد حزيناً، فقال له الوليد: "مالي أراك حزيناً يا ابن أخي؟" فقال: "وما يمنعني أن أحزن؟ وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك، ويزعمون أنك زيّنت كلام محمد، وإنك تدخل على ابن أبي كبشة وابن قحافة لتنال من فضل طعامهم"، فغضب الوليد، وقال:"ألم تعلم قريش أني من أكثرها مالاً وولداً؟ وهل شبع محمد وأصحابه ليكون لهم فضل؟"، ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه، فقال لهم: "تزعمون أن محمداً مجنون، فهل رأيتموه يحنق قط؟"، قالوا: "اللهم لا"، قال: "تزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه تكهن قط؟"، قالوا: "اللهم لا"، قال: "تزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟"، قالوا: لا، فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه، ثم نظر وعبس، فقال: "ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، فهو ساحر"، ويبدو أنه زعم أن النبي ساحر لما لحقه من قريش، وأخْذهم عليه أنه زيَّن دين النبي محمد (ص). واذا كان القرآن الكريم هو النص الذي بعث روح العربية من جديد فإن محاولة المسلمين فهم ذلك النص بعد أن غاب عنهم الرسول (ص) والخوف عليه من اللحن قد جعلهم يبحثون عن سبل مختلفة لفهمه، ومنها أنهم لجؤوا إلى كلام العرب، غير أن كلام العرب لم يبق منه إلا الشعر -والذي شكك العلماء في نسبته للجاهليين أو بعض العلماء، ومن أبرز المحدثين الذين قالوا بذلك طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي-، وكان هذا الشعر الذي جمع في محاولة لفهم القرآن الكريم من خلاله أدى من طرف آخر إلى تصنيف كتاب في الثقافة العربية الإسلامية وهو (طبقات الشعراء) لمحمد بن سلام الجمحي. ونحن إذا شئنا الدقة رأينا أن القرآن الكريم لم يخلق اللسان العربي من جديد فحسب بل زرع بذور الثقافة وأسس لها، من خلال تلك الأعمال التي تناولت القرآن الكريم، وتلك العلوم التي نشأت صيانة للقرآن العزيز، مثل علم النحو، فالشعر الذي جمع كان الهدف من ورائه محاولة استنباط القواعد الكلية لعلم اللسان العربي وفهم القرآن الكريم كما قلنا، فنشأ علم النحو، ونشأت علوم البلاغة، ونشأ علم
التفسير.
فجاءت تلك العلوم تأسيسًا للصرح الذي قام عليه صرح الثقافة العربية الإسلامية، وكان أن أفرز ذلك العمل المحموم علم الكلام الإسلامي، الذي كان من بواكير قضاياه قضية خلق القرآن. ولقد حفل الدرس العربي بالدراسات البلاغية، حتى أبدع عبد القاهر الجرجاني أثناء معالجته قضية إعجاز القرآن الكريم، فصنف كتابه (دلائل الإعجاز)، شارحًا فيه نظريته في اللغة، ومن خلال تلك النظرية توصل إلى أنَّ القرآن الكريم كان معجزًا في نظمه، ومن خلال تلك الأفكار كان عبد القاهر من العلماء الذين كانوا علامةً فارقة في الفكر اللغوي
والبلاغي.
وإذا أردنا العودة إلى نقطة الانطلاق الأولى في هذا المقال فهو الأس الذي يقوم عليه مفهوم العروبة وهو اللسان، والذي هو السمة الأساس الذي يشد عصب العروبة والإسلام، حيث ليس للعرب عرقٌ يوحدهم ولا تراث معرفي يجمعهم، إلا فن القول، وهي معلقات مفضليات وغيرها من عيون الشعر، وأما النثر فهو قليل، وقد ضاع أغلبه، وربما الخطباء أقل بكثير من الشعراء، فالتراث الذي كان يفاخر به العرب هو الشعر وأعز ما يملكون، وإنهم كانوا يملكون أيضًا ما عُرف بأيام العرب وهي الحروب.
• كاتب من لبنان





