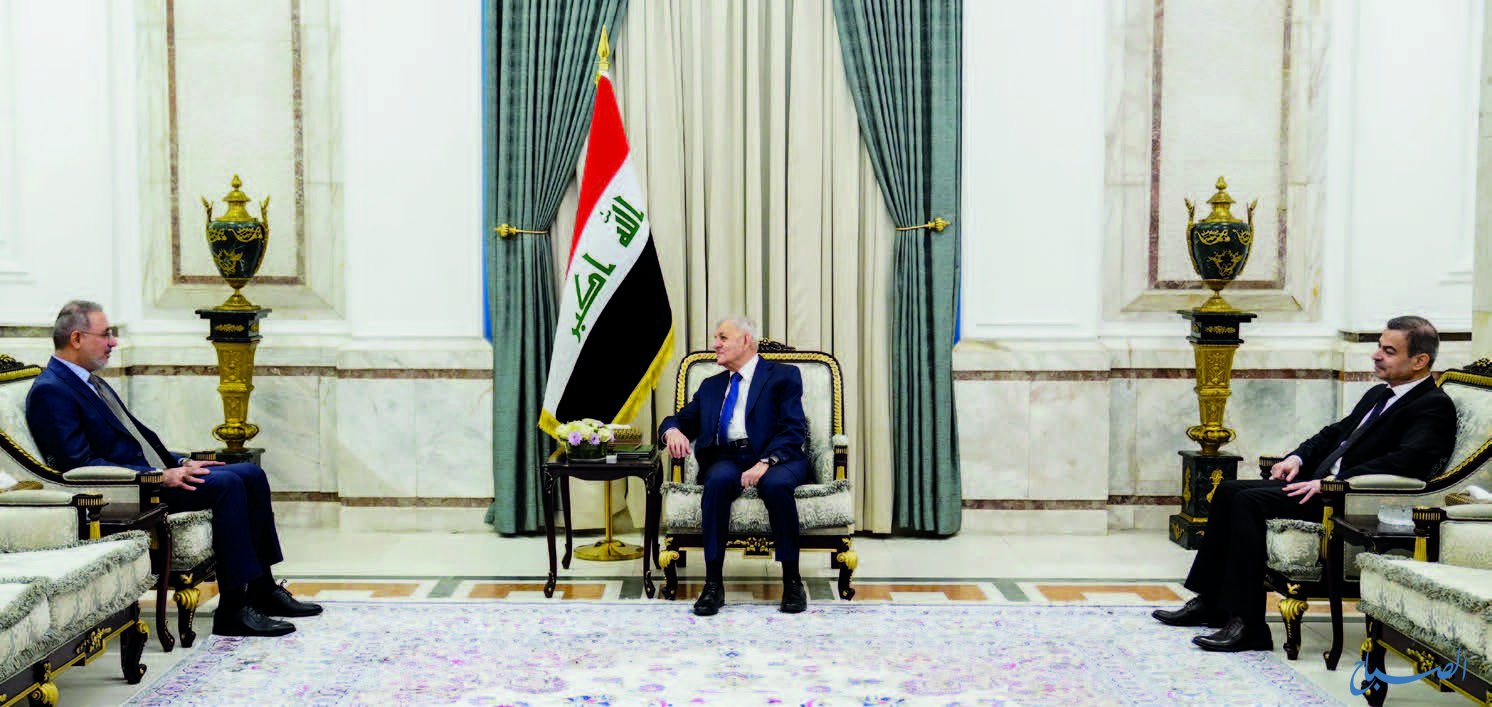هل تعجِّل حرب أوكرانيا بانسحاب أميركا من الشرق الأوسط؟
قضايا عربية ودولية
2022/03/28

+A
-A
ماركو كارنيلوس/ ترجمة: أنيس الصفار
أسعار النفط هي الأخرى تتصاعد بسرعة، والسعودية والإمارات العربية معاً تبديان ممانعة للضغط الأميركي عليهما من أجل زيادة الانتاج لخفض الأسعار.
مع إتمام الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الرابع يبدو أن هناك تبعات تلوح للصراع من شأنها ترك بصمة قوية على المشهد السياسي في الشرق الأوسط. فروسيا وأوكرانيا مجهِّزان مهمان للقمح إلى بعض دول المنطقة، مثل مصر، ومعنى هذا أن أية هزة تصيب إمدادات القمح قد تكون سبباً في حدوث اضطرابات في القاهرة وعواصم أخرى في المنطقة.
أسعار النفط هي الأخرى تتصاعد بسرعة، والسعودية والإمارات العربية معاً تبديان ممانعة للضغط الأميركي عليهما من أجل زيادة الانتاج لخفض الأسعار.
حتى صفقة إيران النووية التي طال انتظارها والتي كانت في مراحلها الأخيرة ربما ستتلكأ الآن أو قد تجهض بسبب حزمة المطالب الجديدة التي تفرضها روسيا.
في خضم سياق كهذا ثمة سؤال يلح منذ عقد على الأقل ويبدو أنه أخذ يكتسب أهمية متزايدة الآن: ترى هل ستحل الولايات المتحدة ارتباطها بالشرق الأوسط عسكرياً؟
التحدي الصيني
في آب 2010 أعلن الرئيس الأميركي “باراك أوباما” عن انتهاء المهمة القتالية في العراق، تلك المهمة التي أقرها سلفه “جورج دبليو بوش”. بعد ذلك ورط أوباما حلف الناتو على مضض بالتدخل في ليبيا للإطاحة بمعمر القذافي، وقد تعمد الإبقاء على حضور مخفف، على حد تعبيره، بأسلوب “القيادة من موقع متأخر”. في 2013 رفض أوباما أن يحكم على الرئيس السوري بشار الأسد بالمصير نفسه.
لم يكن باستطاعة أوباما طبعاً تفادي المواجهة مع جماعة “داعش” عندما كانت على وشك فرض سيطرتها على العراق وسوريا، ولكنه مع هذا لم يفعل أكثر مما يمليه عليه الحد الأدنى وذلك بتقديم التدريب والمساندة الجوية للقوات المسلحة العراقية والجماعات المسلحة الكردية في
سوريا.
في نهاية المطاف وجدت إدارة أوباما نفسها أكثر اهتماماً بإنشاء مرتكزات لها في آسيا منها بترتيب أوضاع الشرق الأوسط. كان الاستثناء الوحيد لتلك القاعدة هو صفقة إيران النووية في 2015.
في 2019 حاول الرئيس “دونالد ترامب” سحب القوات الأميركية من سوريا ولكنه فشل في ذلك وواجه معارضة قوية من جانب مؤسسة سياسة الأمن والخارجية في واشنطن.
اخيراً أكمل الرئيس “جو بايدن” الانسحاب الذي وافق عليه ترامب من افغانستان، ثم كان ما كان من عواقبه الوبيلة، وقد أقدم على ذلك بذريعة ما يزعم الآن أنه التحدي الأمني الأخطر للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين: أي الصين.
تشعر واشنطن بقلق شديد حيال صعود بكين المذهل، بيد أن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وفق هذا السياق لن يكون له معنى. هكذا أصبحت الصين المستورد الرئيس للنفط من منطقة الخليج منذ 10 سنوات وصارت المنطقة تمد الصين بنصف احتياجاتها من النفط تقريباً.
بحلول العام 2030 سوف تستورد الصين 80 بالمئة من نفطها، ومعظم هذا النفط سيبقى مصدره الشرق الأوسط. اعتماد الصين على نفط منطقة تستعد الولايات المتحدة للخروج منها يثير تساؤلات عديدة، لأن مكوث واشنطن هناك من شأنه تسليط قدر مؤثر من الضغط على غريمتها الرئيسة في العالم.
خوف في الأفق
في بيئة ستراتيجية سليمة وعقلانية يمكننا الافتراض بأن حرص الصين على التمسك بالشرق الأوسط لابد أن يكون أقوى من ميل الولايات المتحدة إلى مغادرته، لكن على مدى ثلاثة عقود على الأقل لم تتوفر لنا أدلة كثيرة على وجود تفكير ستراتيجي سليم في واشنطن.
ثمة خوف يلوح في الأفق لحلفاء أميركا في المنطقة من أن يتبع هزيمة الولايات المتحدة في لعبتها الكبرى بآسيا الوسطى إنسحابها من منطقة الشرق الأوسط. كل التطمينات التي قدمها وزير الدفاع الأميركي “لويد أوستن” في تشرين الثاني الماضي من على منصة أهم منبر أمني في المنطقة، وهو مؤتمر حوار المنامة في البحرين، لم تجدِ في تبديد هذه الشكوك.
على رأس اسباب القلق من الانسحاب الأميركي يبرز فراغ القوة الذي سيخلفه الانسحاب واحتمالات أن تبادر إيران وروسيا والصين إلى ملئه، وهذا يفسر إلى حد ما إسراع حفنة من الدول العربية إلى توقيع ما يسمى “اتفاقات إبراهيم” وتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل التي ينظر إليها في هذا الشأن على أنها القوة العسكرية الأمضى فعلاً في المنطقة. ترسم الخطوط العامة لهذه الاتفاقات ملامح نمط محتمل هو باختصار: أن تعهد الولايات المتحدة إلى بعض دول الخليج بدور تمويل إسرائيل بينما تحل الأخيرة بشكل متصاعد محل الولايات المتحدة في تأمين الحماية لهذه الدول.
من المبكر جداً الجزم بما إذا كان هذا النمط سيثبت دقته، أو حتى إن كان سيكفي لتهدئة روع الأطراف التي وقعت الاتفاقات.
مع هذا قد يكون من المبكر المراهنة كلياً على أن الولايات المتحدة سوف تحل ارتباطها، فواشنطن تستطيع ببساطة أن تشارك في إعادة الانتشار، وهذا إجراء أقل إحداثاً للصدمة، كما أن الاحتمال قوي في أن تبقى واشنطن على اعتقادها بأن الانسحاب سيكون دلالة ضعف لا يمكن تقبلها.
المشهد الستراتيجي للمنطقة
لدى تأمل المشهد الستراتيجي للمنطقة يتبين لنا أن الصراع في اليمن لا يزال من شأنه فرض نتائج غير مرضية على السعودية والإمارات، وفي لبنان يمكن أن يتمخض الموقف في لحظة عن فوضى شاملة تكون القوة العسكرية الوحيدة فيها القادرة على الإمساك بزمام الأمور هو حزب الله.
فإذا ما تجسد ولو بعض هذه السيناريوهات إلى حقيقة لكانت مخاوف الدول العربية التي اعترفت بإسرائيل مبررة
جداً.
إذا ما نجحت محادثات إحياء الصفقة النووية مع إيران فإن إسرائيل وبعض الدول العربية لن يهدأ لهم بال، أما إذا فشلت فإن احتمال تفاقم التوترات والتصعيدات سيكون هو الأرجح.
بيد أن التطور المثير المفاجئ هو أن بعض اللاعبين الإقليميين كما يبدو كانوا قد توقعوا من الأميركيين أن يحلوا ارتباطاتهم، وقد فعل توقعهم هذا فعله العجيب في تحفيز مبدأ الحوار في المنطقة بعد أن سطع الوعي بأن الأمن الإقليمي يمكن تحقيقه بشكل أفضل عندما تتبادل دول المنطقة الحديث مع بعضها بدلاً من البحث عن ملاذ في ظل قوى عظمى قد لا تكون أهلاً للثقة في بعض الأحيان.
السعودية وإيران
منذ بضعة أشهر تنخرط السعودية مع إيران في محادثات تهدف إلى إعادة العلاقات الثنائية بينهما والتعاون للتوصل إلى حل يكفل الخروج من اليمن بحفظ ماء الوجه.
على الإيرانيين اغتنام هذه الفرصة إذا كانوا يملكون الفطنة، إذ ليس من الحكمة الإمعان في إذلال الخصم مهما بدت فكرة الانكسار السعودي في اليمن مغرية للقيادة الإيرانية. وإذا ما أبدت الرياض فيما بعد رغبة في عقد صفقة ثانية مع طهران بشأن الملف اللبناني أيضاً فربما سيمكن تجنب كارثة أخرى وشيكة، وسوف تحسن إيران صنعاً إذا ما اغتنمت هذه الفرصة أيضاً لأن البديل عنها هو الانتهاء إلى بلد يعمه الخراب والاستقطاب. مبدأ الفوز الكاسح قلما كان وصفة للاستقرار الدائم.
مرة أخرى كانت دولة الإمارات هنا أسرع وأوسع حيلة. فحكام أبو ظبي بارعون في اللعب على طاولات متعددة لذا تحركوا للتواصل في آن واحد مع تركيا وإيران وسوريا. فبعد فترة طويلة من الخلاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الإسلام السياسي والأخوان المسلمين بادر ولي العهد محمد بن زايد بزيارة إلى أنقرة لأول مرة خلال عقد كامل، وبسرعة رد الرئيس التركي الزيارة.
أوفد محمد بن زايد أيضاً وزير خارجيته إلى دمشق ومستشاره للأمن القومي كي يلتقي بنظيره في طهران. كذلك أصرت الإمارات على إبقاء علاقات تعاون طيبة مع الصين، كما امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي لشجب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو موقف لم تستحسنه الولايات المتحدة.
إن يكن مجرد تصور فك الولايات المتحدة ارتباطاتها في الشرق الأوسط قد أحدث كل هذه الهبة النشطة من النشاط الدبلوماسي، ترى ما الذي سيحدث إذن لو تحول ذلك إلى حقيقة واقعة؟
تخفيف الوطء أفضل
تعتمد الحكمة القديمة الرائجة بشأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على منظور “السلام الأميركي”، وهو سلام أساسه القوة والقيادة من جانب أميركا. بقي هذا المعيار فاعلاً لزمن غير قصير، ولكن عند تأمل السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة طيلة عقدين من الزمن يتجلى بوضوح أنه دون ذلك.
ألن يكون من الأفضل للمنطقة إذن تخفيض الحضور العسكري للولايات المتحدة، لاسيما إذا كان هذا التخفيض سيدفع حلفاء واشنطن إلى تولي المزيد من مسؤولياتهم؟
ماذا لو أن القوة الأميركية ستكون أمضى فعلاً كلما اقتصدنا باستخدامها؟ بعبارة أخرى، أليس من المحتمل أن يكون تكرار استخدام نفوذ الولايات المتحدة وقوتها الناعمة في المنطقة هو الذي أضعف فعاليتهما؟ فمن المعلوم أن التكرار الروتيني يقود إلى التآكل والضعف.
قبل ثلاث سنوات دعوت إلى بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط. حينها كان دور القوى العظمى أمراً مسلماً به، أما اليوم فهنالك ميل ورغبة لترك اللاعبين المحليين يصرّفون شؤونهم، وهم على أي حال لن يصيبوا أنفسهم بأذى أكثر من ذلك الذي أصابتهم به القوى العالمية.
ماذا لو أخذت كتلتا القوى الرئيسيتان في المنطقة، أي كتلة الدول المعترفة بإسرائيل والأخرى التي تحذو حذو إيران، بتحري إمكانيات التوصل إلى أوسع أرضية مشتركة ممكنة بينهما وتخلتا عن لعبتهما المشتركة المهلكة.. لعبة المنتصر والمهزوم؟
إن عاجلاً او آجلاً قد يتكشف للاعبين المحليين أن ثمة تحديات وتهديدات جديدة كأداء يمكن أن تحل محل خصوماتهم القديمة، مثل التغيرات المناخية وتفاقم ظاهرة التصحر وتحولات الطاقة باهظة التكاليف وتدفقات الهجرة الكارثية.
عندئذ ربما تدرك دول الشرق الأوسط، قبل فوات الاوان، أن السبيل الوحيد للتعامل مع تلك التحديات والتهديدات هو التعاون الإقليمي فيما
بينها.
عن موقع “مدل ايست آي”