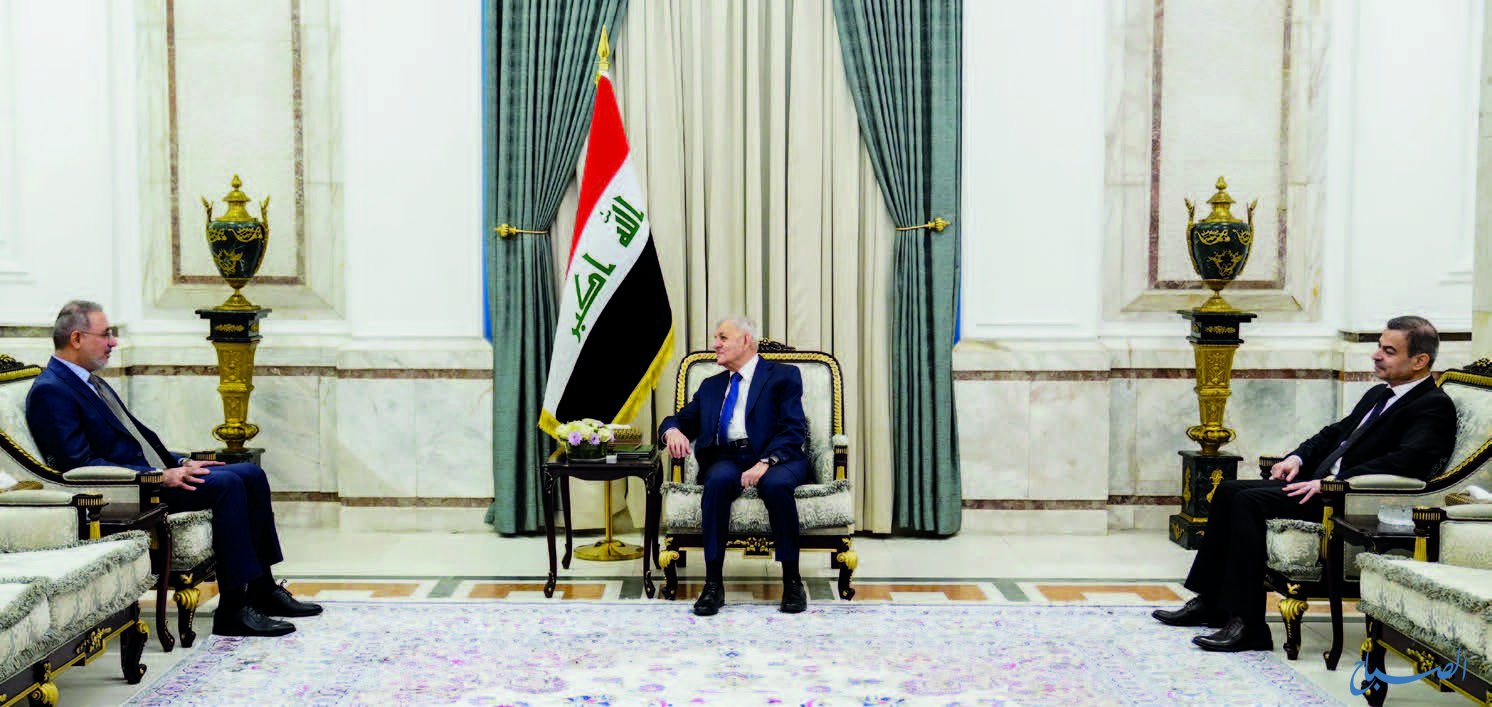الحركة الإصلاحية في إيران وأزمة القيادة الرمزية
قضايا عربية ودولية
2022/05/11

+A
-A
جواد علي كسار
ارتبطت الحركة الإصلاحية في جمهورية إيران الإسلامية تأسيساً وحدوثاً بالرئيس الأسبق محمد خاتمي (في المنصب: 1997 - 2005م). لكن هذه الحركة ما لبثت أن التقت مع هاشمي رفسنجاني في منتصف الطريق، بعد انعطافة احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009م، وما تلاها من متغيّرات عاصفة في المشهد السياسي الإيراني، لتتحوّل إلى قيادة ثنائية لهذا المشهد، كان من أبرز نتائجها احتواء التبعات السلبية الاجتماعية والسياسية، التي ضربت إيران والحركة الخضراء بقيادة مير حسين موسوي ومهدي كروبي؛ عبر عودتها المندفعة القوية وهي تسجّل نتائج حاسمة ومتقدّمة في خمسة مواسم انتخابية كبرى، اثنان للجمهورية تمخّضا عن فوز الأصولي المعتدل حسن روحاني بالرئاسة مرتين، وهزيمة المرشحين الأصوليين المتشدّدين سعيد جليلي في الأولى وإبراهيم رئيسي في الثانية، وانتخابات برلمانية وأخرى للمجالس المحلية، وثالثة لمجلس خبراء القيادة، تقدّمت فيها جميعاً القوى الإصلاحية على مستوى الرموز والواجهات التنظيمية، كما على صعيد الخطّ الفكري ومرجعيات السياسة والاقتصاد، قبل أن يحصل المنعطف.
أزمة القيادة
نقصد بالمنعطف؛ حدثين ضربا الحركة الإصلاحية على مستوى الرمزية؛ الأول وفاة هاشمي رفسنجاني مطلع عام 2017م، ما جعل ثقل القيادة يتمحور حول رمزها الآخر محمد خاتمي. لكن المشكلة أن الضغوطات من قبل أجهزة الحكم، راحت تتصاعد ضدّه في الداخل بعد احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009م، حتى عُدّ من قبل بعض هذه الأجهزة الأمنية المسؤول الثاني بعد هاشمي رفسنجاني، في التخطيط للحركة الخضراء وهندسة أدائها بعد هزيمة مرشحها مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية، ما أدّى إلى تشديد الحصار ضدّه في حالة أقلّ بدرجة طفيفة، من ذلك الحصار المنزلي الذي فُرض عام 2010م، على أبرز قيادات الحركة الخضراء موسوي وكروبي، وطال العشرات من البارزين فيها ودفعهم إلى السجن بعد محاكمات سياسية، أدّت ليس فقط إلى سجنهم بل إيقاف نشاط أبرز الأحزاب الإصلاحية.
بكلام واضح ومباشر؛ محمد خاتمي اليوم ممنوع الظهور كلاماً وصورة، في وسائل الإعلام الرسمي ومواقعه المحسوبة عليه، وجميع ما يمت إليه بصلة من وسائل التواصل والظهور. ممنوع السفر إلى الخارج على عكس أحمدي نجاد، الذي استثنى غضب الأجهزة الرسمية عليه سفره إلى الخارج، فَتُرك طليقاً في رحلاته إلى خارج إيران. كما وصل التضييق المضروب الآن على نشاط خاتمي، حداً بلغ الحصار الشامل تقريباً، لاسيّما بعدَ أن فشلت جميع المساعي العلنية والسرية والخاصة والعامة، التي بُذلت لحلّ إشكالية خاتمي مع المرشد مُباشرة وعودته إلى الحياة السياسية العادية، كتلك التي بذلها مثلاً نائب الرئيس السابق إسحاق جهانگيري مع شخص السيد علي خامنئي، وباءت بالفشل كغيرها من المحاولات مما نعرفه وتابعناه، أو مما نجهله ولم يُكشف النقاب عنه.
غياب رفسنجاني والتضييق على خاتمي وعزله عن النشاط السياسي والاجتماعي العام، أوقع الحركة الإصلاحية في أزمة حادّة ما تزال مستمرّة، هي أزمة الزعامة؛ هذه الأزمة التي كان واحد من أبرز نتائجها الفشل الكبير للإصلاحيين في انتخابات البرلمان الحادي عشر (21 شباط 2020م) والانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة التي تلته (18 حزيران 2021م) وحملت إبراهيم رئيسي إلى قصر باستور رئيساً ثامناً للجمهورية الإسلامية.
لكي تتجاوز الحركة الإصلاحية أزمة الزعامة والرمزية القيادية، شهدت وما تزال محاولات جادّة على هذا الصعيد، كان في طليعتها فك الحصار عن خاتمي، وهو أمر لم تنجح به حتى الآن، ما جعلها تلجأ إلى خيارات رمزية بديلة، في طليعتها تأهيل واحد أو أكثر من الشخصيات التالية: حسن روحاني، حسن الخميني، محسن هاشمي رفسنجاني، إسحاق جهانگيري، علي مطهري وعلي لاريجاني.
روحاني وخيار الزعامة
بشأن حسن روحاني، فبرغم ما يتمتّع به من خصائص كثيرة، وقربه حدّ التمازج إلى فكر رفسنجاني وخطّه ومدرسته، إلا أن العيب الأساسي فيه هو شخصيته المنكمشة، والقيادة المحورية لجبهة عريضة كالإصلاحيين تحتاج إلى شخصية منبسطة، تتحلى بسعة الصدر والقدرة على الجذب، والجمع بين المتعارضين بل حتى المتناقضين. أضف إلى ذلك، أن روحاني لا يزال في التصنيف السياسي، منتمياً إلى اليمين لكن المعتدل حاله حال رفسنجاني قبله، مع الإقرار بأن الاثنين ولاسيّما رفسنجاني، كانا قد ابتعدا كثيراً عن الأصوليين.
ومع أن لروحاني علاقات ما تزال مستمرّة مع «جامعه روحانيت» (جماعة العلماء) أشهر تنظيم لرجال الدين، وعضواً قيادياً فيه. كما له علاقة ما تزال مفتوحة نسبياً مع المرشد الأعلى، إلا أن ما يهدّد مستقبله القيادي والسياسي، بالإضافة إلى انكماشه وميله إلى الهدوء والعزلة، وتنكّره عملياً للإصلاحيين لاسيّما في مدته الرئاسية الثانية (2017ـ 2021م)؛ هو ملفه المفتوح في الرئاسة على جميع الاحتمالات، وفي طليعتها احتمال محاكمته قضائياً كما يلوح من قرائن مكثّفة، أو التلويح بذلك على الدوام لابتزازه وتحييده وإسكاته؛ كما احتمال عزله سياسياً واجتماعياً، أسوة بسلفيه في الرئاسة، وما حصل قبله للرئيس أحمدي نجاد، وللرئيس محمد خاتمي.
جهانگيري ومحسن هاشمي
رغم تعدّد عناصر الكفاءة القيادية التي يؤشر إليها المتحمّسون للوزير والنائب السابق لرئيس الجمهورية إسحاق جهانگيري، واندفاعهم للحديث عنه كمحور قيادي للإصلاحية السياسية في إيران، إلا أن الملاحظ أن أغلب هذه العناصر تصبّ في دائرة البراعة الشخصية، ومحبوبية هذا الرجل، وكفاءاته الإدارية. وهذه لا تكفي مؤهلاً لقيادة الحركة الإصلاحية، لاسيّما أنه يفتقر تماماً في تجربته التنفيذية، إلى مؤهلات التنظير التي تتطلبها قيادة الإصلاح.
أضف إلى ذلك أنه مهدّد بالحصار والعزل حدّ تجميده وإلغاء دوره السياسي، كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (حزيران 2021م) عندما رفض مجمع حماية الدستور، أهليته للرئاسة ضمن مجزرة الحذف والإقصاء التي طالت رموز وشخصيات كبيرة، مثل أحمدي نجاد وعلي مطهري وسعيد محمد ومحسن رهامي ومسعود پزشكيان وعباس آخوندي ومحمد شريعتمداري وإسحاق جهانگيري نفسه، وعلى رأسهم جميعاً لاريجاني؛ ومن ثمّ فالسؤال: من الذي يضمن حماية الحضور السياسي لجهانگيري، واستمرار دوره القيادي، وسط سيف الإلغاء والعزل والإقصاء، من قبل مجلس حماية الدستور، أو القضاء أو أيّ جهة أو جهاز آخر، له صلاحية إصدار قرارات العزل والتجميد؟.
قصة محسن هاشمي رفسنجاني، تكاد تلتقي بالأفق نفسه الذي يحكم مصير جهانگيري. فمع أنه يتمتّع بمؤهلات ذاتية وإدارية وسياسية مشهودة، بالإضافة إلى التوازن والاعتدال والقدرات التنظيرية التي تميّزه عن سلفه جهانگيري، يعزّزها جميعاً انتماؤه إلى عائلةٍ ربما تُعدّ الثانية من كبرى العائلات الإيرانية، التي لعبت دوراً حاسماً في السياسة الإيرانية إبّان العقود الأربعة الماضية؛ هي عائلة أكبر هاشمي رفسنجاني، فمحسن من بين الأبناء الخمسة للراحل رفسنجاني؛ فائزة وفاطمة ومهدي وياسر، الأبرز والأهدأ والأكثر اتزاناً وعقلانية من بقية أشقائه، والأقرب إلى خصائص مدرسة أبيه؛ أقول رغم ذلك كله فلا يزال الوقت أمامه باكراً، للعب دور قيادة الحركة الإصلاحية على مستوى الزعامة ومحوريتها.
محاصرة الرفسنجانية
أضف إلى ذلك، أن واحدة من أبرز نقاط قوة محسن متمثلة بأنه نجل هاشمي رفسنجاني، تُعدّ بنفسها نقطة ضعفه الكبيرة التي يمكن أن تطيح به في أي لحظة، وبالحركة الإصلاحية من ورائه في ما لو كان زعيماً لها. فالتربّص بهاشمي رفسنجاني الآن ليس قليل، بل هو قائم على قدم وساقين (وليس ساقاً واحدة!) لاسيّما من قبل التيار الأصولي المتطرّف، الذي اكتسب في بعض التنظيرات وصف: «الأصولية الجديدة»، من قبيل «جبهه پايدارى" (جبهة الصمود أو الثبات) وتيار "الأحمدي نجادية" (نسبة إلى الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد) وأنصار "مكتب إيران"، وكلّ من يوصف نفسه بأنه ينتمي إلى التيار الثوري الجديد، الذي طبع السلطات الثلاث ببصمته، متوحّداً مع خطّ العسكرة داخل الحرس الثوري، وبقية الأجهزة والمؤسّسات ومراكز القوى في إيران الآن.
فكلّ هؤلاء (وهم ليسوا قلة) لا تروق لهم الرفسنجانية، كطريقة في إعطاء الأولوية لبناء إيران، مع انفتاح اجتماعي واستقرار معيشي وازدهار في الداخل، وعلاقات هادئة مع الإقليم والعالم، وترجيح علاقات أكثر انفتاحاً مع العالم الأوّل بما في ذلك أميركا، ومن ثمّ تقليل مظاهر العسكرة وتدخّل العسكر في شؤون السياسة والاقتصاد، في الطليعة الحرس الثوري الإيراني.
عندما تكون الرفسنجانية بهذه المثابة من الحصار، من قبل خط القوى الثورية، كما تعكسه الآن وفعلاً، أدبيات صحف "كيهان" و"ايران" و"وطن امروز" وغيرها، في هجوم يومي لا ينتهي على هاشمي رفسنجاني ومدرسته وخطه، وكما تفعل "جبهه بايدارى" وخط أحمدي نجاد؛ فمن المؤكد أن الهجوم سيتضاعف ويتجه مباشرة، إلى محسن هاشمي رفسنجاني، في اللحظة التي يكون فيها زعيماً للإصلاحيين، وقائداً للحركة الإصلاحية، وهذا ما يقلل من فرصه العملية ولو إلى حين، لتتحرّك الخيارات على بقية البدائل!.
حسن حفيد الخميني
لزعيم الثورة الإسلامية الراحل السيد روح الله الخميني (ت: 1989م) ولدان هما مصطفى وأحمد، توفي الأول عام 1977م في حياة والده، وتوفي الآخر عام 1995م بعد وفاة والده. ضمن سلسلة من الملابسات الشخصية والسياسية والفكرية والخطية انتهى الأمر بحسين نجل مصطفى وحفيد السيد الخميني الأكبر، إلى العزلة المفروضة المشوبة بشيء من الاعتزال، إذ صار حسين يقضي جُلّ وقته الآن في حاضرة النجف الأشرف، في ما تعزّز دور حسن نجل أحمد أكثر فأكثر، وتحوّل إلى الرمز الأوحد والأهمّ لوراثة بيت الخميني والتربّع على تراثه الديني وميراثه السياسي. وقد عزّز ذلك بخصائص شخصية (كاريزما) ممتازة ومميّزة، تعيد التذكير بشخصية جدّه روح الله الخميني؛ تتماثل معها وتحمل الكثير من الخصائص التي تشابهها.
بمعيار العلوم الدينية المحضة، تشهد له حواضر العلم الديني في بلده ولاسيّما حاضرة مدينة قم؛ تخصّصاً متعمّقاً في هذه العلوم، إذ هو اليوم من اللامعين في البحث الخارج، الذي يُعدّ من أرفع دروس الحوزة ومضماراً يشهد على قدرات صاحبه، بالدقة والتخصّص الاجتهادي، والقدرة على الفتيا واستنباط الحكم الشرعي.
يتمتع بالرضا والقبول على صعيد شبكة من العلاقات الممتدّة، تستوعب جميع القوى اليسارية والإصلاحية، معها اليمين التقليدي المعتدل، على مستوى الدولة وأجهزتها ومؤسّساتها، كما على مستوى الحوزة والجامعات والإعلام، استطاع أن يعمّقها أكثر بخلقه اللين الحسن، وأسلوبه المهذّب، وسعة الصدر، والقدرة على الاحتواء والاستيعاب، وتحييد الخصوم، مع طموح لا يخفيه بلعب دور قيادي محوري، على مستوى الموقع الأول في البلد.
كلّ هذه الخصائص منحته موقعاً متقدّماً ومؤثراً، إلى جوار شخصيات كبيرة على مستوى هذا الخطّ، في طليعتها هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وحسن روحاني وناطق نوري ومهدي كروبي، وغيرهم كثير، عبر ما عُرف بـ»حلقة نياوران» أو غيرها من التجمّعات المحورية القيادية، حتى فكّرت القوى الإصلاحية بتقديمه مرشحاً إجماعياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لولا إشارة سلبية من المرشد، جعلته يمتنع عن قبول الترشيح، بعد لقاء بين الاثنين قُبيل الانتخابات.
بدا حسن الخميني أفضل خيارات الحركة الإصلاحية في ملء فراغ الزعامة، والتحوّل إلى واجهة لهذا التيار، لولا بعض الثغرات التي أجملها البعض بحداثة سنّه، وقلة تجربته التنفيذية، وضآلة خبرته السياسية بالمقارنة مع الزعامات التأريخية لحركة الإصلاح؛ أضف إلى هشاشة قاعدته الاجتماعية، وغموض موقف أجهزة السلطة منه إذا قرّر التصدّي؛ بالأخص مع السابقة السيئة لهذه الأجهزة، عندما رفض مجلس حماية الدستور ترشيحه عضواً في آخر انتخابات مجلس خبراء القيادة، بحجة عدم أهليته العلمية.
العليان مطهري ولاريجاني
ترك رجل الدين والمفكر الإيراني البارز مرتضى مطهري عند مقتله غيلة عام 1979م، سبعة من الأولاد أكبرهم علي الذي يبلغ من العمر (65) سنة.
تميّز علي من بين بقية إخوانه بدخوله مضمار السياسة، عبر البرلمان نائباً ونائباً للرئيس. وقد تميّز بالجرأة والصراحة، وقدرات مشهودة على التنظير والتحليل، والاجتهاد السياسي وتقديم منظورات في قضايا البلد الكبرى، بصراحة ومن دون مجاملة أو محاباة، وهو ما لم يعجب بعض أجهزة الحكم، التي حرمته من الترشيح للمجلس النيابي الأخير، ومن بعدها لانتخابات الرئاسة؛ دائماً بحجة عدم الأهلية من دون الإفصاح عن الأسباب صراحة وبالتفصيل!.
علي الذي تحوّل من اليمين التقليدي إلى المعتدل، ثمّ إلى خطّ الإصلاح يطمح الكثيرون أن يرون فيه زعيماً لهذا التيار، لكنه محاصر بصراحته وجرأته وحدّته، ومن ثمّ فهو معرّض للتهميش كما هو حاله الآن، أو للإقصاء والإلغاء، بالإضافة إلى افتقاره للخبرات في العمل التنفيذي، واقتصار تجربته على العمل التشريعي البرلماني وحده، وذلك على عكس صهره على أخته علي لاريجاني.
نقاط القوّة لدى لاريجاني كثيرة ومتنوّعة، تبدأ من الأسرة العلمية العريقة، والمؤهلات الشخصية، والخبرات التنفيذية المتراكمة عبر أربعة عقود من العمل في أجهزة الدولة وسلطاتها؛ قائداً في الحرس، ورئيساً لجهاز الإذاعة والتلفزيون، ووزيراً للإرشاد، ورئيساً للبرلمان، وعضواً حقيقياً في مجمع تشخيص النظام، بالإضافة إلى قدرات تنظيرية متميّزة، تعضدها علاقات مع أغلب القوى السياسية في اليسار واليمين، وداخل صفوف الإصلاحيين والأصوليين، تدعمها قناة اتصال مفتوحة مع المرشد.
كلّ هذه المزايا دفعت بعض القوى الإصلاحية لطرح علي لاريجاني زعيماً محتملاً للحركة الإصلاحية. وتبقى أطروحات أخرى لمواجهة المشكلة تتحرّك داخل المنطقة الرمادية، وتتبنّى خيارات من قبيل تأهيل موسوي وكروبي، في حال رفع الحصار المفروض عليهما نهائياً، وهو خيار ضعيف. كما هناك من يفكر بأسماء من خارج الصندوق كالشيخ عبد الله نوري مثلاً.
هذه إجمالاً مؤشرات على واقع أزمة الزعامة داخل جبهة الإصلاح حاضراً، تبرز إلى جوارها أزمة لا تقلّ عنها أهمية في التنظيم، كما سنعود إلى ذلك في مقال مستأنف
بإذن الله العزيز.