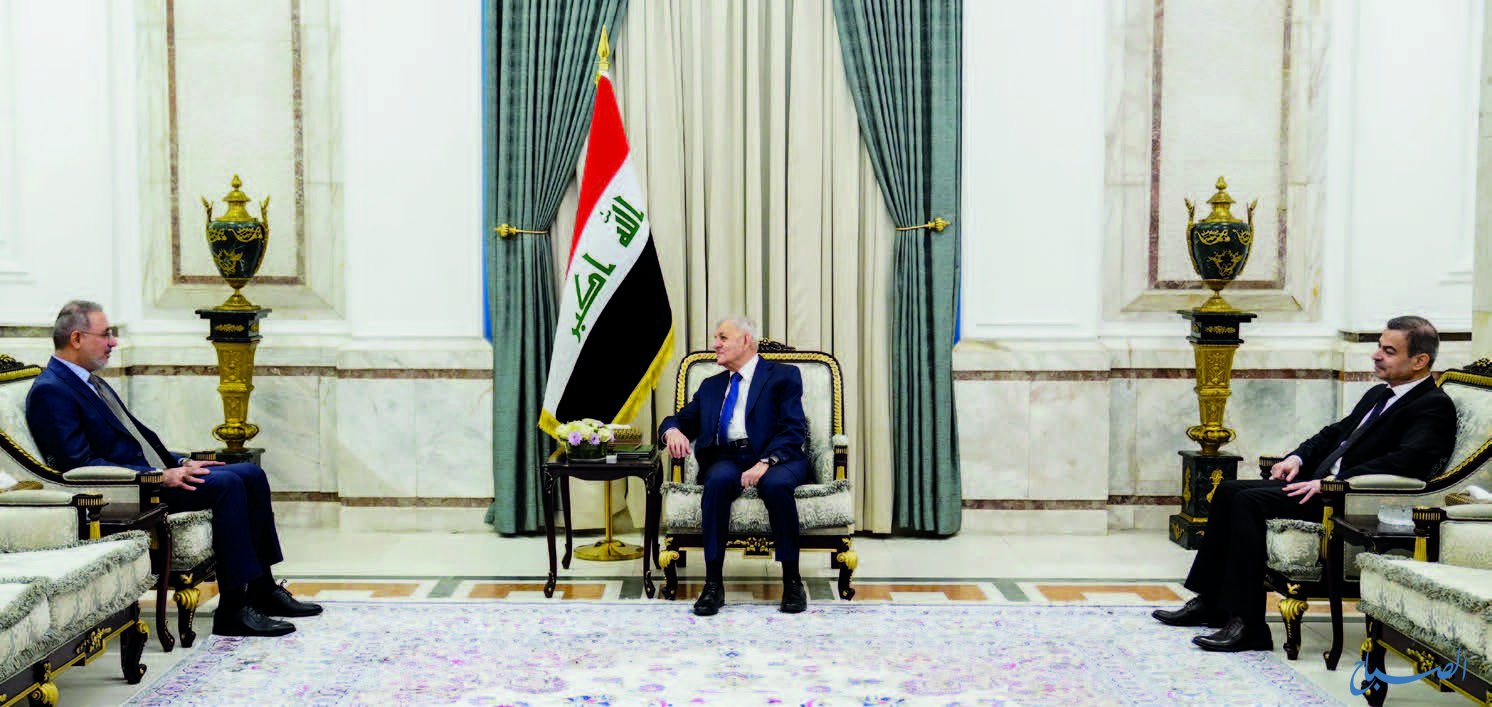عسكرة أوروبا وصعود القوّة الألمانية واليابانية

جواد علي كسار
عند تفكّك الاتحاد السوفياتي أواخر عام 1991م، أطلق يومها وزير الدفاع في إدارة بوش الأب ديك تشيني، أحد رموز اليمين الأميركي المتشدّد (المحافظون الجدد)، دعوةً لاستكمال ما أسماه النصر الغربي ضدّ المعسكر الشيوعي، تقضي بتفكيك روسيا نفسها، بموازاة تفكّك الاتحاد السوفياتي.
استشهد فلاديمير بوتين بهذا المعنى وكرّره عدّة مرّات خاصة في الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية ضدّ أوكرانيا، معلناً أن الغرب ولاسيّما شقّه الأميركي، يضع أمام ناظره تفكيك روسيا الاتحادية الحالية. لكن ثمّ مسافة كبيرة بين الرغبات وبين الخيارات الواقعية على الأرض، فأميركا ترغب بلا ريب بتفكك روسيا الاتحادية، وتضع مراكز الدراسات فيها وغرف الفكر، العديد من الأوراق والخيارات والبدائل، بيدَ أن الجميع يعرف بمن فيهم الرئيس بوتين، أنها مجرّد أفكار في المطبخ الأميركي، لم تتحوّل في المدى المنظور إلى ستراتيجيات فعلية وخطط عملية، وربما لن تأخذ سبيلها إلى الواقع قطّ.
إشارات منهجية
في منهج التحليل السياسي الرصين، لا يمكن المقارنة ستراتيجياً وضمن القواعد الحالية للعلاقات الدولية، بين تفكّك المنظومة الشرقية وما يُقال عن مشاريع تفكّك روسيا الاتحادية، ومن ثمّ لا يصحّ عملياً قياس أحدهما على الآخر، والانسياق وراء لغة التهويل التي تصدر من موسكو، كما ليس من الصحيح أيضاً الانجرار إلى التهويل المعاكس، وهو يتحدّث عن حرب نووية مقبلة أو حرب عالمية ثالثة وما شابه.
أعتقد أن جميع الأطراف محكومة حتى الآن بقاعدة البقاء، وليست هناك بوادر عملية تُشير إلى توجهات لحرب نووية أو عالمية جديدة، فضلاً عن خطط ناجزة لتفكيك روسيا الاتحادية. وهذا ما يُدركه تماماً أصحاب القرار في موسكو وواشنطن، والعواصم الأوروبية ولاسيّما برلين ولندن وباريس، بالإضافة إلى طوكيو وبكين وبقية العواصم المعنية.
أجل، مرور سنة كاملة على حرب روسيا في أوكرانيا، وتحوّل الحرب إلى السنة الثانية، يجعل من الممكن الكلام عن حسابات خاطئة لموسكو وفريق بوتين العسكري، كما يشجّع لإطراء كييف ولاسيّما إدارة الرئيس فولودويمير زيلينسكي للأزمة عسكرياً وسياسياً، والإشادة بحذاقته في اللعب على الهواجس الغربية ومخاوف الغرب التأريخية من روسيا، وخاصة الشقّ الأوروبي، وتوظيف ذلك وتحويله إلى دعم عسكري وسياسي واقتصادي مُباشر لبلاده ومعركته.
كما يمكن الحديث بعد عام من الحرب وبمعطيات مباشرة، عن عسكرة متصاعدة في أوروبا، تمثلت ليس فقط في ازدياد رغبات الانتماء إلى حلف الأطلسي، كما في السويد وفنلندا وأوكرانيا نفسها، التي تعامل الغرب معها عملياً وكأنها عضو فعلي في قلب الأطلسي؛ بل أيضاً في تصاعد الإنفاق وتقوية البُنية الدفاعية في محور دول البلطيق وبلدان أوروبا الشرقية والغربية معاً، ما يؤشر إلى عسكرة متصاعدة في القارة لا نظير لها منذ عقود، والأخطر من ذلك والأهمّ منه، بوادر الانبعاث الجديد لقوّتين عسكريتين نائمتين، هما القوّة العسكرية الألمانية واليابانية؛ وذلك ضمن سلسلة مركّبة من التفاعلات ترتبط جميعاً بمحور الحرب الروسية في أوكرانيا، وطبيعة الخيارات المتوقّعة لمستقبل هذه الحرب.
السيناريوهات الخمسة
قبل سنة وبضعة أيام عندما انطلق الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأت إلى جواره عقول خبراء الجيوسياسة والستراتيجيا وأساتذة العلاقات الدولية، بوضع سيناريوهات توقعية للمستقبل، كان على رأسها السيناريوهات الخمسة التالية:
1ـ المبادرة الفورية لإعلان وقف إطلاق النار وإعادة السلام بين الطرفين، وهذا ما لم يحصل وقد دحضه الواقع ودخول الحرب عامها الثاني.
2ـ حرب محدودة وانتصار لروسيا. وهذا ما كانت تطمع به موسكو، يوم اندفعت إلى قلب أوكرانيا، فقد كانت تفكر بحصر الحرب في أوكرانيا، وتحقيق انتصار عسكري سريع، يمنحها اليد العليا في المفاوضات، لتفرض شروطها من خلال المفاوضات الدبلوماسية الثنائية أو المتعدّدة الأطراف، لكن صمود كييف ونجاح زيلينسكي وحكومته في تعزيز هذا الصمود على مدار عام وأكثر، دفع هذا الخيار جانباً، وهو وإن كان لا يزال ممكناً نظرياً، إلا أن تحققه عملياً بات بعيداً ومكلفاً لروسيا وبوتين.
3ـ حرب محدودة وهزيمة لروسيا. كان هذا الخيار يعتمد على عاملي الداخل والخارج معاً؛ صمود أوكرانيا حكومةً وجيشاً وشعباً في الداخل، وتدفق الدعم الأوروبي والأميركي عبر "الناتو"، للحفاظ على صلابة المقاومة الأوكرانية. وهذا ما نجحت به أوكرانيا والغرب حتى الآن، لكن من دون هزيمة كاملة لروسيا؛ هذه الهزيمة التي لو حصلت لأدّت إلى ضعف جيوبولوتيكي وستراتيجي لموسكو؛ وإلى انتهاء أو تعطّل حلم "الأوراسية" الروسية، كما بلورته أحلام أحد أبرز أقطابها الكسندر دوغين، قبل أن تتحوّل إلى إيديولوجيا رسمية أو شبه رسمية، لسياسة موسكو منذ عقد ونيّف من السنوات على الأقلّ.
أضف إلى أن هذه الهزيمة لو حصلت تكلف بوتين خسارة فادحة لموقعه، وتغييراً لمسارات روسيا في اتجاهات غير واضحة.
4ـ حرب غير محدودة لكن مُسيطر عليها. المقصود بغير المحدودة، هو امتداد الحرب إلى خارج جغرافية أوكرانيا؛ تحديداً إلى فضاءات جديدة داخل روسيا وأوروبا نفسها، لكن يمكن ضبطها وعدم تحوّلها إلى حرب شاملة على جميع الجبهات. وهذا الخيار لو حصل قد يُعلي من دور الهند والصين وغيرهما من اللاعبين السياسيين، لممارسة دور أكبر لتطويق الحرب والسيطرة عليها، وصعود حركة احتجاجية مدنية واسعة في العالم كله، تقود إلى تكريس نظرة سلبية ضدّ روسيا وأوروبا وأميركا، وهم يضعون العالم أمام مخاطر حرب عالمية شاملة.
5ـ آخر السيناريوهات التي كانت تقرأ مستقبل هذه الحرب يوم انطلقت قبل عامٍ وأيام، هو الحرب غير المحدودة التي لا يمكن السيطرة عليها. وهو الخيار الذي يشعل العالم برمته، ويدخله في سلسلة متوالدة من الحروب المركبة، المنفتحة على جميع المناطق وكلّ الأسلحة المدمّرة، بما في ذلك النووية، وهو ما يفترض أن يتحاشاه الجميع ويحرص على عدم وقوعه، لأن فيه دمار المدنية الإنسانية في بُناها العامرة، بمجال التكنولوجيا والاتصالات والاقتصاد والطرق والمواصلات، ما يؤدّي في النهاية عودة العالم إلى عصور الظلمات والتخلف.
عسكرة أوروبا
كانت أوروبا خلال القرن الماضي مسرحاً لحربين مدمّرتين، لذلك نأت بنفسها عن الحروب واتجهت صوب الاقتصاد والتنمية وتطوير الذات، تاركة الثقل الأساسي في مهمّة الدفاع عن القارّة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى حليفتها الأقوى أميركا ومظلة "الناتو".
التقت إرادة أميركا وأوروبا وحتى الاتحاد السوفيتي نفسه، على إبقاء ألمانيا في أوروبا واليابان في آسيا، منزوعي السلاح وبلا أنياب. وهذا ما كان طوال مرحلة المعسكرين والحرب الباردة، لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، انكمشت أميركا جزئياً في الإنفاق وراحت تطالب حلفاءها الأوروبيين في "الناتو"، برفع موازناتهم العسكرية لتكون بين 1,5ـ2 بالمئة من الناتج المحلي، بدلاً من نسبة 1 بالمئة التي كانت ولا تزال سائدة في أغلب هذه الدول. يومها كانت الإدارات الأميركية المتتابعة ترسل وزراء الدفاع، إلى عواصم أوروبا لإنجاز هذه المهمّة وسط عدم وجود ميول أوروبية واضحة، للتجاوب مع الطلب الأميركي.
أجل، كان هناك تململ حكومي وشعبي في أوروبا ضد المركزية الأميركية، من أبرز علائمه التمرّد الفرنسي وانسحاب باريس على عهد الرئيس شارل ديغول من الجناح العسكري للحلف. كما انطلقت صيحات بعد نهاية الحرب الباردة للدعوة إلى ستراتيجية الدفاع الأوروبي الخالص عن أوروبا، تزعّمته فرنسا وناصرته ألمانيا، وتقليص العلاقة مع أميركا إلى مستوى التنسيق وحسب. عزّز ذلك طموحات ألمانية للمزيد من التفرّد والاستقلالية الأوروبية، بعد توحّد الألمانيتين.
على خطّ هذه النزعات الأوروبية المتنامية جاءت دعوات الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى تخفيف الانفاق العسكري الأميركي في أوروبا، مقابل أن تتحمّل بلدانها المزيد من النفقات للدفاع عن نفسها، لأن أميركا ليست على استعداد للإنفاق على أوروبا بلا حدود، وأنها لن تفعل ذلك بلا ثمن
بحسب رأيه.
حرب أوكرانيا قلبت هذه الصورة أو عدّلت منها كثيراً، فقد زادت من حيوية العلاقة بين أميركا وأوروبا، ودفعت "الناتو" إلى أدوار أكبر، والأهمّ من ذلك أن الممانعة (الفيتو) ضدّ إعادة تسليح ألمانيا لم ترتفع وحسب، بل تحوّلت إلى برامج عملية لإعادة تسليح ألمانيا، لاسيّما بعد رصد أكثر من (150) مليار دولار للارتقاء بهذه المهمّة.
شهدنا في الاتجاه القاضي بعسكرة أوروبا وآسيا، رغبة أميركية - أوروبية مشتركة، لدفع اليابان إلى عسكرة مماثلة، وتنشيط دور كوريا الجنوبية، ما يعني أننا أصبحنا أمام عسكرة أوروبية عامة، إلى جوارها انبعاث عسكري خاص، لقوتي ألمانيا واليابان، وقد كانتا إلى وقت قريب نائمتين تحت ضغوط الإدارة الأميركية - الأوروبية، في قرار منع تسلحهما بعد الحرب العالمية الثانية، اشترك فيه الاتحاد السوفيتي غالب الأحيان.
برأيي، إن عسكرة أوروبا وابتعاث القوّة العسكرية الألمانية خاصة، وإلى جوارها القوّة اليابانية، هي أخطر تداعيات الحرب الروسية ضدّ أوكرانيا. وهنا لا يبدو لي مقنعاً إطلاقاً، ذلك النوع من التقارير الأميركية التي تتحدّث عن مشكلات عظيمة أمام الانبعاث العسكري الألماني والياباني؛ وأن هذه العملية تصطدم بميل شعبي للحفاظ على الرفاه الاجتماعي، بالبقاء على مسار التقدّم الاقتصادي وحده، والابتعاد عن العسكرة؛ بل اندفاع هذه التقارير لكلام غاية في السطحية، عن "بؤس" العسكرية الألمانية واليابانية الآن؛ إذ حتى لو قبلنا بوجود مشكلات فهي أقلّ كثيراً مما تضخِّمه التقارير الأميركية، ومن ثمّ فإن انبعاث القوّة العسكرية في ألمانيا واليابان ليس فقط لا يواجه أي عقبات حقيقية على المستوى التقني، بل أراه يتجاوب مع الخزين الشعوري المتراكم تاريخياً، للألمان واليابانيين؛ هذا الخزين الذي كان بانتظار أدنى فرصة لكي يعبّر عن نفسه، وقد جاءت غلطة روسيا في أوكرانيا، لتكون الشرارة في هذا الانبعاث.
الاستخفاف بروسيا
ما يزال الغرب "مادّة" العصر كما كتب الفضل شلق مرّة، وهو "يشكلنا" كما يريد، بحسب المفكر الراحل هشام شرابي، لكن مع ذلك لا يمكن الاستخفاف بالقوى الصاعدة اقتصادياً وسياسياً؛ بالضبط كما لا يمكن الاستخفاف بروسيا، برغم من أنها لا تقارن اقتصادياً مع الكثير من القوى الغربية والآسيوية التي تتقدّم عليها.
لقد تكاثرت التحليلات قبيل بدء الهجوم الروسي ضدّ أوكرانيا في 24 شباط من العام الماضي، كان من بينها أن الغرب وبالأخصّ "الناتو" خان روسيا؛ وأن أميركا كانت تخطط منذ زمن لاستدراج روسيا وتوريطها في أوكرانيا، وذكروا لذلك أسباب متعدّدة أنهاها البعض إلى عشرة أهداف اقتصادية وعسكرية وستراتيجية؛ وتكاد كلمة عدد كبير من المراقبين الغربيين تتفق على أن المطلوب، أن تتحوّل أوكرانيا إلى مصيدة لإنهاك روسيا واستنزافها، وقد ساعد على منح هذه التحليلات درجة كبيرة من الصدقية، هو طول أمد الحرب وتمدّد عمرها نحو السنة الثانية، من دون أن تبدو في الأفق بوادر لحلّ سياسي عسكري، مركب بين الحرب والمفاوضات، خاصة بعد أن أخفقت المبادرة الصينية، أو وضعتها الأطراف المعنية جانباً.
لكن مع ذلك كله لا ينبغي أن تجرّنا كلّ هذه التحليلات إلى ذهان السهولة، وتوقعنا بآفة الاستخفاف؛ فروسيا لا يمكن الاستخفاف بها، وهي تحمل ميراث تأريخي وثقافي وسياسي مركّب، بين الإمبراطوريتين القيصرية والشيوعية، والأرثوذوكسية واللادينية، والشرق والغرب. فقد انبعثت روسيا الماركسية - اللينينية من انقضاض الحكم القيصري المتهرئ، وتحرّرت من حكم العجائز (بريجينيف وتشريننكو واندروبوف) إلى شبابية ميخائيل غورباتشوف وإصلاحيته؛ هذه الإصلاحية التي تعثّرت أواخر عهده وهي تؤول إلى يلتسين، قبل أن تنتعش مجدّداً مع بوتين.
روسيا الشعبية تتغذّى الآن على كلّ هذه الموروثات، الرمزية والتأريخية؛ تنتعش فيها الروح الوطنية المتعايشة مع نزعة توسعية هي أكثر ما تخشاها أوروبا، لاسيّما حين تعود بها الذاكرة إلى استذكار مغامرات القياصرة والسوفييت معاً.
أجل، تعيش روسيا مشكلة على مستوى الاقتصاد رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة، ولم تستطع حتى الآن أن تجرّب الانعطافة العظمى التي جرّبتها الصين بنجاح باهر، بل ليس بمقدورها منافسة تجربة حديثة مثل الهند والبرازيل، وحتى اندونيسيا وربما فيتنام، وإن كانت ما تزال متفوّقة عليها في الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما تسعى موسكو لتعويضها بالعسكرتارية والسياسة، بخاصة جهودها لنسج محور الشرق القائم أساساً على تحالف روسي - صيني، يمكن أن تنتمي إليه قوى
أخرى.
استحضار هذه العناصر يجرّ إلى توازن الصورة بين التحليلات المستعجلة من الجهتين؛ من يبالغ بقوّة الغرب وقدرته، ومن يستخفّ بعناصر القوّة الروسية ويسقطها من الحساب تماماً، وإن كان الغرب (وأقصد به الغرب السياسي دائماً) يتعامل مع روسيا بقسوة، تشهد عليها كثافة العقوبات المفروضة عليها، وتعقيد المشهد من حولها.
الحل الكيسنجري
ليس من الواضح للآن في ما إذا كان بمقدور الغرب تنفيذ ستراتيجية: "النصر المستحيل" ضدّ روسيا أم لا؟ لكن بالعودة إلى منظّر متشدّد مثل زبنغيو برجنسكي (ت: 2017م)، يسجّل أن روسيا بدون أوكرانيا لن تكون قوّة عظمى، وهذا ما يفسّر ربما حماس بوتين في حربه الحالية ضدّ أوكرانيا.
لكن على الضفة الأخرى برزت مبادرة هنري كيسنجر، وقد شهدت آراؤه تحوّلاً كبيراً. فقد سبق له أن عرض مبادرة في شهر أيار الماضي، تقضي بتنازل أوكرانيا عن المقاطعات التي تطالب بها روسيا، مقابل السلام، ما أثار عليه غضب زيلينسكي شخصياً، عندما وصفه بأنه "عدو أوكرانيا".
أما اليوم فالعناصر الأساسية لمبادرته، تقوم على أساس قبول روسيا بانضمام أوكرانيا لـ"الناتو"، مقابل اعتراف غربي بدور روسيا في النظام العالمي، ولاسيّما في مركز أوروبا وشرقها، شرط أن يتزامن ذلك كله بانسحاب قوّات روسيا من أوكرانيا، وترك المناطق المتنازع عليها لدبلوماسية التفاوض.
الغريب أن كييف صمتت هذه المرّة، والأغرب منه أن بوتين وعد بدراسة المبادرة وقراءتها بتأنٍ، ما قد يعني أفقاً جديداً قد يفتح طريقاً للحل.
لا يمكن عزل أفكار أي إنسان عن خلفياته، وهذا ما يصحّ على برجنسكي المنحدر من أزمة عميقة ضدّ روسيا ناشئة عن أصوله البولندية، في مقابل مرونة لدى كيسنجر لا يمكن أن تكون بعيدة عن أصوله الألمانية، والأهمّ من ذلك خبرته المعروفة في تدوير الزوايا الحادّة بدبلوماسية "الخطوة خطوة"، وحثه على التفاوض الذي قد يدوم سنوات، بعد أن تهدأ المعارك.