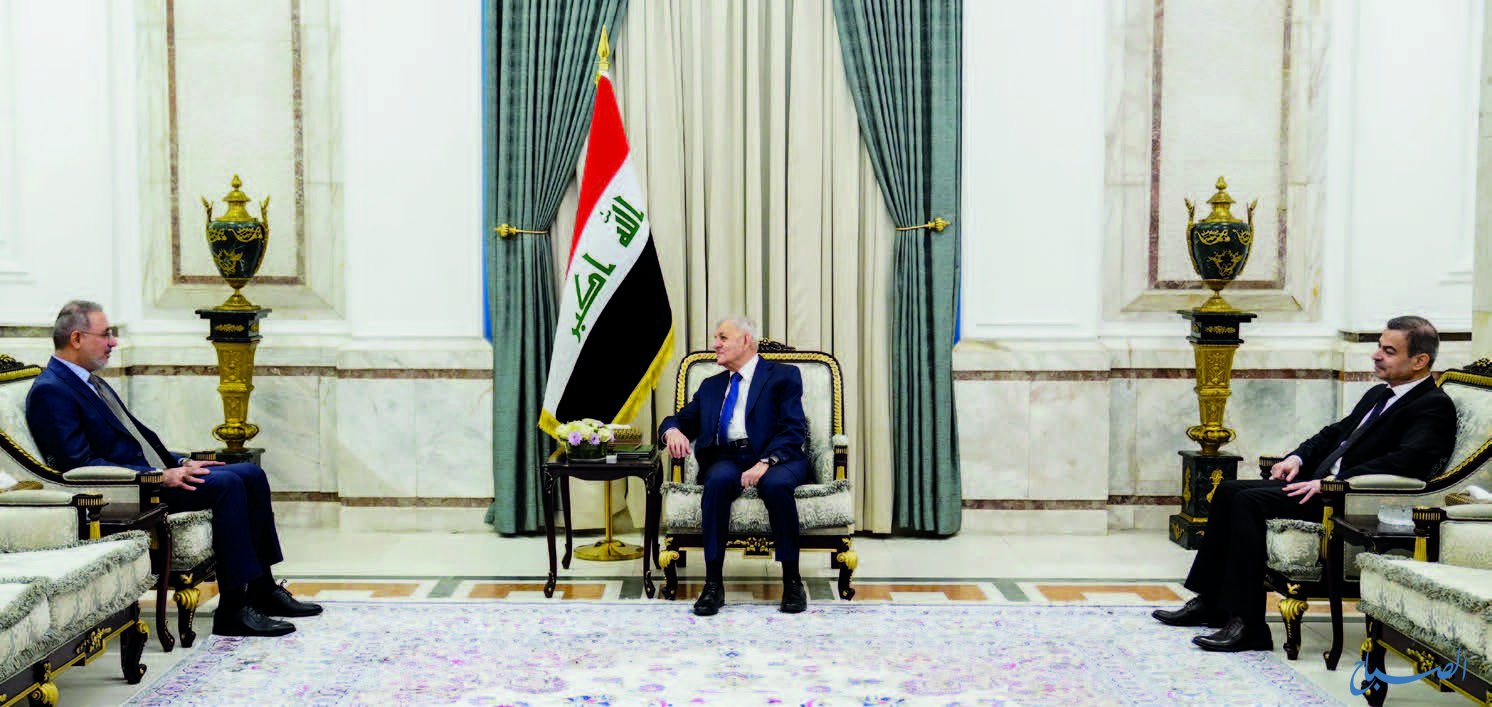عبد الكريم كاصد: الشك والنوايا في رهان الستينات { 3 - 1}

كريم شعلان
سبق وأن أشرت إلى كتاب - رهان الستينات، نقد البيان الشعري- للشاعر عبد الـكريم كاصد، حيث نبّهت لأهميّة هذا الكتاب وضرورة التوقف عنده، لما يطرحه من قضايا اعتبرها خطيرة وبالغة الأهميّة. تكمن أهميّة هذا الكتاب في إيغاله وتفكيكه لأهم بيان شعري ظهر خلال مرحلة الشعر العراقي في القرن الماضي، وأقول: أهم بيان، ليس لكونه مادة فاعلة أو إضافة إيجابيّة مساهمة في تطوير الشعرية العراقيّة، بل لكون المرحلة تلك كانت في صراع وتجاذب بين الأجيال في العراق من جانب وبين شعراء المناطق العربيّة الأخرى من جانب آخر، لذا كان البيان محاولة لسد حاجة أو فراغ كان يعاني منها المشهد الشعري العربي لتداخل والتباسات سادت الشعرية العربيّة بعد مرحلة الرواد. لكن السؤال هنا: هل حقق هذا البيان مبتغاه، أو ما يرتضيه الواقع حينها؟
هذا ما يقوم بالإجابة عنه الشاعر عبد الكريم كاصد.
ظهور البيان الستيني بمجموعة من أسماء شعريّة لها حضورها - رغم الاختلافات الكبيرة بين الأعضاء من جوانب وتوجهات على مستوى الفن الكتابي والتوجه الآيديولوجي- إلّا أن البيان جمع هذه الأسماء بمشترك واحد، هو تعريفات ومحاولات لإيجاد صيغ لتسمية الشعر وتجنيسه ضمن ضوابط مُتّفق عليها فيما بينهم، على اختلاف توجهاتهم: "سامي مهدي، فاضل العزاوي، فوزي كريم، خالد علي مصطفى".
جاء البيان ليشكّل محاولة لناقوس يُشير لهذه الأسماء بغضّ النظر عن قيمته المعرفيّة أو الدلاليّة (البيان) لكن هل أيقظ هذا الناقوس الوعي الذي يصبو لمعرفة الكثير عن عوالم الشعر وما يحيطه من أسئلة وشكوك؟
وعي الشعر العراقي والعربي في تلك المرحلة التي تركها السيّاب ومجايلوه من الروّاد والتي كانتْ تنذر عن تغيرات بتأثير الأوضاع على كلّ المستويات الحياتيّة في العراق وخارجه والتأثرات بالمدارس الشعريّة الغربيّة.!
هذا السؤال وغيره، هو ما جعلنا ننتظر مَن يحمل الإجابة والشهادة اللتين يُفترض أن يكون حاملهما مُعاصرا لتلك المرحلة.
من جانب آخر بعيد عن البيان وصنّاعه، يأخذنا الشاعر كاصد إلى مقتطفات من ترحاله وتنقلاته بين الأمكنة التي كانت ملاذا ونوافذ أمل في البحث عن الحريّة في الكتابة والحياة عموما، وبين تلك الرحلة الشيّقة المكتوبة برشاقة حرفيّة عالية، تطالعنا أسماء كبيرة في عالم الأدب العربي، كان الكاصد يمرّ عليها سريعا بذكر الأسماء والمواقف، لكنّها تبقى في ذاكرة المتلقي حاضرة لما لها من حضور ونتاج أدبي مؤثّر.
الصادم في هذا الكتاب والذي أثار أسئلة كثيرة من الوسط الثقافي والمتابعين، هو واقعة ساعة الشهيد سلام عادل ودور البعثي سامي مهدي في تعذيب الشهيد والتباهي في مشاركته في تعذيبه وسرقة ساعته اليدويّة التي بقيت في معصمه مفتخرا بها.
أسئلة كثيرة ممكن أن تُطرح للشاعر كريم كاصد، بخصوص محتوى الكتاب ومدى ثبوت حقائق توثيق ماتضمّنه الكتاب وما جاء بين السطور من خلال قلمه الذي كان حادّا في ذكر الأحداث، ومثقّفا في تفكيك البيان بضوابط نقديّة مُقنعة إلى حدّ بعيد.
بناءً على ما جاء، كان لي هذا اللقاء أو الحوار مع الشاعر والمترجم كريم كاصد بعد أخذ موافقته -مشكورا-، لغرض تسليط الضوء على النوايا وجعل الشكوك في مرحلة اليقين، لكوني أرى فراغا بين صفحات الكتاب، ذلك الفراغ هو صنيعة المتلقّي المتوجّس الباحث عن البراهين لجعل الشكّ يقينا.
س1 - هل كان القصد من تفكيك البيان الستيني، وإظهار اخفاقاته، هو فتح نافذة لفضح المشهد الشعري والثقافي آنذاك بشكل عام وممثليه.. بالأخص الأسماء الأربعة في صياغة البيان لما ترى لهم من أدوار في نشر بيان مليء بأخطاء في جوانب مختلفة – كما ذكرت بالتفصيل – وما لبعضهم من جرائم مرت بصمت ومن دون عقاب؟
بعد إكمال دراستي الجامعية قي قسم الفلسفة والدراسات الاجتماعية في جامعة دمشق عدتُ إلى العراق أواخر عام 1967 وتمّ تعييني مدرسًا لعلم النفس في معهد المعلمين عام 1968.
وحين صدر البيان الشعري في مجلة "شعر 69 " لاقى ردودًا أغلبها ذات طابع صحفيّ من دون التوقف عند تفاصيله الكثيرة التي تستدعي الردّ، ولاسيما في الجانبين الفلسفي وعلم النفس الذي كنت أدرّسه وأحرص على قراءة كل ما يصلني منه تأليفاً أو ترجمة.
وما أدهشني أكثر أن البيان لم يتورع، فضلا عن أخطائه، من استعارة بعض المقاطع مما هو منشور في كتبٍ لينسبها إليه، فوجدتني مضطرّا إلى الكتابة في ما هو مدعاة للجدل حقّا، لاسيما أن للبيان تأثيره الواضح آنذاك في الوسطين الأدبي والسياسي، رغم ما تربطني من علاقة طيبة بالشاعرين فاضل العزاوي وفوزي كريم هذه العلاقة التي نمت فيما بعد إلى ما هو أعمق وأشدّ آصرةً.
وكان ردي قد استغرق آنذاك أكثر من 20 صفحة في مجلة "الثقافة الجديدة" التي نشرته مع مقدمة احتفائية لهيئة التحرير.
لم يتلقّ المقال أي نقد، أو إشارات مستفزّة مثلما جرى مع المقالات المنشورة الأخرى، وكان صداه كبيرًا في الأوساط السياسية والثقافية.
بعد نشره بفترة قصيرة صدر عدد أو عددان من مجلة "شعر 69" لتعلن، إثر ذلك، عن توقفها نهائيًا.
في تلك السنة ذاتها حان وقت رحيلي إلى الجزائر للتدريس، غير أن السنوات الخمسين التي أعقبت نشر البيان شهدت صراعات وصدور الكثير من المقالات والكتب التي لم تستوقفني كثيرًا، فلي انشغالاتي الأخرى في المنفى، لكن ما استوقفني حقّا هو الاحتفاء، في السنوات الأخيرة، بالبيان مجدّدًا من خلال المقالات التي قرأتها، مع ذلك لم أجد لديّ الحافز لنشر ما كتبت سابقًا أو تضمينه في كتاب، أو العودة إلى الموضوع ثانيةً، ففي المنفى ما يستغرقك ولا يدع لك متّسعًا لعودةٍ قد تكون غير مجدية.
الحدث الذي جعلني أعود لا إلى البيان، وإنما إلى واحد من أصحابه، هو رحيل أخي وصديقي الشاعر ممدوح عدوان.. هذا الرحيل الفاجع الذي دفعني إلى كتابة قصيدتين عنه، ومقالة استدعيت فيها لقائي به في البصرة مرات عديدة من بينها لقاءان بصحبة الشاعر علي الجندي وأصدقاء حميمين يحملون محبة كبيرة للضيفين العزيزين.
في المقالة المنشورة في الحوار المتمدن 19/ 12/ 2006 أي بعد اللقاءين بما هو أكثر من ثلاثين عامًا.
أوردت تفاصيل اللقاءين كما شهدتهما، وكما شهدهما أصدقاء، بعضهم لا يزال حيّا هو الناقد المعروف "جميل جاسم الشبيبي" الذي يمكن الرجوع والاتصال به في صفحته عبر الماسنجر.
من بين هذه التفاصيل حادثة الساعة التي فاجأت الجميع.
كان ذلك في أوائل السبعينات في أثناء انعقاد المربد، إذ جاء الضيفان في اللقاء الأول بصحبة شاب أنيق قدمه الضيفان بصفته دكتورًا ولكنهما أسرّا لنا بأن من يصحبهما هو مخبر للسلطة، لذا اقتصرت الجلسة على النكات والمرح البهيج الذي عُرف به عليٌّ وممدوح فلم يتركا مجالا حتى للصمت أن يحلّ ثانية واحدة، وكان هذا الدكتور الأنيق اللطيف حين ودعنا في غاية السرور؛ لأنه لم يضحك ولم يُسرّ في حياته مثلما ضحك وسُرّ في تلك الليلة، كما أفضى إلينا بذلك، حتى أشفقنا عليه وقلنا ما الذي سيكتبه وقد خرج من الجلسة صفر اليدين؟
أما اللقاء الثاني الذي جرى بعد سنة فكان بصحبة ممدوح وعلي الجندي مَنْ هو أشهر من أن يشيرا إليه ألا وهو : الشاعر سامي مهدي الذي أغاظه مفتتح الجلسة المرح الصاخب ليفاجئنا بساعة سلام
عادل.
لقد ذكرت ما شهدته بعينيّ، فليس من المعقول أن أذكر الجلسة ولا أشير لهذه الحادثة المروّعة التي ذكرتها في كتابي، تجنّبًا لردود موتورة توقعتها من أطراف عديدة قد يكون من بينها أطراف صديقة لها مصالحها الخاصة وتاريخها الخفيّ.
بعد كتابتها بسنوات التقيت بـ "جميل جاسم الشبيبي" في البصرة فلامني لأنني لم أذكر حوار الصديق الصحفيّ "جعفر موسى" الذي كان حاضرًا، مع سامي مهدي وإدانته له باعتباره كان أحد الذين مارسوا تعذيب الشهيد سلام عادل، في قصر النهاية، وردّ سامي مهدي بأنه كان شاهدًا وليس جلادًا، وإصرار جعفر على أنه كان جلّادًا أيضًا.
قلت لجميل أنني لست في وارد نقل تفاصيل هذه الواقعة، لأنني في حضرة صديق ميت أرثيه هو ممدوح عدوان، ولكن قد تحين فرصة أخرى للحديث عن هذا التفصيل الذي ذكرته.
كان نشر المقالة كما قلت قبل 17 سنة وكان سامي مهدي حيّا وعلي الجندي أيضًا وآخرون من بينهم جميل جاسم الشبيبي الذي أتمنى له العمر الطويل، وجاسم العايف الذي أورد حوار جعفر مع سامي مهدي في عدة أماكن ولا أزال أحتفظ بنص له عن هذه الواقعة سأرفقه هامشًا في آخر إجابتي هذه.
كيف يمكن أن أختلق حادثة شهودها حاضرون وبأي وجه سألاقي على الجندي صديقي الحميم إن كان هذا اختلاقًا؟
دع عنك الآخرين من الأحياء! ولكن يبدو أنهم اعتادوا الاختلاق والأكاذيب حتى حسبوا أن ممارستها شيءٌ طبيعيٌّ في سلوك البشر.
قد يظن البعض أن سامي مهدي لم يكن على علم بمقالتي المنشورة وللرد على هذا الظن أورد ما كتبه الصديق الشاعر معتز رشدي في صفحة الصديق كامل عبدالرحيم بتاريخ 4/ 9/ 2022:
* لماذا حملة التشكيك بما قاله الشاعر عبد الكريم كاصد؟
المسألة بسيطة، البساطة كلها؛ نشر الرجل مقالته في موقع الحوار المتمدن، في 2006! لماذا لم يرد عليها سامي مهدي المفعم بالحياة، حينذاك؟
أنا نفسي سألت سامي مهدي من على صفحة الشاعر إبراهيم الماس، عن ذلك، وأرفقت له المقال المنشور في صفحة الحوار المتمدن، هل تعلمون ماذا كان رده؟
رد، بما يلي" الظاهر عدكم حلف عائلي"!!!! وهي إجابة شديدة الصفاقة عن موضوع حساس يهمه شخصياً، ويهمنا، نحن، أيضاً.
هل كان ينتظر وفاته- مثلاً- حتى نقوم بتكذيبها، بالنيابة عنه؟
لماذا لا يكذبها خدينه الآخر أبا بادية، أي حميد سعيد؟
وهو أعلم من الله نفسه بأفعال خدينه المتوفي"
لم يكتف معتز برده هذا، بل أرفق رابط المقالة ليطّلعَ عليها القارئ.
وعودة إلى سؤالك عن فتح نافذة لفضح المشهد الشعري الذي يمثله موقعو البيان فإنّ من فضحهم هم أنفسهم من خلال كتاباتهم فبعضهم لا يعتبر البعض الآخر شاعراً إطلاقا ( رأي فاضل العزاوي بفوزي كريم وسامي مهدي، رأي خالد علي مصطفى بفاضل العزاوي) والأغرب من ذلك أن الشاعر الذي يجمع عليه جميع هؤلاء هو خالد علي مصطفى الذي هو بينهم أضعفهم وأبعدهم عن الشعر.
شهادة جاسم العايف:
التقاعد حق لكل موظف خدم الدولة، مهما كانت تلك الدولة، ومسألة دستورية لا غبار عليها، باستثناء مَنْ يمنعهم القانون من هذا الأمر.
ولكن فقط أريد أن أؤكد إنني على علاقة وثيقة جداً بالصحفي الراحل (جعفر موسى علي- وسأكتب عنه يوماً ما - وللأمانة والتاريخ إنني سمعته يتحدث عن (ساعة الشهيد سلام عادل) وحواره مع الشاعر (سامي مهدي) حولها، ونحن نجلس على (دكة) مقهى ( أبو مضر) بحضور بعض الأصدقاء، وقد شرح الراحل (جعفر موسى علي) بدقة، معروفة عنه هذه المسألة بألم شديد، لا بل كرر حديثه حولها أكثر من مرة في جلساتنا الخاصة، في النوادي الاجتماعية الموجودة حينها في المدينة، خاصة "جمعية الاقتصاديين العراقيين فرع البصرة" والتي كنا نتردد عليها دائماً.
س2 : - كيف جاءت فكرة كتابك "رهان الستينات"؟
اتصل بي الصديق الفنان والروائي حازم كمال الدين ليخبرني أنه اقترح اسمي للاسهام في مجلة "عالم الكتاب" المصرية للكتابة عن جيل الستينات وأنّ رئيس تحريرها الدكتور زين عبد الهادي سيتصل بي، وبالفعل تمّ هذا الاتصال ومما جاء في رسالة الدكتور زين عبدالهادي ما يلي: "وأرى ان تكون الكتابة عبارة عن شهادة عن اعمالك واعمال مجايليك، هذا يسد نقصا شديدا في الوعي، نحتاج اليه لاعادة اللحمة بين ابناء الوطن مهما كان شتاتهم، ولذلك نترك للكاتب الحرية في الاختيار بين الشهادة وبين الكتابة عن الشعر او الرواية او القصة القصيرة واهم ماصدر وبماذا كان فارقا.... كما اننا نخطط ايضا لاصدار كتاب يظل حاضرا في المكتبة العربية والعالمية عن هذا الجيل العظيم".
وحين قلت له أن شهادتي قد تكون بحدود 100 صفحة أبدى سروره بذلك.
كانت فرصة لأدلي بشهادتي عن الحياة الأدبية في سورية والعراق وعن أهم حدث أدبي في الستينات ليستغرق ذلك الفصل الأول مُلحِقًا به البيان الشعريّ، وما كتبته عنه منذ أكثر من خمسين عامًا، عندما كان لي من العمر 22 سنة، لتكتمل الصورة لدى القارئ وليدرك أن ما كتبته من تقييم لم يكن وليد اللحظة المتأخرة، والتذكر الغائم، والمراجعة المتعمّدة، وأنما هو وليد تلك اللحظة الراهنة آنذاك وانعكاساتها، وما رافقها من ظروف، ورهانات أثبت التاريخ بطلانها وخساراتها؛ وإن ما يسمى بالأجيال وتجانسها، إنما هو وهم الغرض منه خلط المفاهيم والرؤى الفكرية والشعرية معًا، والتبرئة من جرائم واقع بوهم الشعرـ ورهاناته الخاسرة.
ولم يكن الضجيج الذي رافق البيان غير صمتٍ يخبئ الكثير من الإدانة، وأن الحرية المزعومة لم تكن إلا وجها آخر لسلطة لا تقيم للأدب والإنسان وزنًا أبدًا، وليس ما رافق هذه الظاهرة من بهرجة إلا عرسًا يتيمًا يخفي مأتمه معه، وكان أول من أحالوا هذا العرس إلى مأتم هم القائمون به، وهذا ما كشفتْ عنه نقاشاتهم التي لم تكن حوارًا بل شتائم بينهم لا تراعي للفكر أو الشعر قيمة أبدًا.
ويبدو أن هذا الضجيج وهذه البهرجة لم يتخلّ عنهما من تصدّوا للتعليق على ما كتبتُ فاستمروا بالحماقة ذاتها.
لقد كان سامي مهدي أذكى بكثير من المدافعين عنه، في صمته، عن واقعة معروفة لايستطيع إنكارها كلَّ هذه السنوات، بينما أثبت هؤلاء غباءهم بعد رحيله، وإذا ما استمروا في غبائهم فسيجدون هناك من الشهادات ما تدينهم هم، ولعل أبرز سمات هذا الغباء هو أنهم لم يقرأوا الكتاب، ومحاولتهم إيهام القارئ بأن كتابي صدر بعد رحيل سامي مهدي، رغم صدور المقالات العديدة في الصحف العراقية والمواقع الإلكترونية، في أثناء حياته، عن الكتاب وعنه بالذات فلم يردّ أيضًا.
والأدهى من ذلك أنهم في دفاعهم عن سامي مهدي وإنكارهم يحاولون عبثًا تجاهل وقائع معروفة في الوسط الأدبي لا تقلّ بشاعة عن حادثة الساعة أشعر بالاسف لاضطراري الإشارة إليها.