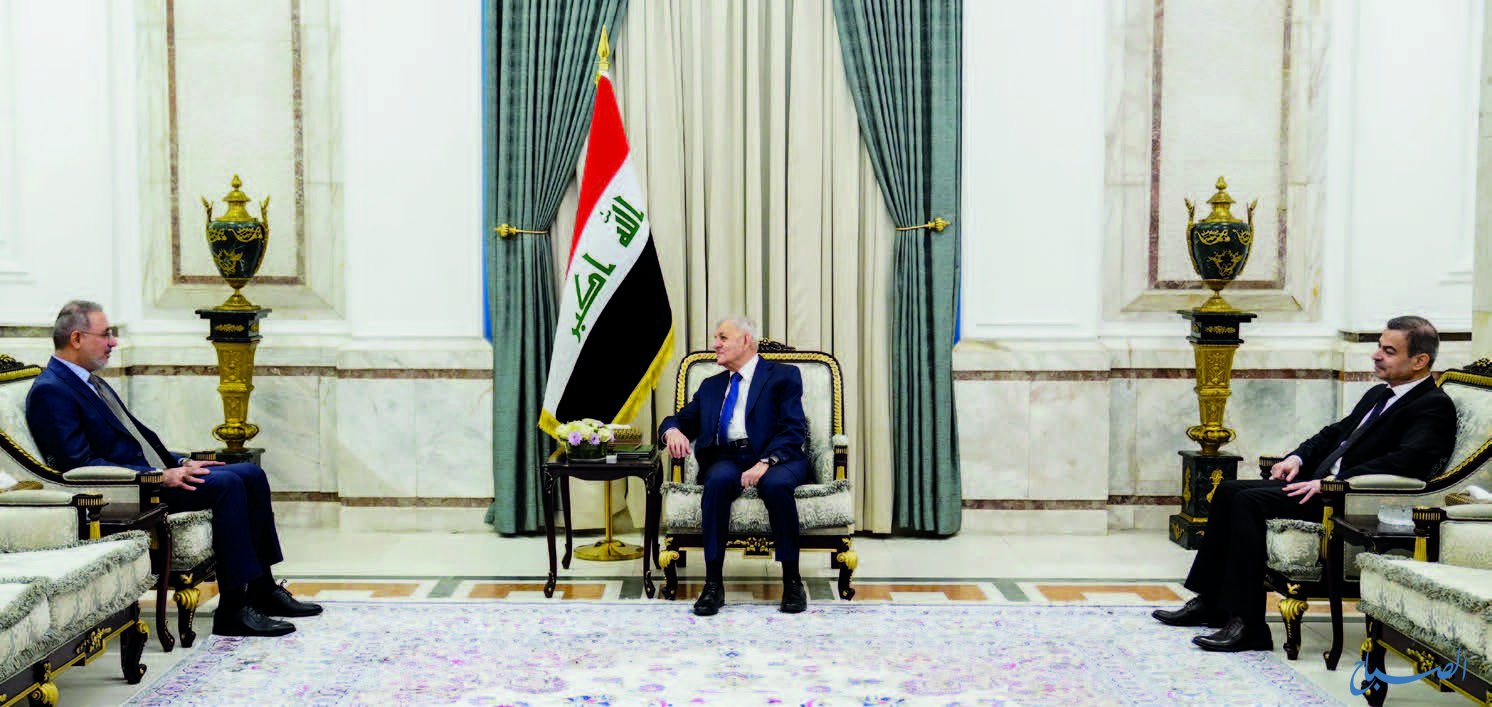عبد الكريم كاصد: كيفَ ننصحُ الأجيال في ظلِّ هذا الوضع الأكثر ظلاماً؟ {3-3}

كريم شعلان
سبق وأن أشرت إلى كتاب - رهان الستينات، نقد البيان الشعري- للشاعر عبد الـكريم كاصد، حيث نبّهت لأهميّة هذا الكتاب وضرورة التوقف عنده، لما يطرحه من قضايا اعتبرها خطيرة وبالغة الأهميّة.تكمن أهميّة هذا الكتاب في إيغاله وتفكيكه لأهم بيان شعري ظهر خلال مرحلة الشعر العراقي في القرن الماضي، وأقول: أهم بيان، ليس لكونه مادة فاعلة أو إضافة إيجابيّة مساهمة في تطوير الشعرية العراقيّة، بل لكون المرحلة تلك كانت في صراع وتجاذب بين الأجيال في العراق من جانب وبين شعراء المناطق العربيّة الأخرى من جانب آخر؛ لذا كان البيان محاولة لسد حاجة أو فراغ كان يعاني منها المشهد الشعري العربي لتداخل والتباسات سادت الشعرية العربيّة بعد مرحلة الرواد. لكن السؤال هنا: هل حقق هذا البيان مبتغاه، أو ما يرتضيه الواقع حينها؟
هذا ما يقوم بالإجابة عنه الشاعر عبد الكريم كاصد في الجزء الثالث والأخير من الحوار الذي يسلط الضوء على النوايا وجعل الشكوك في مرحلة اليقين تجاه كتابه «رهان الستينات، نقد البيان الشعري.
س5 كم سامي مهدي بيننا الآن من الأحياء، أو الأموات الذين يؤرّخ لهم البعض ويجمّلهم عنوةً؟
إذا كان ما تبتغيه الفاشيات التي مرت في التاريخ هو الولاء التام فإنَّ البعثيين ازدروا هذا الولاء، وتجاوزوه إلى ما هو أبعد منه: الولاء القسريّ، حتى من أشدّ الموالين لهم للوصول إلى منطقة الخضوع التام من خلال أرذل الوسائل، وليس أدل على ذلك من اغتصاب النساء، لا نساء أعدائهم وحدهم، بل وحتى نساء موالين لهم من مسؤولين في أعلى المناصب الحكومية لضمان خضوعهم الأبديّ بتعبير دستويفسكي، عندئذٍ سيكونون في منأى عن التفكير في صدق هذا الولاء أو عدمه، وعن الغوص في أعماق من يحيطون بهم، فلا وقت لديهم للغوص، لأنَّ لديهم ما يشغلهم عن سفاسف السيكولوجيا، وهم القادمون من أطراف المدن المنسية وبوادي البلاد.
(يمكن الرجوع في ذلك إلى عشرات الشهادات المرعبة في وسائل الإعلام العديدة).
في الولاء القسريّ لا مجال للأسئلة، أو وجع الرأس في أيّ فعل قادم، وفي الاستباحة لا مجال هناك لشرف أو أيّ قيمة عليا غير قيمة الفعل ذاته، وإن كان الفعل في أشدّ دناءاته، وهذا ما منح أراذل الناس قوةً، أو بعبارة أدقّ، سلطة لإشاعة الخوف، ومسخ شخصية الآخر، وشمول الإرهاب الذي لم يقتصر على عامة الناس، بل شمل حتى المنتمين منهم ومن هم في قمة المسؤولية، وقد تمّ بالفعل إعدام العديد منهم في محاكمات علنية مموّهة نقلت في وسائل الإعلام، وعرضت في قاعة سينما النصر ببغداد لأيام عدة على منتسبي الحزب الحاكم لبث الرعب في نفوسهم والمصير الذي ينتظرهم، وهذا يتطلب إعلامًا رهيبًا لن يستطيع القيام به سوى شعراء وكتّاب قادرين، يبدون وكأنهم في هامش السلطة، لكن تأثيرهم الإعلامي اليومي يجعلهم في القلب من الأحداث وإرهابها المشاع.
ولأن الإعلام يتطلب دقة وشمولية لا يمكن أن يجيدهما إلا القليلون من الكتّاب، لذلك فهم دائمًا في الميزان، وإن امتثلوا، وقد يكونون ضحيتهما ايضًا، فمثلما كلّ شيء خاضع للضرورة، فإن هناك متسعًا للمصادفات التي تطيح بكل شيء حتى بمن هم أشدّ ولاءً للسلطة من الكتّاب والشعراء.
يسألون كيف يلوّح جلّاد أو شبيه الجلّاد، شاعرًا كان أو غير شاعر بساعة الضحية في جلسة شرب، ولا يسألون عما جعل هذا الشاعر أو غير الشاعر جلّادًا أو شاهدًا لجلسة تعذيبٍ، ومهرجًا في جلسة شرب.
هل سأل هؤلاء المستعبدون مدمنو العبوديَّة عمّا هو أقرب، أقصد اغتصاب نسائهم واستعبادهم؟
أمّا المقابر الجماعيَّة، والتهجير القسريّ لشرائح عراقيّة واسعة، ودفع الملايين من الناس إلى المنافي هربًا من موت محقق أو سقوطٍ فكريّ، والحروب الدموية داخل العراق وخارجه، فهي ليست سوى تصورات لا أثر لها في واقع.
إنهم يفرغون جغرافيا بلد بأكمله من أي أثرٍ يشير إليها، وكأنهم يمحون أسماء مدنه وبشره من خريطة مرسومة، وفي المحصلة لا واقع هناك سوى تصوراتهم هم.
هؤلاء لا يرون حتى السطح لأنَّ وضوحه الشديد لا تتحمّله أبصارهم المشبّعة بالذل والجريمة.
هؤلاء صنفان: منفيون ارتدوا قناع الضحية ليحوزوا الكثير من المنافع في المنفى، من خلال علاقاتهم، وولاءاتهم، ومقاولاتهم، أو مقيمون في الوطن في مناصب عليا، وهم، منفيين ومقيمين، سينقلون مهاراتهم إلى أماكن جديدة بأساليب أخرى؛ ولن يتحرّجوا حتى لو كانت هذه الأساليب هي الأساليب السابقة العتيقة؛ لأنَّ ثمة بيئة تقدم لهم كل ما يساعدهم على النماء مبرئين لا تعنيهم الفضائح ونشر غسيلهم، لذا ينبغي عدم الكفّ عن فضحهم وفضح أساليبهم وإصرارهم، رغم كل تاريخهم المريع، على الردود الوقحة حتى في أسوأ اشكالها تواطؤا وانحطاطًا مع النظام الحالي، ولعب دور الضحية القادرة على الافتراس فيما بعد.
إنّهم الآن ينقلون خدماتهم إلى السلطة الجديدة التي أصبحت قديمة، مستفيدين مما تقدمه لهم من وسائل يحسبون أنها قادرة على مواصلة خداعهم، وتزيين ما لا ينفع معه حتى التحنيط، ولكن هيهات لأنهم مهما مكروا ولعبوا أدوارهم الجديدة الموكلة لهم فهم هم، لا ينفع معهم دور ولا مسرح لأنّ الواقع أخبث من مسرحهم، تتصدره كتاباتهم القديمة وأشعارهم وعبوديتهم.
س6 كيف ننصح الأجيال - في ظلّ الوضع الأكثر ظلامًا الآن - لتحاشي ظهور رموز شبيهة لما أفرزته مرحلة البعث المنقرضة؟
سألخص لك ما يمكن أن تعدّه إجابة غير مباشرة على ما طرحته في هذا السؤال.
في دمشق تعرفنا أنا وصديقي الشاعر الراحل مهدي محمد علي على موظف شاب مسؤول في مكتبة تراثية شهيرة يرأس فيها قسمًا خاصّا لمن يعدّون لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير، وهو لعمق علاقته بي وبمهدي خاصة دعانا إلى زيارة هذا القسم وتوفير ما نحتاج إليه من مصادر ومخطوطات ليست في متناول اليد.
وغالبا ما يتوّج زيارتنا هذه بأقداح شايه اللذيذة الممزوجة بالليمون الذي يقتطفه من الشجرة الهائلة التي تظلل باحة هذا القسم من المكتبة.
أراد مرة مواساتنا على ما عانيناه ونعانيه في المنفى، ولا سيما بعد قراءته ما كتبناه من نصوص عديدة عن رحلتنا عبر الصحراء على جملين، ثم حشرنا مع عشرين هاربا في تنكر ماء للوصول إلى الكويت، فذكر أن عائلته عانت هي الأخرى من تسلط النظام في زمن الوحدة بين سورية ومصر، حين اقتحم رجال المخابرات بيتهم لإلقاء القبض على أبيه، إلا انهم فوجئوا بصورة عبدالناصر على الحائط في غرفة الاستقبال، والأب وهو يهتف بحياة عبد الناصر وبشعارات الوحدة، فأسقط ما في أيديهم، وهذا ما كان موضع فخر صديقنا الابن بهذه الماثرة التي لا نعرف ما موضعها من الافتخار، وبعد رحيل مهدي الذي ارتبط به بعلاقة حميميَّة أشدّ وأعمق من علاقتي به، إلى ليبيا للتدريس في مدارسها، بعد أن ضاقت به الحياة في دمشق، استمرت هذه العلاقة الحميمة عبر الرسائل المتبادلة بينهما إلا أنه فاجأني يومًا أنه يطلب مني ان أبلغ مهدي بقطع الرسائل.
لم أسأله لماذا؟
وإنما هو الذي سأل نفسه لماذا؟
ليجيب عن سؤاله: «لأن المخابرات تستنسخ الرسائل» وهو يخشى أن النظام الذي قد يأتي مستقبلا، لا النظام الحالي الذي يعيش تحت ظله آمنًا، سيطّلع عليها وهذا ما سيسبب له بلاءً عظيمًا، ولا سيما أنه يرتبط الآن بخطيبة.. إلخ. لم أندهش، ولكنني تخيلت دهشة مهدي حين سأؤكد له رغبة هذا الصديق الطيب المنبئ بتغيير النظام القائم حتى الساعة التي أكتب فيها هذا الرد، أي بعد ما يقرب من أربعين عامًا أو أكثر. ليس هذا موضوعنا، ولا سيما أن البقاء لله وحده، وإنما الموضوع أصحابنا الشبيهون بهذا الصديق وإن لم يملكوا طيبته على الأطلاق:
الناقد الذي ذكرته سابقًا، أعني الدكتور ضياء خضير، مثلًا، له كتاب عن سامي مهدي ناقداً، وآخر عن شعر حميد سعيد ومعلقته عن بغداد، وثالث بعنوان «شعر الواقع وشعر الكلمات» عنهما أيضًا، بصحبة شعراء بعثيين أو موالين للسلطة آنذاك كراضي مهدي السعيد مع إضافة اسمين أو ثلاثة من رعيل الرواد كالبياتي ونازك الملائكة، لتبدو اختياراته توسيعًا لمجاله الإيديولوجي الضيق الذي يتحرك فيه، وابتعادًا عن الإيديولوجيا في آن واحد، لكن محاولاته هذه باءت كلّها بالفشل فلم تفعل إلا على تعميق مأزقه، فهو يتناول راضي مهدي السعيد غير مطمئن إلى موقعه الشعريّ فتراه يراوح في مكانه بين مدح وذم على استحياء، ليخلص مرغمًا إلى استنتاجات لا يسبقها ما يمهد إليها من تحليل وفهم، على العكس من فزعه وهرولته مع سامي مهدي وحميد سعيد، لذلك كثرت في حديثه «لكن ولكنني» كلما اضطرّ إلى قولٍ كهذا القول: «نعم أن قصيدة راضي مهدي السعيد جميلة وحلوة ولا عيب فيها ولكنني أحسّ أحيانًا....إلخ» ص131 (لاحظوا «جميلة وحلوة» وموقعهما في النقد أيّ نقد)، أما إشاراته إلى سعدي يوسف الذي كتب عنه مقالات لا أدري هل جمعها في كتابٍ من كتبه أم لا، فهي تدلل على أنه ما زال مسكونًا بهذين الشاعرين (سامي وحميد)، دون غيرهما، من خلال عقد المقارنات المتعسّفة بين أشعارهما وأشعار سعدي يوسف، كما في مقالته «البحث عن خان أيوب» حيث لا تصح المقارنات أبدًا، وكأن هذا الناقد يعيش كابوسًا ورعبًا متواصلًا، لا يتخلص منه إلا بالإشارة إليهما. هذا الناقد هو شاعر وقاص أيضًا وإن لم أعرف منزلته في الشعر، لأنني لم أطلع على شعرٍ له، أو أتعرف على من يذكره في قائمة الشعراء، وإنما قرأت له ما ذكّرني بصديقي الدمشقي فهو يدعي بطولة وينسب إليه مآثر، لا نعرف موضعًا لها في المآثر حتى وإن بخست، عندما كان بعثيًا انتمى للحزب لغاية وظيفية، كما صرّح هو بنفسه، وعضوًا في الهيئة الإدارية في اتحاد الأدباء، وماثرته هذه هي وقوفه ذات يوم أمام صدام ناطقًا أو متأتئًا ببعض الكلمات وهذه ما سبب اضطرابًا في سماء البلاد وأجوائها فلم تُنقل الجلسة في شاشات التلفزيون، ولم يُعاقب، بل عوتب من قبل وزير الإعلام الأسبق «المهذّب» الذي اكتفى بالقول له: لماذا أزعجت الرئيس؟
مأثرة ما بعدها مأثرة.
أين منها مأثرة والد الصديق الذي أوقف رجال المباحث، وأوقعهم في حيص بيص.
أمّا مأثرته الأخرى التي أحالته إلى لجنة التحقيق فهي مطالبته في يوم الانتخابات التي جرت عام 1996 بأن تكون عضوية الاتحاد بالمستوى المطلوب.
يا سلام يا دكتور كلامك يزعج الرئيس فتُعاتب بأرق الألفاظ، وتُطالب بمستوى «مطلوب» فتُحال إلى لجنة تحقيق! حقّا.. إنها لشجاعة نادرة.
ليتك قلت لنا ما الذي تكلمت به أمام الرئيس لنعرف انزعاجه أولا ولنعرف مستوى المأثرة... مأثرتك ثانيًا.
أما مأثرة هذا الناقد الصنديد في الخارج فإنّها تكمن - كما يقول في المقابلة التي أجراها معه عبدالرزاق الربيعي المنشورة في مواقع عدة - في اختلافه عن الآخرين، وهذه ميزة الصناديد قاطبة، فهي أنه – كما قال بعظْمة أو عظَمة لسانه - «لم يرم بلده بالحجارة ويشتمه عندما صار خارجه» لماذا «لأني اعتقد أن موقف الدفاع عن البلد (ويقصد نظام البعث) وحماية بيضته ...... يختلف عن موقف شتمه واختصار كل ما فيه ومن فيه بشخص واحد أو مجموعة أشخاص». إذن المشكلة كل المشكلة هي في «حماية البيضة» من دون أن يدري وهو جلجامش العارف بكل شيء أن البيضة انكسرت عندما كان هو هناك قريبًا من رئيسه وحزبه. ولم يبقَ منها في منفاه إن كان منفيًّا، سوى قشورها.
يا ضياء خضير أيّها الذكي هذه القشور هي ما تكتبه عامدًا مفزوعاً معبّرًا عن ولاءٍ سمّاه سلام عبود في كتابه «ثقافة العنف في العراق»: إدمان العبوديَّة.
هذا هو واحد منهم يا صديقي كريم.
ويبدو أنَّ محاوره الربيعي ساورته شكوك بأقواله فسأله:
هل هناك براهين تؤكد صدق كلامك هذا؟
فكان جوابه - كجواب الصناديد عادة - أقرباؤه الذين أعدم النظام بعضهم وهروب أخيه المدرس، الذي كان شيوعيًّا، منذ 1976 وهو بذلك يريد رضى طرفين آخرين هما حزب الدعوة والشيوعيين، ويبرئ ذمته أمام أقربائه البعيدين وأخيه الشيوعي إن كان لا يزال شيوعيّا.
مع ذلك فلا يزال المدعو ضياء خضير متماسكا «يحمي بيضته».
وحين أجاب هاتفًا عن سؤال الربيعي المطالب بالبراهين: «إنني كنت وسأبقى عراقيا»
سأله محاوره:
بأي معنى؟
فأجابه كما يجيب البعثي الماكر المتمرس:
بمعنى أنني أشعر وأحس بما يشعر به سواد الناس
وما يريده أن يقوله حقًّا: «إنني كنت وسأبقى بعثيًّا»
هل تريد أن آتي بأمثلة أخرى:
ستراها في ردودهم على ما نكتبه الآن. سيخرجون كمن يخرج من القمقم ليدلي إلينا بصحف الأولين.
كيف ننصح الأجيال في ظلّ هذا الوضع الأكثر ظلامًا حيث الجميع يمكرون حتى الله؟
سينقرض هؤلاء وتنقرض الرموز الشبيهة لما أفرزته مرحلة البعث المنقرضة شاؤوا أم أبوا بنصائحنا أو عدمها فللواقع قوانينه إن لم يصنعها البشر فسيصنعها الواقع نفسه.
لعلّ هذا من بين أجمل ما قدمته الماركسية لمن نفضوا أيديهم من حاضر مقيت.