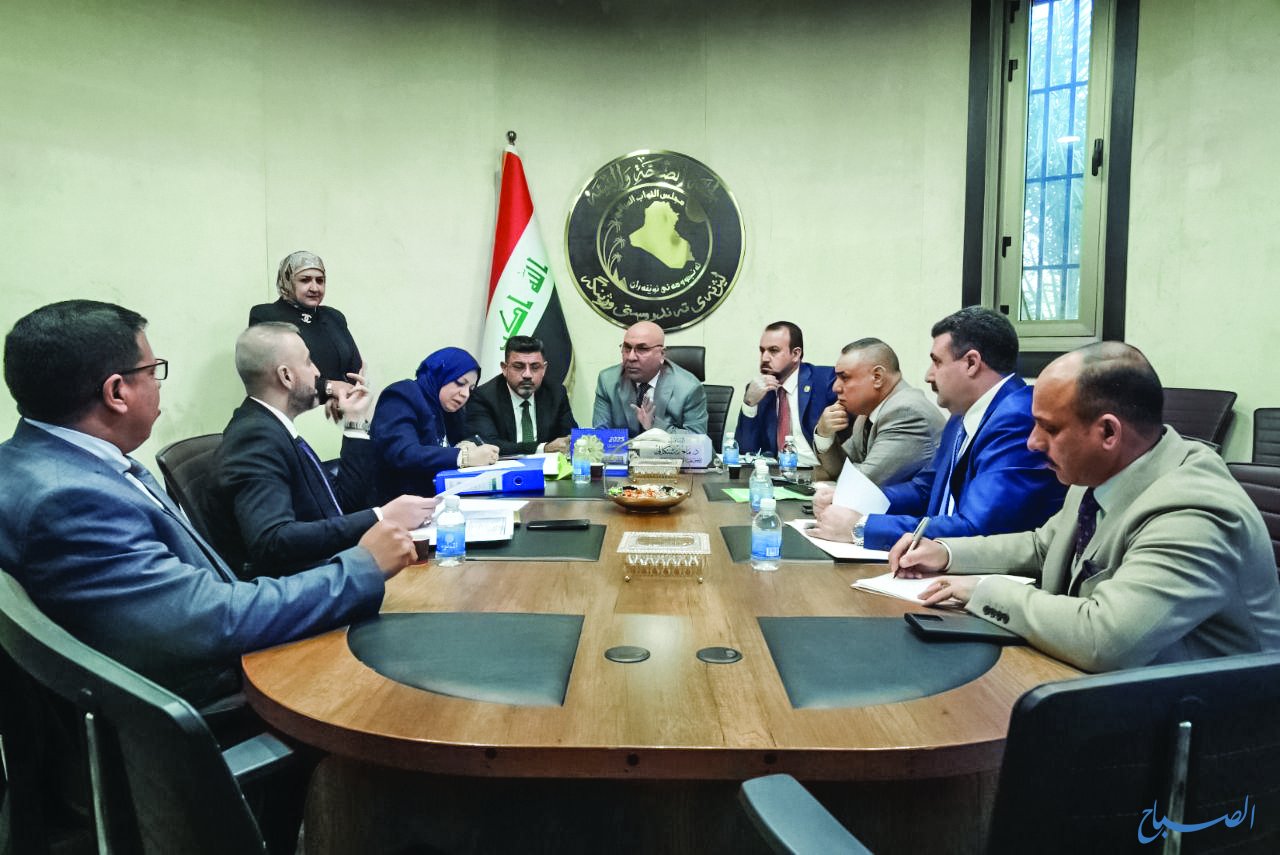ميلان كونديرا.. الفيلسوف الذي كتب الرواية

البصرة: صفاء ذياب
(ما يفترض أن يشغل اهتمامنا هو جنس الرواية وليس جنس من يكتبونها. إن كل الروايات العظيمة، كل الأعمال الصادقة هي ثنائيَّة الجنس. وهذا يحيلنا إلى القول بأنها تعبر عن كل من الرؤية الأنثويَّة والذكوريَّة للعالم. أما جنس الكتاب فهو شيء يقع ضمن خصوصياتهم ولا يجب برأيي أن يستدعي الأمر منا الالتفات إليه).
من مقولة الكاتب التشيكي ميلان كونديرا، يمكننا فهم فلسفته الخاصة في القراءة، أما الكتابة، فلها أبعادها الخاصة التي لا نستطيع استيعابها إذا لم نقرأ أعمال كونديرا الروائيَّة والنقديَّة والفلسفيَّة كسياق ثقافي كامل.
فهذا الفيلسوف الروائي، أو الروائي الفيلسوف، الذي رحل يوم أمس عن 94 عاماً تاركاً خلفه أعمالاً تجعله خالداً، فهو الكاتب الفرنسي من أصول تشيكيَّة، ولد في الأول من نيسان/ أبريل عام 1929، لأبٍ وأمٍ تشيكيين. كان والده لودفيك كونديرا عالم موسيقى ورئيس جامعة جانكيك للآداب والموسيقى ببرنو. تعلّم العزف على البيانو من والده، ولاحقاً درس علم الموسيقى والسينما والآدب، تخرّج في العام 1952 وعمل أستاذاً مساعداً، ومحاضراً في كليَّة السينما في أكاديميَّة براغ للفنون التمثيليَّة. نشر في أثناء فترة دراسته شعراً ومقالاتٍ ومسرحيات، والتحق بقسم التحرير في عددٍ من المجلات الأدبيَّة.
أما عن توجّهاته السياسيَّة، فقد التحق بالحزب الشيوعي في العام 1948، وتعرّض للفصل هو والكاتب جان ترافولكا عام 1950 بسبب ملاحظة ميولٍ فرديَّة عليهما، وعاد بعد ذلك عام 1956 لصفوف الحزب، ثمَّ فُصل مرَّة أخرى عام 1970.
نشر كونديرا في العام 1953 أوّل دواوينه الشعريَّة، لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، ولم يُعرف كونديرا ككاتبٍ مهمٍ إلَّا في العام 1963 بعد نشر مجموعته القصصيَّة الأولى (غراميات مرحة). وفي العام 1968 فَقَدَ وظيفته بعد دخول الاتحاد السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا، بعد انخراطه في ما سُمّي "ربيع براغ"، ليضطر للهجرة إلى فرنسا عام 1975 بعد منع كتبه من التداول لمدّة خمس سنوات، فعمل أستاذاً مساعداً في جامعة رين ببريتانى، وحصل على الجنسيَّة الفرنسيَّة عام 1981 بعد تقدّمه بطلبٍ لذلك إثر إسقاط الجنسيَّة التشيكوسلوفاكيَّة عنه عام 1978، كنتيجة لكتابته كتاب الضحك والنسيان. تحت وطأة هذه الظروف والمستجدات في حياته، كتب كونديرا (كائن لا تحتمل خفّته)، التي جعلت منه كاتباً عالمياً معروفاً لما فيها من تأمُلات فلسفيَّة، تنضوي في خانة فكرة العود الأبدي لنيتشه.
لم تكن روايته الأولى (المزحة) بعيدة عن كتابه (كتاب الضحك والنسيان) في بحثه عن فلسفته الخاصة، ليصدر بعدها عدداً من الروايات، منها: كائن لا تحمل خفته، الجهل، الهويَّة، حفلة التفاهة، الخلود، فالس الوداع، وغيرها.
أما عن كتبه النقديَّة والفلسفيَّة، فقد أصدر كتاب (الوصايا المغدورة)، و(لقاء)، و(فن الرواية)، كما كتب في المسرح والموسيقى وغيرها من الفنون.
الخلود.. مدخل لكونديرا
لم تكن رواية الخلود- عراقياً- مجرّد رواية لكاتبٍ جديدٍ على ثقافتنا، بل كانت مدخلاً مهماً لفهم عالم هذا الكاتب، فقد انتشرت هذه الرواية في العراق مطلع تسعينيات القرن الماضي، وغرابتها كانت أنّها تشتغل على عملين متوازيين في بناءٍ واحد، عمل يسرد حياة غوته، وآخر يسرد قصة شخصيات معاصرة، غير أنَّ التناوب في سرد الحكايتين جعلهما تترابطان للوصول إلى العمل النهائي الذي أراده كونديرا، وقد أثّرت هذه الرواية في الكثير من الروائيين العراقيين، حتى أنَّ أحدهم اقتبس بنيتها وألف رواية شهيرة وحصلت على جوائز عراقيَّة.
وعن الخلود، تتحدث الكاتبة سوار قوجه، قائلة إنَّ كونديرا يبسطُ في (الخلود) شخصياته وهي مُلتَفّة بنفحةٍ من السخريَّة والمقامات الجدليَّة، ومع ذلك هي شخصياتٌ كُتبَت بجذالةٍ فذّة. لكنَّها لم تُكتب بصورة سايكولوجيَّة، كما يرى البعض. إذ يقيم كونديرا الفرق بين الترجمة اللاتينيَّة لكلمة الإدراك بوصفه رشدًا حتميًّا لا مناص منه. والترجمة الألمانيَّة لكلمة الوطيدة، أي يقيم الفرق ما بين الأسباب والدوافع، فلأفعالنا جذورٌ في وعينا، لكنَّ كونديرا يرى أنَّنا نستعرض الدوافع، كما نمتلك أيضًا أساسات وقواعد متأصّلة في وعينا ومحفورة بطريقة تسيطر فيها على معظم سلوكياتنا. وقد يتساءل أحد أتباع المدرسة الفرويديَّة في علم النفس عن الدافع وراء تجنّب كونديرا الانخراط في الحديث عن اللا- وعي. وتقترح العديد من الفُكاهات في رواية «الخلود» حول (جاك لاكان) أن تجنّب كونديرا التطرُّق إلى فكرة اللا-وعي كان مُتعمّدًا!
وفي حديثه عن كونديرا، يرى الكاتب العراقي علي حسين أنّه في كل حديث عن جائزة نوبل يتذكر كونديرا مواطنه الشاعر التشيكي ياروسلاف سيفرت الذي حصل على نوبل عام 1984 وكان قد بلغ الثالثة والثمانين من عمره، ويقال إنَّ السفير السويدي عندما أراد إبلاغ ياروسلاف سيفرت بفوزه بالجائزة كان يرقد في المستشفى وقال للسفير بحزن: "لكنْ ماذا سأفعل الآن بكل هذه الأموال؟".
كونديرا المفكر
على الرغم من شهرة كونديرا روائياً، إلَّا أنَّه كمفكرٍ لا يقل شأناً، فقد كتب في الرواية والفلسفة والموسيقى، موضحاً في حديثٍ معه طريقة تفكيره: يجدر بالضعيف أنْ يتعلّم كيف يكون قوياً، ويرحل عندما يصير القوي أضعف من أنْ يستطيع إيذاء الضعيف. إنّ حياتنا اليوميَّة مفخّخة بالصدف وتحديداً باللقاءات العرضيَّة بين الناس والأحداث، أي ما نسمّيه المصادفات: والمصادفة هي لحظة يقع حدثان غير متوقّعين في الوقت نفسه فيتلاقيان. في أغلب الأحيان تمرُّ مصادفات كثيرة من دون أنْ نلاحظها إطلاقاً.
ويضيف: يمكنني القول ربَّما إنّ الإصابة بالدوار تعني أنْ يكون المرء سكراناً من ضعفه الخاص.. فهو يعي ضعفه، لكنّه لا يرغب للتصدي له، بل الاسترسال فيه. ينتشي بضعفه الخاص فيرغب في أنْ يكون أكثر ضعفاً، يرغب في السقوط أمام أعين الآخرين في وسط الشارع، يرغب في أنْ يقعَ أرضاً، تحت الأرض بعد.
فلسفته النقديَّة
على الرغم من أنَّ كونديرا بدأ شاعراً، غير أنَّ السرد سرقه من عوالمه الشعريَّة التي لم ينجح فيها على حدِّ قوله، فبدلاً من أنْ يكتبَ الرواية ويصمت، ظلَّ ينظّر للكتابة الروائيَّة وتقنياتها وكيفيَّة ولوج عوالمها.
ويرى الناقد الفسلطيني المعتصم خلف أنَّ كونديرا مسار رسم الرواية كتاريخٍ موازٍ للأزمنة الحديثة يعيد من خلاله رسم دوائر مغلقة حول علاقة الإنسان بالرواية. مفارقات عديدة جعلت من المغامرة في الرواية محاكاة ساخرة لنفسها، ومن الحرب في رواية «الجندي الشجاع شفيك» مادة هزليَّة، في حين كانت الحرب واضحة عند هوميروس وتولستوي وتملك أسباباً يمكن أنْ تؤطّرَ الحربَ بإطارٍ منطقي، مثل هيلين الجميلة والدفاع عن روسيا، في حين كان شفيك ورفاقه يتوجهون إلى الحرب من دون أنْ يعرفوا دافعاً لهذا التوجه. إذ إنَّ اكتشاف الروائيين لما يمكن للرواية وحدها اكتشافه وضعهم أمام مفارقاتٍ قصوى في علاقة الإنسان مع الزمن وعلاقته مع نفسه، وأمام فهمٍ أدقٍ لتغيّر معاني كلّ المقولات الوجوديَّة عبر مراحل التاريخ.
يعيد ميلان كونديرا الحديث عن احتمالات نهاية الرواية في رؤية يمكن من خلالها فهم هذه النهاية ويضيف إلى احتمالاتها قدرة الزمن على استيعابها كفنٍ يمكن من خلاله أنْ يكتشف الإنسان شكل وجوده، واختزال نهاية الرواية بسبب مستقبلٍ جديدٍ يمتلك فنَّه الخاص الذي سيكون مختلفاً عما تقدمه الرواية لا يعني فقط تبديلاً بالأشكال الأدبيَّة بل نهاية للأزمنة الحديثة، بالمنطق ذاته الذي تعامل به ميلان كونديرا مع مفارقات الرواية، فهو يعطي النهاية شكلاً يشبه الموت على دفعات، أو الموت الذي يليه موتٌ أكبر، مثل الأنظمة الشموليَّة التي حاصرت الرواية بالرقابة الشديدة والقمع والضغط الإيديولوجي الذي عايش الكاتب ميلان كونديرا جزءاً منه ورأى فيه شكلاً من أشكال موت الرواية وفنائها بهدوء، بسبب الفارق الكبير بين العالم الشمولي القائم على حقيقة واحدة وعالم الرواية القائم على النسبيَّة والشك والسؤال والالتباس، فعالم الاختزال الذي يختزل فيه الإنسان وتاريخه وحاضره ويسقط فيه الوجود بكل ما فيه في النسيان المتكرر لا يعتبر عالماً للرواية.
في حين يوضّح الكاتب بسام البغدادي أنَّ الرائع في لذة القراءة لميلان هي كلّ تلك الجواهر (المتفجرة) المكنونة والمنثورة بين صفحاته، سطور تقشعر لها الأبدان في مدى صراحتها وصدقها وفي مدى تعريتها للواقع المزيّف الذي يغطّي أعيننا، ليس هذا فحسب، بل يقوم ميلان نفسه بتعرية أفكاره و(كلائشه) أكثر من مرّة فاضحاً فخاخ الكاتب التي يقع فيها في انحناءات تثير البهجة والذهول والرغبة بالتوقف وابتلاع للكلمات في الوقت نفسه.
كونديرا موسيقياً
ربّما لم يعلن كونديرا كونه ناقداً موسيقياً، غير أنَّ روايته (فالس الوداع) جعلتنا نعتقد أنّه يعيش الموسيقى كما يعيش الرواية، وهو يفرّق في حديثٍ له، مبيناً أنَّ هناك فرقاً كبيراً بين البناء الموسيقي والبناء الملحمي. يُجمِع أغلب الروائيين على أنَّهم حينما يبدؤون الكتابة يجهلون كيف ستكون عليه نهاية أعمالهم. أراغون- مثلاً- قالها، وكذلك أندريه جيّد الذي أكّد هذه النظرة في «المزوِّرون»، بينما الموسيقيُّ لا يقول، أبداً، إنَّه يجهل الشكل النهائي لمقطوعته؛ فعندما يبدأ بكتابة أوَّل تيمة في مقطوعته المتكرِّرة تكون على هيئة أشكال تنتهي- عادةً- بالتيمة نفسها التي بدأت بها. تقوم الموسيقى على مبدأ التجدُّد والتكرار، أمّا مبدأ البناء الملحمي فمختلف تماماً. العمل الروائي، من خلال منطق الخصوصيَّة، يتمثَّل في الحدث الذي يستفزّ الذي يليه، ولا شيء يتكرَّر. أحاول، دائماً، دعم المبدأ الملحمي عبر المبدأ الموسيقي. خذ مثالاً «فالس الوداع»: في أرضيَّة الرواية، تدور أحداث ملحميَّة مع الكثير من الإثارة، بينما في الدور الأرضي هناك تركيبة موسيقيَّة. هناك صيغٌ تتكرّر، وتتنوَّع، وتتبدّل، ثم تعود أدراجها. لا توجد جملة إلّا وتعكس صورتها وازدواجيَّتها، وتقدّم جواباً في مكانٍ آخر في الرواية. خُذ، أيضاً، تيمة الميلاد في «فالس الوداع» هي محطّة موضوعاتيَّة لعلاج العُقم، وكلّ الشخوص تواجه هذه المشكلة: «كليما» مهدَّد بشكلٍ لا إرادي بأنْ يكون أباً، وتصبح «روزينا» حاملاً، بينما طبيب النساء «سكريتا»، الذي يعالج المرضى، يكون سبباً في ذلك. «جاكوب» لا يحبّ مسألة الإنجاب، واختار قصّة نسَبها إلى هيروت، الذي كان يرغب في تحرير العالم من مخالب البشر، وشرورهم. في «الحياة هي في مكان آخر»، تبرز تيمة الشتاء والبرد، حين يموت «جازوفيل» بسبب البرد، كما أنَّ الحبّ كان مبتغى «كزافييه»، لكنَّه مات، أيضاً، من شدّة البرد، موضوع البرد يرافق كلّ تركيب في النصّ.. إلى ما هنالك.