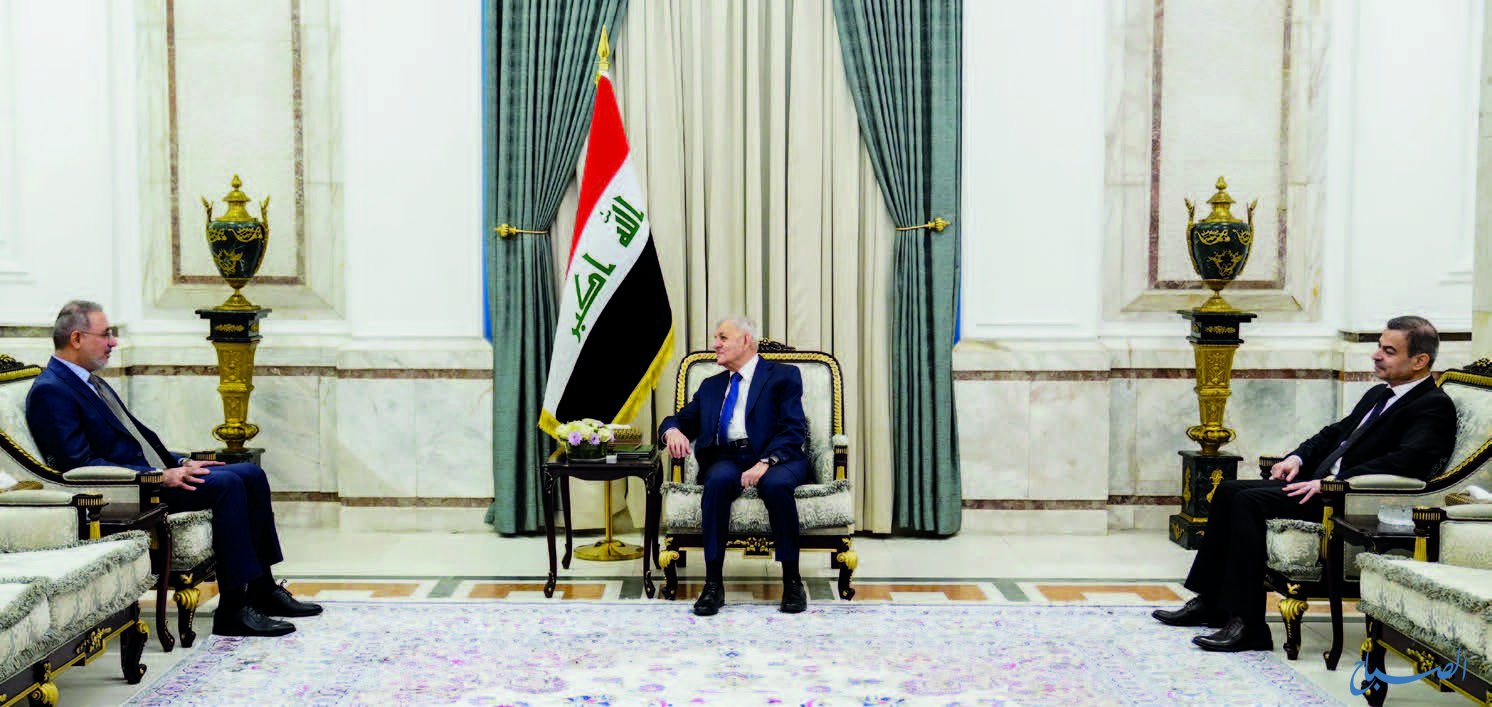ألفاظ الطبيعة والجمال عند لؤي عبد الأمير شرع الإسلام

د. مصعب مكي زبيبة
الوقوف بثبات، وعدم المهادنة، في الحقيقة وفي الشعر، تجسدهما ألفاظُ القوة والصلابة، والصرخة الرافضة، أما أن تتجسد بألفاظ الطبيعة والجمال، فهذا هو الجديد، الذي يحاول أن يخوض غمارَه شاعرٌ من طينة الكبار هو الشاعر لؤي شرع السلام، وهو بهذا يحاول أن يفقأ عين التقليد، والجمود والركود، بما يمتلك من أدوات تمسُّ جوهر الشعر، وليس أطرافه وهوامشه، شاعر يرتفع صوته عند كلّ موقف وطني، ولا يقبل بأنصافِ الحلول، تتفجر فيه الهمَّة تحدياً، والحروف ناراً مُلتهبة، والشعور حرباً مُستعرِة، ومشاهد الحزن والغضب حماساً، يقول الشاعر لؤي شرع الإسلام في قصيدة الثائر الشهيد محمد باقر الصدر وهي من مجزوء الكامل المُرَفَّل :
الحرُّ يقرنُ بالذمامِ ويكونُ كالبدرِ التمامِ
إنَّ كان ليلٌ حالكاً سيسيرُ في لُججِ الظلامِ
أو كالسفينِ بنوفلٍ يُنجي الجَميعَ من الحِمامِ
يا لؤلؤاً متألقاً أيقظتَ وَسْنانَ السَّقام
أمحمدَ الصدرِ الذي ضجَّ العوالمَ باحترام
أخرستَ كلَّ مفوَّهٍ فنأى برائعةِ الكلامِ
هل في الأوائلِ بَغشَةٌ أم في الأواخر من رِهامِ
إلّاكَ غيثاً زاخِراً يَهمي بفيفا للأنامِ
إذ طالكَ البغيُ الذي طال الجَنانَ وباهتضامِ
أنتَ الزهورُ بعِطرهِا وعِداكَ في قعرِ الرُّكامِ
ستظلُّ داعيةَ السَّما ويظلُّ خَصمُكَ بالتَّعامي
تزيّنت هذه الكلمات الصادقات، وهذه الأبيات عن العالِم الجليل، والشهيد السعيد، والمرجِع (السيد محمد باقر الصدر) قدسَ اللهُ سِرَّهُ الشّريف ؛ بأثوابِ الغزل المشبوب بالإطراء لهذه الشخصية الجليلة، وهذا هو الفتح الجديد الذي يضاف إلى أزياء القصيد العربي، بل قل: هو لون مُبَهرجٌ بالفرح والغبطة؛ لأنّ الشعر هو سير عبر طرقِ المحبّة والابتهاج، وهو فرحٌ للروح والوجدان، وهو تيارٌ من العواطف المختلفة بين اندفاع وغضبٍ، وثورة وتوهّجٍ، وصراخٍ وهمسٍ، ووخزٍ للمشاعر بإبر الإبداع الشعري، فقد استطاع الشاعر بما يمتلك من أدوات فنية ناضجة أن يخطَّ لنفسه أسلوباً جديداً عبر مدحٍ يشبه الغزل، أو حتى رثاءً يشبه التشبيب، وهذا التجديد، أو هذا الأسلوب المتفرّد يُحسب للشاعر، وليس عليه؛ لأنّ الشعر إذا كان تقليدياً أصبح كالجثَّة الميتة، لا حراكَ لها، وأصبح كالبضاعة التي لا رواجَ لها، وها نحن عندما نقرأ القصيدة نحسّ بنبضها الدافق واشتعالها المتوقّد، وأنفاسها الحرّى، وفرحها الطفولي، ومرحها الوثّاب، فهل أقول له إلّا كلمة شكراً لهذا الإسعاد، وهذا الانتماء الحقيقي لتلك الشخصيّة التي ضحّت من أجل الآخرين، الذين كانوا على قدر المسؤوليّة، فقلعوا جذور الخوف، عبر كلمة الرفض، وعبر الانتفاضة الشعبانية، وإن جاءت بعد حين، وجعلوا قلوب الطغاة واجِفةً، وهي التي تملك مقوِّمات السلاح والجبروت، حتى انهزموا على كبر خطرهم، وما هذه الأبيات التي قالها الشاعر وغيرها من الكلمات والأشعار التي قيلت وستقال إلا فرعٌ من ذلك الإنجاز الكبير الذي نحن في فلكه دائرون إن شاء الله.
فالإنسان الحُرُّ هو البدر التمام، والليل الحالك يسير إلى اندحار، واللؤلؤة المتألِّقة تُوقِظ سُبات الخضوع، ومحمد باقر الصدر رضوان الله عليه، يُسكتُ أفواهَ الطواغيت، والغيث الزاخر سيطال البغي فيحيله إلى رماد، وتتحول الأرض إلى جنة تحياها الإنسانيّة، والزهور بعطرها تقتلع الزيف المتراكم على الصدور والأوهام، فالأحرار باقون في كلّ عصر ومكان، والسماء بزرقتها وصفائها سوف تُصيب بإرادتها الخصم بالتعامي، فهذه الرؤية تُحوّلُ صور الطبيعة إلى رمزٍ للمقاومة، والفعل المنتفض، وبهذه الرمزية أراد الشاعر الدكتور لؤي عبد الأمير شرع الإسلام أن تمدّنا بالمزيد من هذا الاحتضان لأجواء الطبيعة؛ من أجل الجمال والإسعاد والفرح الروحي الخالص الذي يعرفه من يتذوّق الشعر، فالجمال هو الذي يولِّد الفعل المقاوم، والإبداع هو الذي يُنشئ المطالبة بالحرية، فلا فاصل بين القلب والمطالبة بالحقوق، ولا فاصلَ بين ضلوع الصدر الحاضنة للوطن، والكلمة الصافية الرقراقة التي تستطيع أن تعبّر عن همها الوطني.
ويقول أيضاً في قصيدة أخرى من البحر الكامل:
ما أنت إلا غَيمَةٌ في مَعْبَرِ
بادَتْ وذابَتْ إِنْ تَكُنْ لَمْ تَمطُرِ
فامْطُرْ على هذي الأنامِ بزَخَّةٍ
واترُكْ رياضاً تَستَديمُ لأدهُرِ
فالشاعر الأديب، والطبيب الحاذق لؤي عبد الأمير شرع السلام يبدع في أدبه مثلما يبدع في طبه، عارفاً بالأدوية ووصفات الشفاء، مثلما هو عارف بتركيب الكلمات، وصياغة الجمل، تمنح يده وعقله وقلمه بلسماً وعطارة حب، فتتعافى الروح من همِّها بإذن الله، طالما هما الاثنان ينهلان من ثدي التفرّد والجودة والتميّز والنجاح، الأدب يدور في حلباته العامرة بالزهو وخوابي الروح وسلاف الفن، يجول في سويداء القلب ويحطُّ متوركاً على فرح الجمال، ونماء المعاني، فها هي الكلمات تزهو بالأمل، وتنشد أن يكون العدل هو المنفذ لما نحن فيه من اعوجاج وإمت واختلال، فأين تلك الغيمة التي تمنح الفقير رغيف عافيته؟ّ!، وأين تلك الغيمة التي تمد يدها؛ لتمسح على رأس يتيم؟!، أين تلك الغيمة المتّصلة بالسماء؛ لتمنحنا اطمئنان التراتيل، فقد توسّدت على قلوب خطيئاتها، يا منقذ، يا مفرح، يا جوهر الإنسانيّة، ها هي الدنيا أسوَّدَ نعيمها، وأصبح غنيُّها لا يسمع صراخَ فقيرِها، فقد أحسن الشاعر بما أشَّر عليه من جرح غائر في مجتمعنا، وأحسن بما صوَّب بمنظار دقيق إلى خللٍ اجتماعي مشرع التخلف، فاغر الفم، وأحسن في تأسيس مدرسة إنسانية تأخذ بأولوياتها التراحم والتكافل والتعاطف والتشارك والتسامح، فالشاعر ما زال، ولّما يزل مورداً فياضاً بالمعاني الناضجة، والألفاظ السيّالة الممزوجة بسمفونية الجمال والعشق.
والقصيدة لا تتخلى عن همّها الإنساني، وشكلها الخيالي الذي يرتبط بالمشاعر، وبما تنطوي عليه من محاكاة للمشاعر والأحاسيس، ومن دون تلك الروافد الإنسانية الخصبة لا يتم النماء، ولا تزدهر الكلمات، ولا تكتسب القصيدة دفأها وانبعاثها وهيمنتها الغنائية الوجدانية، وهذا ما تحرك عليه الشاعر تحسساً لتلك المشاعر الذي لا تعرف الانجماد والانزواء والنمطية؛ ولهذا آمن بكل ثبات ودراية بأن الشاعر لا يُعرف إلا من خلال الغزل، والشعر الرومانسي أو ما يعرف بالشعر الغزلي، هو من الأغراض التي ترتبط بالتغنِّي والجمال والموسيقى المرتفعة؛ لتُفصح النفس عن انفعالاتها وتجربتها الشعورية الحقيقية، ومن دون ذلك الصدق والعبق الحسي تصبح القصيدة زائفة غير مؤثرة، فكانت القصيدة صادقة الإحساس، وهذا الصدق تعبر عنه أوصافها الجمالية في داخل التشكيل البنائي للقصيدة يتجسد في العفة في الحبّ والإحساس والوجدان، وهذا ما نلحظه في قصيدة (مشيت دربي) من البحر البسيط :
مشَيتُ دَربي وكانَ القلبُ يبتهلُ
فصادفتني وغشّى وجهَها الخجلُ
ناجيتُها عِفَّةً حتى أكلّمَها
فكلمتني حَياً والشاهدُ المُقلُ
كلمتُها ويدي راحت تصافحُها
فصافحتْ ولهَا دمعٌ وينهملُ
سَحَبتُ من يدِها شَدَّتْ على عجلٍ
ثم استحتْ سحَبتْ شدَدتُّ لا وَجَلُ
مشتْ دمائي بها حَرّى مزمجرةً
جرتْ دماها بجسمي وهي تشتعلُ
وداعبَ القلبُ قلباً كلهُ شغَفٌ
أجابني قلبُها هيّا أيا رجلُ
ذابتْ قُوايَ كأنْ روحٌ بلا جسدٍ
ونادتِ الروحُ قَلبي إنهُ الغَزَلُ
حتى اقتربنا وكان الحبُّ أغنيتي
هـذي الشفاهُ بجَنبٍ حانتِ القُبَلُ
لملمتُ بعضي وكُلّي زاخرٌ هَطِلٌ
وفي لَماها سُلافٌ زاخرٌ هَطِلُ
كلٌّ يناغي الجَوى في خلّهِ ثَمِلاً
حتى انتشى مِنْ جوانا الحُبُّ والثَّمَلُ
في غرفتي عندليبٌ صادحٌ غَرِدٌ
غَنَّى كعَزفٍ بهِ إِذْ يَطرِبُ الزَّجَلُ
أصحاني حُلْمي على أنغامِ غُنوتهِ
فجُنَّ عقلي فهلْ أهواكَ يا جَلَلُ
توضأتْ روحيَ الحُبلى بشَقوَتِها
وسِرتُ دربي بهِ أمشي وأبتَهِلُ
تتراءى أمام القارئ ألفاظ الغزل العفيف، أو ما يطلق عليه بالغزل العذري، الذي يخترق بوجهه المتأجج الجوهر الحقيقي للنفس الإنسانية، وليس البواعث الزائفة التي تتلاعب بما هو حسي زائل، وألفاظ العفة في القصيدة الغزلية عند الشاعر مثلت مهيمناً أسلوبياً، تلك التي عرَّفها جاكبسون بأنها البحث عما يتميز بالكلام الفني من بقية مستويات الخطاب أوّلاً، ومن سائر أصناف الفنون الإنسانيّة ثانياً.
وهذا الغزل لم يضر بتمسك الشاعر الراسخ للشريعة والدين الحنيف، فكانَ القلبُ يبتهلُ بما تصوره سيميائية الدعاء والتضرّع والتوجه واستقبال السماء والاستكانة لله سبحانه وتعالى، وما يقدمه من سيميائية الحياء والعلاقة غير الطائشة، والعاطفة غير المندفعة، وشعور الحب الصامت الذي يتجاوز الانفتاح غير الأخلاقي والجرأة في التعامل غير المسؤول مع الجنس الآخر، فقدمت القصيدة ألفاظ العفة بما صورتها المطابقة من دون الحاجة للتأويل، إذ تظهر اللفظة بكامل وضوحها بما تقدمه من سيميائية لصور الإيمان والصدق النفسي، وبث روح الفضيلة في المجتمع.
وبهذا بقي الشاعر لؤي شرع الإسلام عاشقاً لطهارة الحرف، مؤرقاً بالهم الثقافي والشعري، مسافراً عبر طريق الارتقاء والرفض وعدم الرضوخ.