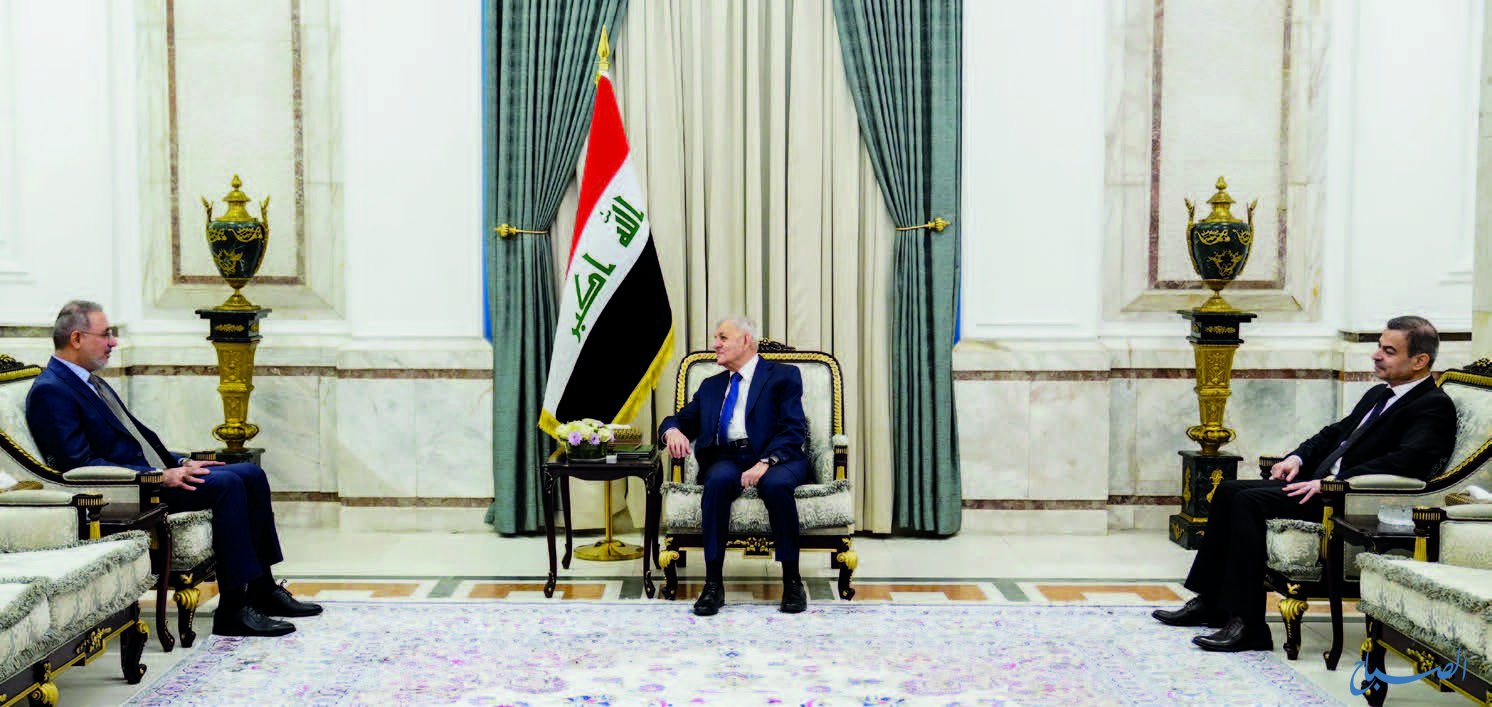عبود الجابري: كتبتُ قصائدي محمولاً على لوح الحنين المؤجَّل

حوار: صلاح حسن السيلاوي
هذا شاعرٌ سافرَ مكبلا بالأسى، فافتتحت الأحلامُ قيود أيامه، واستنفرت غوايات القصائد قلبه، تلمعُ روحه بين السطور، حتى كأنك تسمع بين الكلمات أنفاسه، وتستوقفك الفوارز شرفات على بساتين معانيه. شاعرٌ تتداوله أيَّامُ العزلة، تسكنه البيوت، وتنادمه الحقائبُ عن ذاكرة بلاده المتشابكة كالأنهار. رجل يملك سمعة السواقي أيَّام العطش، بعيداً عن مسقط رأسه على ضفة الفرات، أجاد كتابة النخيل وفهرسة الأغصان على أصابع الآفاق. مشغول بالعراق كأنه يعيش فيه، يركض على ضفافه نذيراً من الطوفان، ثم يطلق من سفن كلماته طيوراً للبحث عن أراض انحسر عنها الماء.
إنَّه عبود الجابري، شاعر ومترجم عراقي مقيم في العاصمة الأردنية منذ عام 1993 ولد في النجف سنة 1963. صدر له في الشعر: (فهرس الأخطاء- 2007)، و(يتوكأ على عماه- 2009)، و(متحف النوم- 2013)، و(فكرة اليد الواحدة- 2015)، و(تلوين الأعداءـ 2017)، و(في البيت وما حوله- 2022) و(أثر من ذيل حصان ـ 2021) له مخطوطات وترجمات غير منشورة لشعراء باللغة الانجليزية، تُرجم شعره إلى العديد من اللغات ومنها الأنجليزية، والفارسية، والأسبانية والتركية.
إنَّه يفتتح أبواب ذاكرته وقلبه عبر هذا الحوار:
* في مجموعتك الأولى (فهرس الأخطاء) تقول: (اقتربي أيّتها اللبؤات العليلة، لك في لحمي، فراسة المخالب، وشغف الأنياب المسنونة، اقتربي أيتها الضباع الحزينة). كأنك هنا تتجول في صحارى الأسى متعثراً بفوارز أخطاء البلاد، ألهذا أشعت لحمك لفراسة المخالب؟
- لم تكن البلاد تُحسِنُ وضع فوارز بين أخطائها، حتى أننا لم نجد تجنيساً لما كانت تكتب على جلودنا، كان كل شيء مستباحاً لدرجة شعرنا معها أنّنا نمارس وظيفة تأجيل موتنا أو موت من نحب، وقد كتبت قصائد فهرس الأخطاء محمولاً على لوح الحنين المؤجل إلى البلاد، لغة تصخب بين السطور واستذكار مرير لم تفلح الهجرة في ترويضه، وفي الوقت ذاته كانت هناك فسحة لتقول إنّك كنت تعرف كل شيء وتعبر عن احتجاجك صارخاً، في الوقت الذي كنت تخشى أن تشي بك همسة فيصرخ سيف الجلّاد في رقبتك.
* (إبراهيم الذي توشك النار أن تحنو على جسده، لم يفعل شيئاً، سوى أنه بنى بيتاً، وأسكن روحَ خالقه فيه.) من نصك هذا أتساءل: نار الغربة أم نار الحنين تلك التي تأكل جسدك، إلى أي مدى ما زلت مشغولا بتأويل البيت بنهريه، ومثيله الذي يحنو على الشاعر وأسرته؟.
- تتسرَّب مفردة البيت في شعري بطريقة لا إراديَّة وحين أخلو إلى نفسي أجدني مأسوراً بكليتي إلى بيتين، البيت الأب الذي أسعده تشرّدنا، والبيت الابن الذي تكوَّن ونما في غفلة منّي وكلما مسَّه الضيم أجدني أهرع إلى البيت الأب، أعاتبه، أبكي بين يديه، وأشتمه أحياناً فلا ألقى منه جواباً، وتلك هي عادته حين حينما كنا نستظل به خائفين من جبروته، فكنا نطيعه كأطفال مؤدّبين لا يملكون أن يغنوا أو يلعبوا في فنائه، وأحمل في جرابي من مخلّفات تلك المرحلة ما يفوق الخيال من قسوة البيت الكبير والألعاب النارية التي كان يعكر سماواتنا بها، نحن جيل بار بالعراق، لأنّنا لم نذكره بسوء إلا أمام أنفسنا رغم أنّه شطب أسماءنا من دفتر الأسرة.
* هل أنصفك النقد العربي والعراقي؟
- لا أعرف معنى الانصاف في النقد، فأن يكتب الناقد عن منتج أدبي فهو أمر يمثل إنصافاً له وليس للمؤلف، وما كتب عن شعري لا يوازي غزارة ما أصدرت من دواوين، ويؤلمني أن بعض النقاد قد تركوا سفارة النقد ولجأوا إلى قنصلياته، فهناك النقد بالتكليف، والنقد للمشاركة في مهرجان، والنقد الوجداني امتثالاً للصداقات، والنقد للحصول على مغانم أدبيَّة أو سواها، ورغم ذلك فإنّي فرح بالقليل الذي كتب عن إصداراتي بتلقائيّة من كتبوا، وهو أمر يمنحني شعوراً أن هناك من يجد في نصوصي ما يحفزه على الكتابة عنها.
* سأسألك ما سألتَه مرة في نصك، (تخطيط أولي لمساء الشاعر) : هل ستكفيك عشرة أصابع تحصي بها ندوبا في ظهور ملائكة ذابلين؟
- تلك قصيدة مطلعها «مساء سيقعي المساء على أربعٍ ثم ينجب أيتامه» حتى أنّهم لم يحظوا بفرصة إدراك الضوء، وحتى لو استطعنا أن نحصي الندوب فإنّنا لا نملك أن نمحو آثارها على جلودنا أو أرواحنا، لقد كنا مسخرين للنظر في المرايا التي تقع خلفنا حيث لم تكن هناك مرايا تعكس الضوء على وجوهنا، لذلك كنا نهرب بطريقة التراجع إلى الوراء.
* بماذا تصف عمان التي تعيش فيها وما رأيك بالمشهد الشعري في الاردن؟.
- منذ وصولي إلى عمّان اختبرت نفسي شاعراً وأرسلت مجموعة من النصوص عبر البريد إلى الملحق الثقافي لجريدة صوت الشعب الذي كان يُديره آنذاك الشاعر ابراهيم نصر الله، وأسعدني أن نصر الله قد نشر النصوص وخصص لها صفحة كاملة، وكانت تلك المحاولة بمثابة جواز سفر نفسي جعلني أنخرط في المشهد الثقافي والفني في الأردن، وكان لي في الأردن قصة حب مدوية تكللت بزواجٍ تكلل هو الآخر بثلاث بنات وولدين أصغرهم بعمر السادسة عشرة، كما أن دواويني جميعها صدرت في فترة إقامتي في الأردن، وأظن أن ثلاثين عاماً كافية لكي أتكيّف مع تفاصيل الحياة فيها، أما عن المشهد الشعري فهو شبيه بأمثاله في البلاد العربية، ثمة شعراء مكرّسون ومؤسسات تعنى بالشعر ومهرجاناته غير أن العوامل الاقتصادية تؤثر سلباً على نمط حياة المثقف هنا، فيتخلى أحياناً عن الشعر لصالح الحياة.
* تقول في قصيدة (قمصان) من مجموعتك الثانية (يتوكأ على عماه) مخاطبا بغداد: لم يجدك البرابرة والسماسرة، حين عبروا الجسر لم يجدوا عيون المها ولم يجدوا عليّاً بن الجهم لم يجدوا الشعراء لم يجدوا سوى سفينة تحمل من كل زوجين اثنين وتوغل عميقا في الطوفان. هل أنت أم البلاد في الطوفان ومتى ينحسر الماء برأيك؟
- أنا في الطوفان حتى لو لم أكن في البلاد فلا عاصم لنا سواها، وحين أخاطب بغداد فإنّني أستعير من صورة وجهها الجمال الذي خربته الغضون، وخيبة الأنبياء الذين دعوها إلى الهدى فأبت إلّا أن تكون عرضة للطوفان الذي يمكن له أن ينحسر عندما يفور تنور الألفة وينضج الرغيف الذي نغطي به خارطة البلاد ونتقاسمه كي لا يبقى منا جائع.
* ما الذي غيره الشعر في حياتك؟
- لقد علمني الشعر أن أصمت طويلاً حتى أن صاحب مقهى قال لي يوماً: «جميع الناس هنا يأتون ليتكلموا، إلا أنت فتأتي إلى المقهى كي تصمت»، وعلمني الشعر أن أتحدث مع نفسي عندما لا يكون هناك من يستحق المنادمة، وعلمني الشعر أن الوقت حكم ظالم عندما لا تسخره في تطوير ذاتك، كما علمني أن أمزق من القصائد أكثر من تلك التي أنشرها، وتعلمت من الشعر أن لا أكون متاحاً على منصة أندم بعد النزول منها، لذلك تجدني مقلّاً في تلبية الدعوات.
* تتساءل في إحدى قصائدك: (أرأيت كم يكون الحبُّ قاسياً، وكيف يصيرُ في النهاية، مضيعة للقلبِ، عندما أحدثك عن الجوع، وتشتمينني بالوردة..؟ ثمَّ نعقد هدنة جارحة، نعترف من خلالها، بأن الحياةَ في جوهرِها، حادث تصادم مروع بين رغيفين) تعريفك الشعري للفقر، ينبئ عن حرب طويلة أكلت بأفواه شتائمها ورود الحب حتى أن السلام بعدها أصبح جارحا، والخبز صار نتيجة للألم، بِمَ تعلق؟
- منذ جائحة الكورونا نحوت بشعري لتخليد طغاة كانوا يضربون بأيدٍ من حديد مفاصل أيامنا، حيث تم تسريحي من العمل وبقيت حتى اللحظة بلا عمل، فكتبت نصوصاً إلى الله ونصوصاً إلى نفسي، وسعيت إلى أنسنة الرغيف لكي أتمكن من مخاطبته، والأنكى من ذلك أن القارئ كان يتعامل مع ما كتبت على أنّها أفكار جماليّة، وهناك ما لا يقال في هذا المقام عن معاناتنا، لكن الجمال الحقيقي كان في الصمت الذي احترفناه كي لا ننكسر أو تلامس أغصاننا التراب نتيجة الذبول.
* في قصيدة (مواربة) تصف الجرح (قنطرةً يعبرُ النمل عليها) أهكذا جرى جرحك حتى أصبح نهرا وصرت يائسا من شفائه حتى قلت: (أنني أسكنت فيه كثيراً من الأكاذيب، أهونها ضحكة ملساء، وأصعبُها ما أردده في الأدعيةِ عن كشف الضرّ). هل أسقط الألم أيوبك عن سلالم السماء يا صديقي؟
- لم تستغرق كتابة هذا النص أكثر من خمس دقائق، وأني لأعجب حتى الساعة كيف انهمر على الورق كما لو كان تنهيدة أو زفرة حرّى، وهو كما تقول يا صديقي سقوط مدوٍّ عن سلالم السماء والنص كان هو الصرخة في المسافة بين السماء وتراب الأرض، لم أنتبه إلى الألم الأيوبي فيه إلا عندما قرأته في اليوم التالي، كان زفرة مصدورٍ لم يجد أمامه سوى الشعر وسيلة لمكاشفة الكون وخالقه بما يعاني.
* ما تقييمك للحراك الشعري العربي على مستوى قصيدة النثر العراقيَّة والعربيَّة؟.
- قصيدة النثر من أصعب فنون الكتابة الأدبية كونها مدينة بلا قوانين سوى ما يضعه الناس من قواعد للسير في شوارعها، وقد وجد الكثير من قليلي المواهب ضالتهم فيها وصار لهم جمهور يوازيهم في الذائقة، غير أن المشهد الشعري عامر وثري بأسماء من مختلف الأجيال تؤثث حاضرها، وذلك ينسحب على مستقبلها، وعلى الجميع أن قصيدة النثر العربية موجودة منذ سبعة عقود من الزمن وما من جدوى لمحاولات البعض في النيل منها أو قياس الكتابة الشعرية بمعايير التجنيس أو التصنيف التي باتت لعبة مملة.
* (بهذا أختمُ، وأتمنى للرعاةِ شياهاً أكثرَ طاعة وأقل زاداً، وللحطابين، نيراناً تشعل الأخضر، مادام اليابسُ يشتعل من أول قدحة فليسَ من المروءة أن نسلمَ مصائرنا للنار، ونتيبَّسَ من أجلِ أن نتقد كما يراد لنا) نصك هذا يؤدي إلى التساؤل عن المدى الذي جففت نارُ النضج فيه حياتك، عن كمية ما قطع الحطابون من أشجار عمرك؟
- كتبت يوماً ما نصّهُ
«لم أكن يوما» شجرة
لكنّ أعضائي
تجفّ آخر النّهار
ويسقط رأسي بين كتفيّ
فتبني عليه العصافير أعشاشها
ولفرط الوهم
صرت أرتجف كلّما نظر إليّ عابر
يحمل في يده فأساً»
كل ما حولي يعزز هذا الخوف من فؤوس لا مرئية ومعاول بأعناق بعيدة يمكن لها أن تجتث ما يروق لها أو ما تجده غير موائم لرغائبها، كنت ربّان سفينة يضيق بها الموج فيرقصها بكامل حمولتها، وهذا الشعور جعلني ضجراً لا يدهشني شيء في الحياة سوى الأدب بكافة فنونه والفن بأجناسه المختلفة، صار لديَّ زهد بمفاتن الحياة وملذاتها، وقد يكون ذلك قاسياً لكنه بالمقابل يهذّب النفس ويمنحها نوعاً من السمو على الصغائر.
* مشغول بالطرق والبصيرة تقول: (عرفت من وحشةِ الطريق لماذا يهتف العميان باسمِ «هوميروس») هل يخفف الشعر من وطأة العمى أم يزيده، وأي الطرق الموحشة مشيت إلى نهاياتها؟
- الشعر بصيرة يلزمها حُسْنُ القياد، وفي ظنّي أن الخلق جميعهم شعراء، لكن وسائل التعبير مختلفة من شخص إلى آخر، لذلك تجدني أكتب عن العمى مادحاً البصيرة التي تدرك صاحبها وتنير له الطريق، حتى أني أذكر مقطعاً للشاعر (بيل نوت) يذم فيه إبصاره في بلاد العميان قائلاً: في بلاد العميان، الجميع يشير إليك، وهو أمر يعزز فكرة مفادها أن العمى لم يعد إعاقة بيولوجية، وقد قيل في تراثنا أن العمى عمى البصيرة، وفي الريف العراقي كنا نقول إنّ العمى هو عمى القلوب، وفي ما يتعلق بالطرق فقد خرجت من حروب البلاد بأقدام لا يهمها إن سارت في حقول الشوك أو في مروج العشب، لذلك تقحمت منذ طفولتي جميع ما يراه الآخرون شائكاً، طرقاً مضيت في بعضها حتى النهاية، وأخرى عدت من منتصف الطريق وذلك ناتج من انحسار الأمل.
* مجاميعك (فهرس الأخطاء) و(يتوكأ على عماه) و(متحف النوم) و(فكرة اليد الواحدة) و(تلوين الأعداء) و(في البيت وماحوله) و(أثر من ذيل حصان) كأن الأخطاء أدت إلى عمى، والعمى هو متحف للنوم، والنوم يد ضعيفة بمواجهة الأعداء الملونين وهم يحومون في البيت وما حوله وهنالك أثر للحصان، برمزية الحرب أو الفروسية أو الركض في مضمار الحياة، أين أنت من هذا؟
- أنا كل هذا وذاك، يمكنك حساب عمري بقسمة الأيام على القصائد فيكون الحاصل هو حقيقة ما عشته حتى وإن كان مجروحاً بأسباب الحياة الناقصة، أملك من التفاؤل ما يوازي أحزاني، ولديَّ من الأمل ما يجعلني أحاول القفز لأعبر إلى نهايتي سعيداً.