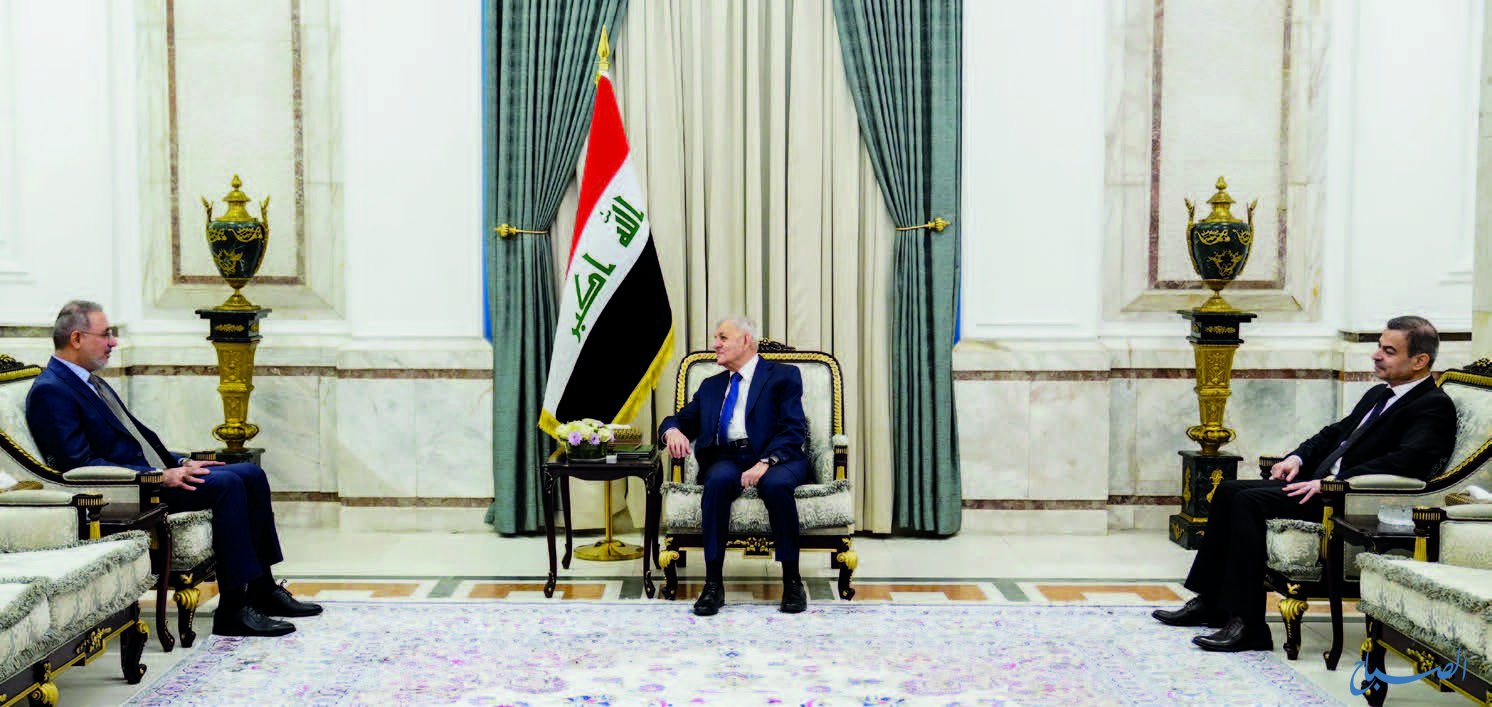الأقلمة السرديَّة.. مشروعاً نقديَّاً

د. نادية هناوي
إذا كان النقد الأدبي البنيوي قد تغاضى بانغلاقه على البنية عن دراسة خارجيات هذه البنية، وكان النقد ما بعد البنيوي قد وجه اهتمامه نحو هذه الخارجيات لكنه اقتصر في الغالب على الميراث الأدبي اليوناني والروماني واستبعد البحث عن جذور هذا الميراث الشرقية ـــ باستثناء حكايات ألف ليلة وليلة التي درسها تودوروف وبعض قليل من المنظرين الغربيين ــ فإن النقد الانجلوأمريكي كان أكثر انفتاحا لأنه اتخذ من التداخل والاندماج مسارا بحثيا يفتح آفاقا جديدة ومغايرة.
توسع نطاق دراسات السرد ما بعد الكلاسيكية نحو مجالات جديدة تساعد في وضع تصورات سردية تعتمد بالدرجة الاساس على ما تقدمه الروايات ما بعد الحداثية والميديا وأفلام الفديو من موئل مهم في هذا المجال. بيدَ أنَّ مساعي هذا النقد في التمثيل تظل كمساعي المدرسة الفرنسية لا تتعدى حدود الخريطة الجغرافية للآداب الغربية. وهو أمر ليس بالغريب، فالحواضن والمرجعيات هي نفسها والمبتدأ واحد لكن الطموح يختلف من ناحية الإفادة من السرديات الكلاسيكية سواء التي تعود الى الآداب الهومرية في العصور القديمة او التي تعود إلى عصر النهضة الذي فيه تشكلت أوربا الحديثة وعليه قامت متروبولية العالم الغربي.
وليس مهما أن نتفاعل مع هاتين المدرستين ونتبنى طروحاتهما لكن المهم هو أن نعمل على الإفادة من كشوفاتهما وتوصلاتهما، كي نبتكر ما يخدم أدبنا وتاريخه الحافل بالمرويات التراثية والسرديات الحديثة والمعاصرة، ومن تلك التوصلات الأقلمة السردية التي بها نؤكد أولا عالمية خصوصياتنا وندلل ثانيا على هويتنا في الاستزادة العلمية والإضافة المعرفية إلى الفكر الإنساني.
وعلى الرغم من مواكبة الدارسين العرب لهذه المنهجيات على تفاوت ما فيها من أغراض وأساليب، فان دراسة السرد القديم ظلت في الغالب بنيوية وأحيانا ثقافية. ولا شك في أن الدراسات الثقافية أخذت بالتزايد بينما تراجعت الدراسات المقارنة، لكن ذلك لم يلغِ ما للبنيوية من رسوخ منهجي في النقد العربي المعاصر لسببين؛ الأول أن ما توصلت إليه (الدراسات البنيوية) في أواخر القرن الماضي كان قيما وعلميا في ما يتعلق بجزئيات ما اقتطعته من السرد القديم، والثاني أن (الدراسات الثقافيّضة) على كثرتها لم تستطع أن تحقق ـــ على صعيد دراسة السرد القديم ـــ نتائج يعول عليها وذات قيمة خلافا لما توصل إليه المستشرقون القدماء والجدد وإنما هي تأويلات أقرب إلى التخمين منها إلى العلم.
وما بين النصيَّة والانغلاق عليها والتأويل والانغماس في استشراقيته، بقي التراث السردي العربي منطويا على كثير مخفي، فيه تُختزن ذاكرة أمة، ومن المهم الكشف عن هذه الذاكرة ومعرفة مخزونها بكلية ما فيه من أنظمة وأبعاد. فدراسة الأقلمة السرديّة ضروريّة لا بالاتجاه المستقبلي الذي تبحث فيه حاليا المخابر الغربية التي في أوطانها خصوصيات. وهي موضع اهتمام منظري السرد ما بعد الكلاسيكي، وإنما في الاتجاه الاستعادي الذي فيه لأدبنا خصوصية تتفاوت بحسب أولوية بلداننا العربية وما كان لها من أدوار تاريخية وثقافية. ولأن أقلمة التراث السردي مهمة، سعى المنظرون في الصين إلى اتخاذ دراسات الأقلمة مشروعا يستعيد دراسة السرد الصيني بقديمه وحديثه، فكشفوا عن تقاليده وبنوا نظريات تحت مسمى (علم السرد الصيني).
إنَّ فهم الأقلمة في دلالتيها النظرية والتطبيقية يجعل منها منطلقا مهما لبناء أرضية للصنعة السردية بها يمكننا مسك خيط السرد في ماضيه من جهة وإلقاء نظرة فاحصة على حاضره من جهة أخرى، فلا يغدو ذاك الماضي جامدا في شكله وبنائه ولا يكون الحاضر طاغيا في أدق تفاصيله. وما من حاضر نتمكن من فهمه ما لم نكن قد عاينا ماضيه. فالسرد ذاكرة تراكمت فيها خبرات الحياة. وما من فن سردي بلا ذاكرة يترسّب فيها المتخيل والواقعي تعبيراً عما هو طبيعي أو غير طبيعي.
وما بين تراكم الخبرات واستمرار الترسّب يصبح السرد نظاما كلاميا حرا شكلا ومضمونا وإبداعا تلقائيا. وكلما ازداد التراكم كانت للسرد مواضعات نظامية مدركة بالإبداع ومميزة بالحدس ويعبر عنها بالكلام كفعل لفظي سماعي أو بالكتابة كفعل ذهني عياني. فالسرد نظام إنساني شأنه شأن الأنظمة الحياتية الأخرى كالأخلاق والسياسة والعواطف. ويمكن لهذه الأنظمة أن تتطور تشذيبا وصقلا. ولأن الذاكرة هي موئل الكلام على صعيد الممارسة الإبداعية والحياتية، تغدو لعملية التكرار والإعادة أهمية في أن تجعل للسرد أنظمة وفيها قوالب، وكل قالب هو عبارة عن مواضعة أجناسية تمخضت عن تحولات فنية. وأول قالب في ذاك النظام كان الشعر الغنائي. ومن بعده كان الشعر الملحمي ثم تشكل الشعر الدرامي. وما بين جنس وجنس تاريخ طويل من الابتكار والبناء والتقليد.
إنَّ حضور الذاكرة كفاعل سردي، منه تولدت أنظمة الحكي يعني أن هناك تاريخا طويلا من السرد، يمكن استقصاء تفاصيل ما مر به من اعتمالات اتخذت شكل تقاليد عمل بها بشكل تلقائي ثم راحت تمتد خارج نطاقها الإقليمي حتى شملت العالم القديم على اتساعه. ونتجت من جراء إتباع هذه التقاليد، سرديات توصف اليوم بالكلاسيكية سواء تلك التي تعود إلى عصور قديمة أو التي تنسب إلى العصور الوسيطة والحديثة.
وتتفاخر الأمم بما لتاريخها من ذاكرة سرديّة، تتجسد في نماذج هي خلاصة ما لذاك التراكم من غنى وتميز. وأكثر الأمم اعتدادا بذاكرتها السردية هي التي لها تقاليد عريقة، تعكسها نماذج بشرية وقيم فنية، انتقلت إلى الأمم المجاورة. وكلما كان تاريخ التقاليد السردية ضاربا في القدم، ترسخت الأنظمة السردية أكثر وبكل ما فيها من تراكمات ذاكرة الأمة وإبداعات حضارتها. وإذا كان للحضارة أن تأفل، فإنّ التقاليد لا تذوي بل تبقى مستمرة وفاعلة. وما ينبغي على نقدنا الراهن هو تبني دراسات الأقلمة من أجل الحفر في الأصول بحثا عن الاستزادة المعرفية مما هو كامن في تراثنا السردي ولم يكشف عنه بعد. وبما يعطي لجهودنا النقدية خصوصية تضعنا على طريق بناء نظرية نابعة من صلب المنجز السردي العربي ومستندة إلى حقيقة ما لنا من تجارب فكرية ذات سمات وأبعاد.
وما أقلمة المرويات التراثية سوى همزة وصل تربطنا بالمرويات التراثية العالمية وكخطوة على مفترق طريق نحو دراسة السرد في حديثه ومعاصره بكل ما يشتمل عليه من تقاليد وظفت في السرد الحديث او انتقلت او استمرت او تغيرت. فليست دراسات الأقلمة السردية توسيعا او تطويرا وإنما هي بحث عن المرتكزات وفهم لفاعلية السرد في ماضيه وحاضره كأنواع وأنماط وطبائع وتحولات وتفاعلات وعلاقات وقضايا تقتضي معرفة وتبادلا وتقاربا واعترافا للسابق على اللاحق، فيتعزز من ثم التقارب الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب وتتأكد بعد ذلك كله عالمية الأدب العربي.
والناقد العربي مؤهل وقادر على المساهمة في تأكيد هذه العالمية لا بترجمة إبداعه إلى اللغات الأجنبية، فذلك لن يغير من الواقع الامبريالي للثقافة الغربية ومتروبوليتها الأمريكية شيئا. إذ ما دمنا نتبع خطوات الآخر ونريد ان نلحق به ونضاهيه، فلن نبلغ العالمية حتى لو ترجمنا أدبنا عن بكرة أبيه إلى لغات العالم كلها. من هنا يغدو مهما العمل على الجذور قبل الفروع والاهتمام بالبواطن قبل الظواهر، وليس ذلك بالعسير. ومعلوم أن التدليل على الخصوصية لا يتأتى وحده من دون مراهنات وفرضيات ومشاريع. ومشروع الأقلمة السردية مثال أكيد على إمكانية تحقيق ما تقدم عبر الانفتاح ثقافيا وحضاريا بكل ما يملكه السرد العربي من تاريخ عريق ومنجز كبير له هويته ومشاغله. ولعل مروية واحدة مثل المقامات أو رسالة الغفران أو الحكايات الشعبية كافية وحدها في إدامة زخم هذا المشروع.