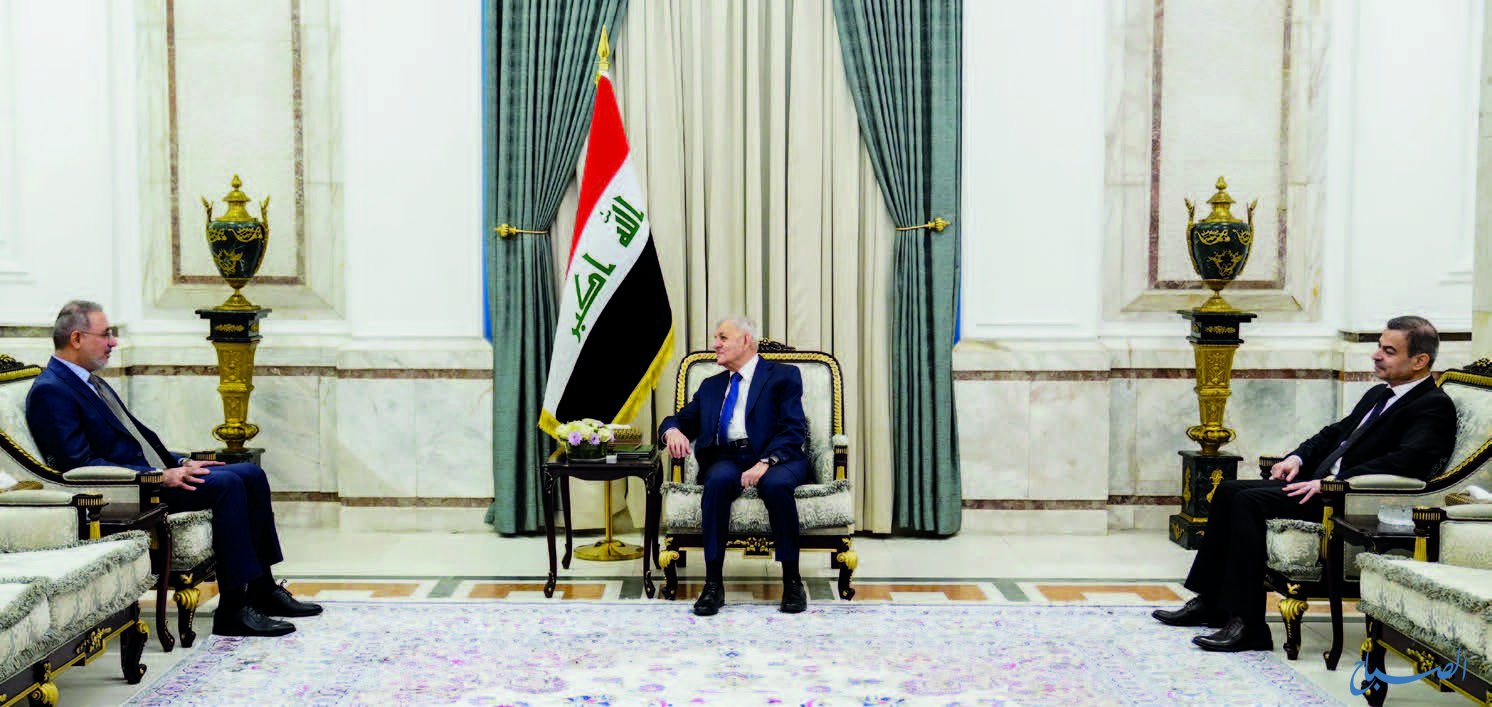صورة الإمام الحُسين في رواية (التجليات) لجمال الغيطاني

عبدالله الميّالي
لا أعتقد أنّ القارئ يستطيع سبر أغوار رواية (التجليات) للروائي المصري جمال الغيطاني (1945 – 2015) من قراءة واحدة، فهو بحاجة إلى أنْ يطوف على أجواء الرواية أكثر من مرة متسلحاً بتراكم ثقافي ومعرفي وفكري وأدبي وتاريخي لا بأس به، فحسب تعبير الناقد الأمريكي روبرت شولز: “ترفض بعض الأعمال أنْ تنفتح لنا حتى ننضج بما فيه الكفاية، وتنغلق علينا أعمال أخرى حين نفقد قدرة الوصول إلى السياقات نتيجة الكبر أو النسيان” ، وهذا التعبير ينطبق تماماً على (تجليات) الغيطاني،
ويبدو أنّ الغيطاني قد استشعر هذا الأمر، فكتب في مقدمة الرواية: (عكفتُ على تدوين ما كتبت، فكان هذا الكتاب الذي يحوي تجلّياتي وما تخللها من أسفار ومواقف وأحوال ومقامات ورؤى، وهذا كتاب لا يفهمه إلا ذوو الألباب وأرباب المجاهدات، أما إذا أظهر البعض استغلاق الفهم أو الملامة فإنني أتلو: (قال ما خطبك يا سامريّ، قال بصرتُ بما لم يبصروا به).. فهو نص وخطاب لا ينفتح بسهولة لدى القارئ أو المتلقي نظراً لما يحمله من إشارات ورموز ونصوص متعددة ومتباينة أيضاً، فهو عمل يرفض الانفتاح أمام القارئ الذي لا يمتلك ثقافة واسعة ومعرفة كافية بآليات النسق المعرفي الصوفي و إلماماً كافياً بأحوال التراث الإسلامي بكافة أبعاده، فنحن هنا أمام رواية غير تقليدية، وهي مبتكرة بأسلوب جديد متمرّد على الأنماط والأشكال الروائية السائدة التي استهلكت كثيراً، (في التجليات يسعى الغيطاني إلى تحقيق شكل فني تجريدي يقوم على أساس تحطيم بِنية الشكل التقليدي في الكتابة الروائية) ، فقد انفتحت هذه الرواية على أبواب الحياة والفنون والآداب كلها وغرفت من معينها، حيث اختلط فيها السرد مع التصوّف مع البلاغة واللغة مع التراث مع الأسطورة مع السياسة مع التاريخ مع الدين مع الشعر، وأغلب الظن عندي أنّ الغيطاني وهو يكتب روايته هذه كان يستحضر في ذهنه قصة (الإسراء والمعراج) الإسلامية ، و(رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري الأدبية ، و(الفتوحات المكية) لابن عربي، ففي روايته الكثير من ملامح تلك المؤلفات، وهذا الترصيع في بِنية الرواية هو ما عبّر عنه الناقد الروسي ميخائيل باختين في أحد مؤلفاته: (إنّ الرواية تسمح بأن نُدخل إلى كيانها جميع أنواع الأجناس التعبيرية، سواء كانت أدبية “قصصاً، أشعاراً، قصائدَ، مقاطع كوميدية” ، أو خارج أدبية “دراسات عن السلوكيات، نصوص بلاغية وعلمية ودينية، الخ”)
لم يكن جمال الغيطاني أول من يوظّف هذه الأبواب في روايته، فقد سبقه نجيب محفوظ والطيب صالح وغيرهما في الكثير من الروايات الأدبية، ولكنّ من المؤكد أنّ رواية (التجليات) هي الأدسم في توظيفها الصوفي والديني والتاريخي لكونها رواية طويلة تقطع الأنفاس، فهي بحدود (800 صفحة) من ثلاثة أجزاء أو كما سمّاها (أسفار)
ولا نستغرب أنْ يقوم كاتب نهل من الثقافة اليسارية الماركسية ما أهَّله للدخول إلى المعتقل الناصري قرابة نصف سنة في منتصف الستينيات، أن يقوم بتوظيف التراث الإسلامي متعدّد الأبواب في كتاباته ونصوصه، وذلك لإدراك هذا الأديب وغيره أنه لا يمكن تجاهل هذا التراث الضخم بسهولة، وأنّ هذا التراث مَعين لا ينضب ومادة دسمة للكثير من الخطابات والكتابات الأدبية، وهي تحتاج الكاتب الماهر المبدع ليعيد صياغتها بقالب جديد، وهذا ما فعله جمال الغيطاني في أكثر من رواية كتبها لعل أشهرها (التجليات) التي حصدت جائزة (لور باتليون) الفرنسية كأفضل عمل أدبي مترجم إلى اللغة الفرنسية عام 2005 من بين 800 عمل أدبي من مختلف أنحاء العالم.
شخصية الإمام الحسين عليه السلام في رواية (التجليات) ، هي الشخصية الأكثر حضوراً في الرواية إلى جانب الزعيم جمال عبد الناصر والعارف الصوفي ابن عربي، ورغم أنّ القارئ والمتلقي يدركان جيداً أهمية توظيف شخصية دينية كالإمام الحسين في نص أدبي، لما تحمله هذه الشخصية من رمزية معروفة في التراثين الديني والتاريخي عند المسلمين بل عند الإنسانية جميعها (فبطولة الحسين جزء من إيمان كثير من الجماعة العربية، وهو رجل المبادئ الذي ضرب المثل الأعلى للدفاع عنها حتى الشهادة) ، إلا أنّ جمال الغيطاني ذهب إلى أكثر من ذلك في روايته، فالغيطاني وهو (الاشتراكي الماركسي، لكن البعد الروحي له تكوّن في حي الحُسين، فصورة الإمام الحُسين تلوح في مخيلة الغيطاني ويستعيدها في ذهنه، فلا يوجد شخص تأثر به الغيطاني كما تأثر بالحُسين فهو تخطّى محدوديته على مستوى الرمز، وهذا أسمى أنواع الخلود .. والحُسين الذي مثّل له منذ اعتناق المصريين للإسلام رمزاً، وليس شخصاً خرج من محدوديته الإنسانية، فأصبح ملاذاً للمصريين، وإذا كان هناك شخص يعاني ضيقاً يأتي للحُسين.)
فنجد الغيطاني وهو يبحث عن الحسين في (تجلّياته) يتجوّل في فضاءات ومحطات عربية متعدّدة منها الكوفة والنجف وكربلاء والبصرة والقاهرة وفاس، ليعيد للقارئ المعاصر رسم شخصية الحسين وإسقاطها على الأحداث المعاصرة، فتكون كربلاء هي القاهرة، والحسين هو عبد الناصر، وشهداء كربلاء هم شهداء حروب السويس وبور سعيد وسيناء وحزيران واكتوبر، والخيانة هي هي، في تناغم واضح مع المقولة الشهيرة: (كلّ يومٍ عاشوراء، وكلّ أرضٍ كربلاء.) ، فالحسين مصلحاً وثائراً ومنهجاً هو لكل الأجيال ولكل الأحرار في العالم، ينهلون منه معينه الذي لا ينضب، وكما قال عبدالله العلايلي: “كان الحسين بركان الإصلاح، وقد مضى كل مصلح بقبس من ذلك البركان، يرسله مناراً يهدي في الحَلَك”.
لم يأتِ الاهتمام بشخصية الحسين في رواية الغيطاني من فراغ، فقد كانت هذه الشخصية محور اهتمام الغيطاني منذ طفولته حيث يقول: (ورثتُ عن أبي حُبّ الحُسين، كانت يده لا تفارق يدي في زيارته ضريح الحُسين منذ كان عمري أربع سنوات، إلى درجة أنّ رائحة سجاد الحُسين ما تزال في أنفي .. أنا متعلق بالحُسين، متعلق بسيدنا الحُسين كشخصية، كدور، كموقف.)
لنعود لرواية (التجليات) ونطالع عدداً من نصوصها:
ــــ يبدأ الغيطاني تصوير شخصية الإمام الحسين مع بداية صفحات روايته بهذا المقطع: (انتبهت، فإذا بنور ساطع يشرق في ليل نفسي، نور ليس مثله مثل حتى ظننتُ أني عدتُ إلى مركز الديوان البهي، ثم رأيتُ في بؤرته ثلاثة وعلى مسافة خلفهم ثلاثة، وفي منتصف المسافة بينهم واحد، أما الثلاثة الأول فيتوسطهم حبيبي وقرّة عيني ورفيق تجلّياتي وملاذ همومي ومقيل عثراتي، إمامي الحسين سيد الشهداء..)
الرواية بلسان السارد الظاهر (الأنا)، والسارد هو بطل الرواية أيضاً، فهي رواية أشبه بسيرة ذاتية ولكن بطريقة مبتكرة وغير تقليدية فهي سيرة تحمل الكثير من العجائبية والغرائبية والمواقف المدهشة.
وفي هذا النص، يعيد الكاتب إلى الأذهان حديث نورانية أهل البيت عليهم السلام، الذي تكرّر كثيراً في أدبيات ومؤلفات العقيدة الشيعية وفي غيرها أيضاً.
ومن النص السابق وعدّة نصوص أخرى في الرواية، نرى الإمام الحسين فيها هو الحبيب والرفيق والملاذ والشفيع لبطل الرواية. فيصف الحسين في نص آخر: (شفيعي ودليلي)
وفي نص آخر يخاطب الإمام الحسين: (يا أخضر القلب، يا طاهر النفس)
ويصفه في نص آخر: (مولاي ونوري الأتم سيدي الحسين)
وفي نص آخر: (مولاي وضياء عيني الحسين عليه أزكى السلام وأطيبه، آه يا ابن الأكرمين لو بقيت معي).
وفي نص آخر: (المُنجب النجيب شهيد كربلاء).
في هذه النصوص نجد الغيطاني قد حشّد العديد من الصور التشبيهية والاستعارية لرسم صورة الإمام الحسين عليه السلام في ذهنية القارئ، مبرزاً الصفات الجمالية والجلالية والمعنوية والرمزية (ما ظهر منها وما بطن) للإمام الحسين. فهو (النور، الضياء، الشفيع، الدليل، أخضر القلب، طاهر النفس، ابن الأكرمين، النجيب، الشهيد، المولى، السيد، الزكي). وسنرى في نصوص لاحقة مفردات وملفوظات أخرى تنحو نحو ذلك.
ــــ في هذا النص يصف السارد/البطل وهو في رحلة معراجه السماوي، سروره بلقاء الإمام الحسين: (احتواني صريع كربلاء، سيد شباب أهل الجنة بعينين سمحتين وجبين وضّاء، ونظرات محب شفوق، حتى أني خجلت من التطلع إليه، تلك رقّة لم أعهدها، وهذا حنان لم يسبغ عليّ مثله، سُررتُ، وتبسّمتُ، وتبشبشتُ، ونزل في قلبي أمن وشوق، أنستُ بعد وحشة، وأصبحتُ كأني في جماعة وحشد عظيم، اقتربت فشممتُ رائحة طيّبة ونفساً عطرياً، سألني: إلى أين السفر؟ قلت: أتطول المسافات؟ قال: الإنسان لا تسهل عليه صعوبات البداية، إلا إذا عرف شرف الغاية، أمسكتُ بيده ذات الندى والطل، وقلت: إني مسلمٌ إليك ذاتي، لكني توّاق إلى لحظات الميلاد).
ــــ ويعود السارد مرة بعد أخرى ليصف الإمام الحسين مرشده الروحي: (التفتُ إلى جانب قلبي الأيمن، رأيتُ صريع كربلاء، دليلي، مولاي وصفيّي ومرشدي. يغيب عني إذا غبت عنه بفكري، ويبدو لي إذا ما فكرت فيه، وإذا ورد على بالي، وضمّد خاطري، إذا لفتني حيرة، أو لفّني خوف، هو قاب قوسين أو أدنى مني..)
في النصين السابقين نجد الطمأنينة والسكينة التي خيّمت على السارد وهو يصف قربه من الإمام الحسين في ذلك المعراج السماوي وسروره الكبير من الالتقاء بالإمام.
ــــ أما هذا النص رغم إيجازه الشديد، فهو أجمل وأبلغ وصف أدبي في الرواية كلها: (رحل بصري إلى الموضع الذي احتزّ فيه رأس سيد الشهداء، رأيته مضمّداً بالنخيل).
في إشارة رمزية إلى عدم وجود ناصر للإمام في تلك المعركة الدموية التي احتزّ فيها رأس سبط الرسول الأعظم .. النخيل امتلك الرقّة والرفاهة ليحنو على جسد السبط الشهيد .. وهنا تلميح لما ورد في بعض أدبيات العقيدة الشيعية من تأثر الجمادات والطبيعة بحادثة عاشوراء.
وهذا وصف آخر لمدى التبجيل والتقديس لشخصية الإمام الحسين عند الكاتب: (لا أقدم على تصرف أو فعل إلا إذا نظرت إلى سيدي الحسين ثم أستأذنه بالقول أو النظر)
وهكذا يواصل السارد كشف عشقه للإمام الحسين بوصف أدبي رائع أيضاً: (نظرتُ إلى قرّة عيني، إلى الحسين، وجهه مضوّع بالحنين، مأوى ومرقداً للطيف الجميل، انجذبتُ إلى محيّاه الرقراق فشفّ قلبي وتمنيت لو دام عليّ وقت النظر إليه).
ــــ وهنا يستحضر الكاتب مشاهد فاجعة عاشوراء، كأنه حاضر في أجوائها على وجه الحقيقة، بل يرى نفسه مشارك فيها إلى جانب الحق حيث معسكر الإمام الحسين عليه السلام.
(رأيتُ صاحبيّ اللذين رحلا معي عبر موقف التأهب، رأيتهما أو هكذا شبّه لي، يرتديان زي العصر، ويمسكان أسلحة العصر، ويقفان بين صحب الحسين الذين بقوا معه ولم يفارقوه .. أخذني العُجب، فانطويت تحت لواء الحبيب الأوفى، الحبيب المنزّه، مرآة الحق، ومجلي الغموض، عين القدر وعطر أيامي التي لم تأتِ بعد).
ــــ ولأنّ الكاتب/السارد/البطل، أصبح من رفقاء الإمام الحسين، فقد أطلع على أسرار لم يعلمها غيره: (سبحتُ في سماء مدينة الكوفة، رأيت من علوٍّ المدينة مضمومة، ملمومة مضمّدة بالنخيل والشجر، استعدتُ بأسى أحوالي في موقف الظمأ، ورؤيتي لحبيبي ومولاي الحسين وهو محاصر، ممنوع من ماء الفرات. حدّقتُ ببصري الجديد فرأيتُ ذلك الموضع الذي اجتث عنده رأس مولاي الطاهر، وهذا موقع لا يعلمه الآن من البشر الفانين غيري، ولا يمكن لآدمي تعيينه سواي، لكنني لا أستطيع البوح به في تدويني هذا، لقد خصصت بذلك أثناء محنتي، وما خصّني لا يمكنني نشره إلا بإذن، والإذن لم يقع، لذا أسكت).
ــــ استغرق الكاتب ذوباناً في شخصية الإمام الحسين، فكانت روح الحسين تخفق في ثنايا كلماته، فيختار منها الأفضل فالأفضل: (ولّيت قبلة إمامي الحسين، وفاض أساي فخاطبته بوجهتي وليس بنطقي:
ـــــ لماذا تركتني يا قرّة عيني؟
يقول الشفوق، نزهة الناظرين، وموضع الإنصاف:
ـــــ إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه .. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟
أتضرع: يا نبع الصفاء، يا مشرق المودة، تعذبني قلة حيلتي، وصعوبة الطريق .. يا إمامي، لم يعد حالي حالي، جئتك ملوَّعاً بالفقد.
يقول صاحب الثغر المنكوث بعصا الظالمين: كل شيء بقدر.)
وفي نص آخر نقرأ: (لاحظت أنّ سيد عرش قلبي والمتولي على خفقاته يرجع الطرف بيني وبين مكنوني.. أولِّي بوجهي تجاه حبيبي، أنطق من حزني وخوفي: أتنفيني عنك؟
يقول أنور الجبين: هذا شيخك في مقاماتك، اتبعه، واخلص، تكن من الكُل ..
إذن أوصاني تاج فؤادي ونبراسي، فأسلمت أمري .. لم أخف عندما صحبت الحسين، فهو الأمن وإن أخافني، وهو الرضا وإن أسخطني، وهو الرحيم بي وإن كدرني أو عاقبني)
ــــ وفي إحدى محطّات عروجه يستوحش السارد/البطل من غياب حبيبه الحسين، فيناجيه: (شفيعي سيد فؤادي حُسيني الوحيد، الشفوق عليَّ في مسلكي وغربتي، وشتاتي وهجاجي، حتى إنْ قسا عليّ، حتى إنْ نهرني، حتى إنْ عاقبني، فشدّته لصلاحي، واستقامة ما اعوجّ مني، وإتمام إفاقتي، واستدراك أمري). (نظرة يا مولاي الحسين، يا أكرم ولي، يا نجي، يا وفي، يا روضتي، يا صفحتي الجامعة، يا بستان القلوب، يا حديقة المعاني كلها)
نرى من خلال هذه النصوص من الرواية المتعددة، كيف تمكن الكاتب من اقتحام عوالم الخفاء والغيب وما وراء الواقع، تلك العوالم الخارجة عن سلطة الزمان، ومحدودية المكان، ومملوءة بالعجائب والغرائب والروحانيات، ويتحكم في مسارها الإمام الحسين عليه السلام، فهو الشخصية التي تتوافق وطبيعة الرحلة التي يقوم بها الراوي في عالَم الغيب، حيث كان ولا بد أن يكون الدليل والمرشد عالماً بأحوال ذلك العالَم العُلوي، ومَن غير الإمام الحسين وأهل بيته أعرف بذلك العالَم السماوي، ومَن غيرهم يستطيع أداء دور المرشد والدليل والعارف، كما تقول الباحثة الجزائرية عرجون الباتول: “ها هو الحسين في التجليات يلعب دور الدليل والمرشد ويمتهن مهنة لم يعرفها في زمانه -كربلاء القرن الهجري الأول- وها هو الحسين لا يزال محافظا على مكانته الماضية من جهة أخرى حيث يذكرنا السارد ببطولته وجهاده واستشهاده”.
رسالة الغيطاني من مختلف ما سبق نصوص، هي أن الشخصية الكبيرة من الناس (كالحسين)، بما فيها من المعنى الآلهي والسر القدسي والقبس العلوي، تنير السبيل للإنسانية في حالك الظلام، وفي الليل الأليل، فتكون حياتها دليلاً أميناً، وبعد مماتها أُمثولة رائعة، فيها من كل عناصر الخلود والسموّ.
والحقيقة التي لا غبار عليها هي أن تاريخ كل أمة إنما هو في الحقيقة تاريخ عظمائها، والأمة التي لا عظيم لها لا تاريخ لها، أو هي ليست جديرة بالتاريخ.
ويجدر بنا هنا أن نستذكر مقولة الأديب عبدالله العلايلي: “إذا قدّمنا حسيناً بين العظماء، فإنا لا نقدم فيه عظيماً فحسب، وإنما نقدّم فيه عظيماً دونه كل عظيم، وشخصية أسمى من وكل شخصية، ورجلاً فوق الرجال مجتمعين”.
نلحظ من النصوص السابقة، كيف أنّ الإمام الحسين قد هيمن بشخصيته الروحية على وجدان وكيان الكاتب/السارد/البطل بصورة مطلقة، فلم يعد يرى في حِلّه وترحاله في أجواء أسفاره ومعراجه غير الإمام الحسين، فأغدق عليه العديد من الصفات التي تعبّر عن هذا الحب والعشق الروحي. حتى عندما يصف مئذنة مسجد الحسين في القاهرة، فإنه يختار أعذب الكلمات لارتباطها بمعشوقه الإمام الحسين على قاعدة “شرف المكان بالمكين” : (المئذنة الأوضح، الأول، الألطف، الأقرب إلى الأفئدة، الطالعة دائماً، مستمرة الصعود في ثباتها، إنها القائمة على مثوى الضريح القاهري لناصر المستضعفين، لِمن حيل بينه وبين الماء فقضى ظامئاً، الإمام الحسين.)
كما يصف بأحد مقاطع روايته مشهد الضريح الحسيني من الداخل: (تختلط الملامح، تذوب في غسق خريفي، تتبدل وجوه أخرى، تطوف الضريح القاهري للحسين الشهيد.. تطوف الدنيا بمن فيها حول الضريح والمثوى، فانصف يا سيد شباب أهل الجنة، يا خير الأدلة)
يصف الكاتب طواف الزائرين حول ضريح الحسين في القاهرة، كأنّه يصف طواف الحجيج حول الكعبة المشرّفة، وهو وصف أدبي بليغ يتماهى بمعنى من المعاني مع الطواف كجزء من شعائر الحج، كأنّ الكاتب يرسل رسالة سبقه غير واحد من الأدباء والمؤرخين حول أهمية شخصية الإمام الحسين الرسالية، وأنه بموقفه البطولي والجهادي أصبح قبلة ثانية للمسلمين.
من خلال ما قدّمناه من نصوص من الرواية تتمحوّر حول شخصية الإمام الحسين، نستطيع أن نلحظ اهتمام الروائي جمال الغيطاني بإبراز أهم ملامح هذه الشخصية الرمزية ليس وفق ما ترسّخ في ذهنية القارئ والمتلقي فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك.
فلم يكتفِ الكاتب ببيان شخصية الحسين كحفيد للنبي محمد صلى الله عليه وآله، وزعيم وثائر وشهيد ومظلوم وقتيل ومحروم من الماء ومقطوع الرأس .. الخ، حيث يذكرنا الكاتب في أكثر من نص بجهاد وبطولة واستشهاد الإمام الحسين، وثباته على موقفه في الخروج على السلطة للتغيير والإصلاح، فهذا هو المتعارف عليه أصلاً حسب أدبيات التراث الديني الإسلامي العام لهذه الشخصية الدينية التاريخية.
لكننا نلحظ اتجاهاً لدى الكاتب الغيطاني لإبراز صورة أخرى لشخصية الإمام الحُسين تتماهى مع ما هو مرتكز في أدبيات التراث الإسلامي الشيعي تحديداً، فيكون الإمام الحُسين فيها في مرتبة الدليل، والمرشد، ورفيق تجلّيات البطل/السارد، حيث صورة الإمام الحسين هنا تتصف بصفات غيبية فوق مستوى البشر وخارقة للطبيعة كما في هذه النصوص أيضاً:
(حدّق إليّ الحُسين بنظر ثابت جميل، فتعذر النطق عليّ)
(أطلَّ عليَّ في سماء رحيلي، نجم هذا الوجود وسر أنسه، بهي الطلعة، سيد شباب الأولى والآخرة، من اغتيل بعد ظمأ، صاحب الولاية عليَّ بحق وجودي القديم، وبؤرة وجودي المُحدث)
(وكان مولاي الحسين على مقربة مني – معذرة – بل أنا على مقربة منه، فإليه تنسب الموجودات)
إذا كان لكل كاتب رمزه الخاص الذي يتلبّس روحه، ويغدق عليه إلهام الكتابة، فإنّ جمال الغيطاني هنا قد تجاوز تلك الموضوعة، فالإمام الحسين هنا ليس للغيطاني وحده، بل هو نجم الوجود وسر أنسه، وقطب رحى الموجودات.
ونجد السارد وهو يخترق الحُجب في معراجه يستغيث بالإمام الحسين: (الغواث يا مرادي الأصفى يا من نأيت عني، وضننت عليَّ بصحبتك، يا حُسينيّ.) .. (أدركني يا صاحب الدم المراق هدراً في هجير كربلاء)
وفي تماهي مع القصة القرآنية لنبي الله موسى عليه السلام والعبد الصالح، نقرأ للكاتب هذا النص: (تذكرت صوت سيدي الحُسين وكأني أسمعه الآن: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فوجفت وتوقفت وتعشّمت.) ، فالإمام الحُسين هنا حسب قراءة ما بين السطور، وعاء حمل الأسرار والعلوم الغيبية، والكاتب جعل منه نسخة ثانية تُحاكي شخصية العبد الصالح الذي أوتي من الأسرار والعلوم الغيبية ما جعل نبي الله موسى عليه السلام رغم شخصيته النبوية والرسالية يقف حائراً ومعترضاً على تصرفاته.
من الواضح أن الغيطاني أراد من سرديته الطويلة المشبعة بكثير من الأحداث الغريبة والعجيبة والمدهشة، وهو يهاجر في (تجلياته) لتطهير نفسه، أن يرسل رسالة إلى القارئ مفادها: إذا أردت البحث عن الذات وتطهير النفس، فعليك بتلك الروح الشفّافة الصافية الطاهرة الصادقة النورانية ذات الخُلق الرفيع والمُثل العُليا التي تمثّلت بشخص الإمام الحسين عليه السلام، الذي لم تعد ذكراه ذكرى رجل بل ذكرى الإنسانية الخالدة وتاريخه تاريخ البطولة الفذّة، فكان جديراً أن يستوحيه الغيطاني كمصدر إلهامي انبثق وهّاجاً قوياً، وامتدّ بأنواره أجيالاً وأجيالاً.