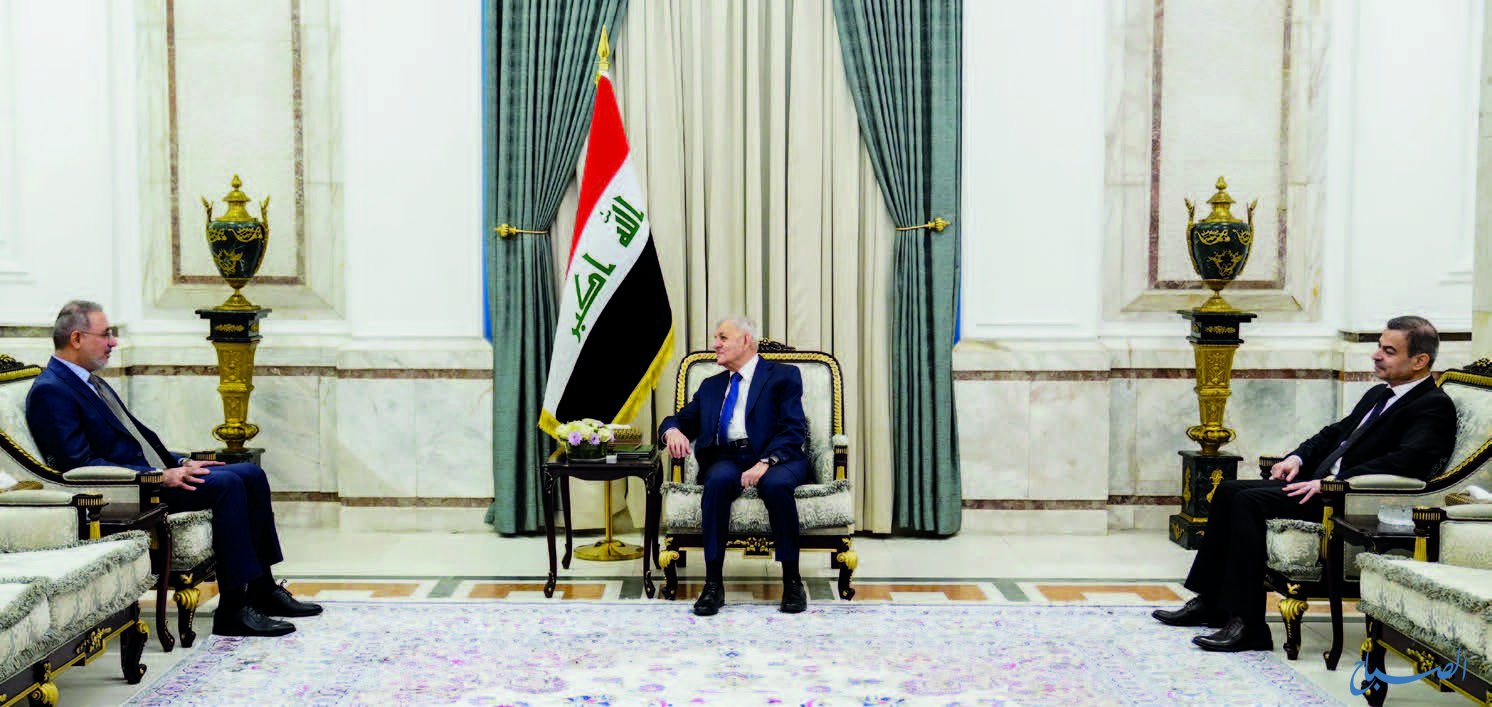حين يرسمُ الضحيَّةُ صورةَ جلَّادِهِ

إدريس الجرماطي
مدخل إلى الباب الأول (حكاية الحكاية) وتحليل لغلاف الكتاب…
أن تكتب عن (ذاكرة يد) أو (السيرة العراقيّة)، تكون كمن يجر النفس للخروج من مستنقع. الوقائع بشعة وغير معقولة. هذا العمل الضخم، هو غلاف مشبّع بكينونة الاحتراق والأصفاد، وسلطة الدم والاعتقالات، والدفع بالذات إلى الإحساس بالقهر والانهيار. إنها حكاية من نوع مختلف، من نوع ظلم وقهر وانتهاك للحقوق الإنسانيّة أشد رهبة من قصص كفر قاسم وغيرها من بلاد القتل والرهبانيَّة منذ زمن آدم إلى يومنا.
استطاع الكاتب بحسٍّ متميزٍ أن يغوص في متن أحداث، لم يكن قد عاشها إلا من خلال الاكتشاف وسبر أعماق السارد - الضحية. وبدقة أخويّة نابعة من العطف ولما له هو نفسه من دراية بوضع البلاد حيث العذاب المقيم فيها. تدفّق المداد وأعوج السطر، وتوغل في بساط أسلوبه الحكائي الممتلئ بالأسئلة والآهات والحسرة على بلاد كان عليها أن تكون الأصل، إذ تفوقت يوما ما على كلِّ معاني من يتغنّى بالحضارة الآن، الحضارة المتحوّلة إلى تكسير لكلّ حق إنساني.
بدأت عقدة الرواية أو الحكاية أو الواقع الذي كانوا فيه ضحايا (ذاكرة يد)؛ أن يأتي من ينقذهم من خارج البلاد. لم يكن تدخل (دان نورث) منتج الأفلام الأمريكي المقبل مع الجيش المحتل، سوى العقدة التي كان على الكاتب أن ينفذ منها إلى عالم هذه الأرواح. وكان هذا الأمريكي الوجه المشرف والمنقذ الروحي لموقف لا يحسد عليه، كما لو أن الأمر يتعلّق بتشفٍ من نوعٍ ما ينفذ إلى الأعماق ليُزيل الترسّبات العملاقة والتي كانت تشكل عبئاً على القلوب التي كانت بالأمس القريب محاصرة من قبل هذا المنقذ، ولا حيلة لديها سوى أن ترتشف الوجع والعار الذي أريد لهم، من طرف المسيطرين على الوضع، حكامهم المتحكمين في كل شيء.
اعتبر هذا المنقذ رغم ما يخالج نياته، بمثابة صرح متين، يجبر الخواطر بطريقته ووعوده ومفاجآته، ليتحول فعله إلى أفلام وروايات، تلك التي لا يشبهها أي مشهد في الكون، وعبر كل الحقب التاريخيّة، تجعلك لا تشفق على مصائرهم كيفما كانت، لأنّها لا تساوي كفاً واحداً من التي فقدوها غصبا وتقتيلا، ولأن القضية لم تعد خاصة فلا بدَّ أن يعرف العامة كل الأحداث ولا سبيل إلى ذلك إلا عبر الحقيقة المرة من صور وأفلام ومشاهدة. يعتبر ذلك بمثابة شهادة تمسح القليل من وجع الضحايا وترجع القليل من دم الوجه إليهم. إذ لولا الواقع المفضوح بعد الاحتلال، لظل الجميع يظن بأن الضحايا هم الخارجون عن القانون. وكان ذلك التدخل الاستعجالي بمثابة معالجة القضية، بإعادتها إلى الأصل من طرف الغرب الذي كانوا يصنعون لنا منه وحشا ضاريا.
ها هو (الغرب) اليوم يسقينا من بئره وينتقم لنا برد الاعتبار لسيادة رجال أنهكهم الزمن وكسر القهر أنفاسهم. كما لو يريد أن ينفذ إلى أعماقنا ليوضح الصورة بتشكيلها الدموي والمدمي، ليعالج ما تمَّ تكسيره وترميم ما أفسده الأخ الذي لا يرحم. لقد تحول المشهد المروّع إلى صفقات من طرف الأمريكيين، كما جاء في عرض «دان نورث» وجعل القضية ذات صبغة عامة تتخابر فيها الآراء بين مؤيدٍ وناكرٍ لهذا السلوك، كل يدلي بدلوه، كل بما أوتي من إعلام يتربّص، وقنوات ترى في القضية أمورا أخرى.
ويظل الأجمل ذلك الاعتبار الذي ناله الضحايا من طرف السلطات الأمريكية، حيث أخرجتهم من العزلة النفسيّة ومن جحيم المعاناة، إلى أمل حياتي. وهذا ما شجّع الكاتب الماهر والفيلسوف المقتدر، كريم كطافة من التوغل في بركان هذه الأحداث بصدق ومصداقية، وسبر في الرواية بمساعدة الضحية الرئيسية الأستاذ (صلاح حسن زناد) هذا البطل الذي كشف الأحداث بأمانة مطلقة وبتفاصيل دقيقة، وخاصة أن الموضوع يحتاج إلى آليّات وغوص يجعلك تتسلّح بالصبر والعيش بأحاسيس تنبض من خلالها جمرة الأمانة رهينة بين يديك.
جاءت الرواية بصيغة حواريّة ثنائيّة بين الضحية والجلّاد بعد سقوطه المريع. حواريَّة مترعة بالأسئلة والرسائل الصاخبة مرة بلسان الضحية ومرة بلسان (دان نورث) عبر أفلامه ومفاجآته الغريبة، حواريَّة تنكأ الجرح وتُسائل الجلّاد عن ظلمه لضحايا لم يكن ذنبهم سوى أنّهم يعيشون في وطن تحول كأنّه الوحش المفترس ينهش قلوبهم تاركاً فيها رغبة في الانفلات من صخب الهوية المرعبة والمواجهة القاسية. حواريَّة تلاحق الأرواح عبر الأفكار، يتمنّى الضحية لو تصير جواباً شافياً لألم لا يمكن نسيانه. رغبة جامحة في كشف كل الحقائق التي لم يقلها أحد، حين كانت كل وسائل التضليل والتشويه والسيطرة بيد الجلّاد. أسئلة لن يجد لها الجلّاد من أجوبة. لكنها رغبة الضحايا في كشف السر المخبوء، ليعرف الجميع، ليصبح الضحايا في نهاية الأمر أبطالاً، ورمزاً للشهامة بعد كلِّ الشماتة التي عوملوا بها حين كان الجلاد يحتكر جميع المواقف.
دخول الضحايا إلى عالم آخر، وجدوا فيه أنفسهم أبطالا بعد أن تخلصوا من الظلم الذي لحقهم، يتمتعون بالحرية أمام شاشة أحداث مختلفة، تحول فيها الجلّاد إلى دمية لا تقوى على الحركة، تجتر الخوف وتدّعي القوة المصطنعة، والضحايا يشيرون إليه وهو في قمة المعاناة، يتلذذون بموته وتكسير شوكته، بعدما كان لا يفارق أحلامهم. مشهديَّة مختلفة من فيلمين غريبين وتبادل للأدوار، يصير معلم الكراهية جباناً منحطاً، ويصير ذلك التلميذ -الضحية الذي لم يكن يرفع رأسه خجلاً وخوفاً، ذا شرعية في الحديث، حرا يمتلك الدنيا من كل المناحي. اليتيم يصير رسولا ونبيا، إنها مواقف لا يقوى عليها سوى القدر المحتوم.كان أحد الضحايا (علاء شبر) صاحب المخيلة العجيبة، قد وصف ما كانوا فيه بـ(المفرمة).
وصف يفوق قدرة الأمريكي على الاستيعاب، لا قدرة للخيال على استيعاب هذا الشكل من الشر المفضوح الآن، لا قانون ولا ميثاق للمفرمة، سوى قانونها العشوائي. مفرمة بشيفرات باشطة تدور في غرفة مظلمة تضم الشعب، لا أحد يدري متى تقطع أذنه، أنفه، يده، أو رأسه. لا حق بالاحتجاج ولا بالخروج من الغرفة. الخوف والانتظار سيدا اللحظات. هذا الإحساس يسرده (علاء) كمن يركض هرباً من الرماد، ليكشف الستار عما كان يحدث، بموازاة وصف آخر لعالم الجلّاد وهو في ضعفه وسقوطه.
لا شيءَ يسلم من مفرمة الوطن، حتى الكتب تتحول إلى فخاخ. لا منشور يوزع إن لم يكن موشوماً بوشم الرداءة، أتباع البلاط وحدهم لهم الحق في نشر التفاهة والعفن، سموماً في مزبلة بحجم الوطن، أوراق بالية هي مجرد عناوين تخدم مصلحة الواحد، هو من له حق الرضى من السخط، من دون أن يعرف أن زمناً سيأتي وسيرى كتباً ذات قيمة تنشر بعد سقوطه، كتب ترسم جبنه وظلمه، وهو من رحل إلى هنالك حيث سيلقى مكيال ما أتى، وتغدو كتب المزابل وأوليائها رفاة تعتصر الحقد والعدوانيَّة.
استطاع الكاتب التوغل في الأحداث على لسان سارد أديب فصيح، فاجتمع في النص حكي وحبكة وتناص بلون الحرارة والألم، إنّها شخوص وضحايا، كل بسلاسته وتبحّره وتخبره بأوضاع أوجاع الوطن. استطاع أن يرحل بنا في أسطول شائك، في رحلة مؤلمة حد الأفق، مطلقاً بوجوهنا أسئلة محيرة، تجعل الجبابرة بأنفسهم يخجلون عند كل سؤال، أسئلة مسجلة وكأنّها حروب نفسيّة من مجهول غادر، كانت عذاباً بلون الوطن، وأي وطن هذا الذي تتمزّق فيه الأجساد أشلاءً وقطعاً، إنّها البهائميّة بكل اللغات، إنها قوانين المفرمة. إنها تواريخ وأرقام مرتبطة بالهلاك النفسي، أحداث يتجلى فيها الظلم بلغة الوضوح، إنها سرد لأحداث لم يكن فيها الضحايا إلا مجرد أكباش فداء، نتيجة عفويتهم وبلادتهم في بعض الأحيان، الأبواب مشرعة كما للحيطان أذان، إنها أذان الموت كما جاء في كتاب الكاتب المغربي عمر الموريف من الجنوب الشرقي المغربي، ابن الوطن المهمّش للطاقات، رجل أديب يعي فصول النار. أسئلة عن كل شيء، عن النار وعن الماء، وعن العذاب، وعن.. وعن..
كاتب من المغرب