تجربة البشر على ألسنة الحيوان
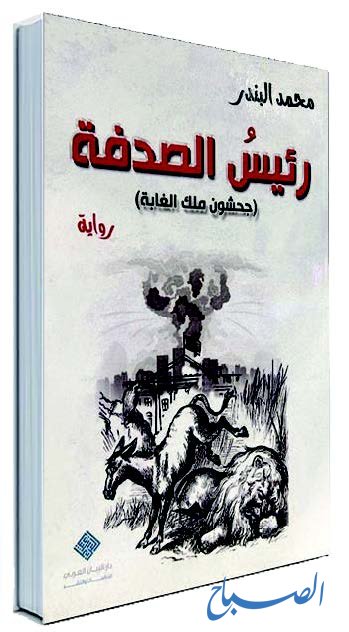
خنجر حمية
عمل محمد البندر هذا هو في ظاهره رواية يستثمر فيها الحوار على ألسنة الحيوانات. ومثل هذا النمط من الكتابة الأدبيّة قديم في الشرق وفي الغرب.عندنا تبقى «كليلة ودمنة» أحد معالمه البارزة، وكتاب البهائي، التدين والنفاق على لسان القط والفأر مثلا، أنموذج، يقرر فيه صاحبه شكلا من أشكال النقد على لسان البهائم في ظروف اجتماع جد معقدة، كان النقد السياسي والاجتماعي فيها يبنى بواسطة الرمز والإشارة والتلميح.. خوفاً من سلطة عاتية في الدين أو السياسة، وتخطياً لسلطة الموروث.. التي تقلل من فرصة أي تغيير أو تجاوز أو تخط، وتمنع من الخروج على ما رسخته من أنساق. وكما عرف شرقنا مثل هذا النمط من الكتابة فقد عرفه الغرب سواء بسواء.
وإذا كان مثل هذا الأدب إنّما يتوسّل ألسنة الحيوانات اعتصاماً بها من سلطة متعسّفة أو تقاليد راسخة، وإذا كان يعتمد في بنيته الأدبيَّة على الرمز والإشارة والتلميح هروباً مما قد تجلبه الوضوح والمباشرة والصراحة على صاحبها من مهالك فإنَّ البندر يقصد من وراء ذلك هدفاً أبعد مدى وأوسع دائرة وأرسخ معنى، فهو لا يقرر أحكامه بالمواربة، بل بصراحة ووضوح ومباشرة، ولا يلجأ إلى أساليب التعمية والتلميح خوفاً من سلطة طاغية أو مستبد ظالم أو رقابة صارمة أو موروث مهيمن، وهو لا يخفي قناعاته وراء الرموز والحكايا والحكم على لسان حيوان هنا وحيوان هناك.
بل يعلن عنها بكامل دلالتها في وضوح جلي وصراحة شديدة الوقع على العقل والوجدان والعاطفة.
لكن ما الذي يدعو محمد البندر إلى أن يخاطبنا بلسان العجماوات؟، وما الذي يريده من مثل هذا الحوار المفترض على ألسنتها على تنوع موقعها الطبيعي في سُلّم التصنيف الحيوي لعالمها إذا كان لا يهدف إلى تضليل سلطة قامعة، أو قوة طاغية، أو حراس تقاليد، يرغب أن ينأى بنفسه من خلال ذلك عن أن يصيبه منها أذى محتمل!.
يكشف نص محمد البندر عن مفارقة لطيفة يقع القارئ عليها منذ الصفحات الأولى لعمله، وهي أنّه يقلب لنا تصنيف عالمنا رأساً على عقب، فيصور الحيوانات في الغابة كما لو أنّها تجسّد في عالمها المتوازن، عالم الإنسان في حقيقة ما ينبغي أن يكون عليه، ويدني من جانب آخر عالم البشر الفعلي الذي نشهد على فصوله أو الذي سجل لنا التاريخ الكثير من أحداثه إلى أسفل مراتب الأحياء، ليصبح العالم عنده مقلوباً يقع البشر في أسفل سلَّمه وليصبح أقل شأناً، وأدنى مرتبة وأنزل مكانة وأهون قيمة من كل عالم من سواه.
لا لأنَّ الإنسان هو كذلك في أصل فطرته، ولا لأنَّ البندر يضع نفسه ضمن تلك الزمرة من المفكرين التي تعد الطبيعة الإنسانيّة طبيعة شريرة في أصل تكوينها كما عرَّفنا هوبز مثلاً.
فالبندر لا تجذبه الميتافيزيقا هنا، ولا تغريه رؤى السياسة، وفلسفتها ولا يؤرقه تحليل بنية الشر وكيف يوجد.
ما يغريه هو التجربة الفعليّة، ما يقع هنا والآن، ما ينجز من فعل وما يتحقق في ممارسة، أعني ما يحدث ويجري.
من هنا جاء قلب النسق في صورته الطبيعيّة، وعكس سُلّم الكائنات الحيّة بحيث صار الإنسان ضمنه هو أدنى مراتبه، لأنّ تجربة الكائن البشري هذا الملقى في العالم حسب تعبير هيدغر، تجربة مظلمة سوداء، ولأن سجله سجل ملوّث بالموبقات والفظائع، مذ بدأ البشر يستغلون مآثرهم ويحفظون تاريخه، على الصخر أولاً، ثم في صفحات الكتب.
ولأن ما اقترفته يد ابن آدم في مدى تاريخه من الموبقات شيء لا يكاد يتصوره عقل ولا يستوعبه ضمير.. وهو الكائن الذي ميّز بالخلقة عن غيره من الكائنات بالوعي والعلم والإدراك والإرادة والحرية لكنّه ما لبث أن استثمر كل ذلك لتعظيم شروره مستغلاً كل تقدم بلغه وكل علم استحوذ عليه وكل قوة طبيعيّة استأثر بها ليدمّر بواسطتها كل ما بلغته يمينه وكل ما وصلت إليه يده من غير أن يوفر من ذلك عالمه الذي ينتمي إليه أعني عالم البشر على وجه خاص، فانتهك الطبيعة وقانونها واستثمر كل طاقاتها ونهب كل خيرها وعطل نظامها، ثم انعطف إلى عالمه يقوّض دعائمه، ويفتك بوجوده ويدمّر بنيانه غير آبهٍ بمبدأ ولا بقيمة ولا بشرعة ولا بمنهاج.
ألم يكن هذا هو تاريخ البشر في أظهر صوره وأوضع دلالاته وأبلغ معانيه؟.
ومن هنا نفهم في سياق نص الرواية، لم يقحم البندر، وهو يؤسس عمله على حوار بين حيوانات الغابة، أقول لِمَ يقحم البشر، أو عالم الإنسان، على لسان الذئب تارة، وعلى لسان الأسد تارة أخرى.
في سياق أحداث، يترفّع الحيوان نفسه عن أن تنسب إليه، أو تنتج عنه، أو ينخرط فيها.
وهذا يوحي، بالرغم من أن العمل في مغزاه العميق هو تأريخ موارب لتجربة البشر في مرحلة من مراحل تاريخهم، بأن البندر يتعامل، وهو يدير حواراً على ألسنة الحيوان، مع عالم البشر كعالم عرضي عابر، لا يُستدعى إلّا لاقتناص عبرة، أو الإشارة إلى موبقة أو التلميح إلى حدث وضيع.
في عالم الحيوان نفسه. ذلك أن ما هو استثنائي في هذا العالم حسب الرواية، هو اختلال في نظامه وتردٍّ في صورة بنيته.
وما هو عرضي عابر في تجربته هو الأصل عند البشر. في عالمه الأصل هو النظام، والعدالة، والحق والاستفاضة وفي عالمنا الأصل هو عكس ذلك على الإطلاق عالم الفوضى والظلم والباطل والانحراف والهمجيَّة والشر... إلخ.
واستناداً إلى هذا الأفق العدمي للرواية في جانبها الفلسفي يندفع محمد البندر ليكشف شيئاً من صورة تاريخنا المظلم الأسود القاتم المليء بصنوف القتل والتدمير والهمجيّة، والنهب المنظم للثروات الطبيعيّة والانتهاك المبالغ لقانون الحياة الذي تقوم عليه الطبيعة في كليتها... منذ القرون الوسطى وما تلاها من اندفاع محموم للبحث عن الثروات واكتشاف عوالم جديدة كما هو الحال في اكتشاف العالم الجديد لأميركا واستعمار استراليا وأفريقيا وآسيا.. إلخ، ومنذ أن بدأ الإنسان يتملّك شيئاً من قوة العلم وسطوته، فاندفع لا يُقيّده قيد ولا يقف في طريقه حاجز، ولا يمنعه مانع.. مطلقاً العنان لرغائبه البهيميّة ولشهواته ولرغبة الهيمنة عنده مستغلاً أمماً فقيرة وشعوباً هانئة مستقرة، فأمعن في استغلالها وتدمير حياتها وسفك دمائها واستعبادها، متخذاً منها مواطن يحصل من خلالها على عمالة رخيصة يقيم عليها صناعته الجديدة واقتصاده الصاعد، وأسواقاً يصرف فيها نتاجه.
فتوحّش حتى لم يعد يظن أن ثمة حدوداً لتوحّشه وتعالى حتى لم يعد يعتقد أن ثمة حدوداً لتعاليه وارتكب في إثر ذلك ما لا يحصى من الفظائع والمذابح من غير أن يجد ضرورة لأنّ يعلل ذلك، أو أن يبرره مستنداً إلى تفوق يملكه أو قوة يستحوذ عليها أو ثروة يتفرّد بها أو سلطان يتمتع به.
وهكذا مارس أبشع أنواع الهيمنة والاستئثار والسيطرة، وسام شعوباً ضعيفة ضروب المهانة والمذلة، وسخرها في خدمة طموحاته الإمبراطوريّة متخذاً منها أرضية يقيم عليها صرح نفوذه وقوته وسلطانه، ووقوداً لدفع عجلة تقدمه المادي والتقني وهكذا راح يتقدم العالم على جماجم الفقراء والبسطاء والضعفاء والمسحوقين وما زال كذلك إلى يومنا.
وحين أقول بأنَّ البندر يكشف عن الأفق العدمي لوجودنا، لا أقصد أنه يصبح أسير نزعة عدميَّة لا يرى من خلالها في عالمنا كوة ضوء قط كما هو الحال مع مذاهب عدميّة فلسفيّة قديمة وحديثة، ما كان يرغب في الكشف عنه هو الخداع المضلل الذي يمارسه العالم المتقدم حين يعلن لنا عن صورته، ويقدم لنا نفسه من خلال عالم قيم وعدالة وحق.
والتزييف الذي يمارس على عقولنا باسم العلم والحرية والكرامة الإنسانيَّة.
هنا يتبدّى أن ما قدم لنا على مدى عقود كشكل من أشكال تطور البشر فيه هو في حقيقته انحدار، وما صوّر لنا على أنّه ارتقاء للإنسان إلى ذرى رفيعة هو في واقع أمره سقوط راحت تزيّنه آلة الدعاية وتبرزه على غير صورته.
ولا ينسى محمد البندر وهو يعرفنا على لسان الحيوان الذي يفوقنا مكانة، ويرتقي في ضميره فوق ضميرنا ويرتفع في قيمه فوق قيمنا، أقول لا ينسى أن يمرَّ على مجتمعاتنا التي يعصف بها الاستبداد السياسي والديني والاجتماعي، ويحيط بها القمع من كل جانب، وترفل مع تخلّفها وسقوطها، وتسحق فيها كرامة البشر، وتداس حقوقهم وتدمر طاقاتهم، وتصادر إراداتهم. وهكذا إذًا هم البشر عند البندر فيما يقدمونه لنا كإنجاز، يستبيح القوي منهم الضعيف ويستبد الحاكم برعيته، ويذل صاحب القوة من لا قوة له ولا معين، ويخضع صاحب السلطان من لا سلطان له. ويستثمرون جميعاً عقولهم في ارتكاب الشرور، والآثام بلا حدود ويطلقون العنان لطاقاتهم لتدمير عالمهم الذي يعيشون فيه غير آبهين بما يمكن أن ينتهي إليه ذلك في ما يخص وجودهم وبقاءهم.
هذا نص اتهام يقدمه محمد البندر هنا في وجه الإنسان أو هو لائحة اتهام. وهو أي البندر يحسن إنشاء محكمته الدوليَّة في «جحشون» ويحسن إدارة جلساتها، ويحسن انتخاب قضاتها وشهودها. ثم يقدّم لنا أحكامه قاطعة لا ارتياب فيها ولا شك، ولا التباس تقررها حيوانات ذاقت هي بنفسها شيئاً من شرورنا، وكابدت صنوف العذاب على أيدينا واختبرت اندفاعة غرائزنا وتهويماتنا وأطماعنا والشرور التي ولدها سوء طويتنا. وهي بعض قليل مما اقترفته أيدينا حتى يومنا من شرور.





