تفاصيل الفضاء بين القراءة ومتعة الحياة
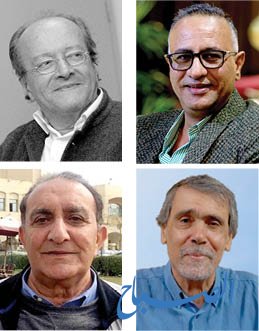
صدوق نورالدين
قيل لأعرابي: لماذا لا تصاحب، قال: أخشى الفراق.
(ص/165)
(1)
يوازي الكاتب صفاء ذياب في منجزه الأدبي بين مسارين: مسار المبدع متمثلا في تجربته الشعريَّة التي تشكلت نواتها منذ ديوانه «لا توقظ الوقت» بغداد/ 2000، وإلى غاية إصداره «سلم قديم تآكلت أضلاعه» البصرة/2017، ومسار الناقد الباحث متجسدا في التركيز على قراءة الموروث التراثي القديم صيغة ومادة. وهو المسار الذي استهل بـ : «تمثلات العجيب في السيرة الشعبية العربية»، (دمشق/ بغداد/ 2015)، وإلى دراسته العميقة «السيرة الشعبية في النقد العربي المعاصر، دراسة في المفاهيم» (الكوفة/2019).
والواقع أن التجربة النقدية لصفاء ذياب لا تنحصر في قراءة وتأويل السيرة الشعبية وحسب، وإنما تمتد لتلامس الأدب الحديث على وفق ما تجسد في كتابه «يرشد الظلام إلى طريق جانبي. في أدب طيب جبار»(البصرة/ 2016) و»النظر في المرآة. 30 كاتبا عربيا في سؤال الكتابة» (العراق/ 2020) ومؤلفه الأخير «أن نحكي. كيف نقرأ؟ كيف نعيش؟» (العراق/2022).
بيد أن ما ينتظم الموازاة بين المسارين الإبداعي والنقدي، الأدبي كما يفصح عنه التعبير. الأخير المستند للتخييل من حيث الكتابة الشعريّة، وللموضوعيّة النقديّة حال البحث والدراسة. فالتكامل في الجوهر يسم ويطبع المسارين من منطلق كون المؤلف واحدا، إلى الاختلاف في الرؤية إلى الأشياء والقضايا.
على أن الغاية من هذه الكتابة، الوقوف على المؤلف الأخير «أن نحكي. كيف نقرأ؟ كيف نعيش؟». وذلك للاعتبارات التالية:
_ كونه المؤلف الذي صدر ونشر مؤخرا.
_ فرادة الصيغة المعتمدة في كتابته.
_ التنوع الذي يسم مادته.
فإذا كان «أن نحكي» المؤلف الذي نشر كآخر إصدار لصفاء ذياب دون أن يكون الأخير، فإنه يعكس صورة أخرى للباحث الناقد، صورة المتأمل في قضايا نقدية إبداعية، وفي محاولة للربط بين القديم والحديث في نوع من الامتداد.
وبناء على السابق، فالصيغة المعتمدة - وفق ما ألمح الناقد الدكتور حاتم الصكر - صيغة التحرر من صرامة المنهج، وذلك بالرهان على التأمل والانطباع والمقارنة، وهو التوجه الذي غدت تنحوه العديد من الكتابات النقدية العربية الحديثة، نحو ما يطالعنا لدى محمد برادة في كتاباته النقدية الأخيرة، أيضا لدى كل من عبد الفتاح كيليطو، وفي الحقل الفلسفي عبد السلام بنعبد العالي. فالانطباع والتأمل تكسير لقيد المنهج، ورهان على الحرية في القراءة، التفسير والتأويل، إلى كونها - وفق الصكر - دعوة مفتوحة للتلقي المشارك الذي يثبت قاعدة التفاعل بين القارئ والنص.
ويبرز التنوع على مستوى الأجناس الأدبية المتناولة: السيرة الشعبية، الحكاية الشعبية، السيرة الذهنية وأدب الرسائل إلى التأملات الذاتية المرتبطة بالرموز الحضارية التي تتفرد بها المدن، وهي الرؤية التي يتداخل فيها الأدبي بالأنثروبولوجي.
تقود الاعتبارات السابقة، إلى الوقوف على صورة الناقد المثقف، والقارئ المنفتح على ما أشرنا إليه سابقا في نوع من التكامل بين القديم والحديث. وأرى أن في المرجعيات المستحضرة سواء من الأدب العربي قديمه وحديثه ومن الأدب العالمي في سياق الإنجاز، الدليل القاطع على ما نشير إليه.
(2)
تحقق تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول أو أبواب :
_ حيواتنا الشعبية
_ سرديات يومية
_ صورة مدينة
_ و ثقافة آيلة
بيد أن ما يوحد التقسيم ويهب الكتاب قوة تماسكه، الربط بين الحكاية والحياة. أقول متعة الحكاية، ومتعة الحياة التي تقولها الحكاية. إذ وبالتأسيس على الاستفهام المرتبط بالأداة «كيف؟» : (كيف نقرأ؟ كيف نعيش؟)، فإن وظيفة الأداة هي السؤال عن الوضعية، عن الحال، مادام المعنى المطلوب ترسيخه (كيف يمكن أن نقرأ؟ كيف يمكن أن نعيش؟). ومن ثم فإن كيف أداة استفهامية وليس إخبارية. الاستفهام الذي يجد جوابه في المعنى المنتج ضمن الكتاب أي في الحكاية، من منطلق كونها الولع الذي يرتبط به المؤلف صفاء ذياب. فهو يتمثله، يفكك مقصدياته باعتماد بلاغة التكثيف وخلخلة ما قد يكون ساد كمعنى جاهز من قبل، ويتحتم إعادة تخييله والتفكير فيه وربطه بما يسم الحاضر ليس في العراق وحده، وإنما على امتداد العالم العربي. ولعل ما يلفت في سياق التأليف، كون المنطلق أو البداية في أغلب نصوص الكتاب، تتأسس وباستمرار انطلاقا من حكاية ما، وبالرهان عليها يتم الإفضاء بما يقتضي القول. وكأن ما يتغيا ذياب ترسيخه وتثبيته أن الحكاية هي الأصل، ومنها تفرعت بقية الأجناس. فإذا كانت الحكاية هي الحياة في القديم، فإن هذه الحكاية متضمنة في جنس الرواية اليوم. و بمثابة تحول يتغيا فهم الحياة، وبالتالي فإن الرواية حياة:
«هل الرواية حياة أو الحياة رواية؟ كلاهما يتداخلان فيما بينهما، يتوسلان الألم والفرح، يتخذان من الزمن نسيما يمران به، يطيران في عوالم متآلفة، ويسبحان في وجود متوهم، وجوه نمر بها، تعطينا دفقا من الذكريات، وهبات من الحكي الذي لا يتوقف، وجه أم وأب وأخت وجدة وجيران يتناسلون كما تتناسل البيوت، في الأزقة تتراكم الحكايات وفي الشوارع تتوسد اللغة أرصفة متواصلة، لتحفر في السرد أخاديد متشعبة. الحياة هكذا. كذلك الرواية.»(ص/79)
على أن الحكاية بما هي الحياة، والرواية على السواء، فذلك يستدعي استجلاء تفاصيل الفضاء في ضوء كونه التمثيل عن المساحة مدار تفاعل وجريان الأحداث. من ثم يحضر الحديث عن ماضي بغداد باعتبارها الزوراء ومدينة السلام. وفي هذا الأفق يغدو المتأمل باحثا أنثروبولوجيا يعمل على قراءة الرموز التاريخية التي ترسم صورة المدينة من حيث تاريخها: النوافذ، الأبواب، الجدران وشكل البيوت. والواقع أن فراءة من هذا المستوى، حفر في التاريخ، وكتابة مغايرة للمدينة، أقول إنها السيرة التي يتضافر فيها الأدبي والتاريخي، سيرة بغداد لمن لا يفقه رموزها:
« المدن برموزها، وهذا ما نراه في علم كل مدينة في أوروبا. فضلا عن علم الدولة الرئيس، ترفع كل مقاطعة علما خاصا بها، ويأتي بعده علم المدن التي تشكل بمجملها الدولة الحديثة. إلا أن الأهم من هذا هو أن لكل مدينة علامة تمثلها، علامة تجمع في تصميمها أهم ما تعرف به هذه المدينة.» (ص/122) «للأبواب روائح ساكنيها، ولها أيضا مباهج الفرح وآلام الحزن وتمتمات الأم الوحيدة.» (ص/127) إن استجلاء الرمز في بعده التاريخي، تمثيل عن ثقافة تمتلك مفرداتها التي تتفرد بها. المفردات التي تجسد الحاضر وتدعو إلى التفكير في مستقبل قادم يطرح رمزيته واستمراريته إذا ما أريد له أن يغدو في القادم الصورة الحقة عن ماض يحكي حكايتنا. وبحكيها يرتبط ماضيان يتم التفاعل معهما:
« ففي هذا الحاضر الذي نسعى لتجديده من خلال ماض جميل، سيأتي حاضر آخر لا ماض له، حاضر طاف فوق الإهمال. إنه مستقبلنا الذي نركله خلفنا، وماضينا الذي لا نراه إلا من خلال تراب.» (ص/196)
(3)
إن ما يمكن استخلاصه من هذا التقريب الأدبي لكتاب «أن نحكي» :
1/ كوننا أمام كتابة أدبية تأملية تجمع بين قراءة القديم والحديث في نوع من الامتداد والتكامل، من دون التقيد بصرامة المنهج.
2/ إن الرهان على الحكاية وما يجاورها من أجناس، هو الإفصاح عن الأصل، والقاعدة التي تشكلت الآداب بالاعتماد عليها.
3/ إن الأستاذ والكاتب صفاء ذياب، نموذج لمثقف جامع، ومبدع يدرك أسرار الكتابة وخباياها وهذا سر نجاحه ناشرا على السواء.
ناقد وروائي من المغرب





