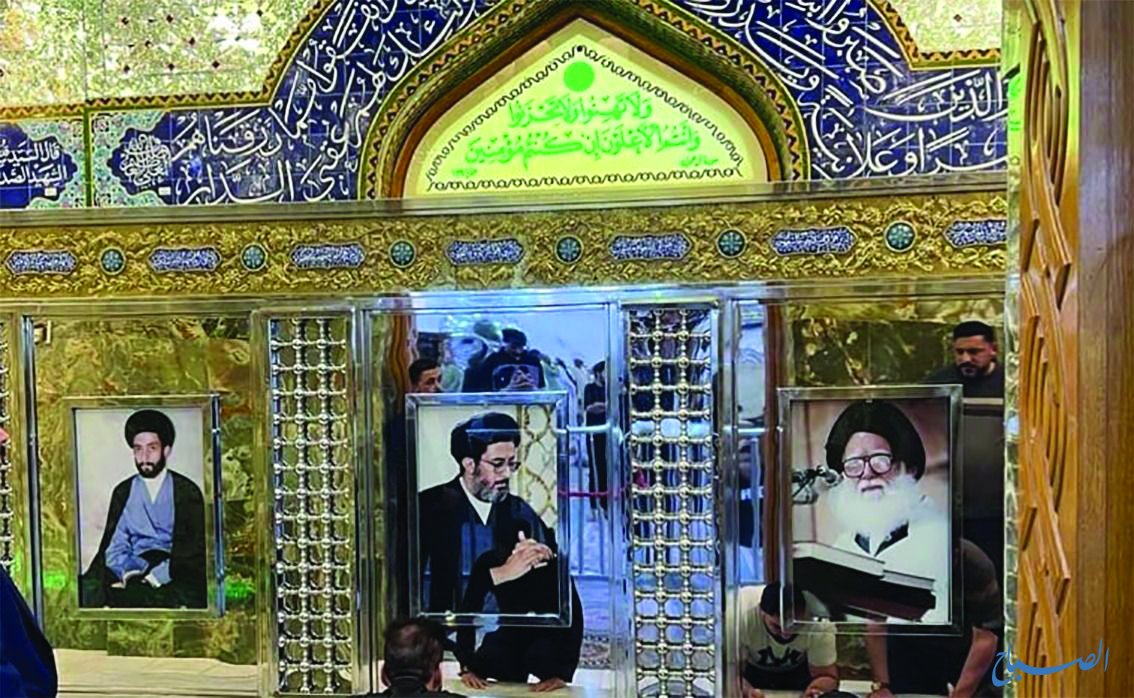الخللُ المنهجيُّ الاستشراقيُّ في تلقِّي الأدب العربي

ياروسلاف ستِيكفِتش
ترجمة: د. فارس عزيز المدرس
الدكتور ياروسلاف ستِتكڤِتش Jaroslav stetkevych (من مواليد عام 1929) مستشرقٌ أمريكيٌّ مِن أصولٍ أوكرانية؛ حصل على الدكتوراه في الأدب العربي مِن جامعةِ هارفارد عام 1962م، وشغل منصبَ أستاذَ الأدب العربي بقسمِ اللغاتِ وحضاراتِ الشرق الأدنى في جامعة شيكاغو، تُرجم عددٌ مِن أعمالِه إلى العربية.
لـياروسلاف كتبٌ وبحوثٌ كثيرةٌ؛ منها هذا البحثُ الذي نشرته مجلةِ دراسات الشرقِ الأدنى، وعنوانه الأصلي: (Arabism and Arabic Literature, Self-View of a Profession العروبةُ والأدبُ العربي، نظرة مهنية)، وهو مِن أهمِّ البحوث في نقدِ الاستشراق؛ قبل كتابِ إدوارد سعيد (الاستشراق)، ويركز فيه على قضيةٍ شِبهِ مغيبةٍ؛ وهي نقدُ الاستشراق الأدبي منهجياً ونفسيِّاً، ويبْدي فيه عمقاً وتفهُّماً؛ وينزل هذا الأدبَ منزلتَه؛ بخلافِ ما كان سارياً في أروقةِ الاستشراقِ.
لا يعني ياروسلاف بكلمةِ عروبة Arabism البعدَ القومي؛ بل الروحَ والرؤيا العربية التي يتَّسمُ بها هذا الأدب.
“ المترجم”.
نحن المستشرقين معتادونَ على التصرُّف وكأننا عشيرةٌ غريبةٌ باطنيِّة؛ إذ نعتقدُ أنَّ العالمَ الخارجيَّ ليس لديه مؤهلاتٌ لفهمنا، ونشاطُنا يتواصل داخل الجدرانِ المصقولةِ لبرجنا العاجي الملوث، ولا نستطيع تسلُّق الجدران الزلقة إلى قمة البرج، كي نتمكَّن مِن إلقاء نظرةِ شاملة على العالم الخارجي.
وفي الداخل نعمل بصبرٍ وتفانٍ ملحوظين؛ لكنَّنا لسنا متأكدين مِن الغرضِ الذي نعمل مِن أجله، ومن أجل مَن نعمل، ولمَن نوجِّه نتائج دراساتِنا؟.
إنني معجبٌ بالجيلِ الرومانسي مِن المستشرقين، لقد كانوا مسكونين بحمَّى الاكتشاف، والوهم الذي يملأ الروح، والصبر الممتِع الذي يخلصنا من ركودنا.
لقد كانوا علماءَ لامعين، لكنَّ تألقَهم لم يكن مديْناً في كلِّ شيءٍ للكفاءةِ المهنية؛ ففي الأدبِ كانوا في الغالب مترجمين رائعين.
إنني أفكر في روكرت بشكلٍ رئيسي، وأفكر أيضاً في جونز، وكارليل، وليال.
كان الهدفُ الأساس لسعي هؤلاء إثراءَ آدابِهم الوطنية: وهو هدفٌ مشروع، وقد كافأهُ صدى أعمالِهم بين معاصريهم، فمِن جوته إلى بودلير وما بعدهما؛ نال الاستشراقُ الرومانسي أعظمَ تكريم.
وإذا جاز لي أنْ أضيفَ ذرةً من الثناء والامتنان إلى الرومانسيين فلا بُدَّ أنْ أعترف بأنه لولا ترجمةُ روكرت لكتابِ الحماسةِ لأبي تمام، وبعض التنويعات الشعرية المبهجة على الموضوعات العربية التي كتبها الشاعر الأوكراني إيفان فرانكو لَمَا كنتُ هنا اليوم.
والواقع فإنَّ طموحي الأول كان ولا يزال أنْ أصبح مترجماً للأدبِ العربي إلى لغتي.
بعد الرومانسيين جاء المستشرقون كمؤرخين ثقافيين؛ جرفتْهم آخرُ موجاتِ المثالية الألمانية، وفعلوا الكثيرَ من الخير وكانوا يتمتَّعون بثقةٍ يُحسدون عليها؛ في ما يتصل برسالتهم الفكرية: لقد كانوا يعملون على دمج الشرق في الثقافة العالميَّة.
والآن جاء دورنا، ونحن لسنا على القدْر نفسِه من الثقة بأنفسنا؛ إذ فقدنا البراءةَ الرومانسية، ويبدو أنَّ آدابَنا الوطنية لم تعدْ تريدنا، وأصبحنا متشككين في الثقافة العالميَّة، وما تبقى لنا هو المعرفةُ مِن أجل المعرفة.
في ضوء هذه الحيرة يتعيَّن علينا أنْ نطرحَ على أنفسنا بجديِّة بعضَ الأسئلة الأساسية: هل ما زلنا نعتقد أننا - بنقل تجاربنا مع الأدب العربي إلى قرائنا - نسهم في العملياتِ الأدبية الإبداعية الجارية في آدابنا الأصلية؟، هل يمكننا تحفيز شاعرٍ ناشئ في الإنجليزية لإيجادِ بعض القرابة الإبداعيَّة مع امرئ القيس أو المتنبي! وإذا شعرنا أنَّ هذا ممكنٌ، فما هو النهجُ الذي يجب أنْ نتَّبعه؟ هل ستكون الترجماتُ مجرَّدَ مزيدٍ من الترجمات؛ فحسب.
إنّني أشعرَ بانطباعٍ غيرِ مريحٍ مفاده: أنه مهما كان حجم الترجماتِ التي ننتجها عن الأدب العربي فلن يتمَّ حلُّ مشكلة الغرض والتبرير الذاتي؛ فترجماتُنا مِن النوع الأكاديمي، ومَن يحتاج إلى ترجماتٍ أكاديميَّة! ربما يحتاج إليها علماءُ آخرون.
ولا شك في أنَّ طلابنا في اللغة العربية قد يستفيدون مِن ترجمة الشعر العربي، ولكن هذا لن يكون إلا غرضاً محدوداً، يدخل في نطاق الكتب المدرسية، وإلا فإنِّ الترجماتِ لا بُدَّ أنْ تتم بهدفٍ أدبي أكثر طموحاً؛ وإلا فلا يجوز حتى ذكرها في مناقشةِ المشاكل الأدبية.
ولعلني - من أجل توضيح ما أعنيه - أقتبس من مقدمةِ إليوت لقصائد عزرا باوند:
أشك - كما كتب إليوت - في أنَّ لكلِّ عصرٍ الوهمُ نفسُه في ما يتصل بالترجمات، وهو ليس وهماً تماماً؛ إذ حين ينجح شاعرٌ أجنبي في ترجمة لغتنا وعصرنا نعتقد أنه ترجم؛ ونعتقد أنَّه من خلال ترجمته نحصل على الأصل، ولابد أنَّ الإليزابيثيين تصوَّروا أنهم نقلوا هوميروس من خلال تشابمان، ولأننا لسنا من إلاليزابيثين فلا نملك هذا الوهم، وندرك أنَّ الترجمات العلمية الحديثة لا تقدم لنا ما قدمه لنا آل تيودور.
فإذا ظهر تشابمان الحديث فلا بدَّ أنْ نعتقد أنه كان المترجم الحقيقي، ولا بُدَّ مِن أنْ نثني عليه بالاعتقاد بأنَّ ترجمته كانت شفافة؛ بالنسبة لمعاصريه، أمَّا عندنا فهي “نماذج رائعة مِن النثر التيودوري”، والمصير نفسُه ينتظر باوند.
إنَّ هذا لا يعني أنَّ الشعر الصيني كما نعرفه اليوم هو شيءٌ اخترعه عزرا باوند، ولا يعني أنَّ هناك شعراً صينياً في حد ذاته ينتظر مترجماً مثالياً؛ بل إنَّ باوند أثرى الشعرَ الإنجليزي الحديث كما أثراه فيتزجيرالد، والناس الذين يحبون الشعر الصيني اليوم لا يحبونه أكثر مِن الذين يحبون فخار الصفصاف والفن الصيني.
ومن المحتمل أنَّ الصينيين فضلاً عن البروفنساليين والإيطاليين والساكسونيين قد أثروا على باوند، لأنَّه لا يمكن لأحدٍ أنْ يتعاملَ بذكاءٍ مع مادة أجنبية؛ دون أنْ يتأثر بها؛ وكذلك الحالُ مع الأدبِ العربي.
هذا كل ما في الأمر لدى إليوت، وهذا كلُّ ما في الأمر عن المشاركةِ من خلالِ الترجماتِ في الحياةِ الأدبيةِ؛ في مجالاتنا الثقافية واللغوية، ولكنْ إذا كانت الإجابةُ التي نعطيَها لسؤال المشاركة المحتملة في العمليات الإبداعية، وفي تشكيلِ وجهاتِ النظر والأذواق في آدابنا غيرَ صادقةٍ أو سلبية، فهل ينبغي أنْ نسعى إلى تحقيقِ أهدافِ التاريخ الثقافي العالمي؛ حيث يحتل الأدبُ مكانَه الصغير على شكلِ توليفةٍ غامضةٍ مما يُسمى “الأفكار والمخاوف الحاكمة”، أمْ أنَّ هذا تصورٌ خاطئ لِما يفترض أنْ يفعله المرء بالأدب؟
قد نمتلك معرفةً ببليوغرافية ونصيِّة معينة بالأدب العربي؛ فهل المعرفةُ الببليوغرافية والنصيِّة في الأدب هي معرفةٌ بالأدبِ حقاً!.
ويبدو أنَّ هناك في الوقتِ الحاضر اتجاهاً للدراساتِ المقارنة في بعضِ الجامعات الأميركية، وقد تلقَّى هذا الاتجاهُ دعماً مادياً من مصادرَ ماليةٍ مختلفة، والواقع فإنَّ الدعمَ المالي يولِّد الحماسةَ بين العلماء؛ وهذا أمرٌ مشروعُ.
وقد لا يكون مشروعاً تماماً في مجالنا الخاص بالأدب العربي؛ لكن على الأقلّ ليس في هذه المرحلة من حالنا في الشؤون النقدية الأدبية.
إننا في الأدبِ العربي لم نسألْ أنفسَنا مثلَ هذه الأسئلة؛ فالجامعةُ تنشئ برنامجاً في “الأدب المقارن” وتترك الباقي لسير الأحداث، وما ينتج عن مثلِ هذا الموقفِ نادراً ما يكون أكثر من مجرد كُتيبٍ يحتوي على عباراتٍ تمهيدية تأسر خيال الطلاب المذهولين؛ الذين لم يتلقَّوا تنبيهاً مُسبقاً. والحقيقةُ أننا غير مستعدين للتعاملِ مع مجال الأدب المقارن على أيِّ مستوىً؛ سوى المستوى الأولي، والتدريب والتوجيه الذي توفره لنا جامعاتُنا لا يؤهلاننا سوى للتوفيقِ بين الحقائق وبيانات التاريخ الأدبي للأدب العربي. ولعلنا في هذه المرحلة نسأل أنفسَنا ما إذا كان مصدرُ صعوباتنا يكمُن في حقيقةٍ مفادُها أننا في الأساس لا نهتمُّ بالأدب؛ لأننا علماء لغويون، أو مؤرخون، أو علماء اجتماع متنكرون، أو بكلمةٍ واحدة لأننا “مستشرقون”.
إنَّ النظرَ حتى في أفضل كتبِ التاريخ التي أنتجتها الدراسات الاستشراقية للأدب العربي سوف يكشف لم نتوصَّل إلى فهمِ ما الذي يشكِّل أدباً، وما الذي ينبغي أنْ يشكل تاريخاً أدبياً. إننا نميل إلى أنْ نطلقَ على كلِّ ما كُتب باللغة العربية منذ أكثر مِن قرن ونصف من الزمان اسم الأدب العربي، فالتقاليد الدينية والرسائل اللاهوتية، والقانون، والسجلات التاريخية، والتاريخ السياسي، والجغرافيا، والمنوعات العلمية، والفلسفة، وفقهُ اللغة؛ كلُّ هذا قد نجده ضمن مفهومنا للأدب العربي، وهذا التنوُّع في الموضوعات والأساليب والأغراض الذي نصنِّفه بوصفه أدباً عربياً؛ يتحول إلى وحشٍ قادرٍ على تخويفِ أيِّ شخصٍ قد يقترب منه؛ انطلاقاً مِن فرضيةٍ غير استشراقية حول ما يُفترض أنْ يكونَ عليه الأدب.
إنَّ مثل هذا النهج هو بقايا الوقتِ الذي كان فيه علمُ الدراساتِ العربية برمته يُعامَل بوصفه إرثاً من العصور القديمة البعيدة والميتة، حيث يجري إنقاذ كلِّ شيءٍ بعنايةٍ؛ وتصنيفه تحت مسمى الأدب.
لم نتوقفْ لنفكر في أنَّ ما هو مشروع لعلمِ الآشوريات أو السومريات قد لا يكون مشروعاً للغةِ العربية، وواصلنا تقييد أنفسنا بمسائلَ منهجية مع تلك المجالات القديمة مِن الاستشراق.
ربما فقدنا اهتمامَنا بالأدبِ العربي لأنَّه كان مِن الصعبِ علينا إتقانُ العربية؛ عندما كنا لا نزال مليئين بالحماس، لأنَّ السنواتِ والقواميس والقواعد استنفدت طاقاتَنا، وجعلتنا ننسى ما كنَّا قد شرعنا في القيام به، ونشعر بخيبةِ الأمل تجاه أنفسِنا، لكنَّنا نرفضُ الاعترافَ بشعورِ الخيبة، ونخفيْه تحت سِتارٍ مِن دخَانٍ يغلِّفه التعقيدُ وادعاء الكفاءةُ العلمية، وربما نشعر بعداءٍ تجاه الأدب الذي رفض أنْ يسلِّمنا سرَّه.
تشكل اللغةُ وأدبُها للطالب لدينا بيئةً مختارةً؛ يعيش فيها بهذا المعنى المجازي الذي يقترب من الواقع، ومِن المعروف أنَّ البيئاتِ إمَّا أنْ تكون لطيفةً أو ملائمةً أو معادية؛ فأيُّ هاتين البيئتين هي البيئةُ اللغويةُ والأدبية العربية بالنسبة لنا؟
هل هي وادٍ أخضر وفيرٌ أمْ هي مَشهدٌ قمريٌّ من الحفرِ والسهول القاحلة؟
هل نعيش في هذه البيئة في صُحبة طيبة من الأصحاب والحكماء، من هند وسعود وليلى، أمْ أننا وحدُنا منعزلون، لا يستجيبون لنا؟ والإجابةَ الصادقة على هذه الأسئلة ستعتمد على ما إذا كنَّا قادرين على توصيل تجربتنا مع الأدب العربي إلى بيئتنا الثقافية واللغوية، وبأيِّ طريقة؟.
هناك إمكانية أخرى متبقية لنا؛ وهي إمكانية سأوْليها بعضَ الاهتمام؛ ولكنني سأفترض أننا نكتب عن الأدب العربي بلغاتٍ أخرى غيرِ العربية، وأننا نفكِّر في المقامِ الأول في مستمعينا وقراءنا، وهدفُنا النهائيُّ إقامةُ نوعٍ مِن التفاهم مع التيارات في حياتنا الأدبية.
ولكي نطالبَ بهذا الاهتمام فنحن بحاجةٍ إلى المعِدات اللازمة، ويجب أنْ نكون قادرين على عرْض قضيةِ الأدب العربي، بالمصطلحاتِ التي تتقنها الدراساتُ الأدبية الغربية، لكنَّ الأساليبَ والمناهج النقدية تتغيَّرُ باستمرارٍ في الأدب الغربي، وهذا النوعُ من التغييرِ يُسمى التطور، وهو مشكلة.
إن تطورَ الفهم النقدي للأدب لا ينبغي أنْ يقتصر على الأعمال أو الاتجاهات الأدبية الحديثة أو المعاصرة؛ بل على العكس، فإذا ما ساءت الأمورُ قد يستغني الأدب الحديث عن هذه الأعمال.
والأعمال الكلاسيكية هي التي تحتاج إلى التطور؛ على الأقلّ في فهمنا لها؛ كي تظل حيَّة. وعلى هذا فمِن الناحية النقدية ومن حيث التقدير لا يوجد عملٌ حاسمُ في الدراسات الشكسبيرية، أو دراسات جوته، حتى وإنْ كان من الممكن تصوُّرُ سيرةٍ ذاتيةٍ نهائية لأي منهما.
إنَّ أعمال شكسبير النقدية ليست مجرد نتاجٍ لشغفٍ علمي مفرط بالشاعر، أو على الأقل لا ينبغي لها أنْ تكون كذلك، بل هي بالأحرى بحثٌ دائمٌ عن رؤيةٍ جديدةٍ للأشياء التي كانت موجودة دوماً، أشياءٌ ما كانت تُرى بشكلٍ مختلف؛ من عيون وأجيال مختلفة.
إذا نظرنا إلى دراساتنا الأدبية العربية فسوف نلاحظ رباطةَ جأشِها وهدوءها، ولستُ أدري ما إذا كان هذا راجعاً إلى الرضا الذاتي المفرط، أمْ إلى عدم الاهتمام، أو الافتقار إلى الأصالة، وإذا كنا نلوم الأدبَ العربي لأنَّه لم يشهد تطوراً حقيقياً؛ فلابد وأنْ نكون نحن المستشرقين قد وقعنا تحت تأثير سحر السكون، وفي هذه الحالة لن يتبقَّى لنا الكثير لنتواصل به مع أيِّ جهة، لكن إذا كان الأدب العربي يعني لنا شيئاً فلابدَّ وأنْ نستجيب لتحدي الحوارِ الأدبي مع آدابنا وفكرنا النقدي.
وإذا تحدثنا اللغة نفسها في جوانب أخرى فلماذا لا نتحدَّث اللغة نفسها مع “المستشرقين” عندما يتعلق الأمر بـ”الاستشراق”.
لماذا تكون أساليبنا وأجهزتنا المفاهيمية النقدية، وحتى ذخيرتنا مِن الأسئلة التي يبدو أننا نطرحها على الأدب بعيدةً عمَّا يفعله الآخرون ويطلبونه من الأدب؟.
إنَّ ما أحاولُ قولَه هو أنَّ المنهجيةَ التي نفهمها على هذا النحو يمكن أنْ ننظر إليها بوصفها تواصلاً فكرياً، وهذا بالضبط ما يبدو أننا نفْتقر إليه؛ حين ننظر إلى أنفسِنا بوصفنا جزءاً لا يتجزأ مِن مجالنا الثقافي؛ فنحن في الواقع على هامش هذا المجال، وهذا الوضعُ لا يمكن علاجُه بمجرَّد إعلان النوايا الطيبة لبذل المزيد من الجهد والعمل بجدية، لأنَّ الكمَّ وحده يشكِّل عبئاً ثقيلاً، كما أنَّ الجديةَ غير المجدية تثير الشفقة. فنحن جادون ومثيرون للشفقة عندما نفعل ما نفعله بالطرقِ المعقدة، ومهما بدا العائدُ من دراساتِنا الأدبية العربية صغيراً الآن فإنَّه غزيرٌ؛ إذا أخذنا في الاعتبار أننا نتحدَّث إلى أنفسِنا ونكتب لأنفسِنا فحسب، وكلُّ ذلك في بيئةٍ مقيدةٍ لأسرة تتبع نظاماً صارماً لتحديد النسل.
مِن المستحيل أنْ ننسى أنَّ علاقتَنا بدراسةِ الأدب العربي في المقامِ الأول علاقةٌ أكاديميةٌ وعلمية، وقد جرى تدريبنا لكي نصبحَ تلاميذَ في مجالنا، وكان علينا أنْ نمرَّ بالتجربةِ المؤلمة المتمثلة بكتابةِ أطروحة علمية صارمة واحدة على الأقل، حيث قيل لنا أنْ نبحثَ عن الحقيقة والمعرفة، وأنْ نكون موضوعيين وأصيلين، لكنْ ما انتهينا إليه في أغلب الأحيان هو البحث بشكلٍ يائس عن موضوع، ويفضَّل أنْ يكون موضوعاً غير مستغَل؛ معتقدين أنْ الحصولَ على مثل هذا الموضوع وتقديمه بكفاءة مِن شأنه أنْ يضمن إسهاماً إيجابياً في المعرفة، لذلك فإنَّ أحدَ الأسئلة التي قد نطرحها على أنفسِنا قد يكون: كيف ينبغي التعامل مع موضوع أدبي؟ هل ينبغي أنْ نُدفع إلى العمل على موضوع معين؛ لأنّه غير مدروس!.
ما أهدف إليه توضيحُ أنَّ الحقائقَ في الدراسةِ الأدبية لا تعكس الحقيقةَ الأدبية، كما أنها لا تثبِت الصلاحيةَ الأدبية والجمالية، والسعيُ وراء مثل هذه الحقائق وحدُه أمرٌ خارجَ نطاق الأدب، وينبغي أنْ نرحبَ به بوصفهه تمهيداً وتسهيلاً للانخراط بشكلٍ أعمق في المشاكل الأدبية على النحو اللائق، ولكنْ لا يمكن أنْ يكونَ سلسلةً لا نهائيةً من العمل النصي اللغوي والسيرة الذاتية، والتاريخ الأدبي وتفاصيله الهامشية.
ما أقوله هنا والطريقة التي أقوله بها ربما يجعلاني غيرَ مؤهلٍ حتى لتولِّي منصبٍ داخلَ مؤسستنا الأكاديمية الحالية؛ حيث البحث هو ما يصنع الناس. ومع ذلك فأنا متشكك في إمكانياتِ البحث في الأدب على هذه الشاكلة، ولديَّ نفورٌ مِن حكمة الحواشي!، ولا أقبل الحقائقَ بوصفها مكتفية بذاتها.
وإذا كان عليَّ أنْ أقولَ شيئًا دفاعاً عن النفس فمِن المشكوك فيه أنْ أقول إنني لا أقبل تعريفَ المعرفة بوصفها يقيناً، بل أفضِّل مفارقةَ اليقين الديكارتية؛ بوصفها شكَّاً. وكلُّ ما قيل أعلاه يقودنا إلى سؤالٍ يتعلَّق بالطريقة التي يمكن بها الوصول إلى هذا الشيء الذي يُسمى القيمة الأدبية؛ أو الجوهر الأدبي وإحيائه.