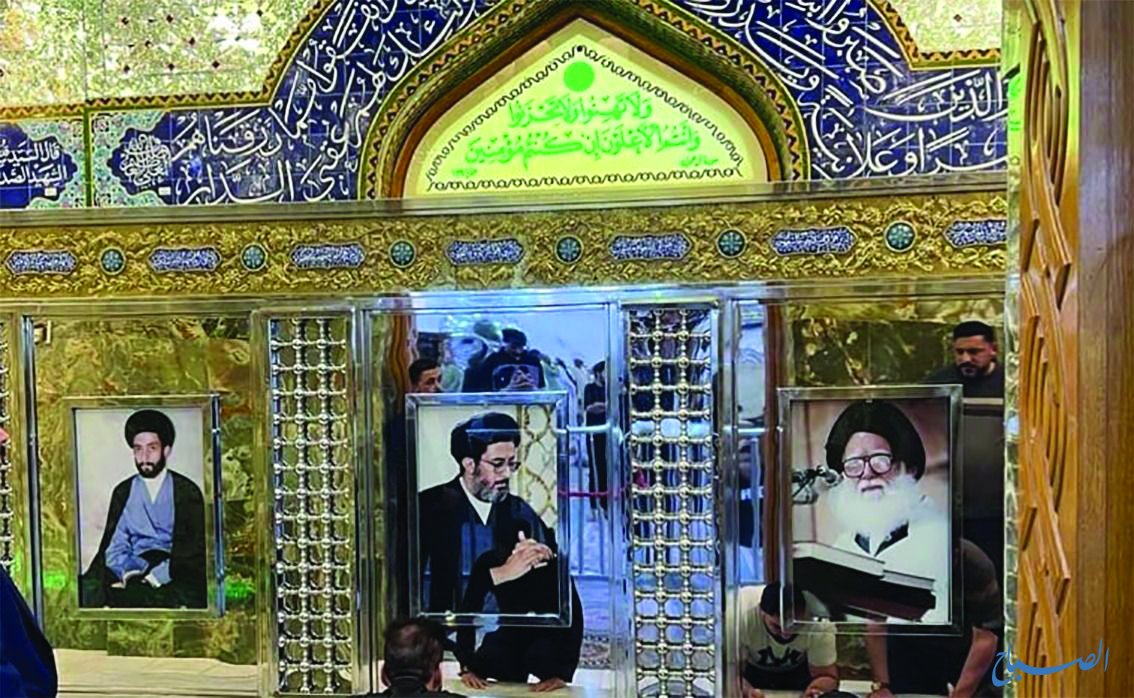صرامة الجنس الأدبي شرعنة المغايرة

عبد علي حسن
ظهر النقد النسوي في ستينيات القرن الماضي بعده واحداً من المناهج النقديّة والفكريّة لما بعد الحداثة، وبظهوره والتطورات الحاصلة على رؤاه من الجنوسة والجينثوية فقد انفصل هذا النقد عن الرؤية النقديّة التي سادت في المناهج لما قبل بعد الحداثة التي تمزج النصوص المعالجة لقضية المرأة سواء كان الكاتب رجل أم امرأة تحت مسمّى "أدب المرأة". وبذا فقد تمَّ استقلال النقد النسوي عن هذه النظرة الشموليَّة ليختص بالنص الذي تنجزه المرأة حصراً.. وعودة إلى أصل الثنائيَّة (ذكر/ أنثى) فقد تمت تسمية هذا النص المنجز من قبل المرأة بنص الأنثى .إذ اسهمت الدراسات النسويَّة وخاصة الدراسات الجينثوية ورائدتها الين شولتز في وضع منهجية خاصة لنقد نص الأنثى بغية اكتشاف السمات الأنثوية للنص عبر اللغة الخاصة باستخدامات الأنثى لها والأساليب والتقنيات البلاغية، فضلاً عن الكشف عن الفضاء الأنثوي الذي لا يستطيع الرجل من التعبير عنه بشكل دقيق مثلما تعيشه المرأة.. ولعل مناطق ارتياد الأنثى في المنجز الأدبي أو الفني يطوف في أربع مناطق وجدناها محيطة بعالم المرأة، وهي:
1- علاقة المرأة بالرجل
2- علاقة المرأة بالمجتمع.
3- علاقة المرأة بنفسها "علاقة داخلية".
4- علاقة المرأة بالمرأة الأخرى.
ونرى بأنَّ الكشف عن هذه العلاقات هو نتيجة لوضع المرأة في المجتمعات البطرياركية "الأبوية" التي تضع المرأة الطرف التابع في ثنائية (الذكر/ الأنثى) لذلك اهتمت حركات التحرر الوطني والعالمي بالمرأة بشكل عام وبما تنجزه ثقافياً منذ روزا لوكسمبورغ وموجهات الفكر الماركسي وتطوره حتى أصبح نقداً ذا منظومة مستقلة تتقصّى سمات الأنثى في النص الابداعي.. فصار هذا النقد النسوي يعنى بالنص الابداعي الذي تنجزه الانثى تحديداً ويمكن تسميته بالنقد الأنثوي احتكاماً بالجنوسة والتأكيد على جنسيّة المرأة في ثنائية الذكر/الانثى التي ألغتها المنهجية الفكرية والفلسفية لما بعد الحداثة وإلغاء التمييز الثقافي بين الذكر والأنثى وإعطاء الأحقية في التعبير للمرأة كما للرجل والتأكيد على أن الفارق إنّما هو فارق ثقافي تكرّسه البنية الاجتماعية والفكرية للمجتمع القائم على دعامات السلطة الذكورية والبطرياركية.
أما المنجز الذي ينجزه الرجل وهو يعالج قضية من قضايا المرأة فإنه يدور في محورين..
الأول: يتم وفق تقنية القناع وفيه يتقنع الرجل بقناع المرأة ليتحدث وكأنّه امرأة باستخدام ضمير المتكلم.
الثاني: معالجة وضع معين للمرأة وفق ضمير الشخص الثالث.
وفي كلا المحورين فإن ما ينجزه الرجل من نص يعالج فيه قضايا المرأة انما هو نص المرأة.. وفيه يتضمن وجهة نظر الرجل في هذه القضية أو تلك.
وقد ساد في الدراسات الادبية والنقدية هذا الاتجاه مثل "المرأة في قصص.. المرأة في شعر..".
لذا أرى من المناسب التمييز بين نص المرأة الذي يكتبه الرجل ونص الأنثى الذي تنجزه وتكتبه المرأة تحديداً.. وقد ذكرت هذا المفهوم بالتفصيل التنظيري في كتابي النقدي الثالث "سرد الأنثى" الصادر عن المركز الثقافي للطباعة والنشر 2015.
وتأسيساً على ما تقدّم فإنّه يمكننا القول بأن الجندر الأدبي هو مفهوم يعبر عن كيفية تمثيل الجنسين في الأدب وكيفية تأثير الهوية الجندرية على إنتاج النصوص الأدبية وتلقّيها، ويتعامل هذا المفهوم مع الأساليب التي يتم من خلالها تصوير الرجال والنساء وأدوارهم وتجاربهم في الأدب وكيفية تأثير السياقات الاجتماعية والثقافية على هذه التمثيلات، ويمكن ملاحظة أن هذه التمثيلات تكرّس الفوارق بين الأدب الذكوري والأدب الأنثوي من قبيل:
1. اللغة والأسلوب: فنص الذكر يتّسم بلغةٍ أكثر مباشرة وأسلوب يميل إلى القوة وتأكيد السلطة الذكوريَّة، في حين يتّسم بلغة تهتم بالتفاصيل بشكل أكثر، فضلاً عن تركيزه على المشاعر والتجارب الشخصية، الأمر الذي يجعل هذا النص عمق العلاقات الإنسانية.
2. المواضيع: إذ إنَّ نصَّ الذكر يكرّس القوة والمغامرات والصراعات والتحديات التي تواجه الرجل؛ لذا فإن تلك الموضوعات غالباً ما تتعلق بالنجاحات والمنجزات التي من الممكن أن يحققها، أما نص الأنثى فإنه يتناول موضوعات الهوية والعلاقات والضغوط الاجتماعية، مما يعكس التحديات اليومية التي تواجه النساء.
3. التمثيل: إذ إن نص المذكر يتمثل ويعكس تجارب فردية أو جماعية للذكور، بينما يتمثل نص الأنثى ويعكس تجارب النساء وفق المحاور التي أشرنا إليها سلفا، أي مجموعة العلاقات بمستوياتها الأربعة، وقد يتناول قضايا مثل التمييز والقوة والتحرر بمستوياته المختلفة.
4. المرجعية الثقافية: وقد تتأثر النصوص بشكل كبير بالثقافة والتقاليد السائدة، حيث يمكن أن تعكس أو تتحدى المعايير الجندرية المتّبعة.
ولا شكَّ بأن هذه الفروق وغيرها تساعد في فهم كيفية تشكيل الأدب لوجهات نظر متنوعة، وكيف يمكن أن يعكس أو يتحدى الصور النمطية الجندرية، ويتبدى في هذا المقام الدور الذي من الممكن أن يقوم به النقد في تأكيد وشرعنة المغايرة بين النص الذكر ونص الأنثى وتحليل الجندر الأدبي من خلال جوانب رئيسية عدّة منها:
1. كشف التمثيلات الجندرية عبر تسليط الضوء على كيفية تمثيل الجنسين في النصوص الأدبية، من خلال تحليل الشخصيات والحبكات والرموز المستخدمة في تمثل التجارب الفردية والجمعية وحركتها في السياق الاجتماعي.
2. يركز النقد على كيفية استخدام اللغة في إنتاج النصوص، مما يساعد في فهم الفروق بين أساليب الكتابة الذكورية والأنثوية، وكيف تعكس هذه الأساليب القيم الثقافية والجندرية.
3. ينظر النقد الأدبي إلى السياقات التاريخية والاجتماعية التي أنتجت النصوص الأدبية، مما يمكّن من فهم الكيفية التي تؤثر فيها تلك السياقات في تصوير الجندر.
4. يوفر النقد الأدبي آليات لمراجعة وتحدي الصور النمطية الجندرية الموجودة في الأدب، مما يعزّز من التنوع والشمولية في التمثيل.
5. يسعى النقد الأدبي إلى تقديم قراءات متعددة ومتنوعة للنصوص، مما يسمح بتبني وجهات نظر مختلفة حول الجندر، ويعزز من تفعيل الحوار حول القضايا الجندرية.
6. يسعى النقد إلى الكشف عن الكيفية التي يؤثر فيها الأدب على تشكيل المفاهيم الجندرية لدى القرّاء، وكيف يمكن أن يسهم في تغيير أو تعزيز المواقف الجندرية في المجتمع.
7. يسهم النقد الأدبي في إبراز الأصوات النسائية والمهمشة التي قد تُهمل في السرد التقليدي، مما يعزز من التنوع في الأدب.
وبشكل عام يعد النقد الادبي أداة قوية ومهمة لفهم الجندر الأدبي، حيث يساعد في تحليل النصوص بطريقة تكشف عن التعقيدات والمواضيع المرتبطة بالجندر في الأدب.
يتّضح مما سلف الإشارة إليه أن المغايرة الجندرية/ النوعية هي واقعة اجتماعية وثقافية تستمدّ شرعيتها من طبيعة الاختلاف بين النوعين الذكر/ الأنثى وتكريس الفوارق بينهما ثقافياً تعزّزه التقاليد والأعراف المتراكمة، وتنعكس هذه المغايرة وتأكيد خصائص كل نوع ثقافيا واجتماعيا وفكريا في النصوص الأدبية التي تتمثل التجارب الشخصية والجمعية لكل نوع، إذ تتطلب شرعنة هذه المغايرة فهماً عميقاً للتنوع الإنساني وتجليات الهوية في السياقات الثقافية والاجتماعية المختلفة التي تسهم اللغة والأسلوب وتمثل التجارب في تشكّلها، وجدير بالذكر أن النقد النسوي قد تكفّل وفق آلياته التي تم اجتراحها وفقاً لوجهات نظره في شرعنة المغايرة الجندرية عبر تكريسه الفوارق التي شكّلتها السياقات المختلفة.