إمضاءات
ثقافة
2021/07/07
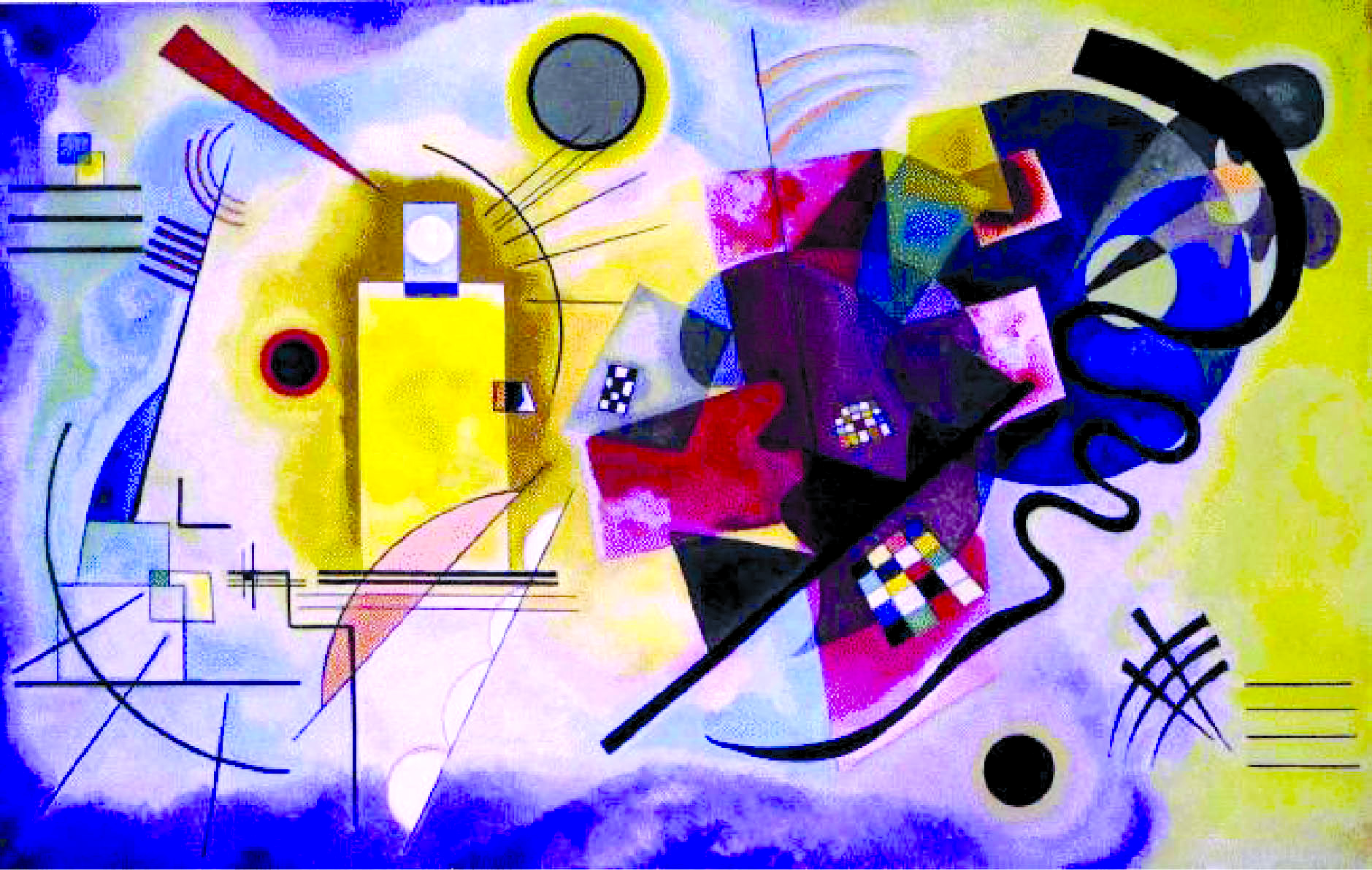
+A
-A
رعـد فاضل
* يتخطّى المرء مسؤوليّة كونه شاعراً أو كاتباً ما إن يفرغ من كتابة كلّ نصّ، وهذا يعني أنّه يعيش هذا الكونَ في أثناء الكتابة. هذه الأثناء هي حياته الكِتابيّة - حياته الحقيقيّة.
* هل هنالك ((نقـد محِبٌّ)) حقاً؟، من قال إنّه ليس موجوداً؟ إنّه موجود فعلاً، ولكن علينا قبل كلّ شيء: ما طبيعة هذا النقد المُحِب؟ بلا شك يمكنني أن أحيل هذه الطبيعة إلى أمرين: أنا أكتب نقداً في كاتب ما تربطه بي علاقة شخصيّة قد تكون حميميّة، وذلك بلا ريب سيوفّر لي راحة نفسيّة من شأنها أن تفتح أمامي آفاقاً في نصوصه من خلال بضعة أسرار تكون بمثابة مفاتيح لتلك الآفاق، لا لتكون معياراً نقديّاً وإنما لتبعدني نوعاً ما عن صرامة الفحص وتقرّبني من عيادة أشياء النصّ وجسّها، أي لأكون حميميّاً ومعرفيّاً في آن مع ما أقرأ.
أما الأمر الثاني: توفّر تلك العلاقة معرفة مسبّقة بغرائز الكاتب ورغباته وأحلامه، آماله ويأسه..، توفّر لي أنّي عارف بذات الكاتب قبل أن أكتب في ذاته الكاتبة ونصوصها.
* كتبَ تودوروف ((في المدرسة لا نتعلّم عن ماذا تتحدّث الأعمال الأدبيّة، وإنّما عن ماذا يتحدث النقّاد))، والأخطر من ذلك أننا نتخرّج في المدارس ولا يراودنا سؤال مفاده: ماذا تريد منّا المناهج التعليميّة نفسها بوصفها سياسة موضوعة من قبل ايديولوجيا بعينها؟، يتخرّج أغلب المهتمّين بالأدب وهم متبلِّرون بما حُشوا به من تلك المناهج، ومن رؤيات أولئك النقّاد منفِّذي تلك السياسة أدبيّاً ونقديّاً، لا من ما كانوا يودّون هم اكتشافه في تلك الأعمال الأدبيّة وبذلك يكون التّدريس، في الغالب، ليس سوى تخريج لدفعات هائلة من متلقّين أغلبهم سياقيّون، وفي أفضل الأحوال قرّاء غير فعّالين كونهم غير نقديين.
* القول بأنّ البحر أزرق، على سبيل التمثيل؛ هو استخدام حقيقيّ بدرجة صفرٍ أسلوبيّةٍ، أما القول بأنّ البحر خمريّ أو بنفسجيّ، فبدرجة أسلوبيّة عالية، ذلك أنّ فيه انحرافاً، فيه صناعة، وهذا ما يجعل ((الإشارة إلى المعنى أبلغ من المعنى)) كما أشار الجاحظ إلى ذلك.
* ما من أدب يعمِّر طويلاً إن لم يخلِّص قرّاءه أولاً من سياقيّة كلّ نزعة ايديولوجيّة متزفّتة قارّةٍ، ذلك أنّ هذه السّياقية تسمّم كلّ الأفكار وطرقِ التّعبير الحرّة، وتمنعها من النّمو والبروز بأشكال وفحاوى جديدة. الأدب كما الزّراعة دائماً في حاجة إلى تربة حيّة رطبة تُحرث وتقلَّب وتشمَّسُ على الدّوام، وما هذه التربة هنا إلّا القراءة والقرّاء.
* عندما يقع الغياب الطويل يكون الشّعور به قاسياً أليماً من جهة المُغيَّب، لأنّ المُغيِّب غير مهتمّ حتّى وإن كان مجبراً على المضيّ في الغياب. الحبّ بوصفه تعالقاً لا توطّده إلّا لغة الحضور، إذ بها وحدها يهدأ روعُه ويطمئنّ حتّى لا يظلّ يضرب في مهامه وغياهب الشّك. الغياب تديمه الرسائل، وإن كانت ظاهريّاً وسيلةَ اتّصالٍ لأنّها جوهريّاً ((علاماتُ انفصال)) لا تُكتب إلّا لملء منطقة الفراغ، أو لتجسير الهوّة الواقعة بين الحضور والغياب. وفي حالة غياب الرسائل يركن العقل الحُبيُّ إلى ما يعرف بالذّكريات التي هي ظاهريّاً علاماتُ عيشِ ما مضى من نعيم الحضور، وعمقيّاً ما هي في الحقيقة سوى يأس مغلَّف بما يُعرف بالأمل.
* الشّعر لا يعمل على تكريس القرابة بين ما هو متخيَّل وما هو واقعيّ موضوعيّ، بين ما هو راءٍ وما هو حسيّ، على العكس إنّه ينمّي ويبرِّز ويعمّق ما بينهما من غرابة. ببساطة: أليس المجاز غريباً بالنسبة إلى اللغة، والكلام كذلك أمام الكتابة، أليست اللغة الفصحى (لغة الشّعر) غريبة عند لغة الواقع (لهجاته) الشعبويّة، حتى لكأنّنا نتطلّب بعامةٍ نوعاً من الترجمة للغة الشّعر إلى لغة الواقع. كأننا بهذه الترجمة إنّما نجترح لغة (وسيطة) بين لغة الشّعر ولغة الواقع التي ترى لغة الشّعر غريبةً عليها، وما هذه اللغة الثالثة الوسيطة إلّا تلك التي عُرفت بشعر الواقع ((الذي يدخل القلب قبل الأذن)) و ((الأتِيّ السَّمْح)) إلى آخره.
ما معنى أن يكون شاعر أو كاتب ما متميّزاً؟ سؤال يبدو في ظاهره عاديّاً متداولاً، كما تبدو الإجابة عنه غايةً في السهولة، غير أننا إذا ما أعدنا صياغة هذا السؤال هكذا: لغة شاعر ما تكون متميّزة واستثنائيةً قياساً بمَن؟ يقول دولوز ((إنّ علينا أن نكون مزدوجي اللغة حتّى داخل لغة بذاتها، علينا أن نحوز لغةً أقليّةً داخل لغتنا نفسها بالذّات، علينا أن نستخدم لغتنا نفسها استخداماً أقلّياً، أن نتكلّم لغتنا كأجانب)). وعلى هذا تكون هذه الازدواجيّة هي مَن وراء صعوبة قراءة لغةِ مثل هذه الكتابة من قِبل قرّاء لا يعون لغة الأقليّة هذه التي يتمتّع بها كلّ شاعر أو كاتب من دون غيره، كونهم لا يقرؤون جيداً إلّا اللغة الأمَّ - الرئيسة المتعارف عليها، كونهم يشعرون بالغربة ازاء لغة الشّعر (الأقليّة). وعلى هذا يمكنني إِعادة السؤال بصياغة أكثر أهميّة من سابقه: كيف يكون شاعر أو كاتب ما مبدعاً داخل لغته نفسها؟ تاركاً الإجابة عنه هذه المرّةَ لمارسيل بروست ((إنّ المؤلَّفات الرائعة تبدو وكأنّها كُتبت بلغة أجنبيّة)).
من هنا تكون كلّ كتابة خلّاقةٍ غريبةً ذلك أنّها في تخطّ وتحوّل متواصلين، كتابة تظلّ تبدو جديدة في كلّ مرة، فكما يتجاوز المرء ذاته أو يتخطّاها في مواقف معيّنة، تفعل اللغة الأمُّ كذلك عبر الأدب مع ذاتها، أي إنّ الشاعر أو الكاتب ما هو بدءاً إلّا وليد طفولته مع لغته الأصل، غير أنّه في ما بعد سيكون ((ابن اللغة التي يكتب بها)) ولا يُعرف إلّا بها، فكأنّما هو حفيدٌ للغته الأصل وابنٌ للغة التي يكتب بها، وما علينا إلّا أن نقيس درجة قرابة النَّسب هذه التي ما بين أن تكون حفيداً وأن تكون ابناً لنعرف درجة التّجاوز والتّخطّي هذين.





