إزهار اللغة في الدروب الشائكة
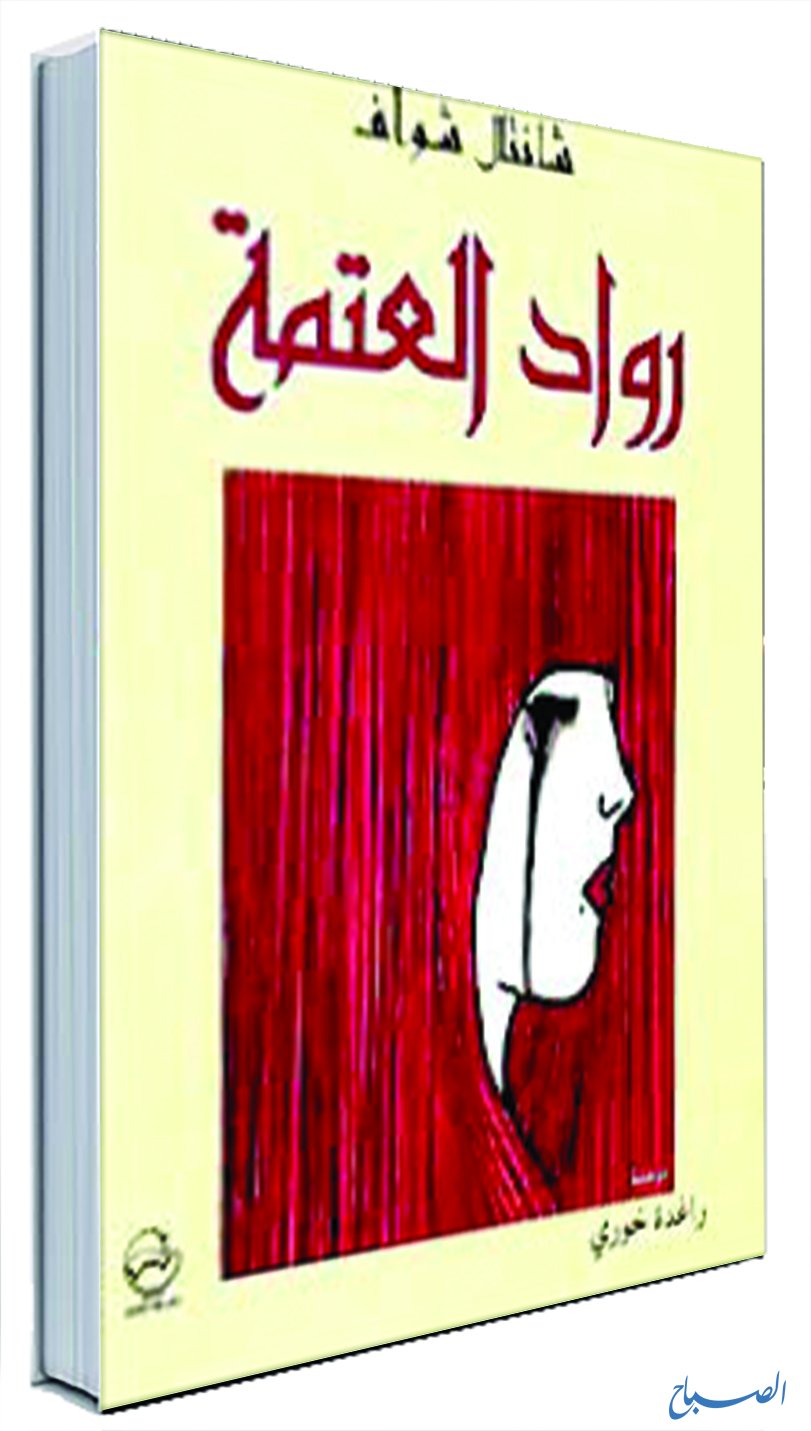
جينا سلطان
ينعكس التشظي في الرواية الفرنسية المعاصرة في بلبلة اللغة وعجزها عن تحقيق الانسجام بين الأفكار المحملة للشخصيات وحالات نموها المطردة نحو بلوغ الرشد الذي أطره الفيلسوف جان بول سارتر في ثلاثيته «دروب الحرية». لتتحول تلك الحرية إلى اقتراب عفوي من كلية النمط الأنثوي عبر الحدس، لقولبة روح العصر المثقل بقيود التساؤلات الوجودية وسكبه في أشكال تعبيرية متجددة. ولكونها تملك خاصية التحويل، أي التغيير والمرونة الانسيابية عند التنقل بين المشاعر والانفعالات المتدفقة، تغدو أقدر على استشعار التنبؤات المصيرية، وصياغتها على نحو أفضل من الخطابات النظرية الجامدة.
فيدافع «فرانسوا جارد» عن البراءة المنتهكة بفعل النفاق الاجتماعي الفرنسي، الذي يغطي الغرائز البشرية بأسلوب منمّق مهذّب.
ويحمل استلهامه لقصة حقيقية دعوةً إلى التفكير بالإنسان وفق رؤية مختلفة، تفسح المجال أمام كينونته، كي تتحرى السمو الأخلاقي النابع من نقاء السريرة وصفاء القلب، لأنّ دهشة الروح تتفتح فقط في غياب المكر.
«ماذا حدث للمتوحش الأبيض»
تعود أسطورة المتوحش الأبيض إلى منتصف القرن التاسع عشر، عندما هُجر بحار فرنسي في الثامنة عشرة من عمره يدعى «نرسيس بيللوتي» على أحد شواطئ أُستراليا البعيدة المجهولة. وهناك فقد لغته الأم، وعاش عارياً بجسدٍ تغطيه الوشوم، وتعلم الصيد من مضيفه، ثم عثر عليه أبناء جلدته مجدداً بعد ثمانية عشر عاماً. وهذه المدة الطويلة تقلب طبيعة تجربته كليّاً، إذ يتغرّب تماماً عن المفاهيم الحضارية للمجتمعات الأوروبية، مما يدفع الجغرافي «فالومبران» للتساؤل عن ماهية المقاومة التي أبداها «نرسيس» تجاه الضغط البيئي، وكيف كان بوسعه احتمال أو مجرد تخيل عزلة بهذه الخطورة.
تضم الرواية رؤيتين تتناوبان بتواتر مشوق، فتنساب الأولى على لسان «نرسيس» كذكريات، وتتخذ الثانية قالب رسائل متبادلة بين «فالومبران» ورئيس جمعيته الجغرافية، مما يهيئ لـ «جارد» وسيلة نوعية لتفسير الماضي والحاضر. فحين يسرد «نرسيس» مشاعره نقترب من تملك الحالة النفسية الفريدة التي امتحن بها وجوده، ونتلمس جلياً كيف جسدت الوحدة المطلقة مسؤولياته كاملة في مواجهة لعبة لا قواعد لها، حكمت عليه بالحرمان التام من سائر العلاقات الإنسانيّة. وعندما يستعيد لغته خلال أربعة أشهر ويستكشف مفرداتها من أعماقه، مقلّداً ما أمكنه تصرفات المحيطين به، تفرض ظاهرة التعلم بحد ذاتها على الجغرافي واقعاً مختلفاً يحرك يقينه بأسئلة عن ماهية المتوحّش والمتعلّم، وهل ينبغي التعرّف على ثقافة العادات الهمجيّة التي يبديها «نرسيس» في كل لحظة، مقارنة بثقافة العادات الحضاريّة، أم أن لها عالمها المستقل.
تكتمل فرضية «فالومبران» عقب مرور ست سنوات على عودة «نرسيس» إلى عالم ذوي البشرة البيضاء، حين يدرك أن التأرجح بين عالمين، كان يفنيه ألماً وتمزقاً ويجعله يتلاشى عدماً. فمن كان سيصدق أنه أمضى أيامه خوفاً، ومرَّ الوقت عليه ذعراً لحظة بلحظة، ومن كان سيغفر إذلال الجوع له، ويتفهم رعب الحاجة إلى أولئك الذين يستبطن فيهم الأعداء.. لا أحد، سوى من يمكنه أن يستوعب عودته كطفل، ببساطة روح مدهشة وغياب مطلق للمكر والتهكّم. بالمقابل، يبحث «باسكال كينيارد» عن الشغف المحبوس في الكلمات الضائعة، بعد أن غدت الكتابة وسيلته الوحيدة للكلام. فيتطور نصه وفقاً لإزهار اللغة في داخله، بحيث تجتاز ضائقة نقص الوجود لتصل إلى ذروة الإشراق، بعد أن تلقي إضاءة داخلية على الأشياء قبل تخلقها، وعلى الذات حين تكون مجرد حلم من دون وجه.
«الاسم على طرف اللسان»
يتخذ «كينيارد» من العجز اللغوي وسيلة لبث التناغم الموسيقي في عناصر حكاية تراثية، تدور حول خياطة تنسى اسم منقذها، فتجازف بخسارة زواجها. ومن ثم تتلمس الحكاية ماهية الجحيم، بوصفه الضفة المظلمة في أعماقنا، والمكان الذي يتعذب فيه الجميع. ويقوم بتوجيهها وتطويرها وفق مفهومه الخاص حول اللغة الناقصة، وألم البحث عن الأسماء، التي تقف على طرف اللسان، ثم تتجمع لتكون مملكة العجز، حيث يسكن الأطفال والموسيقيون والكتاب. فالكلمات العالقة على طرف اللسان تفرض سطوتها على الإنسان، لكونها تبجل انفعالاً أو خوفاً تم عيشهما في الذات قبل اللغة. وهنا مكمن ضائقة نقص الوجود، التي تستتر خلف ضائقة الكلمة المكتسبة، فتفتح باب الحنين بين جحيم الأثر وبديل الهلوسة، حيث تتشكل هوية الأحلام.
تقودنا الحكاية البسيطة إلى متاهة «كينيارد» اللغويَّة، التي تتجمع حول التخبّط والتبعثر في الذاكرة، عند استعادة اسم ما. فإضاعة كلمة ما، يعني أنَّ اللغة داخلنا شيء مكتسب، ومن ثم يمكن لمكوناتها أن تتقهقر على طرف اللسان، ولكنها في الواقع ليست فعلاً منعكساً في دواخلنا فلسنا حيوانات تتحدث كما ترى. وهذه الفكرة تدفعه لإعادة إنشاء ذكرى أمه، وتثبيت صورته كطفل يراهن، طوال حياته، على مجهود أمه من أجل العثور على اسم كانت تمتلك ذاكرته. وهذا التماهي الكامل مع حركة تفكير الأم، وهي تجوب في شقاء كبير، القنوات والطرق، حيث ضلت كلمةٌ طريقها، جعل منه الطفل المحبوس في الكلمة الغائبة تحت شكل الصمت.
ظلت الأم الغائبة جوهر حياة «كينيارد»، وبقي يُرجع كل شيء إلى تلك النظرة الضائعة المرتسمة على وجهها؛ وجه يتجمد في تركيزه بحثاً عن كلمة مفقودة تجد نفسها فيها. وهذا «التوقف عند الصورة» هو التعبير عن الزمن الذي يوقف انهيار اللغة، ويعيد إحياءها في قلق الانتظار، وترقب فرح الوضوح بمجرد العثور عليها، فتغدو الكتابة هي الإمساك بزمن الضياع، ومن ثم، الوصول من جديد بفضل العجز الى ضفة اللغة، على غرار سمك السلمون الذي يحاول بجنون الصعود إلى منبع النهر طوال حياته كي يضع بيوضه، ثم يموت. والكتابة ضمن هذا المعنى تعني التوليد، والفعل المعادل للموت. أما «شانتال شواف» فتنسج رؤيتها الإبداعيَّة بأسلوب أنثوي جميل، يتكئ على «اللغة المضيئة للأرواح العائدة من الموت»، وتنكأ الإرث التاريخي للنساء المقهورات، وتحرره من ماضي الترحال المنسي. ثم تعاهد النفس على الدفاع حتى الرمق الأخير عن القدرة السليمة، والحيوية المبعثرة، والمتعارف عليها من خلال معاناة الضحايا في العالم. كي تحذر من عواقب توطين الجنون كمعادل لتخليد التضحية الأنثويَّة واستبعاد الطبيعة، وتنازل النساء المرسّخ في الوعي الجماعي المازوخي.
«رواد العتمة»
تختار «شواف» بطلتها الفرنسية «ليز»، «المرأة ـ الطفلة» من الوسط المُغيب بفعل تداعيات الهوية المجزأة، وترصد من خلالها تفاصيل العودة إلى بدء التكوين، وجوهر الوحدة التي حرفتها الحياة الإنسانية المعقدة. فتدرس جيداً مكونات المتعة من خلال عقل يكتفي بالشعور بالحياة؛ عقل طفلة عاجزة عن القيام بحسابات صحيحة. وحين تنتهي الحياة المختلسة والملطخة التي ساقها إليها زوجها التركي، بعد أقل من عام، تجد نفسها زوجة مهجورة في الضاحية الجنوبيَّة شبه المائيَّة. مما يمهد لطقوس الانغماس التدريجي في الجوهر الفطري للطبيعة الحيوانية، وميراث الغرائز الحيوية، للتحول، لأسطورة الولادة والخلود. تتآلف «ليز» تحت تأثير العزلة والوحدة مع الأصوات البرمائيَّة لمستنقع الضاحية، وتعيد صياغتها في رأسها كدعامة للغةٍ تعطي كلماتها للماء معنى شعائريا، يقود المادة إلى حالة الغمر الماضية. فتغسلها الأصوات ضمن الذاكرة الجماعية، وتعيدها نحو قدسية الجسد، مولدة الشعور بالعرفان للحياة، فتنصقل الرغبة وتفسح المجال للشعور بألوهية المرأة، بوصفها الفرصة المتبقية أمام الحياة كي تربح. ثم تغادر شرنقتها، وتدخل صخب الاحتكاك مع الآخر، من خلال المراهقة التركية «يشار»، التي جاءت لتقيم معها في الضاحية الموبوءة، محملة بأصداء جسد جائع للحب، وارتعاش متواصل للتواجد. فترتحل معها بحثاً عن إمكانية الحفاظ على الشباب في شيخوخة العالم. لم تعرف «يشار» من تاريخ الشرق سوى إرث القهر الذي نهض من بيع الجمال من قبل تجار النساء، فأجج البؤس الأنثوي الموروث الكامن داخل حقدها، كفتاة مهزومة، متأذية، معقدة، مهملة، رغبتها في التطهر بالعنف لمحاكاة إرث الثقافة الدمويّة الذكوريّة. لكنها تكتشف في المشفى أشباهها، وتدرك وجود عقل حي يبكي، ويقاوم بعنف دفنه حياً، في كل مكان. تحذر «شانتال» على لسان «ليز» من عواقب تجاهل ما سجله باطن النساء لقرون؛ من المحرمات والخوف والغضب، من احتقارهن وخصي آرائهن، المقترن بتزايد أعداد الهالكين والمحذوفين من الخريطة الإنسانية. كما تذكر بأن الزمن لا ينسى، فهو منقول إلينا من أمهاتنا وجداتنا من خلال البويضة التي تستمر حتى الموت، وتمتد في الذرية، وتبشرنا بأن الحياة سوف تعود لتلقانا من جديد. ثم تشكر «يشار» لأنها أحيت لغة الطفولة البشريّة، واحتضنت النداء الملح للحياة، وحررته من صيغة القلق والجنون.
تتعاطى الروايات الثلاث مع مسألة الهوية الذاتية وعلاقتها باللغة الحية التي هي ثمرة التيقظ الداخلي، والانفلات من سطوة الحيوات الجافة المفرغة من المعنى الإنساني الخلاق. وهو ما حاول حمايته «نرسيس» بيأس، فصمت عن ماضي الانكسارات، وركن بثقة إلى مهارات التعامل العفوي البسيط مع الطبيعة والإنسان كما اكتسبه من البدائيين المتوحشين. بينما تتخذ الهوية عند «كينيارد» إشعاع المدد الروحاني، الذي يحرض البشر على إعادة خلق حياتهم بوعي يقظ عبر استخدام اللغة الحية، بوصفها الشغف بسر المكنون الوجودي وجماليته، فتغدو الكتابة الفعل المعادل للموت، لأنه يوصل اللغة إلى ذروة التوهج والإشراق. بالمقابل تقودنا «شواف» نحو لملمة شظايا الهوية المجزأة بفعل استلاب الجانب المؤنث من الحياة، وبعث أسطورة الولادة الكامنة في كل ذات
إنسانيَّة.





