تسريع التاريخ
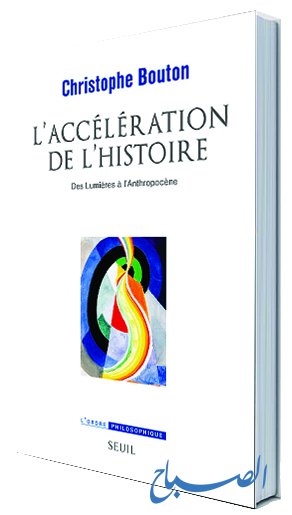
كامل عويد العامري
مثل قاطرة انطلقت بأقصى سرعة وفقدت محركها، يتميز تاريخ المجتمعات الغربيَّة، منذ منتصف القرن الثامن عشر، بالتسريع المضطرد الذي أصبح خارج نطاق السيطرة. في العقود الأخيرة، زادت الآثار المدمرة للنشاط البشري على الكوكب بمعدل مذهل. لكن يظهر نوع من التراجع: فالطبيعة، التي كان ينظر إليها ذات مرة على أنها مكان للتكرار، تجد نفسها ذات طابع تاريخي وحتى أنها متتعجلة نحو النهاية، في حين أن التاريخ، مكان التغيير ذاته، يبدو راكدا بشكل غريب. من خلال الربط الوثيق بين تاريخ المفاهيم والتفكير في الحداثة، يدعو كريستوف بوتون، مؤلف هذا الكتاب (تسريع التاريخ) إلى إجراء تقييم نقدي لهذه السردية المتعلقة بـ «تسريع التاريخ». من هم المدافعون عنها؟ ما هي معاني استخداماتها النظرية والعملية والسياسية؟ هل نعيش حقا في عصر التسريع الشامل؟ ألا ينبغي علينا بالأحرى تغيير وجهات النظر من خلال الانتباه إلى تجارب أخرى من الزمن التاريخي، مثل الاهتمام بالماضي أو روح اليوتوبيا، التي تقاوم هذا الاتجاه الأساسي؟
كريستوف بوتون أستاذ الفلسفة بجامعة بوردو- مونتين. المتخصص في هيغل، وسّع بحثه إلى نظريات التاريخ. من مؤلفاته، من الثورة الفرنسية إلى الربيع العربي (2013).
«تسريع التاريخ». بهذه الصيغة المقتضبة، بدأ بيير نورا تقديمه للمجلد الأول من كتابه (أماكن الذاكرة Lieux de mémoire، في عام 1984. وقد أسهم نجاح هذا العمل المبتكر، بلا شك في تعميم التعبير، إلى حد جعله توبوس [مخطط إجمالي]: “لقد أصبح تسريع التاريخ أمرًا شائعًا”، كما كتب أودون فاليت في عام 1993. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أثار مارك أوجيه “الاستنتاج الشائع الذي يمكن أن يقودنا إلى تكريسه يوميًا وهو أن التاريخ يتسارع”. بالنسبة لعالم الأنثروبولوجيا، فإنَّ تسريع التاريخ يعني في الوقت ذاته غزارة الأحداث والمعلومات التي تمر بنا بوتيرة متزايدة، وتحولها السريع إلى ماضٍ قد انقضى، في اتجاه من شأنه أن يشير إلى دخولنا في “الحداثة الفائقة”. حتى أن جان بودريل كان يعتقد أن الغزارة في سرعة تدفق الأحداث ستؤدي في النهاية إلى الامتناع عن الترسّب في التاريخ، كما لو أن التسريع كان يجعلنا نفقد الاتصال بالواقع. في هذه الحالة، يتأرجح تسريع التاريخ فيسقط، من خلال نوع من الانعكاس الديالكتيكي، على نقيضه - نهاية التاريخ. من أين جاء هذا الاستنتاج الذي يبدو راسخا؟ هل يجب مشاركته؟ كما أوضح راينهارت كوسيليك في دراستين كانتا نقطة انطلاق لهذا البحث، في أن موضوع تسريع التاريخ هو في حدِّ ذاته جزء من التاريخ، والذي يقودنا إلى ما قبل نهاية القرن العشرين بوقت طويل. لقد ظهرت الفكرة في فجر عصر الأنوار ثم رافقتها الحداثة بمعاني مختلفة إما لتمجيدها أو لانتقادها. دعونا نتذكر بعض المعالم المهمة من أجل إعطاء القارئ لمحة عامة عن سلسلة النسب التي سيجري تطويرها بشكل كامل في الفصلين الأولين من هذا الكتاب. في بداية القرن التاسع عشر، في سياق الانعكاسات التي أثارتها الثورة الفرنسية، شهد على فكرة تسريع التاريخ من قبيل كتاب مثل شاتوبريان في فرنسا وجوزيف جوريس في ألمانيا، الذي كتب: “إذا كنت تريد أن تتعلم في مدرسته [أي التاريخ]، اتخذ من الثورة كمعلِّم؛ فيها، درس مسار العديد من القرون البطيئة تتسارع لتتحول إلى مرحلة من بضع سنوات”. ليس لتجربة التسريع أصل سياسي فحسب، بل تنبع أيضًا من التقدم في العلوم والتكنولوجيا. يستشهد كوسليك في هذا الصدد بمحاضرة للمهندس ورجل الأعمال فيرنر فون سيمنز، بتاريخ 1886، بعنوان “عصر العلوم الطبيعية”، إذ يحتفل بحماس بتسريع وتيرة الاكتشافات، التي كانت ممتدة على مدى قرون، ثم على مدى عقود، ومن الآن، يُقاس بالسنوات: “هذا القانون الذي يمكن تحديده بوضوح هو قانون التسريع المستمر لتطورنا الثقافي”. في سيرته الذاتية المكتوبة عام 1907، والتي نُشرت عام 1918، وضع المؤرخ الأمريكي هنري آدامز أيضًا التسريع كقانون “ثابت وحازم” لـ “نظرية التاريخ الديناميكية”، ولكن بنبرة تشاؤمية واضحة، تأسف لعواقب التقدم العلمي والتقني، والتي ستؤدي حسب قوله إلى تدمير هائل للأرواح البشرية (يفكر بشكل خاص في سباق التسلح). وفي فرنسا، كان مقال دانيال هاليفي عن تسريع التاريخ، الذي نُشر عام 1948، هو من لفت الانتباه إلى هذا الموضوع. قبل عامين من نشره “”في مواجهة الريح. بيان الحوليات الجديدة”. وأثار “لوسيان فيبر” هذا التسريع الهائل للسرعة التي تؤدي، من خلال تلسكوب القارات، وإلغاء المحيطات، والقضاء على الصحارى، إلى اتصال مفاجئ بالمجموعات البشرية المشحونة بطاقات معاكسة.
ولكن إذا كانت الفكرة متوافقة مع العصر، فإنَّ هاليفي كان بلا شك أول من صاغ صيغة “تسريع التاريخ”، وهو يرى أن هذه الفكرة لها معنى شامل، فهو يشير إلى كل من التقدم التقني والعدد المتزايد من التغييرات السياسية بمرور الوقت. على الرغم من أنه لم يترك بصمة عميقة على الإنتاج العلمي، فقد بلور الفكرة وأذاع التعبير. يتضح من حقيقة أن حوادث “تسريع التاريخ” في الأدبيات الأكاديمية كلها تقريبًا بعد عام 1948، تاريخ نشر مقالته. إنها تأتي بشكل أساسي من المنشورات في العلوم الإنسانية، والتي تستحضر «البرق» و «المذهل» و «الذي لا يمكن إنكاره» «تسريع التاريخ» في القرنين التاسع عشر والعشرين. من بين المؤلفين الذين استخدموا التعبير في أعقاب هاليفي، نجد مثقفين ومؤرخين مشهورين مثل برتراند دي جوفينيل وفيليب آرييس وإيمانويل بيرل.... إن تسريع التاريخ يعني، في نظر نورا، “التحول السريع المتزايد إلى ماضٍ ميت نهائيًا”، وفقدان “الذاكرة الحقيقية” التي تتميز بها المجتمعات القائمة على التقاليد.
إنَّ تسريع التاريخ، الذي تحفزه العولمة هو نفسه، من شأنه أن يؤدي إلى فقدان علاقة أكثر أصالة مع الماضي والمستقبل، وظهور “ديكتاتورية الحاضر”. هذه الأطروحة الأخيرة تعيد إلى الأذهان فكرة “الحاضر” التي اقترحها فرانسوا هارتوغ، الذي تولى بنفسه تشخيص نورا حول اختفاء “مجتمعات الذاكرة”. وعلى إثر كوسيليك، فإنَّ هارتوغ يرى أن عملية التسريع كانت قد بدأت في مرحلة مبكرة من القرن العشرين، مع “النظام التاريخي الحديث” الذي يتطلع إلى المستقبل، الذي وضع حول الثورة الفرنسية ثم طوال القرن التاسع عشر. وخصص مؤرخون آخرون هذا الموضوع أيضًا في إشارة إلى كوسليك، مثل هنري روسو، الذي يستحضر، “تصورًا للتاريخ متحركًا قائمًا بالكامل على تسريع الزمن الحاضر”. من جانبه، اعتمد كريستوف شارل على هارتموت روزا ليختتم كتابه “تاريخ مختصر للحداثة” في هذه العبارات: “يقول المثل الصيني إن الإنسان يمتطي نمرًا. ويمتطي رجل الحداثة الغربية والعالمية الآن نمرًا لا يتوقف عن التسريع أبدًا إذا حاول إيقافه، فيسقط ويؤكل، وإذا استمر في السرعة، فلا يعرف إلى أين يقوده النمر”.
في مورد آخر، وهو علم الاجتماع النظري المستوحى من مدرسة فرانكفورت، دافع هارتموت روزا عن الأطروحة القائلة بأن التسريع سيكون مقولة الحداثة الأساسية. إنه جزء من سلسلة من الأفكار النقدية للحداثة، التي يمثلها كوسليك وبول فيريليو وبيتر كونراد، صاحب مقولة: “ما هو على المحك عندما نتحدث عن الحداثة هو تسريع الزمن”. بالطبع، مثل هذا التعبير ليس له أي معنى على الإطلاق، لأن التسريع، الذي هو في الأصل مفهوم مركزي في الفيزياء النيوتونية، يقاس بالزمن، يشير إلى زيادة السرعة في وظيفة الزمن. لذلك لا يمكن للزمن نفسه أن يتسارع، لأنه سيستغرق وقتًا آخر لقياس مثل هذا التسريع، مما سيؤدي إلى ارتداد إلى اللانهائي. ما يتسارع هو مجموعة من العمليات داخل المجتمع، داخل التاريخ. في هذا الصدد، أنجز روزا عملاً قيمًا في التحليل المفاهيمي من خلال التأكيد على أنه في سياق تشخيص الحداثة، وبشكل أدق “الحداثة المتأخرة”، الذي بدأه، بعد هابرماس، ابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، يعني التسريع إما الزيادة في السرعة أو زيادة الإيقاع. وهكذا يميز بين ثلاثة أشكال من التسريع: التسريع التقني (زيادة سرعة وسائل النقل والاتصال والإنتاج)، والتسريع الاجتماعي (زيادة وتيرة التغيرات الاجتماعية)، وتسريع إيقاع الحياة (زيادة في عدد الأنشطة وسلسلة من العمليات النفسية اليومية). تتفاعل هذه التسريعات الثلاثة مع بعضها البعض، وتشكل “دوامة التسريع” التي تنتج الانعكاس الديالكتيكي: فمن ناحية يتسارع التاريخ، ومن ناحية أخرى يولد نقيضه، الجمود، الذي يجب أن نفهم به مقاومة التسريع، وبشكل أعمق، حقيقة أنه وراء التسريع الظاهري للمجتمع، تظل البنى الاقتصادية والسياسية هي نفسها. هذا ما يسميه روزا، بما استوحاة من بول فيريليو، “السكون اللامع “. ولكن وفقًا لبعض المؤلفين، فإن عدم الحركة ليست النتيجة المتناقضة للتسريع، بل هي علاجها. إن أزمة عصرنا بالنسبة لبيونغ تشول هان، الذي يؤكد أيضًا أن التاريخ يسير بسرعة كبيرة، هي قبل كل شيء مسألة “عدم التزامن”، والـ “تشتت الزمني”، والتي سيكون حلها هو العودة إلى الحياة التأملية. وإلى فن التوقف على الأشياء.هناك امتداد آخر لبحث روزا في تسريع (التاريخ، المجتمع) اقترحته جُدي واكمان،، التي درست، من منظور جنساني، الآثار السلبية لتقنيات الاتصال والمعلومات الجديدة على إيقاعات الحياة في الولايات المتحدة، حيث لاحظت أن النساء يعانين أكثر من الرجال من ضغط الوقت وقلة وقت الفراغ. ولمعالجة نشوة السرعة، يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ولكن، على العكس من ذلك، “تسريع إبداعنا من أجل السيطرة على وقتنا بدلاً من أن يسيطير علينا الوقت”.
يفسر ظهور فكرة التسريع بحقيقة أنها مكان التقاء عدة تيارات فكرية مختلفة للغاية. فضلا عن المؤرخين وعلماء الاجتماع، كان محط اهتمام العلماء والفلاسفة الذين درسوا مخاطر التقدم. ففي خمسينيات القرن الماضي، حاول فيلسوف العلوم فرانسوا ماير، أن يعطي تعبيرًا علميًا لما أسماه أيضًا بقانون التسريع. ويرى أن نقطة البداية هي فكرة أن الإنسان هو نوع يتمتع بسرعة التطور والتوسع الاستثنائي. ويؤدي “التسريع التطوري” للأمل البشري إلى “تسريع مفرط” تقنيًا وديموغرافيًا، مما يؤدي إلى مخاطر “ارتفاع درجة الحرارة” (الزيادة السكانية، “الازدحام المفرط” على كوكب الأرض، نقص التغذية، التلوث، استنفاد موارد الطاقة، إلخ. ). حظي هذا النمط من التفكير باهتمام كبير بعد نشر تقرير فريق ميادوز عام 1972، الذي نبه الدول إلى خمسة “اتجاهات متسارعة” في العالم الحديث: التصنيع، والنمو السكاني، وسوء التغذية، واستنفاد الموارد غير المتجددة، وتدهور البيئة. في العام نفسه، نشر جيرارد بيل، كتابًا شهيرًا بعنوان (تسريع التاريخ)، والذي كان فيه يوضح قانون هنري آدمز للتسريع في القرن العشرين، خلص فيه إلى أن التاريخ “يسير على طريق التسريع المتسارع”، الأمر الذي “أوصل بالجنس البشري إلى مفترق طرق. إحدها يؤدي إلى طريق مسدود. أما الآخر، الأقل وضوحا، فلا يزال بإمكان جنسنا البشري إيجاد الطريق لتحقيق إنسانيته”.. وهنا لا يتردد برونو لاتور في الربط بين شكلي التسريع:”كنا نرتجف بالفعل أمام تسريع التاريخ، ولكن كيف نتصرف أمام “التسريع الهائل”؟”.
إنَّ الغرض من هذا الكتاب، تفكيك أطروحة تسريع التاريخ، الأمر الذي يثير سلسلة من الأسئلة، أولها ذات طبيعة دلالية وتتعلق بتعدد بمثل هذه الصيغة. بأي معنى نستخدم مفهوم التسريع عندما نطبقه على التاريخ؟ ونتيجة هذه العملية، “تسريع التاريخ”، هل هي مقولة تاريخية، أو على العكس من ذلك، استعارة بسيطة، ومفهوم شامل يحتوي على معاني متنوعة جدًا تشير إلى سياقات متنوعة، و”كلمة رئيسة” مستهلكة وكأنها عملة معدنية بالكاد يمكن قراءتها لكثرة تداولها؟ هل هو واحدة من “تلك الشعارات المعاصرة التي لم يجر تحليلها ويستشهد بها كثيرًا”، والتي لا ترقى أبدًا “إلى مستوى مفهوم محدد أو نمط مثالي بفضائل استدلالية”.. إنَّ التاريخ يتسارع، وأكثر وحشية. لذلك سيكون هناك أيضًا تسريع جيوسياسي للتاريخ، بناءً على زيادة التهديدات. هذا النوع من التأكيد هو جزء من إطار فكري يرى في تسريع التاريخ قانونًا من المفترض أن ينطبق على جميع مجالات المجتمع، من الاقتصاد إلى الجيش. إذا اتبعنا هذا المسار، فهل ينبغي أن نعتقد أن تسريع التاريخ هو “مقولة تاريخية زمنية محددة” خاصة بالحداثة، مما يؤدي إلى “بديهية التسريع داخل التاريخ”، وإلى “تاريخ مبدئي للتسريع في العصر الحديث”؟ المجموعة الثانية من الأسئلة تتعلق بواقع التسريع. هل يمكننا حقًا استخدام مثل هذه التصنيف لوصف الحداثة؟ هل يشير إلى ظاهرة تاريخية حقيقية أم أنه مجرد “هلوسة جماعية”؟ ألا يعرف كل عصر إحساسًا بالتسريع ينتج عنه آليا حاجة إلى البطء ؟ لتبديد الغموض الذي يكتنف هذه الفكرة إلى حد ما، يقدم ألكسندر إسكودييه التمييز الواضح بين “الوجه الموضوعي” للتسريع، الذي يسمي الجوانب المادية والملموسة للظاهرة، و “وجهها الذاتي”، الذي يحدد إدراكها والشعور الذي تلهمه. يمكن أن نأمل في تسريع التاريخ أو الخوف منه أو التقليل من قيمته أو المبالغة في تقديره اعتمادًا على الفترة والسياقات. ومما يعيد صياغة مشكلتنا: هل يمكن أن يكون هناك تسريع من دون إدراك للتسريع أو، على العكس، شعور بالتسريع من دون تسريع موضوعي؟
تثير الطرق المختلفة، الإيجابية أو السلبية، التي يمكن من خلالها استيعاب تجربة التسريع التاريخي، نوعًا ثالثًا من الأسئلة، يتعلق بالمعيارية الملازمة لهذه التجربة. ووفقا لذلك ما هي معايير ظاهرة تسريع التاريخ، بافتراض أنها موجودة بالفعل، أو متوقعة أو مرهوبة، أو ممدوحة أو منتقدة؟ إن مقولات تاريخية معينة - مثل “الثورة”، “التقدم”، “الرجل العظيم”، “نهاية التاريخ”، إلخ. - تحمل معها أحكامًا قيمية تتطور معاييرها، التي لا يمكن شرحها دائمًا، بمرور الوقت. غالبًا ما نلاحظ في الخطابات التي تستدعي هذه المقولات مزيجًا من الوصفية والمعيارية. هذا هو الحال بشكل مثالي مع تسريع التاريخ، الذي كان يُنظر إليه أولاً على أنه تحرير للأفراد، ثم يجري التنديد به باعتباره تهديدًا هائلاً.
ولأنَّ هذا البحث يطمح أولاً إلى توضيح دلالات التصنيف التاريخي للتسريع. فما الذي يمكن الحديث عنه بالضبط عندما نتحدث عن تسريع التاريخ؟ إن إطاره المنهجي هو ما يسمى بالنظرية النقدية للتاريخ، والتي يجب أن نفهم من خلالها نهجًا يهدف إلى تحليل وتفكيك مقولات الخبرة التاريخية.
ماذا يغطي مصطلح “الحداثة” هنا؟ يمكن الإشارة بإيجاز إلى المعنى المعطى، في إطار هذا الكتاب، لهذه المقولة التاريخية المتعددة المعاني بشكل خاص. من الضروري أولاً التمييز بين “التاريخ الحديث” و “الحداثة”. فنحن نعلم أنه في التاريخ الفرنسي، يبدأ التاريخ الحديث في أواخر القرن الخامس عشر وينتهي بالثورة الفرنسية، والتي تمثل الحد الأقصى للتاريخ المعاصر الممتد من نهاية القرن الثامن عشر إلى يومنا هذا.. ومن هنا يبدو أن مفهوم الحداثة يمتد عبر التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر: إنه بناء مفاهيمي يحدد مجموعة من المعايير والقيم (مثل التقدم والعقلانية والاستقلالية وما إلى ذلك) ومن وجهة النظر الزمنية، فترة من التغييرات الكبيرة، وهو اتجاه يبدأ إما بالتنوير أو بالتصنيع، في الثلث الأول من القرن التاسع عشر. بالنسبة للفلاسفة، غالبًا ما تتوافق مع الفترة التي تمتد من نهاية عصر التنوير إلى يومنا هذا، والتي تتميز بطرق مختلفة، بـ “عصر التاريخ” (فوكو)، والعلمنة (كارل لويث)، و (غير المكتمل). مشروع العقلانية (هابرماس)، مشروع الاستقلالية (كورنيليوس كاستورياديس)، “ظهور الديمقراطية” (مارسيل غوشيه)، الميل نحو “الاحتفاء بالذات” (ريكور)، إلخ. في بعض الأحيان، تشمل الحداثة التي يتحدث عنها فلاسفة التاريخ الحديث، كما هو الحال مع بلومنبرغ. ولكن، في هذه الحالة بالذات، فإن المصطلح المستخدم في اللغة الألمانية هو “die Neuzeit”، والذي يُترجم عمومًا إلى “الأزمنة الحديثة”.
وحول مفهوم الحداثة تشترك مفاهيم أخرى التي تبشر بتجاوزه، مثل “ما بعد الحداثة” التي ولدت مع نهاية “السرديات العظيمة” (ليوتارد)، و”الحداثة المتأخرة” (هابرماس، وروزا)، والتي تعيد تأهيل الفترة السابقة من “الحداثة الكلاسيكية”، و”الحداثة الفائقة” (أوجي)، و”الحداثة المفرطة” (نيكول أوبير)، أو حتى “الحداثة الثانية” (أولريش بيك)، والعديد من الفترات الجديدة التي هي بعيدة كل البعد عن كونها موضع “إجماع”. ولإكمال هذه اللوحة، نضيف أن راينهارت كوسليك قد قدم، في شكل فرضية استدلالية، “فترة مفصلية”، هي الـ “” Sattelzeit - وهو مصطلح يستخدم في البحث باللغة الألمانية لتحديد الانتقال من ما قبل الحديث إلى الحديث على وجه التحديد في الفترة من 1750 إلى 1850. والتي وضع خلالها، المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية للحداثة. خلال هذه الفترة، تتغير تجربة التاريخ، وتتميز بشكل خاص بالحداثة وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل، والفرق المتزايد بين “أفق التوقع” و “مجال الخبرة” (الرغبة في الانفصال عن الماضي والأمل بمستقبل أفضل)، و”جدوى” “التاريخ” (فكرة أن الرجال هم من يصنعون التاريخ) وتسريع (النمو الديموغرافي، النقل، الاتصالات، الاكتشافات العلمية والتقنية، التغيرات السياسية). من هذه الزاوية، فإنَّ الـ “Sattelzeit” هي “حقبة انتقالية تخضع للتسريع”، فهي تضمن العبور، بشكل أو بآخر، بين كتلتين تشكلان تاريخًا حديثًا وتاريخًا معاصرًا. وإذا ما استخدمنا صورة إيمانويل لو روي لادوري، يمكننا القول إنّ بداية الـ “Sattelzeit” تتوافق مع ما يلزم من تعديل مع نهاية “التاريخ غير المتحرك”.
في هذا الكتاب، يمنح مفهوم الحداثة معنى جمعيًا حازمًا وامتدادًا واسعًا إلى حد ما، يشمل الفترة من عام 1750 إلى يومنا هذا أو، لاستخدام العنوان الفرعي، من عصر التنوير إلى الأنثروبوسين[ حقبة جيولوجية مقترحة كانت ستبدأ عندما أصبح التأثير البشري على الجيولوجيا والنظم البيئية مهمًا على صعيد تاريخ الأرض.] . .. يجب التمييز بين أنواع مختلفة من التسريع في الحداثة، وتحديد المعايير التي جرى تطبيقها عليها، ودراسة الاستخدامات التي أجريت عليها. وسنرى بعد ذلك كيف أن أطروحة تسريع التاريخ تعمل أحيانًا كبديهية لما يمكن تسميته نظرية التسريع، والتي تبدو متناغمة مع الزمن، على الرغم من عدم تسجيلها في أي مكان. ستكون صياغته على النحو التالي:
- تتميز الحداثة من خلال تسريع التاريخ.
- إن تسريع التاريخ يعني القطيعة مع الماضي وتذويب المستقبل.
- الحداثة تؤدي إلى ديكتاتورية الحاضر.
إنَّ الحدس القوي وراء هذا المنطق هو أنه كلما ذهبت بشكل أسرع، كلما قل الزمن الذي يجب أن تنظر فيه إلى الماضي وتتوقع المستقبل، وكلما كنت سجينًا للحاضر، يشبه إلى حد ما قطارًا مسرعًا. سرعة عالية، عندما تمر المناظر الطبيعية بسرعة كبيرة بحيث يمكنك فقط رؤية المنطقة الصغيرة الموجودة أمام نافذتك بشكل عابر. ما مدى صحة نظرية التسريع؟ كيف بنيت؟ ما هي المتغيرات؟ إلى أي مدى يمكن استيعاب معنى الحداثة؟ هذه الأسئلة تقود إلى استكشاف الخيط المشترك للتسريع، وأنظمة التاريخيانية الخاصة المختلفة بالحداثة، والطرق المختلفة التي من خلالها يجري اختبار الزمن التاريخي وتمثيله فيه. وأبعاده الأساسية الثلاثة - الحاضر والماضي والمستقبل. تتابع الفصول الأولى المسارات التي تؤدي من الحداثة إلى تسريع التاريخ (الفصلان الأول والثاني)، ثم من تسريع التاريخ حتى الوقت الحاضر، والتي تعد المقولة التاريخية المهيمنة (الفصل الثالث). الفصل المركزي (الفصل الرابع)، الذي يلعب دورًا محوريًا، ويستجوب، من منظور نقدي، أطروحة الحداثة على أنها قطيعة مع الماضي. الدراسة التالية تدرس، بشكل متماثل، انحلال المستقبل، بدءًا من التفكير في موضوع نهاية اليوتوبيا (الفصل الخامس). ويعيد الفصلان الأخيران بناء المسار الذي يقود من تسريع التاريخ إلى “التسريع العظيم”، من الثورة الصناعية إلى الأنثروبوسين (الفصلان السادس والسابع).





