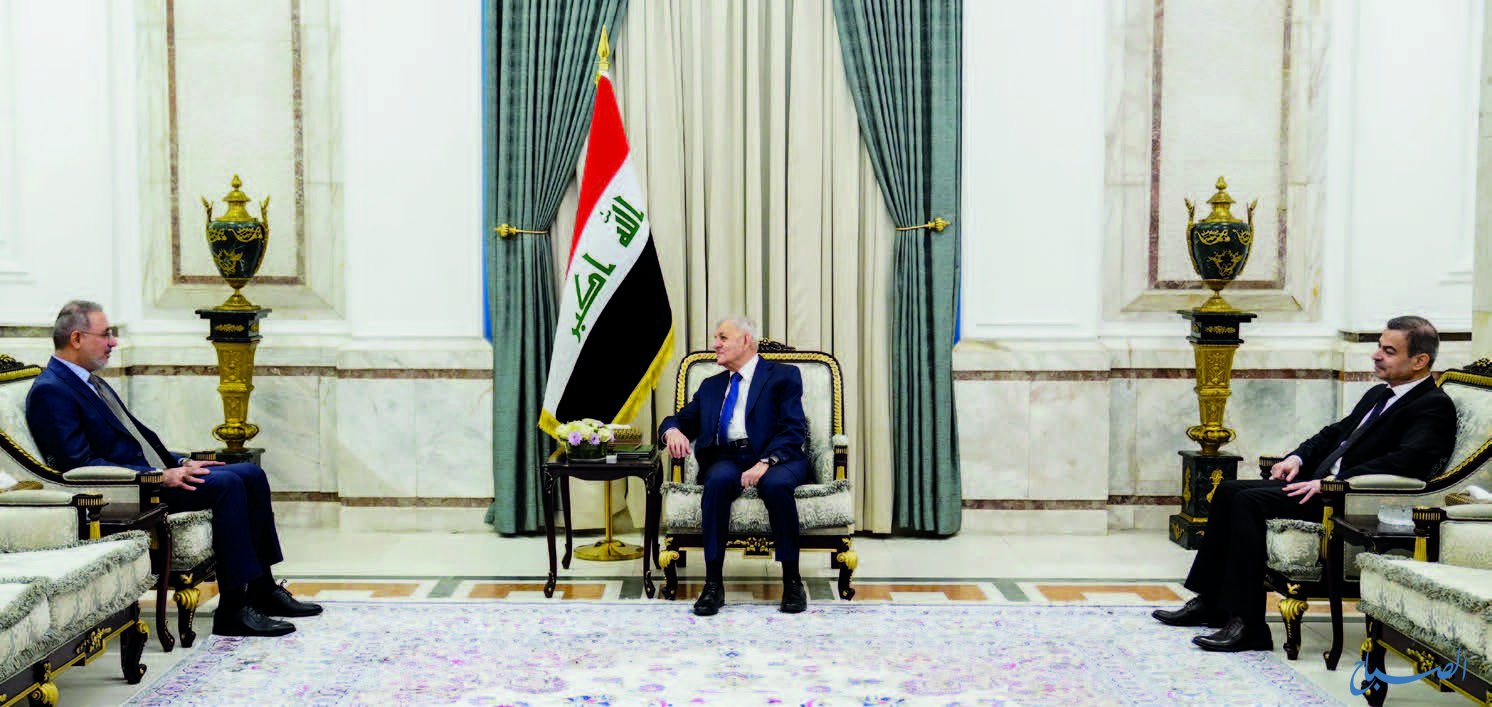حمامٌ للنساء والرجال

محمد مزيد
ما سأرويه لكم، أصدقائي، من خيالي، فقد عثرت مؤخرا، على مخطوطة كتاب عربي في مكتبة تركية، الكتاب عبارة عن مذكرات رحالة غرناطي، فأخذت زاوية من المكتبة، بعد ابتسامة طويلة عريضة لصاحب المكتبة، عرف من خلالها شغفي بتصفح المخطوطة.. أول عبارة قرأتها وشدتني إلى الكتاب، تقول "إن سرائر النور فرشت في قلب الرحالة الغرناطي، من حيث لا يدري، وهو يبحر بحثاً عن الحقيقة في البلدان البعيدة عن دياره، بعدما ضاعت غرناطة من بين يدي سلطان العرب الاندلسي"، عبارة (من حيث لا يدري)، هي التي ألهبت الحماس في عقلي واثارت انتباهي، لتتركني أهيم مثل المجنون، في عالم الكتاب.
حلقت بجناحي خيالي، فالتقيت بالرحال الغرناطي، في ديوان قاضي القضاة أبي اسحاق، كان الرحالة يتحدث عن رحلته الاخيرة الشاقة إلى البلدان التي تقع على نهر النيل، كيف أنه واجه رجالا بطوية جميلة لا بغض فيها، مضى يتحدث ثلاث ساعات، حتى وصل إلى حكاية شد بها انتباهي، تلك هي حكايته عن حمام الرجال والنساء المختلط في بلدة تقع على النيل، لم يذكر إن كانت مصر أو السودان أو الحبشة، وبسبب جدية القاضي أبي اسحاق، فلم يستفض الرحالة بحكايته، فكرت، كيف اتحين الفرصة، لأستفرد بصديق الغرناطي اللوذعي، وهو شاب مليح باشا، يعمل كاتبا لدى القاضي للحديث عن الحمام، فهو لا يتكلم إلا قليلا، بسبب حضور القاضي.
لدى هذا الشاب بيت وزوجة في هذه البلدة، وبعد أن تعب الرحالة من رواياته الشائكة، طلب منا الشاب المليح المبيت عنده في البيت، تردد الغرناطي في بادئ الامر، لكنه عندما وجدني مسرورا بالدعوة، قبلها، كانت في نية الغرناطي أن يوجه له الدعوة القاضي وليس الشاب الذي يعمل لديه كاتبا، فخرجنا من ديوان القاضي ليلا وسرنا في درب ترابي تتنابح به الكلاب، قلت في نفسي، سأنفرد بالرحالة في بيت الكاتب ليروي لي حكاية الحمام المختلط على ضفاف النيل، وما إن وصلنا إلى البيت، حتى خرجت زوجة الكاتب وهي فرحة مسرورة لاستقبالنا، خرجت من غرفتها التي رأيت انها مشرعة النافذة، ولمحت بسرعة خاطفة، رجلا اسود، خرج منها مسرعا، عاري الظهر، بالكاد استطاع ارتداء لباس طويل، ليواري عريه من الاسفل، انتبه الكاتب إلى الطريقة التي نظرت بها إلى غرفة زوجته وما حصل فيها قبل قليل، فابتسم لي وهو يمسك براحة يدي "لا تظن أن الامر فيه سوء، هكذا نحن" لم فهم مقصده، غير أن الرحالة الغرناطي قال لي هامسا، "سأشرح لك ما استعصى عليك فهمه" كما لو كان قد علم ما يجول في خاطري.
جلسنا في رحبة البيت، ثمة قنديلان على طرفي الرحبة، يضيئان المكان، جلبت زوجة الكاتب الاطايب من لحم الطير وهي ترتدي الثوب نفسه التي رأيتها عندما خرجت من غرفتها، أبيض شفاف لا يستر جسدها، إلا قليلا، أخذ الرحالة يدون ما كان قد فاته، وانشغلنا انا والكاتب نتهامس بعيدا عنه، فسألني من أي عصر أتيت؟ وكيف أتيت إلى هنا؟ وماذا تحوي حقيبتك الصغيرة هذه؟ فأخرجت له "الموبايل" فاندهش، وفتحته له فازداد رعباً واعجاباً، كاد يفقد صوابه، لا بد من التذكير أن الصرح الاخلاقي الذي يهيمن على سلوك هؤلاء القوم يختزل ببساطة شديدة مقاربة في ما نعيشه نحن حالياً من تهتك فاضح للجسد البشري، بدليل أن الكاتب، ما إن تلبسني القي نظرة إلى زوجته وهي تودع رجلاً أسود هرب من النافذة، حتى قال لي ببساطة "لا تظن أن الأمر فيه سوء" بقيت أراقب رواح وغدو المرأة، وهي ما زالت ترتدي ثوبها الشفاف الخفيف الابيض الذي يشبه ما نسميه بعصرنا ملابس النوم أو "الاتك" الذي لا يحجب النظر إلى ما وراءه، فكان صدرها بارزا من فتحة الثوب، كلما أحنت ظهرها لتضع الطعام، يتدلى ثدياها، وعندما تذهب إلى المطبخ، يبرز وركيها بشكل لافت، وهما يعزفان موسيقى الخلود، تركنا الرحالة الغرناطي يدون في دفتره الصغير مشاهداته، وأخذ يهمس الكاتب في أذني "سألني عن الحمامات في عصرنا، أليس كذلك؟" بعد صمت قليل، قال مضيّفنا "بعد الانتهاء من العشاء سنذهب أنا وأنت إلى احدى الحمامات ونترك الغرناطي هنا لوحده، إن قبل بذلك"، فلم اسأله كيف يترك رجلا غريبا في بيته مع امرأته السوداء الجميلة.
بدأنا بالتهام الطعام والشراب المعتق، وبعدها قال الكاتب للرحالة الغرناطي "أظنك لا تقوى على التجوال في الليل، فهل ستبقى هنا وأن احتجت إلى شيء سيُلبى طلبك فورا، بمجرد أن تومئ إلى زوجتي العزيزة" وبعد برهة أكمل "حتى نمضي أنا وصديقي المعاصر هذا (وضع يده على كتفي) إلى أحد الحمامات القريبة لنغتسل ويرى ما يحب رؤيته" .
خرجنا من بيته وأنا أغبط الرحالة العجوز (أظنه في الخمسين)، لكونه سيبقى ينظر إلى مفاتن زوجة الكاتب وهي تتلوى بمشيتها بين رحبة البيت والمطبخ، يخيم على الشوارع ظلام دامس إلا من بعض القناديل، موضوعة على حافات أشجار أفريقية شاهقة، كانت تضيء بعض دروبنا الملتوية بين بيوت القرية الطينية، يمسك الشاب يدي كي لا يفقدني في الظلام، وبعد أن تكاثر نباح الكلاب، مشينا باتجاه نهر النيل، حتى وصلنا على اعتاب مبنى من الآجر كبيرا مضاء من الداخل، يطل على نهر النيل، كما لو كان منحنيا عليه، ما شاهدته الآن بسبب نور القمر المنعكس على صفحات النهر، فقال "هذا هو الحمام، سترى مصدر مياهه، يتزود بها من مضخات نواعير، تدورها الحمير، تضخ إلى مجرى نهير صغير، ثم يصب في خزان يرتفع قليلا عن الأرض" كنت مندهشا وأنا أمسك بجهاز التسجيل لأسجل ما أرى.
دخلنا الحمام، استقبلنا مديره بحفاوة مبالغ بها، فعرفت مكانة كاتب القاضي عنده، ثم طلب منا المدير خلع ملابسنا، كان يوجه كلامه إلى الكاتب الذي نزع ملابسه بدون توجيه، غير أن قوله، كان يقصدني به، وما أن بدأت بنزع ملابسي، حتى شعرت بالخجل، تأزر الكاتب بمنشفة كبيرة، وفعلت مثله وقد ذاب خجلي بسرعة، ودخلنا إلى رحبة كبيرة لم تكن مظلمة، ثمة قناديل موزعة في كل مكان، وهناك حوض يشبه شكل السمكة بحدود سبعة أمتار طولا وثلاثة امتار عرضا، يتصاعد منه البخار، وعلى حافته ثمة مصطبة عريضة جلس عليها رجال ونساء عراة، تلمع اجسادهم بالضوء الشحيح في داخل الرحبة، تتدلى سيقانهم في مياه الحوض السمكي، دبت الهسهسة في جسدي، ولاحظ الكاتب أنني منبهر فاغر فمي، التفتُ إلى كل الجهات، ثمة غرف صغيرة بستائر شفافة على أبوابها، كان الكاتب يبحث عن شيء ما قبل أن يطلب مني الجلوس بجانب إحدى الحسناوات السود على المصطبة السمكية، ولما عثر على الشيء الذي يبحث عنه، حتى عرفت أنه يريد من امرأة معينة أن تأتي الينا، فجاءت، فتاة بيضاء تتأزر بمنشفة وردية، همس بإذنها شيئا، فابتسمت لي المرأة ثم اخذتني من يدي إلى إحدى الغرف، طلبت مني الاستلقاء على بطني بدون المنشفة، وقامت برش الماء على جسدي بإناء كبير، ثم بدأت تفرك ظهري بالصابون المعطر، بعد ساعة شعرت أنني صرت مثل طائر يريد الطيران بدون جناحين، عدنا إلى الرحبة ولاحظت أن الكاتب اختفى، اجلستني المرأة على المصطبة وجاءت امرأة أخرى سوداء، جلست بجانبي بعد اشارة من المرأة البيضاء، لا أدري ما الذي حصل لي، أن ما أراه حتى في أفلام "البرنو" لم اشاهد مثله، ففي الغرف الموزعة بشكل دائري حول الرحبة ثمة رجال ونساء لوحدهم، يفركون أجساد بعضهم البعض، لا تتكلم المرأة السوداء الجالسة بجانبي، أنها تراقبني فقط، بابتسامة مشعة تظهر اسنانها اللؤلؤية، ولما استعصى عليها الكلام، بدأت تستعمل يديها لإيصال ما تريد قوله، ثم نهضت وجلبت لي صينية عبارة عن خوص من سعف النخيل، فيها تمر البرحي فالتهمت نصفه، وهي تقف أمامي حاجبة الرؤية عني، انسحبت كل النساء من الحوض السمكي وما هي إلا لحظة حتى خرجت النساء من زاويا معينة، وجلبن الدفوف وبدأن يغنين ويرقصن، ترتدي بعضهن المناشف الوردية، بيضاوات وسوداوات وحنطيات، تدخل أصواتهن مسامعي فتثير في نفسي الراحة والتلذذ، ماذا يجري هنا، نحن في أي عصر نعيش، تقول المخطوطة، أنه القرن السابع الهجري، كنت اتنقل بنظري بين الحسناوات باحثاً عن شيء ما لفت نظري، لا أعرف ماهيته، خطف هذا الشيء من أمامي بسرعة عجيبة، وتاه وسط حشد النساء، لا أعرف ما هيته، شعرت بالقلق والخدر اللذيذ، وعدم القدرة على استيعاب ماهية هذا الحفل الغنائي الراقص، لرجال وقفوا على جانب والمرأة الجالسة بجانبي قد لصقت فخذها بفخذي، مازلنا ننظر إلى الاجواء السحرية الغارقة بـ "البرنو"، ولما انتهى الغناء والرقص انسحبت النساء إلى الزوايا المظلمة من الرحبة، لكنني وجدت شيئا لم يكن ليخطر على بالي، إنني رأيت امرأة تشبه حبيبتي التي فارقتني اثناء حرب ايران، كانت تغني معهن، فبحثت عن الكاتب لكي يساعدني في الوصول إليها ولما عثرت عليه هرعت إليه وهو مغمور بالضحك مع إحداهن، همست بأذنه، فذهب إلى المدير وقال له مضمون ما همست، جئن النساء، مررن من أمامي، هذه المرة بدون مناشف، يسرن بغنج ودلال وضحكات مكتومة، يتهامسن، وفي الاخير، وجدت المرأة التي تشبه حبيبتي، التي فارقتني بسبب الحرب، كانت تسير لوحدها في الرحبة، ولما نهضت إليها كانت قد اختفت من ناظري، كدت أشعر باليأس من فقدانها، حتى وجدتها تقف بدلال، وبابتسامتها التي أحبها في غرفة منزوية بعيدة، خلف الستارة، تومئ لي بالاقتراب منها، ذهبتُ اليها، ولما وصلت عانقتني، قبلتني، هي.. هي نفسها، حبيبتي التي فارقتني أيام حرب ايران، بكيت بحرقة وأنا ألثمها وأقبل كل جزء من جسدها، بعدها انطفأت القناديل وبقي واحد يحمله الكاتب يبحث عني، ولما عثر علي تركتني الحبيبة وغادرت الظلام وأمسك الكاتب بيدي إلى غرفة ارتداء الملابس، ثم ذهبنا إلى بيته وقد طر الفجر، كنت ما أزال أبكي، وأنا غير مصدق بما انعمت به من الخدر واللذة، حتى سقطت دموعي على المخطوطة التي كنت اقرأ أفضل ما بها.