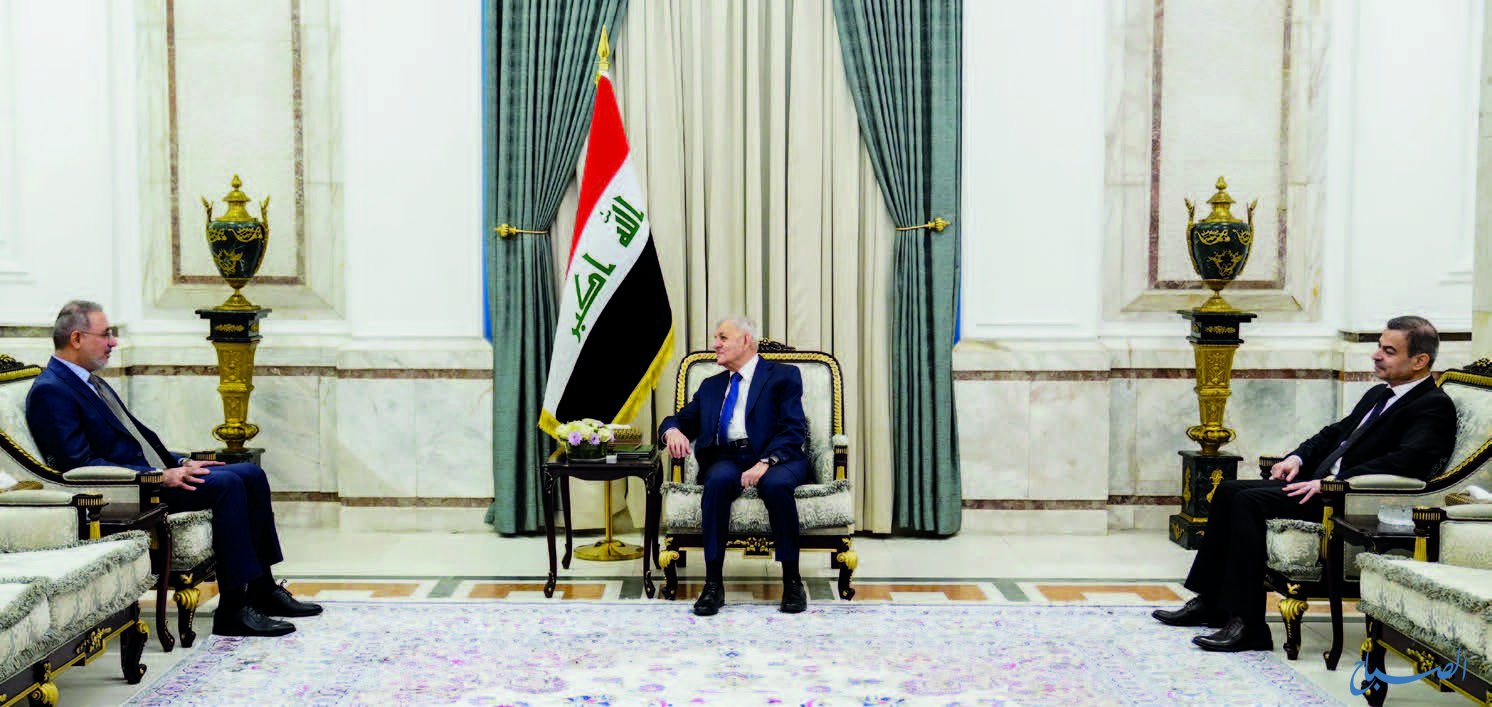زاوية من الأدب المُقارن

ملاك أشرف
ولدت العديد من المذاهب والاِتجاهات في القرنين السّابع عشر والثّامن عشر في أوربا ووصلت ذروة التّطور إلى ما كانَ معقولًا وغير معقولٍ، مُتوقّعًا وغير متوقّعٍ؛ لمّا مرّت بهِ من حركاتٍ وأفعالٍ تنويريّة أطلقوا عليها اليقظة الفكريّة أو النّهضة الحديثة بعدَ عصور الظّلام، التّخلف وسيطرة الكنائِس على النّواحي الاجتماعيّة، الأدبيّة والفنية ومفاصل الحياة الهامّة، قامَ بِها كم من الأُدباء والفلاسفة وبلغوا أشدّ ما بلغوه في القرن التّاسع عشر، وعلى أثرِ هذا نلحظُ تأثيراتٍ عدّة أصابت الأدب المُقارن في مسيرتهِ البحثيّة ورحلتهِ التدوّينيّة التّسجيليّة الاِزدهارية، نشأَ عن كُلِّ ذلكَ مذهبٌ عُرّف باسم الرُّومانتيكيّ (الرُّومانسيّ)، حيث لعبَ دورًا رئيسًا وترك أثرًا كبيرًا بارزًا في تكوينِ الأدب المُقارن وبلورته.
راحَ بعضهم يرى هذا المذهب فاتح العصور الحديثة في الفكرِ والأدب، وفاتح الأبواب للتأثرِ والتّأثير أيّ مُشرعة نوافذه لاستقبال ما هو تجديديّ وبديعيّ من دونِ شروطٍ وقواعد مُعقّدة عسيرة كما كانَ يتّبعُها الكلاسيكيون التّقليديون آنذاك، فمبادئ الرُّومانتيكيّة برمّتِها مُعارضة لمبادئ الكلاسيكيّة ولها مساعيها الدَّؤُوبة والحقيقيّة بمُجملِها في توجيه الدّراسات والمُحاضرات الأدبيَّة إلى ضفّةٍ أُخرى مُختلفة عن الغابرِ، فضلًا عن جهةٍ مُقارنة استحوذَ عليها المذهب الوجدانيّ المعروف باللُّغةِ الشاعريّة الصّافية، الّذي يُعنى بالعاطفةِ المحضة والمقصود هُنا هي المشاعر بتنوِّعها ووسعتها عامّةً.
قال الدّكتور محمّد غنيمي هلال: قد اكتسبت الرُّومانتيكيّة بسبب مُعارضاتها للمبادئ الجامدة المُترسخة وللقضايا الفنّية للأدب ميادين جديدة كانت مُحرمة، وصالت في هذهِ الميادين بنفس الرّوح الثّوريّة الّتي نشأت بِها، وكانت في كُلِّ ذلك مُستجيبة لحاجات المُجتمعات من النّاحية الفنيّة والاجتماعيّة.
إن المسارات الجديدة المُضيئة الّتي تجنحُ إليها الحركة الرُّومانتيكيّة هي نتيجة تجنبها العقل، المنطقيّة المُعتدلة المشبوبة والاعتماد على القلب وهذا يتناقضُ مع الكلاسيكيّة وأرضيتها المبنية على أساسٍ فلسفيّ أرسطي مع تعزّيزٍ ديكارتيّ في الأدب والجمال، شيّدَ أنصار الرُّومانتيكيّة مملكتهم من خلالِ ذوقهم السّليم وصوابهم الحكيم المُرادف للعقل، فتأتي الرّومانتيكيّة إليهم ثائرةً تستدعي بثقةٍ وتمكّنٍ الخيال الخصب والنّزعة الفرديّة الّتي تكمنُ فيها العاطفةُ الجياشةُ والجارفة. شرطها الّذي لا مناصَ منهُ التعرّية، تعرّية الذّات أمامَ النّاس ومُشاركتهم ما يختلج النّفس سواء أكانوا يعلمون بهِ أو لا يعلمون، يعانون منهُ أو لا يعانون.
هيمنت الأنا الحزينة المُنكسّرة على الرّواد الرّومانتيكيين ويمكن القول الأنا البكّاءة الجريحة، وهذهِ الأنا هي السّليمة والسَوِيّة لأنّ الأنا الشّامخة المُتضخمة هي أنا مريضة مُزيفة لاسيّما عندَ الشُّعراء، الشّاعر ذو روحيّة حسّاسة، دقيقة المُلاحظة وثاقبة العين، يصاحبُها حدسٌ غريبٌ ومُخيف في آنٍ واحد فإذن من أين تقبل هذهِ الأنا المُتفخمة؟ تكون بالتّأكيد مُخادعةً مُزورة وليست سليمةً وما يميزُ هؤلاء الرّومانتيكيون وعلى وجهِ الخصوص الشُّعراء منهم هي(أناهُم) الحقيقيّة العاريّة تمامًا، الّتي تجرّدت وأزاحت من على كتفيها زيّفها ومُراوغتها وكشفت ما تعانيه بسبب الحياة القاسية الظّالمة، النّاكرة لوجودها، يجحدون الأقنعة الشعوريّة والرّغبات المغشوشة ويروجون للفلسفةِ العاطفيّة الإنسانيّة الصّادقة وبالتّالي ينظرونَ إلى الشِّعر والأدب بأكملهِ بوصفهِ اِعترافًا صارخًا وكشفًا ضروريًّا.
انصرفَ المذهب الرُّومانتيكيّ المُغاير والحالم إلى تبريرِ غاياته، أهدافه ومُمارساته لشقيقه الكلاسيكيّ، إذ قالَ الرُومانتيكيون لهم إن كانَ أدبكم عقليًّا وإن الحقيقة تنبعُ منهُ ولا شيءَ أجمل من الحقيقة ووحدها أهل للحُبِّ والسّيطرة على كُلِّ شيءٍ فالجمال عندنا هو الأصل ولا حقيقة سواهُ ولا جمال من دونِ حقيقةٍ، والشّاعر تهديه الخاطرة والمشاعر مُباشرةً إلى التّصريحِ البيانيّ البهيّ عكس العقل وتمحيصه للأمور وتقليبها لإنتاجِ ما يخدم المُؤلّف المُنتج قبلَ المُتلقي المُستهلك، هذا الإنتاج جافٌ لا يخلو من رغبةِ أن يطغى على جمهرة القُرّاء والكُتَّاب حينئذٍ.
أنا أرى تغنّي الرّومانتيكيين بالنّفوس باختلافِ شأنها- العظيم والوضيع- وذرف الدّموع على البشريّة والرّحمة بسكان المُجتمعات، الغضب على الظّلمِ والمُناداة بالإنصاف، نظرًا لتركيبةٍ فطريّةٍ مُهذبة تهتمُّ بمصالحَ الأفراد وآمالهم وترجو المثاليّة، الكمال ونبذ المُتمدنين المُنغمسين في الرّذائل وتجاهل الواقع وهذا ما أنشدهُ الكلاسيكيون المُحافظون من أخلاقيّات ووطنيّات على الورقِ فقط وهتافات جماعيّة لَمْ تكن تتماشى أو بالأحرى لَمْ تتماهَ مع الأزمنةِ كافّةً بهيامها التقنينيّ التحديديّ للأجانسِ الأدبيَّة بتوافدها. سَئمَ وضاقَ الرّومانتيكون ذرعًا بهذهِ المفاهيم المُتسلطة الصّارمة، الحبيسة للحرّيات السّاجنة للذوات، مُتخذةً يومها من التّقيد الاستبداديّ طوقًا متينًا لتسييج العباقرة ووضعهم في قوالبَ مصنوعة تحيي ما هو بالي وعفا عليه الزّمن؛ لذا بفضلِ الرّؤى النّافذة والقلوب المُستشعرة استمرت الرُّومانتيكيّة إلى هذهِ اللّحظة وبشرت بميلاد شُعراء وأُدباء يعتنقونها ويرتقونَ بالأدبِ الحديث مرارًا وتكرارًا، أمست ريادة المذهب الذاتيّ الشّاعريّ ساطعةً أكثر في بدايات ومُنتصف القرن العشرين وما تلاهُ من العقود، بعدما وصلت إلى العرب المُتطفلين من الغرب في مطلع القرن الماضي المُنصرم.
علمًا أن أول شخص تحرّك بشكلٍ حثيثٍ لحياكةِ اسم الرُّومانتيكيّة والدّفاع عنهُ هي الأديبة مدام دي ستال ثُمَّ أصبحت أكبر الدّاعين لهذهِ الحركة العاطفيّة الفياضة المُتقدّمة في فرنسا، استعانت بمعرفتِها في الآداب المُتباينة، ثقافتها اللّامعة وسعة اطّلاعها المُتبصِّرة والانتقائيّة في تغذيةِ كُلٍّ ممّن شأنهُ تنمية هذا المذهب والتمهيد لغيرهِ، تبنّت آراء فلاسفة ونقّاد ألمان للنهوضِ بهِ وبالطّابع الفرديّ للأدب؛ بما أن الأعمال الأدبيَّة هي وليدةُ فكرٍ وعبقريّة بشريّة وتقمّص تجارب شخصيّة ثانية.
هُناك علاقةٌ وطيدةٌ بينَ مبادئ الرُّومانتيكيّة ونشأة الأدب المُقارن، بل هي الرّكيزة والعمود الرّئيس في تأسيسهِ وتحوّلاته التدريجيّة؛ باعتبارهِ علمًا من العلومِ الحديثة المُدهشة، تمخضَ برفقتِها وبرفقةِ مَن تلاها من المذاهب الأُخر. بينَ أيدينا قصيدة (ليلة أكتوبر) هي أنموذجٌ وأيقونة للشِّعر الرّومانسيّ الغربيّ للشاعر الفرنسيّ (ألفريد دي موسيه)، تروي قصتهُ الغراميّة مع الكاتبةِ البرّاقة (جورج ساند) فجاءَ في إحدى مقطوعاتها: "الشّاعر: ها هو الدّاء الّذي أدمى فؤادي يتبخرْ/ مثل كابوسٍ مريعْ/ كضبابٍ ينسجُ اللّيل خيوطهْ/ ومع الشّمسِ يضيعْ/ ربَّة الشِّعر:/ أيُّها الشّاعرُ قل لي: أي داء تتشكى؟!/ وأنا أجهلُ كنههْ/ والّذي من أجله أحرم منكَ/وبهِ لا يهدأ الدّمع الغزير".
ثُمَّ أكملَ القصيدة قائلًا بصورٍ مُلتاعة: " الشّاعر:ألمي كانَ وضيعًا يعرفُ النّاس مثالهْ/بيد أنّا عندما نرشفهُ حتّى الثّمالهْ/ قد نظنُّ الغير لَمْ يألم كما نألمُ نحنُ/ ربَّة الشَّعر:/ ليسَ من داء وضيع إن تكن نفسٌ رفيعهْ/ فتحدث يا صديقي فأخ الموت السّكوت/ ولعلَّ البوح يأتي بالنّجاةِ/ فاهدِ للسلوى جناح الكلماتِ".
ولَمْ يكتفِ بهذهِ المقطوعات الشِّعريّة الرّقيقة والمعاني المُتدفّقة، بل استطرد يقول مُترنمًا وهائمًا: "الشّاعر: والآنيا ربَّة شعري هيا غنّي/ وكما في الأيَّام الحلوة- أُغنية ممراحهْ/ ربَّة الشِّعر: هات يا شاعرُ قيثاركَ واعزفْ/ فنسيم اللّيل رفافًا يضوعْ/ الشّاعر: لِمَّ يا قلب اضطرابي؟ / ما الّذي يفزعني؟ من يا ترى يطرقُ بابي؟".
بينما الشّاعر التونسيّ أبو القاسم الشَّابِّيّ (شاعر الخضراء)، رائد الرُّومانتيكيّة العربيّة -ضمن أعلامها الأبرز- الّذي يلتهم التّرجمات الفرنسيّة والإنكليزيّة اِلتهامًا كبيرًا وليسَ جليًا تناوله إياها في أعمالهِ بما فيهِ الكفاية، اللّهم إذا ما كانَ القارئُ ناقدًا ماهرًا غزيرَ الاطّلاع، يلتمس التّأثر من أولِ وهلةٍ، ردّدَ من بعدهِ قصيدةً مُماثلة لقصيدتهِ وأعني هُنا قصيدة ألفريد، مُتأثرًا بِها شاكيًا فيها من وجوم الحياة، عذابها، دائه وغياب الآخر، الّذي يأمّل أن يطرقَ بابه ومن المُؤسف لا يطرق، عنوّنها بالموت فيقولُ فيها الآتي: "يا ربَّةَ الشِّعرِ والأَحلام غنِّيني.. فقد سَئِمْتُ وُجومَ الكونِ مِنْ حينِ/ إنَّ اللَّيالي اللَّواتي ضمَّختْ كَبِدِي.. بالسِّحْرِ أَضْحتْ مع الأَيَّامِ ترميني/ نَاختْ بنفسي مآسيها وما وَجَدَتْ.. قلبًا عطوفًا يُسَلِّيها فَعَزِّيني/ وهدَّ مِنْ خَلَدِي نَوْحٌ تُرَجِّعُهُ.. بَلْوَى الحَيَاةِ وأَحزانُ المَسَاكينِ/ على الحَيَاةِ أَنا أَبكي لشَقْوَتِها.. فمنْ إِذا مُتُّ يبكيها ويبكيني/ يا رَبَّةَ الشِّعْرِ غنِّيني فقد ضَجِرَتْ.. نفسي منَ النَّاسِ أبناءِ الشَّياطينِ/ تَبَرَّمَتْ بينيَ الدُّنيا وأَعوَزَها.. في مِعزفِ الدَّهرِ غرِّيدُ الأَرانينِ/ وفي يديكِ مزاميرٌ يُخالِجُها.. وَحْيُ السَّماءِ فهاتيها وغَنِّيني".
أفردَ الدّارسون أبوابًا عن تأثر الشَّابِّي بغيرهِ من الشُّعراء، هي في الحقيقةِ عنوانات لأبوابٍ جذّابة بشكلٍ مُخاتِل، تستهوي القارئ المُبتدِئ والّذي يجهل تأليف الشَّابِّي، تركيبته وطرائق عيشه فضلًا عن كوّنِها عنواناتٍ مُثيرة؛ لاستقطاب الباحثين الّذين يكرهون الرُّومانتيكيّة وعلى وجهِ الخصوص أدب الشَّابِّي أو الدّارسين الّذين يحاولونَ إثارة الأجواء وإشعالها عندما يجد أحدهم قصائدَ مُتطابقة في المعنى أو قريبة من بعضها بعضًا بينَ الشَّابِّي وشاعر آخر ناهيك عن صنع إنجازات مُشرقة ترفع من مكانتهم الأكاديميّة أو الأدبيّة، أنا لا أنكر حُبّ الشَّابِّي وولعه بالتّرجمات والكتابات العربيّة المهجريّة إلّا أنني لا أستطيع أن أنسى تكوينه العاطفيّ الصّادق ورؤيته للحياة وسعيه للتعبير عن إنسانيتهِ، رهافته، ألمه وعذابه وثورته في أشعارهِ ومُذكراتهِ اللّاتي يحفظنَّ دموعه علاوة على تقديسه للحُبّ والشِّعر وما عليهِ من سماتٍ مُتوهّجة تؤطّرها العذوبة، الحزن الشّفيف والحُرّية، رُبَّما قد تُماثل وتقترب من شاعرٍ مُعيّن وقد تختلف كُلّيًا، بحسب مكنونات القصيدتين، لا يمكنني الجزم!
اِقتفى الشُّعراء العرب أثر الأدب الغربيّ كثيرًا فنحدّقُ دومًا في سعةِ انتشاره في الأدب العربيّ، وهو إلى جانب نماذجه الفريدة باهر للشاعر الجامح الرّافض، ومثال واضح على تجسيد المُعاناة، النّشوة والانسياب الصّوفيّ في أحيانٍ ما، تستمرُّ هذهِ المُقارنات وتطولُ بينَ الآداب أو في الأدب نفسه حتّى، ولكن تُسمى موازنة؛ المُحاكاة مبدأ لا غنّى عنهُ أصلًا والقُرّاء ينتظرونها على وتيرةٍ مُتربصِّةٍ لها لا مُحالة.
يتتبعُ الشّاعرُ القارئ في كُلِّ هذهِ التّكرارات والمُشابهات همومه اليوميّة واِلتقاطاته الفُجائيّة بهدفِ الخلاص أو في سبيلِ التّفتيش عن الحقيقةِ مُتعثرًا بأصغرِ أحجارها البوصليّة الّتي تفضي إلى جوهرِها.
من مُنطلق الجماعة والفردانيّة، الشّخصيّة والعاميّة ومن النسبيّة الشعوريّة الجماليّة والعاطفيّة المُطلقة بالإضافة إلى الآليات المُزاولة في طبيعتها للحصولِ على نتائجَ مُرضيّة، انتشلَ التّعاون اللا إراديّ(العفويّ) بينَ أدبٍ وآخرَ الفنون والآداب بعينها من التّرداد والسّجن المأساويّ، الماكثة فيهِ التّصوّرات والمُعتقدات غير أن الذّائقة الفرديّة والرّغبة الشخصيّة هي مَن انتصرت في الأخيرِ، ما يوجب الانتصار هو الزّعزعةُ الملموسة لثباتيّة التقاليد وقواعدها الأرستقراطيّة المُستقرّة وقتئذٍ.
يعودُ الفضل -بالطّبع- للمُحاكاة الرّشيدة الخلاّقة، فمن غير المنطقيّ أن ننكرها ونشكل حزبًا ضدّها من أجلِ الأصالة،
هذا المُصطلح الأخير الّذي يتوارى خلفَ الجدران (الحواجز) ويقبعُ في الظّلِ على الدّوام، عارفًا أنهُ لا ينفع إن سطعَ وادّعى المُطلق والتّكامل، لَعَمري تبقى الأصالةُ مُتأرجحةً مُتذبذبةً بينَ القلّةِ والمُنتصف، أمّا المُحاكاة العليا فلا يمكن تحقيقها في وجود التّناص وإن تحققت فلَمْ تعدّ مُحاكاةً رشيدةً ناضجة، بل كذب وسرقةً بتعمّدٍ ووعيٍ بلا شكّ.